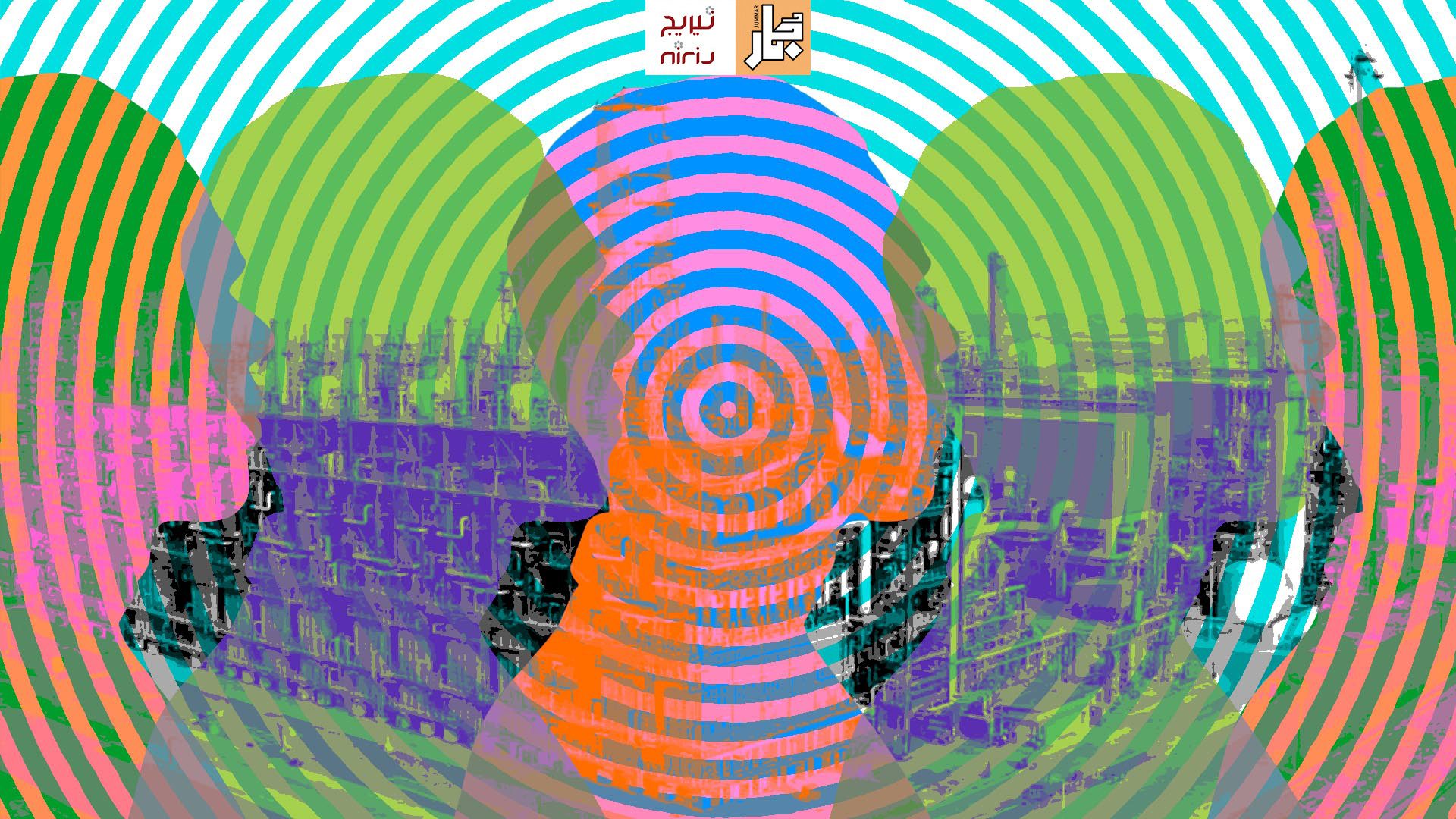حفلات التخرُّج الصاخبة: هل نحال إلى "التقاعد من الحياة" بعد الجامعة؟
20 تموز 2023
الخوف من التخرّج لا يبدأ مع انغلاق وانفتاح عدسات الكاميرا، بل يتعدّى إلى الخوف من السُّمنة، والخوف من انحسار المصروف بسبب غياب أسبابه، والخوف من بقاء الطالبات محبوسات بعد التخرّج وعدم إيجادهنّ وظيفة أو عدم قبول من حولهن بالوظيفة التي يجدنها.. هل نُحال إلى التقاعد من الحياة بعد التخرج؟
خلف الوجوه المُبتسمة للشابات في حفلات التخرج يختفي الكثير مما يتطلب جهداً للتنقيب عنه. ربما تنقيبٌ عن المخاوف من الفرح نفسه، من الكاميرات المترصدة، وخوفٌ من الآتي… من فرص العمل، من المستقبل الذي ينتظرهن بعد التخرج وانتهاء الصور والموسيقى والفرح المبتذل.
“آني شاركت بكل فعاليات التخرج وتوقعت راح احس بفرح قوي مثل اللي تظهره كل فيديوهات التخرج الي اشوفها على موقع الانستغرام.. لكن ما حسيت بشي مختلف مع انه اشتريت روب وقبعة ووشاح ومن أرقى صنف بس اكو قلق بداخلي ماعرف اسميه، منعني استمتع”، تقول ا.س وهي طالبة في كلية القانون في جامعة الكوفة.
استهلاك باهظ للفرح
“طقوس التخرج.. طقوس روتينيّة مملة ومبالغ بيها من ناحية الاهتمام والفلوس المدفوعة واني ما اكدر ادفع كل هذا واصلا تقام بوقت بعيد عن التخرج بأربع شهور”، تقول م.هـ، وهي طالبة في كلية علوم الرياضيات والحاسوب في جامعة الكوفة.
في السنوات الأخيرة، وتحديداً بعد جائحة “كورونا” بات موسم حفلات التخرج حدثاً يتعدّى بهجة العائلة والزملاء والكادر التدريسي بتخرج الطلبة، إلى أن يكون معرضاً للاعتداد بالمظاهر وتوثيق فرح مبهرج، ما حوّل هذه اللحظة المهمة في حياة الطالبة والطالب إلى مجرد استهلاك آخر.
تحت غطاء الشكليات، تُصرف أموال كثيرة ما حدا بأن يصبح محدودو الدخل غير قادرين على المشاركة في لحظة من المفترض أن يتقاسموها مع من تقاسموا معهم مقاعد دراسية لسنوات.
فمثلاً، ساد عدم الاعتماد على زي التخرج الذي تقدمه بعض الكليات بشكل مجاني، بسبب تقادم الزمن عليه أو رداءة المادة المصنوع منها بحيث يبدو رثاً. بالتالي باتت تكاليف التخرج من ألفها إلى يائها تقع على عاتق الطالب نفسه، ومن هذه الحاجة تأسست شركات تنظيم حفلات التخرج، والتي لا يمكن عدّها بالحفلات بقدر ما هي تجمّع لالتقاط صورة جماعية يصحبها غناء ورقص عبر مكبرات الصوت.
والحال هذه، بات الطلبة ملزمين بارتداء بدلات تخرج موحدة تصل قيمتها إلى 50 دولاراً للبنات والذكور، فضلاً عن إيكال مهمة النقش على القبعة والوشاح وصنع باقات الورود لأشخاص مختصين، ما يرفع قيمة التكلفة بالمجمل إلى 100 دولار تقريباً في ظل تضخم اقتصادي واضح.
تخبرنا نور، وهي صاحبة ورشة خاصة بتوفير أرواب وقبعات وأوشحة التخرج المنقوشة منها والمطبوعة، بالإضافة إلى باقات الورد، بأن تكلفة الحصول عليها مجتمعة للطالبة الواحدة يتراوح ما بين 35 إلى 45 ألف دينار عراقي. أما جلسة التصوير الجماعية فتصل تكلفتها إلى 25 ألف دينار عراقي للطالب الواحد.
كما يخبرنا أمير الشمس، وهو صاحب مجموعة المشمشي لتصوير حفلات التخرج، أن المبلغ يرتفع إلى 35 ألف دينار في بعض الأحيان عندما يرتكب منظم الحفل المنتخب من قبل الطلاب فساداً، فيوفر عشرة آلاف دينار من كل طالب لصالح جيبه الخاص. إلى كل هذا تُضاف مصاريف تأجير قاعة الاحتفال وتكلفة الضيافة فيها وتأجير السيارات التي تحيي زفة الطلبة فتجوب المدينة، وغيرها من المصاريف التي تتمثل بعمل بوسترات كبيرة الحجم في الكليات أو تكلفة جلسات التصوير الخاصة.
وهناك أيضاً تكاليف التجميل لدى النساء.
يُترجم الفرح إلى استهلاك واستغراق في الشكلية والبذخ، ومع ذلك فطالبة القانون وعلى الأغلب زميلاتها كذلك، كانت مدركة أن تلك الفرحة يجب استنفادها كاملة، فهي لحظية ولا تشكل بارقة أمل نحو مستقبل واضح ومأمول، كما قالت.
أفراح ليست لهن
“رقصت بالكوستر أثناء الروحة لموقع التقاط الصورة الجماعية.. صفكت وغنيت وعبرت عن فرحتي”، تقول ف.ف وهي طالبة في كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة كركوك.
فيما تصفق اليدان للزملاء من الذكور وهم يعبرون عن فرحهم متراقصين على صوت الدبكات العشائرية التي تمجد الأسلحة والذكورة فتصير فلكاً يدورون حوله، لا تحرك الطالبات أجسادهن إلا بتمايل بسيط بتزييف للرزانة وتأجيل للاستمتاع لحين توفّر المكان الآمن، حيث تجد الطالبات أنفسهن مكتفات مكبلات بقيود غير مرئية، غير قادرات على أن يعبرن عن فرحهن، وذلك تحسباً من ألا يدنسن “قدسية” أو يخرقن حرمة حرم جامعي أو ملعب رياضي، وهي قداسة وحرمة لا يُعرف متى تظهر، فهي أداة مطواعة لرفض أي تصرّف غير مألوف حتى وإن كان عادياً جداً.
طالبة التربية الرياضية والبدنية من جامعة بابل والتي رقصت في حفل تخرّجها الذي انعقد في ملعب النجف الرياضي، تحولت خلال ساعات إلى محتوى رائج، وسبباً إضافياً في فرض ضوابط على حفلات التخرج من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.
أظهرت تعليقات الشابات ومن حسابات غير معروفة الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي كم العطش لدى الفتيات للفرح وتعبيره، فقلن “شكد حلو واحد يكدر يركص.. احنا لازم نروح للجم حتى نركص؟!” وغيرها التي عبرت عن خنق حرية التعبير عن الفرح ومحاولات الطالبات للبحث عن بدائل لعيشه.
الحال هذه، تتمايل الطالبات في حفلات التخرج ولا يرقصن، وغالبيتهن العظمى، وخاصة طالبات جامعات الوسط والجنوب، يحاولن ألا تلتقطهن عدسة كاميرا متطفلة، إذ تخاف أن تصطادها إحدى الكاميرات التي تدعي انها تتغزل بجمالها عندما تبثها في مواقع التواصل الاجتماعي، لتُشيطن وتُعهَّر بعدئذ، بل والإشادة بغيرها ممن يثقلن الأغطية على أجسادهن كنوع من النبذ المجتمعي غير المباشر بطريق التفضيل.
إلى جانب الخوف من اللحظة الآنية والعدسات التي تترصدها في كل زاوية، هناك ذاك الخوف الداخلي من القادم: الخوف من السمنة بعد غياب الدوام وهجوم وحش الأكل العاطفي وهناك الخوف من انحسار المصروف بسبب غياب أسبابه وهي التعليم الجامعي، والخوف من البقاء محبوسات بعد التخرج وعدم إيجادهن وظيفة أو عدم قبول من حولهن بالوظيفة التي تجدها.
خريجات بلا عمل
“الخوف من شعور الركود في البيئة نفسها دون حدوث تغيير.. الخوف من الفشل بعد دراسة متعبة.. ان سنوات الدراسة ذهبت عبثا.. الخوف من عدم توفر فرصة عمل مناسبة”، تقول م.ا، طالبة في معهد نبض القلب للتدريب الطبي في بغداد.
هذا الخوف مشروع لدى الخريجات والخريجين في العراق، إذ ينتهي مصير ما يقارب 180 ألفاً منهم سنوياً إلى البطالة الآخذة بالاتساع، حتى وصلت إلى 16.5% حسب مسح للقوى العاملة في العراق لسنة ٢٠٢١ الذي أجرته وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتشكل معدل بطالة الإناث 28.2 بالمئة أي ضعف معدل بطالة الذكور البالغة 14.7 بالمئة.
تتخوف النساء من البقاء بلا عمل ولمدة غير محددة الأجل قد تصل إلى سنوات طويلة، بالذات إذا كنّ يتوخّين التعيين الحكومي. كما أن ثمة صعوبات جمة في العمل ضمن القطاع الخاص، حيث أن الأجر الذي تتقاضاه النساء قليل، كما يواجهن الاهانة والتحرش وممارسات وتفوهات ذكورية ونمطية شديدة ضد النساء. حيث أظهر استبيان نشره مركز البيان للدراسات والتخطيط أن 70 بالمئة من حالات التحرش بالعمل حدثت في القطاع الخاص، إذ يكون العمل معدوم الضمانات والحقوق التي تحمي الموظفات من التعدي وتحفظ الأمان الوظيفي، حيث بإمكان ربّ العمل تسريحهن متى رغب في ظل عدم وجود عقود أو بعقود لكن غير موثقة، إلى جانب تباطؤ سيرورة التقاضي لدى محاكم العمل بحيث تضطر الفتيات القبول بالأمر الواقع دون اللجوء إلى القضاء.
تقول س.ن، وهي طالبة في كلية اللغات جامعة الكوفة شاركت بطقوس التخرج، “أقاوم شعورا مؤلما بالضياع وأسأل أين المكان المناسب لفتاة مثلي أفكارها وشخصيتها مختلفة وحتى طريقة لبسها.. بعض الأماكن يفرضون لبسا معينا وهذا ضد مبادئي.. أنا لا أستطيع أن أعمل بمكان يريد وصاية على لبسي ومظهري الخارجي”.
عملت س.ن في السابق بالقطاع الخاص، وحصدت العديد من التجارب الاجتماعية والعملية، لكن في رحلتها للبحث عن العمل عرض عليها أحد المدراء أن يمنحها راتباً شهرياً من دون عمل حسب كلامه، “أنت جميلة جداً وما نحب نتعبج)”.
حياة ما بعد التخرّج.. تقوقع وانعزال
حالما تنتهي الدراسة ينضم الخريجون الجدد إلى ملايين العراقيين الذين يفكرون بمخرج من أزمات العيش المتراكمة في العراق، الذي بات ينقسم أغلبيته إلى أناس غير قادرين أن يكونوا مواطنين، وإلى ساسة يفتقدون للمسؤولية تجاه الشعب حيث بنوا لهم مباني وحصّلوا رواتب انفجارية تسهل عليهم حياتهم.
كثيرون من أبناء الجيل الشاب فكروا في الهجرة وجزء كبير منهم هاجر بالفعل، على الرغم من كل الصعاب والمخاطر التي تواجههم في طريق الهجرة. لكن بالنسبة للنساء فحتى خيار التفكير بالهجرة غير مسموح، فإما أن تعمل أو أن تتزوج أو أن تبقى حبيسة المنزل والعمل الرعائي اليومي والممل.
ما بات واضحاً أن ثمة كثراً ممن لا يهاجرون إلى خارج العراق، أصبحوا يهاجرون إلى دواخلهم حيث يعيشون في قوقعة ضيقة ما تفتأ تصغر يوماً بعد يوم، حيث يعتكفون داخل عتمة نفسية يتنقلون فيها ما بين مخاوف ثم قلق ثم محاولة حل ثم فشل ثم موجة اكتئاب ثم تخفيف وطبطبة من النفس للنفس ثم معاودة المخاوف. في ظل كل هذا ليس بالغريب أن يعاني العراقيون والعراقيات من هشاشة نفسية!
تتقوقع النساء بشكل خاص في هذه الفردانية بسبب تقييد حرية التنقل ومحدودية الخيارات وسياسات دفعهن نحو الفضاء الخاص فيقضين غالبية وقتهن داخل المنزل، مقابل الرجال الذين لديهم مساحة كافية من أجل التنزه أو لقاء الاصدقاء أو العمل بأعمال متعددة غير محددة مجتمعياً، فغالبية النساء لا يملكن وقتهن الذي يقضين أغلبه داخل المنزل وما تبقى داخل العالم الافتراضي في مواقع التواصل الاجتماعي المليئة بالمحتوى المسموم والذي يحذرها حتى من الأقربين إليها.
بالنسبة للخريجات الجدد، وقد غادرن سنيّ الجامعة ماضيات إلى مستقبل غير معلوم، تكبلهن هذه التقييدات، ويبتن حبيسات حالة انتظار على أمل الإفراج عنهن بالعمل أو الزواج. كما يحدّ هذا التقوقع قدرتهن على التواصل مع أخريات وآخرين، حتى بتن غير قادرات حتى على البحث عن أخريات لبناء تنظيمات وشبكات تعزيز ودعم تزيد من قوتهن لمواجهة العالم خلف الجدران، بل وتُبنى المزيد من الجدران التي تضعف الشباب والشابات ككتلة تجمعها هموم واحدة في وجه السلطة، ويخلخل الأرضية التي من شأنها أن تؤسس لأفكار حول إمكانيات التنظيم السياسي والمجتمعي.
إذا كانت هناك حياة لا بد أن تكون صاخبة فهي حياة ما بعد التخرج، حيث من المفترض أن تحول كل الهموم تلك لتكون محركاً لتغيير السلطة والدفع بها، بدل التفكير بأن قضايا مثل البطالة وتدهور الاقتصاد والمناخ والتعليم والصحة وتثبيت إقصاء النساء كسياسة تعامل مع المواطنات وغيرها الكثير، هي قضايا لا شأن للمواطنين والمواطنات بها، بالذات الشباب منهم المقبلين على الحياة، بل تخص الساسة وحدهم والمتأثرين المباشرين بها، فيتعامل هؤلاء الشباب والشابات مع أنفسهم كمفعول بهم لا فاعلين أساسيين في هذا المجتمع في حالة من اللامبالاة السعيدة.
فهل نستطيع أخراج أنفسنا من هذا الوضع من تلقاء أنفسنا بما أن الدولة متنصلة عن دورها في توفير أسس المواطنة الصحيحة؟ كيف سنخرج أنفسنا من هجرة تبعدنا عن المجتمع تبدو للظاهر “طوعية”؟
البحث عن معنى للحياة لن نجده في مقاطع الريلز على الانستغرام أو بضع مشاهد من فيلم أو مسلسل تعكس سعادة غير حقيقية. ولا حررت اللامبالاة السعيدة يوماً شعباً أو رفعت من مستوى معيشته. الحل فقط عبر التواصل والتنظيم والرفض والاحتجاج لتغيير هذا الواقع لا الهروب منه بشكل جماعي وكأن ما يحدث قدري وغير قابل للحل.. وكأن التخرج بات إحالة إلى التقاعد من الحياة لا الانطلاق إليها.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
خلف الوجوه المُبتسمة للشابات في حفلات التخرج يختفي الكثير مما يتطلب جهداً للتنقيب عنه. ربما تنقيبٌ عن المخاوف من الفرح نفسه، من الكاميرات المترصدة، وخوفٌ من الآتي… من فرص العمل، من المستقبل الذي ينتظرهن بعد التخرج وانتهاء الصور والموسيقى والفرح المبتذل.
“آني شاركت بكل فعاليات التخرج وتوقعت راح احس بفرح قوي مثل اللي تظهره كل فيديوهات التخرج الي اشوفها على موقع الانستغرام.. لكن ما حسيت بشي مختلف مع انه اشتريت روب وقبعة ووشاح ومن أرقى صنف بس اكو قلق بداخلي ماعرف اسميه، منعني استمتع”، تقول ا.س وهي طالبة في كلية القانون في جامعة الكوفة.
استهلاك باهظ للفرح
“طقوس التخرج.. طقوس روتينيّة مملة ومبالغ بيها من ناحية الاهتمام والفلوس المدفوعة واني ما اكدر ادفع كل هذا واصلا تقام بوقت بعيد عن التخرج بأربع شهور”، تقول م.هـ، وهي طالبة في كلية علوم الرياضيات والحاسوب في جامعة الكوفة.
في السنوات الأخيرة، وتحديداً بعد جائحة “كورونا” بات موسم حفلات التخرج حدثاً يتعدّى بهجة العائلة والزملاء والكادر التدريسي بتخرج الطلبة، إلى أن يكون معرضاً للاعتداد بالمظاهر وتوثيق فرح مبهرج، ما حوّل هذه اللحظة المهمة في حياة الطالبة والطالب إلى مجرد استهلاك آخر.
تحت غطاء الشكليات، تُصرف أموال كثيرة ما حدا بأن يصبح محدودو الدخل غير قادرين على المشاركة في لحظة من المفترض أن يتقاسموها مع من تقاسموا معهم مقاعد دراسية لسنوات.
فمثلاً، ساد عدم الاعتماد على زي التخرج الذي تقدمه بعض الكليات بشكل مجاني، بسبب تقادم الزمن عليه أو رداءة المادة المصنوع منها بحيث يبدو رثاً. بالتالي باتت تكاليف التخرج من ألفها إلى يائها تقع على عاتق الطالب نفسه، ومن هذه الحاجة تأسست شركات تنظيم حفلات التخرج، والتي لا يمكن عدّها بالحفلات بقدر ما هي تجمّع لالتقاط صورة جماعية يصحبها غناء ورقص عبر مكبرات الصوت.
والحال هذه، بات الطلبة ملزمين بارتداء بدلات تخرج موحدة تصل قيمتها إلى 50 دولاراً للبنات والذكور، فضلاً عن إيكال مهمة النقش على القبعة والوشاح وصنع باقات الورود لأشخاص مختصين، ما يرفع قيمة التكلفة بالمجمل إلى 100 دولار تقريباً في ظل تضخم اقتصادي واضح.
تخبرنا نور، وهي صاحبة ورشة خاصة بتوفير أرواب وقبعات وأوشحة التخرج المنقوشة منها والمطبوعة، بالإضافة إلى باقات الورد، بأن تكلفة الحصول عليها مجتمعة للطالبة الواحدة يتراوح ما بين 35 إلى 45 ألف دينار عراقي. أما جلسة التصوير الجماعية فتصل تكلفتها إلى 25 ألف دينار عراقي للطالب الواحد.
كما يخبرنا أمير الشمس، وهو صاحب مجموعة المشمشي لتصوير حفلات التخرج، أن المبلغ يرتفع إلى 35 ألف دينار في بعض الأحيان عندما يرتكب منظم الحفل المنتخب من قبل الطلاب فساداً، فيوفر عشرة آلاف دينار من كل طالب لصالح جيبه الخاص. إلى كل هذا تُضاف مصاريف تأجير قاعة الاحتفال وتكلفة الضيافة فيها وتأجير السيارات التي تحيي زفة الطلبة فتجوب المدينة، وغيرها من المصاريف التي تتمثل بعمل بوسترات كبيرة الحجم في الكليات أو تكلفة جلسات التصوير الخاصة.
وهناك أيضاً تكاليف التجميل لدى النساء.
يُترجم الفرح إلى استهلاك واستغراق في الشكلية والبذخ، ومع ذلك فطالبة القانون وعلى الأغلب زميلاتها كذلك، كانت مدركة أن تلك الفرحة يجب استنفادها كاملة، فهي لحظية ولا تشكل بارقة أمل نحو مستقبل واضح ومأمول، كما قالت.
أفراح ليست لهن
“رقصت بالكوستر أثناء الروحة لموقع التقاط الصورة الجماعية.. صفكت وغنيت وعبرت عن فرحتي”، تقول ف.ف وهي طالبة في كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة كركوك.
فيما تصفق اليدان للزملاء من الذكور وهم يعبرون عن فرحهم متراقصين على صوت الدبكات العشائرية التي تمجد الأسلحة والذكورة فتصير فلكاً يدورون حوله، لا تحرك الطالبات أجسادهن إلا بتمايل بسيط بتزييف للرزانة وتأجيل للاستمتاع لحين توفّر المكان الآمن، حيث تجد الطالبات أنفسهن مكتفات مكبلات بقيود غير مرئية، غير قادرات على أن يعبرن عن فرحهن، وذلك تحسباً من ألا يدنسن “قدسية” أو يخرقن حرمة حرم جامعي أو ملعب رياضي، وهي قداسة وحرمة لا يُعرف متى تظهر، فهي أداة مطواعة لرفض أي تصرّف غير مألوف حتى وإن كان عادياً جداً.
طالبة التربية الرياضية والبدنية من جامعة بابل والتي رقصت في حفل تخرّجها الذي انعقد في ملعب النجف الرياضي، تحولت خلال ساعات إلى محتوى رائج، وسبباً إضافياً في فرض ضوابط على حفلات التخرج من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.
أظهرت تعليقات الشابات ومن حسابات غير معروفة الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي كم العطش لدى الفتيات للفرح وتعبيره، فقلن “شكد حلو واحد يكدر يركص.. احنا لازم نروح للجم حتى نركص؟!” وغيرها التي عبرت عن خنق حرية التعبير عن الفرح ومحاولات الطالبات للبحث عن بدائل لعيشه.
الحال هذه، تتمايل الطالبات في حفلات التخرج ولا يرقصن، وغالبيتهن العظمى، وخاصة طالبات جامعات الوسط والجنوب، يحاولن ألا تلتقطهن عدسة كاميرا متطفلة، إذ تخاف أن تصطادها إحدى الكاميرات التي تدعي انها تتغزل بجمالها عندما تبثها في مواقع التواصل الاجتماعي، لتُشيطن وتُعهَّر بعدئذ، بل والإشادة بغيرها ممن يثقلن الأغطية على أجسادهن كنوع من النبذ المجتمعي غير المباشر بطريق التفضيل.
إلى جانب الخوف من اللحظة الآنية والعدسات التي تترصدها في كل زاوية، هناك ذاك الخوف الداخلي من القادم: الخوف من السمنة بعد غياب الدوام وهجوم وحش الأكل العاطفي وهناك الخوف من انحسار المصروف بسبب غياب أسبابه وهي التعليم الجامعي، والخوف من البقاء محبوسات بعد التخرج وعدم إيجادهن وظيفة أو عدم قبول من حولهن بالوظيفة التي تجدها.
خريجات بلا عمل
“الخوف من شعور الركود في البيئة نفسها دون حدوث تغيير.. الخوف من الفشل بعد دراسة متعبة.. ان سنوات الدراسة ذهبت عبثا.. الخوف من عدم توفر فرصة عمل مناسبة”، تقول م.ا، طالبة في معهد نبض القلب للتدريب الطبي في بغداد.
هذا الخوف مشروع لدى الخريجات والخريجين في العراق، إذ ينتهي مصير ما يقارب 180 ألفاً منهم سنوياً إلى البطالة الآخذة بالاتساع، حتى وصلت إلى 16.5% حسب مسح للقوى العاملة في العراق لسنة ٢٠٢١ الذي أجرته وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتشكل معدل بطالة الإناث 28.2 بالمئة أي ضعف معدل بطالة الذكور البالغة 14.7 بالمئة.
تتخوف النساء من البقاء بلا عمل ولمدة غير محددة الأجل قد تصل إلى سنوات طويلة، بالذات إذا كنّ يتوخّين التعيين الحكومي. كما أن ثمة صعوبات جمة في العمل ضمن القطاع الخاص، حيث أن الأجر الذي تتقاضاه النساء قليل، كما يواجهن الاهانة والتحرش وممارسات وتفوهات ذكورية ونمطية شديدة ضد النساء. حيث أظهر استبيان نشره مركز البيان للدراسات والتخطيط أن 70 بالمئة من حالات التحرش بالعمل حدثت في القطاع الخاص، إذ يكون العمل معدوم الضمانات والحقوق التي تحمي الموظفات من التعدي وتحفظ الأمان الوظيفي، حيث بإمكان ربّ العمل تسريحهن متى رغب في ظل عدم وجود عقود أو بعقود لكن غير موثقة، إلى جانب تباطؤ سيرورة التقاضي لدى محاكم العمل بحيث تضطر الفتيات القبول بالأمر الواقع دون اللجوء إلى القضاء.
تقول س.ن، وهي طالبة في كلية اللغات جامعة الكوفة شاركت بطقوس التخرج، “أقاوم شعورا مؤلما بالضياع وأسأل أين المكان المناسب لفتاة مثلي أفكارها وشخصيتها مختلفة وحتى طريقة لبسها.. بعض الأماكن يفرضون لبسا معينا وهذا ضد مبادئي.. أنا لا أستطيع أن أعمل بمكان يريد وصاية على لبسي ومظهري الخارجي”.
عملت س.ن في السابق بالقطاع الخاص، وحصدت العديد من التجارب الاجتماعية والعملية، لكن في رحلتها للبحث عن العمل عرض عليها أحد المدراء أن يمنحها راتباً شهرياً من دون عمل حسب كلامه، “أنت جميلة جداً وما نحب نتعبج)”.
حياة ما بعد التخرّج.. تقوقع وانعزال
حالما تنتهي الدراسة ينضم الخريجون الجدد إلى ملايين العراقيين الذين يفكرون بمخرج من أزمات العيش المتراكمة في العراق، الذي بات ينقسم أغلبيته إلى أناس غير قادرين أن يكونوا مواطنين، وإلى ساسة يفتقدون للمسؤولية تجاه الشعب حيث بنوا لهم مباني وحصّلوا رواتب انفجارية تسهل عليهم حياتهم.
كثيرون من أبناء الجيل الشاب فكروا في الهجرة وجزء كبير منهم هاجر بالفعل، على الرغم من كل الصعاب والمخاطر التي تواجههم في طريق الهجرة. لكن بالنسبة للنساء فحتى خيار التفكير بالهجرة غير مسموح، فإما أن تعمل أو أن تتزوج أو أن تبقى حبيسة المنزل والعمل الرعائي اليومي والممل.
ما بات واضحاً أن ثمة كثراً ممن لا يهاجرون إلى خارج العراق، أصبحوا يهاجرون إلى دواخلهم حيث يعيشون في قوقعة ضيقة ما تفتأ تصغر يوماً بعد يوم، حيث يعتكفون داخل عتمة نفسية يتنقلون فيها ما بين مخاوف ثم قلق ثم محاولة حل ثم فشل ثم موجة اكتئاب ثم تخفيف وطبطبة من النفس للنفس ثم معاودة المخاوف. في ظل كل هذا ليس بالغريب أن يعاني العراقيون والعراقيات من هشاشة نفسية!
تتقوقع النساء بشكل خاص في هذه الفردانية بسبب تقييد حرية التنقل ومحدودية الخيارات وسياسات دفعهن نحو الفضاء الخاص فيقضين غالبية وقتهن داخل المنزل، مقابل الرجال الذين لديهم مساحة كافية من أجل التنزه أو لقاء الاصدقاء أو العمل بأعمال متعددة غير محددة مجتمعياً، فغالبية النساء لا يملكن وقتهن الذي يقضين أغلبه داخل المنزل وما تبقى داخل العالم الافتراضي في مواقع التواصل الاجتماعي المليئة بالمحتوى المسموم والذي يحذرها حتى من الأقربين إليها.
بالنسبة للخريجات الجدد، وقد غادرن سنيّ الجامعة ماضيات إلى مستقبل غير معلوم، تكبلهن هذه التقييدات، ويبتن حبيسات حالة انتظار على أمل الإفراج عنهن بالعمل أو الزواج. كما يحدّ هذا التقوقع قدرتهن على التواصل مع أخريات وآخرين، حتى بتن غير قادرات حتى على البحث عن أخريات لبناء تنظيمات وشبكات تعزيز ودعم تزيد من قوتهن لمواجهة العالم خلف الجدران، بل وتُبنى المزيد من الجدران التي تضعف الشباب والشابات ككتلة تجمعها هموم واحدة في وجه السلطة، ويخلخل الأرضية التي من شأنها أن تؤسس لأفكار حول إمكانيات التنظيم السياسي والمجتمعي.
إذا كانت هناك حياة لا بد أن تكون صاخبة فهي حياة ما بعد التخرج، حيث من المفترض أن تحول كل الهموم تلك لتكون محركاً لتغيير السلطة والدفع بها، بدل التفكير بأن قضايا مثل البطالة وتدهور الاقتصاد والمناخ والتعليم والصحة وتثبيت إقصاء النساء كسياسة تعامل مع المواطنات وغيرها الكثير، هي قضايا لا شأن للمواطنين والمواطنات بها، بالذات الشباب منهم المقبلين على الحياة، بل تخص الساسة وحدهم والمتأثرين المباشرين بها، فيتعامل هؤلاء الشباب والشابات مع أنفسهم كمفعول بهم لا فاعلين أساسيين في هذا المجتمع في حالة من اللامبالاة السعيدة.
فهل نستطيع أخراج أنفسنا من هذا الوضع من تلقاء أنفسنا بما أن الدولة متنصلة عن دورها في توفير أسس المواطنة الصحيحة؟ كيف سنخرج أنفسنا من هجرة تبعدنا عن المجتمع تبدو للظاهر “طوعية”؟
البحث عن معنى للحياة لن نجده في مقاطع الريلز على الانستغرام أو بضع مشاهد من فيلم أو مسلسل تعكس سعادة غير حقيقية. ولا حررت اللامبالاة السعيدة يوماً شعباً أو رفعت من مستوى معيشته. الحل فقط عبر التواصل والتنظيم والرفض والاحتجاج لتغيير هذا الواقع لا الهروب منه بشكل جماعي وكأن ما يحدث قدري وغير قابل للحل.. وكأن التخرج بات إحالة إلى التقاعد من الحياة لا الانطلاق إليها.