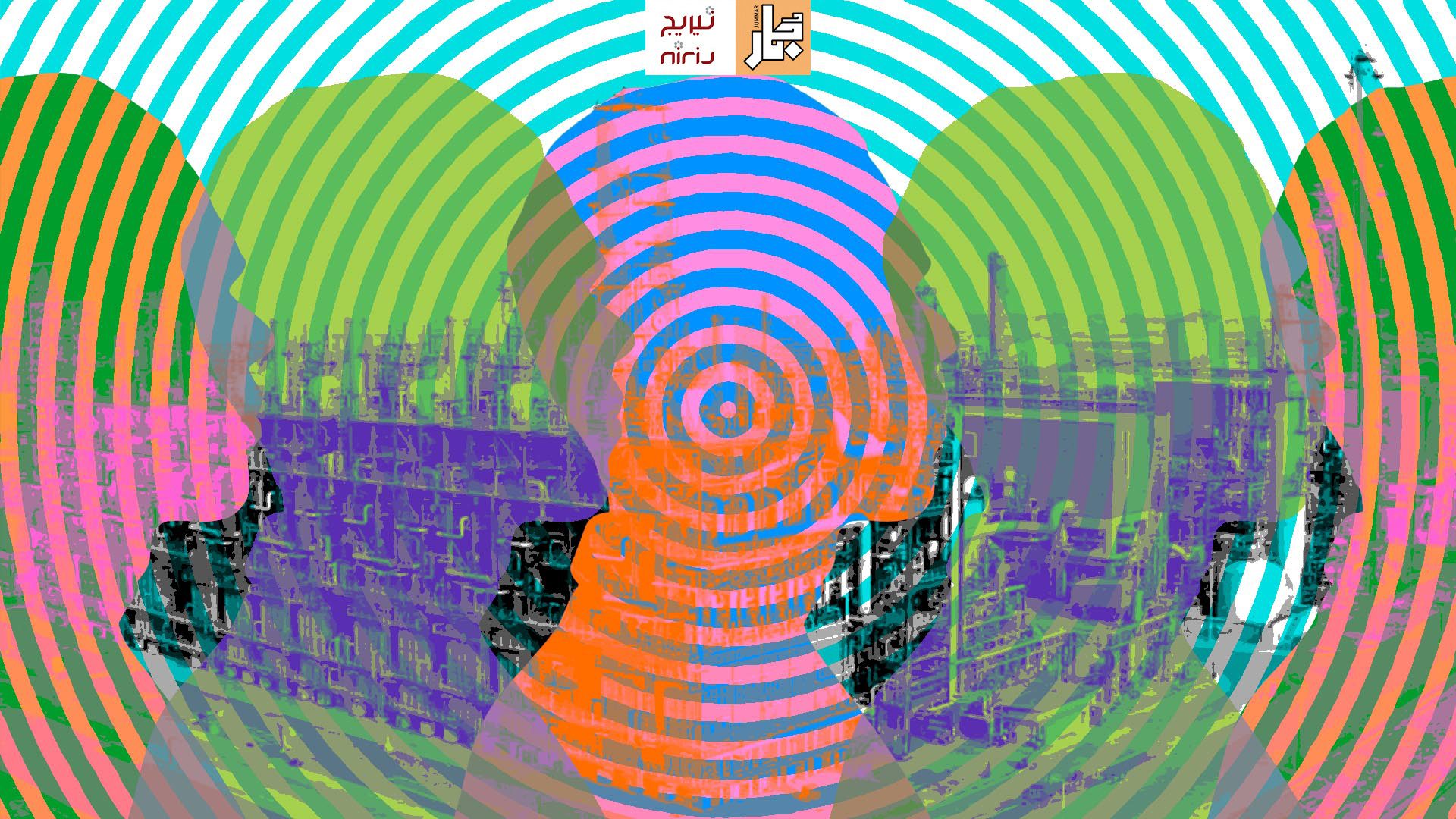من "البرنو" إلى "الثقيل".. عن السلاح الذي لن تنجح حكومة السوداني بحصره
28 آذار 2024
لو خصصت حكومة السوداني مليون دينار لكل قطعة سلاح -كأقل سعر مغرٍ-، فلن تنجح سوى بجمع 15 ألف قطعة سلاح كحد أعلى، وهي نسبة لا تشكل غير 1 بالألف أو 0.1%، من إجمالي السلاح الموجود بيد المدنيين.. عن السلاح الذي لن تنجح حكومة السوداني بحصره
كان صدام حسين جالساً بينما كان شيوخ عشائر من محافظة النجف يلوّحون ببنادق متنوعة على أنغام الأهازيج التي تُنشَد أمامه، كانت البنادق المرفوعة قديمة الصنع، من جنس تلك التي استُخدمت في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، كثير منها من نوع “البرنو”، وهو سلاح لازَمَ العشائر العراقية بعد المعارك التي خاضوها مع العثمانيين بمساعدة الإنكليز، أو بالعكس في بعض المناطق والولايات قبل نشوء العراق الحديث.
لم يكن وجود السلاح بيد العشائر العراقية قبل 2003 أمراً غريباً، فهو رفيق دائم للرجال، لاسيما شيوخ ورؤوس ورموز العشائر، وكانت للبنادق أهمية ومكانة خاصة لديهم، وتطلق عليها أسماء “الدلع” وتتغنى بها الأشعار والأغاني، ولعل تسمية “أم اعريف” مصداق على ذلك، جنباً إلى جنب مع التسميات الأخرى مثل الجعازة والدنكَية، وغالباً ما تشتق الأسماء من الشكل الخارجي للبندقية.
تعدّدت مصادر أسلحة العشائر العراقية قبل 2003، بين وراثتها من الآباء والأجداد، أو التهريب ولاسيما في المحافظات التي تجمعها حدود مع بلدان مجاورة، وكانت الدولة أيضاً مصدراً لسلاح رموز العشائر، عندما كان رئيس النظام السابق صدام حسين يُهدي شيوخ العشائر مسدسات شخصية مرخصة، خصوصاً في فترة التسعينات عندما بدأ بصناعة شيوخ موالين له و”تشييخهم” على العشائر في ما بات يعرف لاحقاً بـ”شيوخ التسعين”، في إشارة إلى كونهم شيوخاً مزيفين وصناعة النظام، كما يُعرف في الأوساط العشائرية الآن.
وعلى الرغم من “القبضة الحديدية” لنظام صدام حسين، لم يكن صعباً أن يتسرب السلاح إلى البيوت والقرى، ليظهر في ما بعد خلال الأعراس والمآتم، أو في حالات أخرى كالثأر والنزاعات القبلية، على ضيق نطاقها، أو بمناسبات نادرة كمحاولة اغتيال صدام حسين، كما حدث في الدجيل عام 1982، المدينة الشيعية التي تقع ضمن محافظة صلاح الدين، مسقط رأس ونشأة صدام حسين، أو أن يكون الهدف الانقلاب على نظام الحكم باستخدام الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب كما حدث عام 1991 في ما يُعرف بالانتفاضة الشعبانية، والتي ترتبط بالمعارضة الشيعية الإسلامية لحكم صدام حسين، وفي جميع هذه الأحداث كانت بندقية الكلاشنكوف AK47 وبقيت في ما بعد، السلاح المتصدر في جميع أحداث التمرد والنزاعات المسلحة لاحقاً.
كيف تسرّبت البنادق؟
بعد أن كان الحصول على السلاح قبل عام 2003 للفئات المدنية غير المرتبطة بالسلطة، مخاطرة تستدعي أن يقابلها هدف يستحق، لم يعد الأمر كذلك فور بدء الغزو الأمريكي للعراق في آذار من ذلك العام. أبواب المشاجب ومخازن الأسلحة فُتحت للنهب، والأسلحة التي تُركت في الأبنية التي تمركز بها أفراد الجيش وعناصر حزب البعث أصبحت متاحة لأبناء المناطق السكنية، بعد هروب عناصر الجيش والحزب، وكانت الأسلحة أول شيء عليهم تركه وراءهم لضمان سلامتهم، خصوصاً مع تحولهم فجأة إلى مطارَدين، تبحث عنهم كيانات مسلحة جديدة في الساحة مثل “فيلق بدر” الذي دخل العراق من الحدود الإيرانية، مع سلاحه، فور بدء تهاوي النظام.
بعد سنوات من الشعور بالقهر، واحتكار القوّة بيد النظام، ظهرت ونَمَت رغبة عامة باقتناء السلاح في العراق، وكان انفلات الأمن سبباً إضافياً لاقتنائه بغية الحماية الذاتية.
لم تكن معركة “الحواسم” في 2003، غيمة أسقطت مطرها لمرة واحدة، بل ينبوع تفجّر وتحوّل إلى نهر سيجري لسنوات لاحقة.
بمرور الأيام، ستكون القوات الأمريكية في العراق مصدراً إضافياً لسلاح المدنيين، وبأشكال عدة، إما عبر تسرب السلاح الذي ستزود به القوات الأمنية العراقية الناشئة، أو من خلال المعارك التي ستخوضها عناصر “المقاومة” السنية، وفي ما بعد الشيعية المتمثلة بجيش المهدي، والاستيلاء على الأسلحة الأمريكية التي لم يسبق ليد عراقيّة أن اختبرتها، بعد أن كانت الأسلحة السوفيتية هي الماركة المسجلة في العراق.
في 2006، رصدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مسدس غلوك الأمريكي الذي تم توزيعه على عناصر الشرطة العراقية معروضاً للبيع في محل بقالة، وكذلك بنادق كلاشنكوف غير مستخدمة، كانت من بين 370 ألف قطعة سلاح اشترتها القوات الأمريكية لعناصر الأمن العراقي، قبل أن تتسرّب إلى متاجر البقالة والحرب.

كانت تجارة مربحة وقتذاك، مع تزايد الطلب عليها خلال الحرب الأهلية الطائفية، وكانت الأسعار تتصاعد مع تزايد الطلب فبلغ سعر بندقية الكلاشنكوف حينها 650 دولاراً بعد أن كانت بـ 450 دولاراً في العام الذي قبله.
وبالطريقة ذاتها، عُرضت بندقية (M4) الأمريكية للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أكدت تقارير أمريكية حينها فقدان أثر نحو 200 ألف قطعة من السلاح الذي قدمته إلى القوات العراقية بواقع 110 آلاف بندقية AK-47، و80 ألف مسدس غلوك، بما يعادل 57% من إجمالي الأسلحة التي سلمتها القوات الأمريكية إلى القوات العراقية بين حزيران 2004 وأيلول 2005.
شعار قديم.. ركن ثابت في برامج الحكومات
بدأ شعار حصر السلاح بوقت مبكر في العراق الجديد، وتحوّل في ما بعد إلى ركن ثابت في البرنامج الحكومية لرؤساء الوزراء المتعاقبين، ولعله لا يوجد محور فشلت فيه جميع البرامج الحكومية بقدر ما فشلت في ملف حصر السلاح.
وبينما تتشابه الدعوة في عنوانها: “حصر السلاح بيد الدولة أو حصر السلاح المنفلت”، إلا أن مفهوم وتعريف السلاح المنفلت والهدف الحقيقي وراءه، كانت تختلف بين رئيس وزراء وآخر، فكان سلاح جيش المهدي هو السلاح المنفلت الذي حرصت القوات الأمريكية وحكومة اياد علاوي على شرائه من المسلحين بعد هجمات ومعارك دامية متبادلة بين الطرفين، وبالفعل تم شراء العديد من الأسلحة، ألا أن الصفقة تحولت بعد ذلك إلى نكتة يتداولها عناصر جيش المهدي التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تتمثل ببيعهم السلاح المتهرئ، والاستفادة من الأموال لشراء أسلحة جديدة وأثقل!.
وفي ولاية المالكي الأولى (2006-2010)، تكرر العرض مع فصائل جهادية سنية وجيش المهدي أيضاً، فكانت أسلحتهم هي “الأسلحة المنفلتة” في معيار حكومة نوري المالكي، على الرغم من وجود العديد من المسلحين الآخرين المدنيين المرتبطين بالسلطة الحكومية؛ على سبيل المثال كانت قوات بدر متهمة بأنها تقتل مسلحي جيش المهدي أثناء خوضهم معارك ضد القوات الأمريكية.
أما في زمن حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي كان سلاح الفصائل المسلحة الشيعية هو المنفلت الذي يستوجب حصره بيد الدولة، لكن هذا السلاح هو الوحيد الذي لم تجرِ أية محاولة للتضييق عليه، وتحول إلى محور تستثمر به الحكومات ورؤساء الوزراء لكسب دعم الدول الكبرى والإقليمية لتشكيل الحكومة العراقية.
أما في حكومة عادل عبد المهدي، وبالرغم من وجود “محور حصر السلاح بيد الدولة” ضمن خطاباته و برنامجه الحكومي، الّا إنه لم يكن المقصود بـ”السلاح المنفلت” معروفاً، على خلاف الدورات الحكومية التي سبقته، خصوصا وأنه كان الأكثر قرباً للفصائل الشيعية المسلحة.
وفي مرحلة محمد شياع السوداني، يبدو أن لا سلاح منفلتاً بنظره إلّا القليل من سلاح العشائر أو سلاح الأفراد، وهو ما قاد إلى مبادرتين جديدتين متوازيتين، قد تعارض إحداهما الأخرى نسبياً.
من يبيع رأسماله؟
في 27 من كانون الثاني الماضي، أطلقت وزارة الداخلية استمارة تسجيل الأسلحة للمواطنين، والتي تشترط أن يكون سلاحاً خفيفاً واحداً لكل منزل، حتى لو كان المنزل تقطنه عائلتان أو أكثر، ويستمر التسجيل حتى نهاية العام الحالي على منصة أور الحكومية.
وبالتزامن، تحضّر وزارة الداخلية لحملة شراء الأسلحة من المواطنين، حيث خصّص مجلس الوزراء 15 مليار دينار، بواقع مليار دينار عراقي لكل محافظة-عدا محافظات إقليم كردستان-، لشراء الأسلحة، في مسعى يشي باحتمال أنه يستهدف الأسلحة الثقيلة، خصوصاً مع تقنين اقتناء قطعة سلاح خفيف في كل منزل، وهذا يستدعي أن تضع أسعاراً تنافس تلك السائدة في أسواق السلاح.
بينما تروّج الحكومة لحرصها على ضبط الأسلحة ونزعها من جهات “تهدد الدولة من خارجها”، تغضّ نظرها وإجراءاتها عن كيانات هجينة (الفصائل الشيعية)، تضع قدماً في الدولة ومؤسساتها وأقدام أخرى في ميادين السلاح والمشاريع الضخمة والأموال والتديّن، وليست هذه الجهات بحاجة للمليارات الـ15، كما أن هذا السلاح هو “رأسمالها”، تحمي به مصالحها ومصالح شركائها المالية والتجارية والسياسية.
لن يكون غريباً، أن يكرر عناصر هذه الفصائل ما فعله سابقوهم الصدريون (جيش المهدي)، ببيع جزء صغير من أسلحتهم للاستفادة من الأموال المربحة التي قد تدفعها الدولة لكل قطعة سلاح مقارنة بأسعارها في السوق، لتستفيد مرة أخرى من هذه الأموال، وبسعر قطعة السلاح الواحدة، ستقوم بشراء قطعتين جديدتين.
توسيع شريحة المسلحين ضد بعضهم
في نظرة على توسيع شريحة الفئات المشمولة بحمل السلاح خلال السنوات الماضية، يظهر أن الدولة تعترف ضمنياً بأن على المواطنين أن يحموا أنفسهم بأنفسهم؛ فدائماً ما سيكون هنالك مسلّح بجانب مواطن، من المحتمل أن يفتح النار، وربما سيكون هذا المسلّح ممن تمنحهم الدولة السلاح بإجازة رسمية ومسجلة، بمشهد أشبه ما يكون باللعبة الالكترونية، حيث تمنح الدولة السلاح للفئات المختلفة وتجعلهم يتربصون ببعضهم أو يحمون أنفسهم من بعض.
مؤخراً، أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري قراراً بالسماح لفئة الصيادلة بحيازة وحمل السلاح داخل الصيدليات، في سياق قرارات سابقة مشابهة لصالح العديد من الفئات، من بينهم التجّار والصاغة والمقاولون وأصحاب منافذ صرف الرواتب، في قرار صدر في آذار 2023.
وتُظهر نافذة تسجيل السلاح في وزارة الداخلية، أن الفئات المشمولة بحمل السلاح، هم أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم وحماياتهم، وحملة شهادة الدكتوراه والمحققون القضائيون و كُتاب العدل وضباط و منتسبو وموظفو وزارة الداخلية المحالون على التقاعد.
وكذلك أساتذة الجامعات والمعاهد والأطباء ورؤساء تحرير الصحف والصحفيون ومدراء القنوات الفضائية والإعلاميون والمحامون وموظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموظفو الرئاسات الثلاث وموظفو مكتب رئيس الوزراء وحمايات القضاة والمدعين العامين.
وتمنح الدولة الحق لفئات أخرى مثل أصحاب شركات الصيرفة، والعاملين في مكاتب المراجع الدينية (رجال الدين)، والعاملين في العتبات الدينية وموظفي هيئة النزاهة الاتحادية واعضاء وموظفي مجلس الدولة… بالإضافة لكل ما تقدم يمكن لوزير الداخلية منح استثناء للحصول على إجازة حيازة وحمل السلاح من غير الفئات المذكورة.
بينما تركز الدولة على السلاح الثقيل عادة، أو منع تعدد الأسلحة، يبدو أنها كالعادة، تركز على السلاح الذي “يهددها”، لا الذي يهدد المواطنين، فالسماح بحمل السلاح لعشرات الفئات ومئات آلاف الأشخاص بمختلف المهن-عدا القوات الأمنية والعسكر-، سيزيد من حالات القتل الجنائي المسيطرة على الساحة العراقية، فأضرار الأسلحة الخفيفة والجرائم التي ترتكب يومياً تأتي على يد أفراد هم عناصر في القوات الامنية أو من الفئات الأخرى الكثيرة المشمولة بحمل السلاح، وعدد ضحايا السلاح الخفيف المجاز هذا، قد يفوق عدد ضحايا السلاح الثقيل الذي يستخدم لموازنة القوى والضغط السياسي في العراق أكثر من استخدامه فعلياً لسلب الأرواح.
أكثر من مجرّد أرقام
تزامناً مع مشاريع الحكومة الحالية ووزارة داخليتها تجاه السلاح، سجلت منظمة ضحايا حرب العراق مقتل 46 عراقياً في أول أشهر هذا العام، وفي الشهر الذي تلاه، فبراير تم تسجيل 44 قتيلًا، وهو أعلى مستوى مسجل منذ شهر مايو 2023 والذي بلغ فيه عدد القتلى 46 قتيلًا.
لا توجد إحصائية واضحة ودقيقة عن عدد الأسلحة “المنفلتة” في العراق، أي المنتشرة بيد المدنيين، إلا أن تقديرات منظمة wisevoter تشير إلى أنها حوالي 10 ملايين قطعة، تزيد أو تنقص، أدنى تقديرات هي 7.5 ملايين قطعة سلاح وأعلى تقدير هو 13 مليون قطعة سلاح.
وتصنف wisevoter العراق في المرتبة 25 عالميًا من بين أكثر من 200 دولة ينتشر فيها السلاح بيد المدنيين، حيث يبلغ معدل انتشار السلاح بيد المدنيين في العراق بواقع 19.6 قطعة لكل 100 نسمة، أي أن نسبة الانتشار تبلغ نحو 20%، أما معدل الموت بهذا السلاح يبلغ 6.57 قتلى لكل 100 ألف نسمة حتى عام 2020.
وفي حال عكس هذه الإحصائيات على عدد السكان في العراق، يتضح أن 19.6 قطعة لكل 100 شخص، يعني أن هناك قرابة 8.5 ملايين قطعة سلاح في العراق البالغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، و بينما يبلغ معدل الموت 6.57 لكل 100 ألف نسمة سنويًا، فهذا يعني وجود أكثر من 2800 وفاة بأعمال عنف سنويا في العراق على يد هذا السلاح.
نجاح آخر.. في الإعلام
بمعدل ضحايا سنوي مرتفع خلال فترة حكومة السوداني بأعمال عنف، وبحوالي قطعة سلاح لكل 4 أفراد، بناء على الأرقام السابقة، وبثقافة تمجّد حيازة السلاح، توسّع حكومة السوداني شريحة حائزي السلاح، على عكس ادعاءات التضييق عليه، من خلال مبادرة غير متماسكة، تنخرها الثغرات مثل تسجيل السلاح أو تخصيص 15 مليار دينار لشرائه، فحتى لو تم تخصيص مليون دينار لكل قطعة سلاح -كأقل سعر مغرٍ- لن ينجح سوى بجمع 15 ألف قطعة سلاح كحد أعلى، وهي نسبة لا تشكل غير 1 بالألف أو 0.1%ٌ، من إجمالي السلاح الموجود بيد المدنيين.
تنجح مبادرات حكومة السوداني بتحقيق أهداف إعلاميّة أكثر من تلك الحقيقية المتمثلة بحصر السلاح، ويكشف الخوض بعمق المعطيات عن رهان الفريق الحكومي على “المدخلات” كوسائل غير مكلفة من الممكن أن تقنع الجماهير بوجود خطوات فعليّة، وغالباً ما تكون هذه الخطوات و”المدخلات” التي تختارها هذه الحكومة، من النوع الذي يحتاج تطبيقه إلى فترة زمنية طويلة، ينشغل خلالها الجمهور بمدخلات مشاريع أخرى وينسى “المخرجات”.
ويساعد قرب السوداني من رؤوس الفصائل المسلحة، غير المعنية بتعريّة سلاحها أو تذكير الجماهير بترسانتها، في عدم إثارة حنقها، على عكس سلفه الكاظمي مثلاً، يساعد بنسيان الناس أن هناك سلاحاً منفلتاً غير الفردي أو الذي تمتلكه بعض العشائر، وهي خطوة إضافية لصالح السوداني.
بعد انقضاء مدة تسجيل وشراء الأسلحة، سيعلن إعلام الحكومة أرقاماً للأسلحة المسجلة والمشتراة، ومن ثم ستضيف هذه المبادرة جملة جديدة تزيّن البيانات الأمنية: “تم القبض على أطراف مشاجرة وضبط عدد من قطع السلاح غير المرخّص”، فيكون السوداني وفريقه ومَن وراءهم حققوا مكسباً إعلامياً آخر.
* تنشر هذه المادة بالشراكة مع الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية ”نيريج”
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
كان صدام حسين جالساً بينما كان شيوخ عشائر من محافظة النجف يلوّحون ببنادق متنوعة على أنغام الأهازيج التي تُنشَد أمامه، كانت البنادق المرفوعة قديمة الصنع، من جنس تلك التي استُخدمت في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، كثير منها من نوع “البرنو”، وهو سلاح لازَمَ العشائر العراقية بعد المعارك التي خاضوها مع العثمانيين بمساعدة الإنكليز، أو بالعكس في بعض المناطق والولايات قبل نشوء العراق الحديث.
لم يكن وجود السلاح بيد العشائر العراقية قبل 2003 أمراً غريباً، فهو رفيق دائم للرجال، لاسيما شيوخ ورؤوس ورموز العشائر، وكانت للبنادق أهمية ومكانة خاصة لديهم، وتطلق عليها أسماء “الدلع” وتتغنى بها الأشعار والأغاني، ولعل تسمية “أم اعريف” مصداق على ذلك، جنباً إلى جنب مع التسميات الأخرى مثل الجعازة والدنكَية، وغالباً ما تشتق الأسماء من الشكل الخارجي للبندقية.
تعدّدت مصادر أسلحة العشائر العراقية قبل 2003، بين وراثتها من الآباء والأجداد، أو التهريب ولاسيما في المحافظات التي تجمعها حدود مع بلدان مجاورة، وكانت الدولة أيضاً مصدراً لسلاح رموز العشائر، عندما كان رئيس النظام السابق صدام حسين يُهدي شيوخ العشائر مسدسات شخصية مرخصة، خصوصاً في فترة التسعينات عندما بدأ بصناعة شيوخ موالين له و”تشييخهم” على العشائر في ما بات يعرف لاحقاً بـ”شيوخ التسعين”، في إشارة إلى كونهم شيوخاً مزيفين وصناعة النظام، كما يُعرف في الأوساط العشائرية الآن.
وعلى الرغم من “القبضة الحديدية” لنظام صدام حسين، لم يكن صعباً أن يتسرب السلاح إلى البيوت والقرى، ليظهر في ما بعد خلال الأعراس والمآتم، أو في حالات أخرى كالثأر والنزاعات القبلية، على ضيق نطاقها، أو بمناسبات نادرة كمحاولة اغتيال صدام حسين، كما حدث في الدجيل عام 1982، المدينة الشيعية التي تقع ضمن محافظة صلاح الدين، مسقط رأس ونشأة صدام حسين، أو أن يكون الهدف الانقلاب على نظام الحكم باستخدام الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب كما حدث عام 1991 في ما يُعرف بالانتفاضة الشعبانية، والتي ترتبط بالمعارضة الشيعية الإسلامية لحكم صدام حسين، وفي جميع هذه الأحداث كانت بندقية الكلاشنكوف AK47 وبقيت في ما بعد، السلاح المتصدر في جميع أحداث التمرد والنزاعات المسلحة لاحقاً.
كيف تسرّبت البنادق؟
بعد أن كان الحصول على السلاح قبل عام 2003 للفئات المدنية غير المرتبطة بالسلطة، مخاطرة تستدعي أن يقابلها هدف يستحق، لم يعد الأمر كذلك فور بدء الغزو الأمريكي للعراق في آذار من ذلك العام. أبواب المشاجب ومخازن الأسلحة فُتحت للنهب، والأسلحة التي تُركت في الأبنية التي تمركز بها أفراد الجيش وعناصر حزب البعث أصبحت متاحة لأبناء المناطق السكنية، بعد هروب عناصر الجيش والحزب، وكانت الأسلحة أول شيء عليهم تركه وراءهم لضمان سلامتهم، خصوصاً مع تحولهم فجأة إلى مطارَدين، تبحث عنهم كيانات مسلحة جديدة في الساحة مثل “فيلق بدر” الذي دخل العراق من الحدود الإيرانية، مع سلاحه، فور بدء تهاوي النظام.
بعد سنوات من الشعور بالقهر، واحتكار القوّة بيد النظام، ظهرت ونَمَت رغبة عامة باقتناء السلاح في العراق، وكان انفلات الأمن سبباً إضافياً لاقتنائه بغية الحماية الذاتية.
لم تكن معركة “الحواسم” في 2003، غيمة أسقطت مطرها لمرة واحدة، بل ينبوع تفجّر وتحوّل إلى نهر سيجري لسنوات لاحقة.
بمرور الأيام، ستكون القوات الأمريكية في العراق مصدراً إضافياً لسلاح المدنيين، وبأشكال عدة، إما عبر تسرب السلاح الذي ستزود به القوات الأمنية العراقية الناشئة، أو من خلال المعارك التي ستخوضها عناصر “المقاومة” السنية، وفي ما بعد الشيعية المتمثلة بجيش المهدي، والاستيلاء على الأسلحة الأمريكية التي لم يسبق ليد عراقيّة أن اختبرتها، بعد أن كانت الأسلحة السوفيتية هي الماركة المسجلة في العراق.
في 2006، رصدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مسدس غلوك الأمريكي الذي تم توزيعه على عناصر الشرطة العراقية معروضاً للبيع في محل بقالة، وكذلك بنادق كلاشنكوف غير مستخدمة، كانت من بين 370 ألف قطعة سلاح اشترتها القوات الأمريكية لعناصر الأمن العراقي، قبل أن تتسرّب إلى متاجر البقالة والحرب.

كانت تجارة مربحة وقتذاك، مع تزايد الطلب عليها خلال الحرب الأهلية الطائفية، وكانت الأسعار تتصاعد مع تزايد الطلب فبلغ سعر بندقية الكلاشنكوف حينها 650 دولاراً بعد أن كانت بـ 450 دولاراً في العام الذي قبله.
وبالطريقة ذاتها، عُرضت بندقية (M4) الأمريكية للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أكدت تقارير أمريكية حينها فقدان أثر نحو 200 ألف قطعة من السلاح الذي قدمته إلى القوات العراقية بواقع 110 آلاف بندقية AK-47، و80 ألف مسدس غلوك، بما يعادل 57% من إجمالي الأسلحة التي سلمتها القوات الأمريكية إلى القوات العراقية بين حزيران 2004 وأيلول 2005.
شعار قديم.. ركن ثابت في برامج الحكومات
بدأ شعار حصر السلاح بوقت مبكر في العراق الجديد، وتحوّل في ما بعد إلى ركن ثابت في البرنامج الحكومية لرؤساء الوزراء المتعاقبين، ولعله لا يوجد محور فشلت فيه جميع البرامج الحكومية بقدر ما فشلت في ملف حصر السلاح.
وبينما تتشابه الدعوة في عنوانها: “حصر السلاح بيد الدولة أو حصر السلاح المنفلت”، إلا أن مفهوم وتعريف السلاح المنفلت والهدف الحقيقي وراءه، كانت تختلف بين رئيس وزراء وآخر، فكان سلاح جيش المهدي هو السلاح المنفلت الذي حرصت القوات الأمريكية وحكومة اياد علاوي على شرائه من المسلحين بعد هجمات ومعارك دامية متبادلة بين الطرفين، وبالفعل تم شراء العديد من الأسلحة، ألا أن الصفقة تحولت بعد ذلك إلى نكتة يتداولها عناصر جيش المهدي التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تتمثل ببيعهم السلاح المتهرئ، والاستفادة من الأموال لشراء أسلحة جديدة وأثقل!.
وفي ولاية المالكي الأولى (2006-2010)، تكرر العرض مع فصائل جهادية سنية وجيش المهدي أيضاً، فكانت أسلحتهم هي “الأسلحة المنفلتة” في معيار حكومة نوري المالكي، على الرغم من وجود العديد من المسلحين الآخرين المدنيين المرتبطين بالسلطة الحكومية؛ على سبيل المثال كانت قوات بدر متهمة بأنها تقتل مسلحي جيش المهدي أثناء خوضهم معارك ضد القوات الأمريكية.
أما في زمن حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي كان سلاح الفصائل المسلحة الشيعية هو المنفلت الذي يستوجب حصره بيد الدولة، لكن هذا السلاح هو الوحيد الذي لم تجرِ أية محاولة للتضييق عليه، وتحول إلى محور تستثمر به الحكومات ورؤساء الوزراء لكسب دعم الدول الكبرى والإقليمية لتشكيل الحكومة العراقية.
أما في حكومة عادل عبد المهدي، وبالرغم من وجود “محور حصر السلاح بيد الدولة” ضمن خطاباته و برنامجه الحكومي، الّا إنه لم يكن المقصود بـ”السلاح المنفلت” معروفاً، على خلاف الدورات الحكومية التي سبقته، خصوصا وأنه كان الأكثر قرباً للفصائل الشيعية المسلحة.
وفي مرحلة محمد شياع السوداني، يبدو أن لا سلاح منفلتاً بنظره إلّا القليل من سلاح العشائر أو سلاح الأفراد، وهو ما قاد إلى مبادرتين جديدتين متوازيتين، قد تعارض إحداهما الأخرى نسبياً.
من يبيع رأسماله؟
في 27 من كانون الثاني الماضي، أطلقت وزارة الداخلية استمارة تسجيل الأسلحة للمواطنين، والتي تشترط أن يكون سلاحاً خفيفاً واحداً لكل منزل، حتى لو كان المنزل تقطنه عائلتان أو أكثر، ويستمر التسجيل حتى نهاية العام الحالي على منصة أور الحكومية.
وبالتزامن، تحضّر وزارة الداخلية لحملة شراء الأسلحة من المواطنين، حيث خصّص مجلس الوزراء 15 مليار دينار، بواقع مليار دينار عراقي لكل محافظة-عدا محافظات إقليم كردستان-، لشراء الأسلحة، في مسعى يشي باحتمال أنه يستهدف الأسلحة الثقيلة، خصوصاً مع تقنين اقتناء قطعة سلاح خفيف في كل منزل، وهذا يستدعي أن تضع أسعاراً تنافس تلك السائدة في أسواق السلاح.
بينما تروّج الحكومة لحرصها على ضبط الأسلحة ونزعها من جهات “تهدد الدولة من خارجها”، تغضّ نظرها وإجراءاتها عن كيانات هجينة (الفصائل الشيعية)، تضع قدماً في الدولة ومؤسساتها وأقدام أخرى في ميادين السلاح والمشاريع الضخمة والأموال والتديّن، وليست هذه الجهات بحاجة للمليارات الـ15، كما أن هذا السلاح هو “رأسمالها”، تحمي به مصالحها ومصالح شركائها المالية والتجارية والسياسية.
لن يكون غريباً، أن يكرر عناصر هذه الفصائل ما فعله سابقوهم الصدريون (جيش المهدي)، ببيع جزء صغير من أسلحتهم للاستفادة من الأموال المربحة التي قد تدفعها الدولة لكل قطعة سلاح مقارنة بأسعارها في السوق، لتستفيد مرة أخرى من هذه الأموال، وبسعر قطعة السلاح الواحدة، ستقوم بشراء قطعتين جديدتين.
توسيع شريحة المسلحين ضد بعضهم
في نظرة على توسيع شريحة الفئات المشمولة بحمل السلاح خلال السنوات الماضية، يظهر أن الدولة تعترف ضمنياً بأن على المواطنين أن يحموا أنفسهم بأنفسهم؛ فدائماً ما سيكون هنالك مسلّح بجانب مواطن، من المحتمل أن يفتح النار، وربما سيكون هذا المسلّح ممن تمنحهم الدولة السلاح بإجازة رسمية ومسجلة، بمشهد أشبه ما يكون باللعبة الالكترونية، حيث تمنح الدولة السلاح للفئات المختلفة وتجعلهم يتربصون ببعضهم أو يحمون أنفسهم من بعض.
مؤخراً، أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري قراراً بالسماح لفئة الصيادلة بحيازة وحمل السلاح داخل الصيدليات، في سياق قرارات سابقة مشابهة لصالح العديد من الفئات، من بينهم التجّار والصاغة والمقاولون وأصحاب منافذ صرف الرواتب، في قرار صدر في آذار 2023.
وتُظهر نافذة تسجيل السلاح في وزارة الداخلية، أن الفئات المشمولة بحمل السلاح، هم أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم وحماياتهم، وحملة شهادة الدكتوراه والمحققون القضائيون و كُتاب العدل وضباط و منتسبو وموظفو وزارة الداخلية المحالون على التقاعد.
وكذلك أساتذة الجامعات والمعاهد والأطباء ورؤساء تحرير الصحف والصحفيون ومدراء القنوات الفضائية والإعلاميون والمحامون وموظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموظفو الرئاسات الثلاث وموظفو مكتب رئيس الوزراء وحمايات القضاة والمدعين العامين.
وتمنح الدولة الحق لفئات أخرى مثل أصحاب شركات الصيرفة، والعاملين في مكاتب المراجع الدينية (رجال الدين)، والعاملين في العتبات الدينية وموظفي هيئة النزاهة الاتحادية واعضاء وموظفي مجلس الدولة… بالإضافة لكل ما تقدم يمكن لوزير الداخلية منح استثناء للحصول على إجازة حيازة وحمل السلاح من غير الفئات المذكورة.
بينما تركز الدولة على السلاح الثقيل عادة، أو منع تعدد الأسلحة، يبدو أنها كالعادة، تركز على السلاح الذي “يهددها”، لا الذي يهدد المواطنين، فالسماح بحمل السلاح لعشرات الفئات ومئات آلاف الأشخاص بمختلف المهن-عدا القوات الأمنية والعسكر-، سيزيد من حالات القتل الجنائي المسيطرة على الساحة العراقية، فأضرار الأسلحة الخفيفة والجرائم التي ترتكب يومياً تأتي على يد أفراد هم عناصر في القوات الامنية أو من الفئات الأخرى الكثيرة المشمولة بحمل السلاح، وعدد ضحايا السلاح الخفيف المجاز هذا، قد يفوق عدد ضحايا السلاح الثقيل الذي يستخدم لموازنة القوى والضغط السياسي في العراق أكثر من استخدامه فعلياً لسلب الأرواح.
أكثر من مجرّد أرقام
تزامناً مع مشاريع الحكومة الحالية ووزارة داخليتها تجاه السلاح، سجلت منظمة ضحايا حرب العراق مقتل 46 عراقياً في أول أشهر هذا العام، وفي الشهر الذي تلاه، فبراير تم تسجيل 44 قتيلًا، وهو أعلى مستوى مسجل منذ شهر مايو 2023 والذي بلغ فيه عدد القتلى 46 قتيلًا.
لا توجد إحصائية واضحة ودقيقة عن عدد الأسلحة “المنفلتة” في العراق، أي المنتشرة بيد المدنيين، إلا أن تقديرات منظمة wisevoter تشير إلى أنها حوالي 10 ملايين قطعة، تزيد أو تنقص، أدنى تقديرات هي 7.5 ملايين قطعة سلاح وأعلى تقدير هو 13 مليون قطعة سلاح.
وتصنف wisevoter العراق في المرتبة 25 عالميًا من بين أكثر من 200 دولة ينتشر فيها السلاح بيد المدنيين، حيث يبلغ معدل انتشار السلاح بيد المدنيين في العراق بواقع 19.6 قطعة لكل 100 نسمة، أي أن نسبة الانتشار تبلغ نحو 20%، أما معدل الموت بهذا السلاح يبلغ 6.57 قتلى لكل 100 ألف نسمة حتى عام 2020.
وفي حال عكس هذه الإحصائيات على عدد السكان في العراق، يتضح أن 19.6 قطعة لكل 100 شخص، يعني أن هناك قرابة 8.5 ملايين قطعة سلاح في العراق البالغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، و بينما يبلغ معدل الموت 6.57 لكل 100 ألف نسمة سنويًا، فهذا يعني وجود أكثر من 2800 وفاة بأعمال عنف سنويا في العراق على يد هذا السلاح.
نجاح آخر.. في الإعلام
بمعدل ضحايا سنوي مرتفع خلال فترة حكومة السوداني بأعمال عنف، وبحوالي قطعة سلاح لكل 4 أفراد، بناء على الأرقام السابقة، وبثقافة تمجّد حيازة السلاح، توسّع حكومة السوداني شريحة حائزي السلاح، على عكس ادعاءات التضييق عليه، من خلال مبادرة غير متماسكة، تنخرها الثغرات مثل تسجيل السلاح أو تخصيص 15 مليار دينار لشرائه، فحتى لو تم تخصيص مليون دينار لكل قطعة سلاح -كأقل سعر مغرٍ- لن ينجح سوى بجمع 15 ألف قطعة سلاح كحد أعلى، وهي نسبة لا تشكل غير 1 بالألف أو 0.1%ٌ، من إجمالي السلاح الموجود بيد المدنيين.
تنجح مبادرات حكومة السوداني بتحقيق أهداف إعلاميّة أكثر من تلك الحقيقية المتمثلة بحصر السلاح، ويكشف الخوض بعمق المعطيات عن رهان الفريق الحكومي على “المدخلات” كوسائل غير مكلفة من الممكن أن تقنع الجماهير بوجود خطوات فعليّة، وغالباً ما تكون هذه الخطوات و”المدخلات” التي تختارها هذه الحكومة، من النوع الذي يحتاج تطبيقه إلى فترة زمنية طويلة، ينشغل خلالها الجمهور بمدخلات مشاريع أخرى وينسى “المخرجات”.
ويساعد قرب السوداني من رؤوس الفصائل المسلحة، غير المعنية بتعريّة سلاحها أو تذكير الجماهير بترسانتها، في عدم إثارة حنقها، على عكس سلفه الكاظمي مثلاً، يساعد بنسيان الناس أن هناك سلاحاً منفلتاً غير الفردي أو الذي تمتلكه بعض العشائر، وهي خطوة إضافية لصالح السوداني.
بعد انقضاء مدة تسجيل وشراء الأسلحة، سيعلن إعلام الحكومة أرقاماً للأسلحة المسجلة والمشتراة، ومن ثم ستضيف هذه المبادرة جملة جديدة تزيّن البيانات الأمنية: “تم القبض على أطراف مشاجرة وضبط عدد من قطع السلاح غير المرخّص”، فيكون السوداني وفريقه ومَن وراءهم حققوا مكسباً إعلامياً آخر.
* تنشر هذه المادة بالشراكة مع الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية ”نيريج”