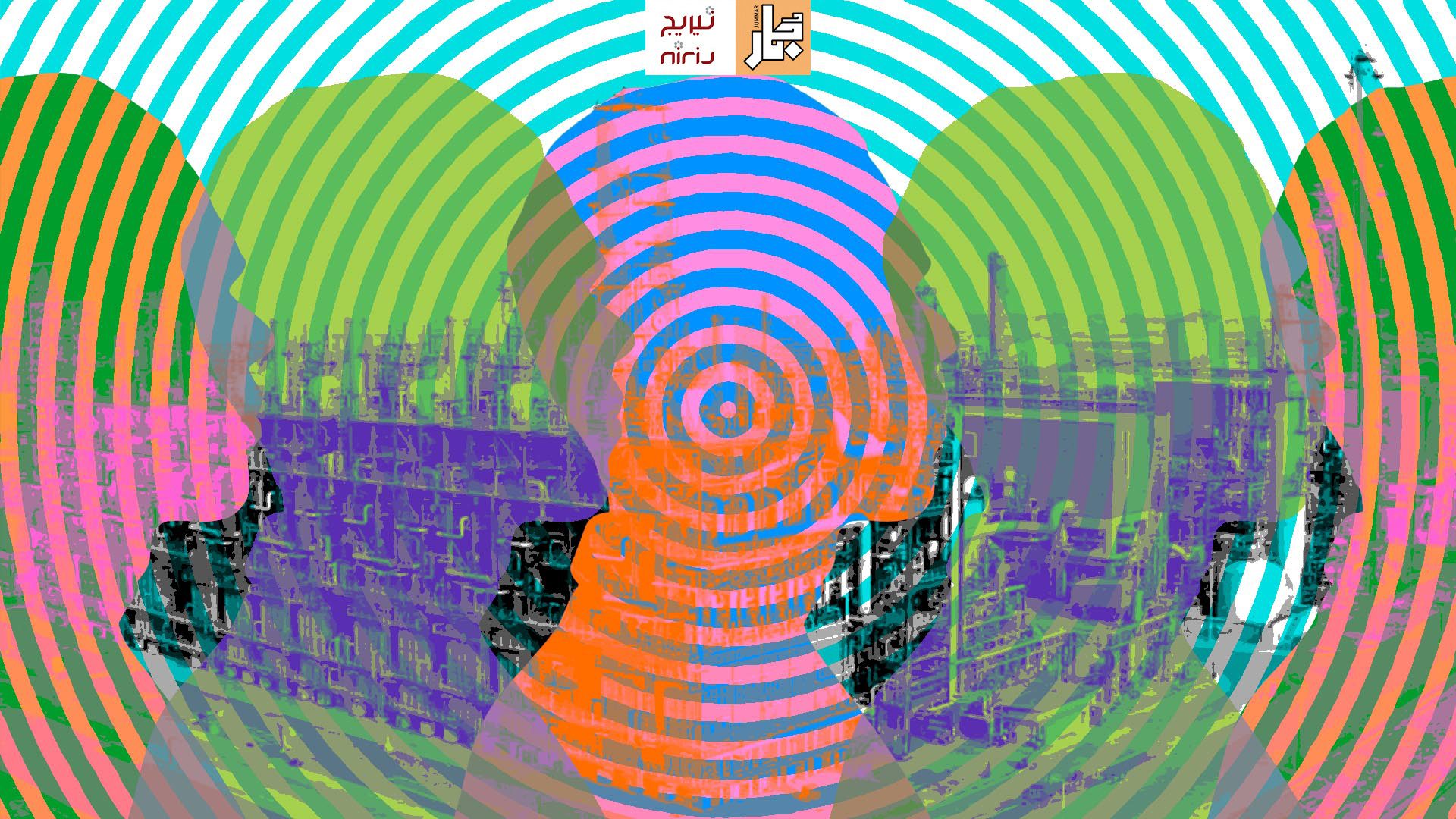رحلة الفضول من سؤال الوجود.. إلى "شكد راتبك"؟
23 آذار 2024
"شكد راتبك"، "شكد عمرك"، "ليش لابس أصفر"، "كم أخو عندك"، "أبوك شيشتغل"، "ليش تشرب جاي اهواي"، "متزوج؟".. وهلمّ جرا من الأسئلة التي يجرّها فضول الآخرين إلى حياتك الشخصية..
يقول حسن، “إننا لا نملك الجرأة على قول (انت شعليك)”، وخلاف ذلك نذهب للإجابة المباشرة، أو عمل نوع من الاحتيال إذا كنّا حريصين على خصوصيتنا، قفز وهروب من الإجابة يمارس باستمرار، وذلك لا يحمي الأفراد من تطفل الآخرين، يرى حسن أنّ حياته الشخصية غير متاحة للجميع، وهو وحده من يملك القدرة على منح الحد الذي يرغب به من المعلومات؛ رغم ذلك يقول، “الآخر لا يقدر إنك لا تريد أن تفصح عن شؤونك، وكل من تحاول أن تخفي شيئاً عنه، يعتقد أنك مغرور، أو تخشى الحسد، إلخ من الأفكار الاجتماعية الراسخة”.
هل نحن وسط عالم مليء بالفضوليين؟ الذين يحجبون أيَّ نوع من الخصوصية المفترضة؟ كيف يعيش من يعتبر معلوماته الشخصية تخصه فقط؟ كيف يحفظ الفرد حياته من عيون الآخرين؟
لا تفتح هاتفك في الكيا
تمتاز وسيلة النقل العامة، التي تسمى محليا “كيا” مهما كانت ماركتها، في أنها تحشر مجموعة من الأشخاص في مكان ضيق، وهذا هو المكان المناسب ليظهر لك المتطفل، فيما تقلب هاتفك، أو تتحدث مع أحدهم، وهناك نكات أنتجها العراقيون عن “متطفل الكيا”.
شخص ما يمسك هاتفه، بالقرب منه شاب، وأثناء ما بدأ يقلب الهاتف جراء الملل، أعجبه أن يدخل على الصور ويحذف منها ما لا يريده، لكنه انتبه إلى الشاب الذي بجانبه، كانت عيونه معلّقة على الهاتف، سأله بلطف عن صورة ما: هل تحتاج هذه الصورة أم أحذفها!
يُقال في باب النكات أيضاً، إن شخصاً، يتراسل مع زوجته في الكيا، وكانت تكتب له، “جيب وياك صمون، وبصل، وخيار، وإذا تكدر حلويات”، قبل أن يرد، انتبه أن الذي بجانبه كان يقرأ الرسائل، أعطاه الهاتف قائلاً، “هاك أنت جيبهن”.
ما الفائدة من هذه المراقبة؟ ما هو الدافع؟ كيف يجرؤ المرء على التطفل نحو الآخرين بهذا الشكل؟ إنه الفضول ولا غيره.
أحاول بين فترة وأخرى، أن أسمع من الآخرين تصوراتهم إزاء الفضول، عن كيفية تجنب الأسئلة والسلوكيات التي تبدو في غير محلها، الأسئلة الملحة التي يحاصرنا بها الآخر، بداعي صلة القرابة أو الصداقة أو غيرها، الجواب غالباً، أن الأمر غير مريح، وأن من حق الفرد حجب ما يريد من حياته، وإخفاءه عن الآخر.
الجذر الإبداعي للفضول
قبل ذلك، في الفضول جذر إيجابي، يرتبط بتطور البشر، فكل اكتشاف لا يخلو من درجة من الفضول، وقت كان الفضول مهارة. بدافع الفضول خلط الإنسان مادتين، فخرجت الثالثة لتعلن عن نفسها مستقلة ونادرة وجادة، فكانت الكيمياء.
بدافع الفضول أراد الكائن البشري حذف البرد، فكانت النار، أراد معرفة قلب الجبل، حفره، فظهر النحاس والحديد والفحم والمعادن الأخرى، أليست الصواريخ بدأت عندما سأل نوبل: كيف يمكن الحفر دون جهد؟ ليست كل عملية تفكير هي فضولية، إلا أنها لا تخلو من الفضول بالضرورة أيضاً.
تبدأ الرحلة البشرية يوم يتعلم الإنسان البحث، لاكتشاف ما يخفيه هذا الشيء وما يضمه ذلك، الرحلة المحفوفة بالأسئلة والتدقيق وجمع المعلومات والربط، كما لو أن الأمر ممارسة فلسفية من نوع ما، ليست الفلسفة التي باتت تُدرّس للطلبة اليوم، عن تاريخ سقراط والمشكلات الخاصة بأرسطو وغيرهما، لكنه الدرس الغريزي الذي نتعلمه بالتجربة.
لا تتوقف الرحلة في السؤال عن العالم والحياة وجدوى العيش وضرورة الوجود نفسه، فالأسئلة المجردة وحسب المنهجية تصبح أسئلة فلسفية وأخرى تحولك إلى فيزيائي، ومنها ما يضعك في حقل الأدب، أو عالم الرياضيات.
هذا الحد المقبول، أو الذي نفترضه كذلك، إلا أن ثمّةَ خيطاً رفيعاً، بين من يسأل: كيف وصلنا إلى هنا؟ وبين من يسأل: شكد راتبك؟
يرى أدموند بيرك أنّ أوّل شعور وأول فطرة وإحساس نكتشفه داخلنا ما أن نعي العالم هو الشعور بالفضول، فهو تلك الرغبة المفرطة في معرفة شيء ما، ما طعم هذا؟ كيف نصل لذلك الطعام؟ من أين نحصل على الماء؟ وهذا المستوى من الفضول نتشارك به مع كل الكائنات في رحلتها الأثيرة حول مصدر الطعام والماء، إلا أن الإنسان يذهب أبعد من ذلك، يبدأ بالتفكير: من أنا؟ من أين جئت؟ لماذا لدي هذا الشكل، وهذه العائلة… إلخ.
في بعض الأحيان يصل الفضول إلى مستواه الكارثي لينتهي بالسؤال عن حياة الآخرين، معرفة أسرارهم وما يخفونه، ولبس قناع الأشباح لمعرفة ما لديهم وما ليس لديهم، ربما يمكن أن نسمّي هذا “انحطاط الفضول”.
بدافع الفضول يضع الطفل الكرة الزجاجية في فمه، وهذا ما يفعله بعض الكبار وهم يضعون حياة الآخرين فوق طاولة الأسئلة، يمضغون تفاصيلهم، لمحاولة معرفة طعم الإنسان، بدافع الفضول مرة غرزت الإبرة في يدي، محاولاً معرفة ما يقع تحت الجلد، أنا فضولي أيضاً، لكن لكل منا طريقته في التعبير عن فضوله، فمرة نذهب إلى الأسئلة عن الحياة، ومرة عن حياة الآخرين.
يجب أن تعرف الآخر
وأنت تعرف عن الآخر ما لا يعرفه سواك، هذا يعني أنك تملك قدرة تدميرية على استخدام ذلك السلاح الحيوي. من هنا تبدأ رحلة الفضول السريّة التي ستشكل في ما بعد معرفتنا بالمجتمع والآخرين وتاريخهم السري والمخفي، والذي عَبرَه يمكن تشكيل صورة دقيقة عنهم، فنحن فضوليون، ولا نتخلى عن ذلك بسهولة، معرفة الذي يعيش معنا في الرحلة، لتشكيل صورة عنه، وانطلاقاً من ذلك، نرسم طريقاً لإدانته وفهمه أيضاً.
تكمن قوة الإنسان في تكوينه للمجتمع، حين تفشل بقية الكائنات في ذلك، شكّل الإنسان الإمبراطورية التي يمكنها جمع ملايين البشر تحت راية واحدة، وهذا أساسه معرفة الآخر، معرفة هويته، الوشايات والفضول والحديث عن حياة الآخرين، هو ما جعل الكائن البشري قادراً على العيش في جماعات، إلا أن ذلك بمرور فصول الحياة، وصل إلى خريفه، حيث بات من غير الطبيعي التدقيق في الآخرين؛ بل يسبب ذلك نوعاً من الارتباك، كما أنه في الآن نفسه صار يدعى تطفلاً، وفضولاً، وهو مرفوض اجتماعياً.
لكنَّ ذلك ليس نهائياً، فالجميع يريدنا أن نعرف عن الجميع، هكذا ندفع بطاقة “معرفة الآخرين”، نصبح أنوفاً تبحث في حياة الآخرين، وتشم الأخبار عنهم، كلاب بشرية تبحث في رائحة الآخر عن زلة هنا، وغريزة هناك، عن رغبة هنا وكارثة هناك، ثم تستخدم كل هذه المعلومات لإدانته وفضحه، أو إيصال رسالة مفادها، “أنت مكشوف لي”.
فصل في الفضول
الثرثرة هي الميزة الاجتماعية في المدن المكتظة بالسكان، والتي يمكن اعتبارها من أسس العمارة في شبه العشوائيات تلك، إلا أنها ثرثرة مليئة بالفضول.
قيل إن والده ميت، البعض يقول إنه شهيد، لكنها على أية حال تبقى ميزة فؤاد الذي يلعب معنا في الطين والكرة أنه الوحيد بيننا الذي تدور حول والده الميت قصة من نوع ما.
لا يدع الناس حدثاً مثل هذا إلا وينسج حوله الخيالات والقصص، لا يهدأ الناس حتى تصل للحدث الحقيقي، أو القريب منه عبر التخمين والتقصي، من يسكن مدينة مكتظة صحفي بالضرورة بهذا الدرجة أو تلك، وأبرز صحفي في تلك المدن هنّ النساء.
لا يسمح لسكان مدينة الثورة أن تبقى قصصهم مخفية، ثمة اتفاق ضمني على هذا، ومن يود أن يخفي قصته عليه أن يعتزل الحياة العامة، وهذا إن حصل فسوف يُطلق عليه وعلى عائلته بالمعقدين، وغير الاجتماعيين، وغيرها من التوصيفات.
انطلاقاً من ذلك لم نحتج إلا شهوراً قليلة حتى اكتشفنا أن زميلنا الجديد أُمّه مطلقة، وأن أحمد هجرت أمّه منزل زوجها لأسباب غير واقعية أو هكذا تقول الناس، رغم ذلك تبقى قصة فؤاد الأكثر غرابة من القصص العائلية التي تشيع في الزقاق، وتصبح حديث المنازل، تشير الشائعات إلى حكاية تعتبر بالنسبة لنا نحن الصغار خالية من الدقة، تتحدث الناس عن زوجة خائنة فتحت تسجيلاً صوتياً “كاسيت” لزوجها “والد فؤاد” وهو يشتم رئيس جمهورية العراق وقتها صدام حسين، ثم ذهبت به إلى الفرقة الحزبية التي لم تتوان في اعتقاله ثم تغييبه، تقول جارتنا إن الزوج قال، “خرب شاربك صدام خليت الخبز حصرة علينا”، تشير الخياطة إنه قال ذلك تحت تأثير الكحول، بينما يصمت الرجال كل الرجال ما إن يصل الحديث عن الرجل نفسه.
أول ما تسرّب من منزلنا
لم يكن الأمر إلا شجاراً بسيطاً بين الأب والأم، إنه سوء الفهم الذي يحصل عادة بين المتزوجين، من خصال الحياة الزوجية إنها تستديم بالشجار كما يرى البعض، في اليوم التالي عدنا من المدرسة وكان الجميع من حولي يتهامس وكأن شيئاً ما قد حصل، التفتُّ إلى القميص ثم الحقيبة وصولاً إلى الحذاء، لا شيء يثير الريبة أو الشك، لا شيء متسخاً أو نشازاً، سألتُ، ماذا هناك؟ أجاب أحدهم، البارحة “أبوك تعارك وي أمك” اليس هذا صحيحاً؟ نعم قلت؛ لكن من سرب ذلك؟ من أخرج صراخ الغرفة إلى المدرسة؟ هل قفز من الشباك إلى الشارع وصولاً إلى الصف الثاني “ب”، غاضباً عدت إلى البيت، منطوياً داخل علبة من الشك والخجل، كيف عرف الجميع بذلك؟ خيالات الزقاق المليء بالدعاء والثرثرة لا تنتهي، في الظهيرة وأثناء دوران الكرة على الإسفلت، عرفت أن ابنة عمّي سربت أخبار البيت إلى ابنة الجيران، التي سربته بدورها إلى أحد إخوتها، والذي لم يكن لديه أيّ حديث في المدرسة غير ما حصل في غرفة أبي وأُمي.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
يقول حسن، “إننا لا نملك الجرأة على قول (انت شعليك)”، وخلاف ذلك نذهب للإجابة المباشرة، أو عمل نوع من الاحتيال إذا كنّا حريصين على خصوصيتنا، قفز وهروب من الإجابة يمارس باستمرار، وذلك لا يحمي الأفراد من تطفل الآخرين، يرى حسن أنّ حياته الشخصية غير متاحة للجميع، وهو وحده من يملك القدرة على منح الحد الذي يرغب به من المعلومات؛ رغم ذلك يقول، “الآخر لا يقدر إنك لا تريد أن تفصح عن شؤونك، وكل من تحاول أن تخفي شيئاً عنه، يعتقد أنك مغرور، أو تخشى الحسد، إلخ من الأفكار الاجتماعية الراسخة”.
هل نحن وسط عالم مليء بالفضوليين؟ الذين يحجبون أيَّ نوع من الخصوصية المفترضة؟ كيف يعيش من يعتبر معلوماته الشخصية تخصه فقط؟ كيف يحفظ الفرد حياته من عيون الآخرين؟
لا تفتح هاتفك في الكيا
تمتاز وسيلة النقل العامة، التي تسمى محليا “كيا” مهما كانت ماركتها، في أنها تحشر مجموعة من الأشخاص في مكان ضيق، وهذا هو المكان المناسب ليظهر لك المتطفل، فيما تقلب هاتفك، أو تتحدث مع أحدهم، وهناك نكات أنتجها العراقيون عن “متطفل الكيا”.
شخص ما يمسك هاتفه، بالقرب منه شاب، وأثناء ما بدأ يقلب الهاتف جراء الملل، أعجبه أن يدخل على الصور ويحذف منها ما لا يريده، لكنه انتبه إلى الشاب الذي بجانبه، كانت عيونه معلّقة على الهاتف، سأله بلطف عن صورة ما: هل تحتاج هذه الصورة أم أحذفها!
يُقال في باب النكات أيضاً، إن شخصاً، يتراسل مع زوجته في الكيا، وكانت تكتب له، “جيب وياك صمون، وبصل، وخيار، وإذا تكدر حلويات”، قبل أن يرد، انتبه أن الذي بجانبه كان يقرأ الرسائل، أعطاه الهاتف قائلاً، “هاك أنت جيبهن”.
ما الفائدة من هذه المراقبة؟ ما هو الدافع؟ كيف يجرؤ المرء على التطفل نحو الآخرين بهذا الشكل؟ إنه الفضول ولا غيره.
أحاول بين فترة وأخرى، أن أسمع من الآخرين تصوراتهم إزاء الفضول، عن كيفية تجنب الأسئلة والسلوكيات التي تبدو في غير محلها، الأسئلة الملحة التي يحاصرنا بها الآخر، بداعي صلة القرابة أو الصداقة أو غيرها، الجواب غالباً، أن الأمر غير مريح، وأن من حق الفرد حجب ما يريد من حياته، وإخفاءه عن الآخر.
الجذر الإبداعي للفضول
قبل ذلك، في الفضول جذر إيجابي، يرتبط بتطور البشر، فكل اكتشاف لا يخلو من درجة من الفضول، وقت كان الفضول مهارة. بدافع الفضول خلط الإنسان مادتين، فخرجت الثالثة لتعلن عن نفسها مستقلة ونادرة وجادة، فكانت الكيمياء.
بدافع الفضول أراد الكائن البشري حذف البرد، فكانت النار، أراد معرفة قلب الجبل، حفره، فظهر النحاس والحديد والفحم والمعادن الأخرى، أليست الصواريخ بدأت عندما سأل نوبل: كيف يمكن الحفر دون جهد؟ ليست كل عملية تفكير هي فضولية، إلا أنها لا تخلو من الفضول بالضرورة أيضاً.
تبدأ الرحلة البشرية يوم يتعلم الإنسان البحث، لاكتشاف ما يخفيه هذا الشيء وما يضمه ذلك، الرحلة المحفوفة بالأسئلة والتدقيق وجمع المعلومات والربط، كما لو أن الأمر ممارسة فلسفية من نوع ما، ليست الفلسفة التي باتت تُدرّس للطلبة اليوم، عن تاريخ سقراط والمشكلات الخاصة بأرسطو وغيرهما، لكنه الدرس الغريزي الذي نتعلمه بالتجربة.
لا تتوقف الرحلة في السؤال عن العالم والحياة وجدوى العيش وضرورة الوجود نفسه، فالأسئلة المجردة وحسب المنهجية تصبح أسئلة فلسفية وأخرى تحولك إلى فيزيائي، ومنها ما يضعك في حقل الأدب، أو عالم الرياضيات.
هذا الحد المقبول، أو الذي نفترضه كذلك، إلا أن ثمّةَ خيطاً رفيعاً، بين من يسأل: كيف وصلنا إلى هنا؟ وبين من يسأل: شكد راتبك؟
يرى أدموند بيرك أنّ أوّل شعور وأول فطرة وإحساس نكتشفه داخلنا ما أن نعي العالم هو الشعور بالفضول، فهو تلك الرغبة المفرطة في معرفة شيء ما، ما طعم هذا؟ كيف نصل لذلك الطعام؟ من أين نحصل على الماء؟ وهذا المستوى من الفضول نتشارك به مع كل الكائنات في رحلتها الأثيرة حول مصدر الطعام والماء، إلا أن الإنسان يذهب أبعد من ذلك، يبدأ بالتفكير: من أنا؟ من أين جئت؟ لماذا لدي هذا الشكل، وهذه العائلة… إلخ.
في بعض الأحيان يصل الفضول إلى مستواه الكارثي لينتهي بالسؤال عن حياة الآخرين، معرفة أسرارهم وما يخفونه، ولبس قناع الأشباح لمعرفة ما لديهم وما ليس لديهم، ربما يمكن أن نسمّي هذا “انحطاط الفضول”.
بدافع الفضول يضع الطفل الكرة الزجاجية في فمه، وهذا ما يفعله بعض الكبار وهم يضعون حياة الآخرين فوق طاولة الأسئلة، يمضغون تفاصيلهم، لمحاولة معرفة طعم الإنسان، بدافع الفضول مرة غرزت الإبرة في يدي، محاولاً معرفة ما يقع تحت الجلد، أنا فضولي أيضاً، لكن لكل منا طريقته في التعبير عن فضوله، فمرة نذهب إلى الأسئلة عن الحياة، ومرة عن حياة الآخرين.
يجب أن تعرف الآخر
وأنت تعرف عن الآخر ما لا يعرفه سواك، هذا يعني أنك تملك قدرة تدميرية على استخدام ذلك السلاح الحيوي. من هنا تبدأ رحلة الفضول السريّة التي ستشكل في ما بعد معرفتنا بالمجتمع والآخرين وتاريخهم السري والمخفي، والذي عَبرَه يمكن تشكيل صورة دقيقة عنهم، فنحن فضوليون، ولا نتخلى عن ذلك بسهولة، معرفة الذي يعيش معنا في الرحلة، لتشكيل صورة عنه، وانطلاقاً من ذلك، نرسم طريقاً لإدانته وفهمه أيضاً.
تكمن قوة الإنسان في تكوينه للمجتمع، حين تفشل بقية الكائنات في ذلك، شكّل الإنسان الإمبراطورية التي يمكنها جمع ملايين البشر تحت راية واحدة، وهذا أساسه معرفة الآخر، معرفة هويته، الوشايات والفضول والحديث عن حياة الآخرين، هو ما جعل الكائن البشري قادراً على العيش في جماعات، إلا أن ذلك بمرور فصول الحياة، وصل إلى خريفه، حيث بات من غير الطبيعي التدقيق في الآخرين؛ بل يسبب ذلك نوعاً من الارتباك، كما أنه في الآن نفسه صار يدعى تطفلاً، وفضولاً، وهو مرفوض اجتماعياً.
لكنَّ ذلك ليس نهائياً، فالجميع يريدنا أن نعرف عن الجميع، هكذا ندفع بطاقة “معرفة الآخرين”، نصبح أنوفاً تبحث في حياة الآخرين، وتشم الأخبار عنهم، كلاب بشرية تبحث في رائحة الآخر عن زلة هنا، وغريزة هناك، عن رغبة هنا وكارثة هناك، ثم تستخدم كل هذه المعلومات لإدانته وفضحه، أو إيصال رسالة مفادها، “أنت مكشوف لي”.
فصل في الفضول
الثرثرة هي الميزة الاجتماعية في المدن المكتظة بالسكان، والتي يمكن اعتبارها من أسس العمارة في شبه العشوائيات تلك، إلا أنها ثرثرة مليئة بالفضول.
قيل إن والده ميت، البعض يقول إنه شهيد، لكنها على أية حال تبقى ميزة فؤاد الذي يلعب معنا في الطين والكرة أنه الوحيد بيننا الذي تدور حول والده الميت قصة من نوع ما.
لا يدع الناس حدثاً مثل هذا إلا وينسج حوله الخيالات والقصص، لا يهدأ الناس حتى تصل للحدث الحقيقي، أو القريب منه عبر التخمين والتقصي، من يسكن مدينة مكتظة صحفي بالضرورة بهذا الدرجة أو تلك، وأبرز صحفي في تلك المدن هنّ النساء.
لا يسمح لسكان مدينة الثورة أن تبقى قصصهم مخفية، ثمة اتفاق ضمني على هذا، ومن يود أن يخفي قصته عليه أن يعتزل الحياة العامة، وهذا إن حصل فسوف يُطلق عليه وعلى عائلته بالمعقدين، وغير الاجتماعيين، وغيرها من التوصيفات.
انطلاقاً من ذلك لم نحتج إلا شهوراً قليلة حتى اكتشفنا أن زميلنا الجديد أُمّه مطلقة، وأن أحمد هجرت أمّه منزل زوجها لأسباب غير واقعية أو هكذا تقول الناس، رغم ذلك تبقى قصة فؤاد الأكثر غرابة من القصص العائلية التي تشيع في الزقاق، وتصبح حديث المنازل، تشير الشائعات إلى حكاية تعتبر بالنسبة لنا نحن الصغار خالية من الدقة، تتحدث الناس عن زوجة خائنة فتحت تسجيلاً صوتياً “كاسيت” لزوجها “والد فؤاد” وهو يشتم رئيس جمهورية العراق وقتها صدام حسين، ثم ذهبت به إلى الفرقة الحزبية التي لم تتوان في اعتقاله ثم تغييبه، تقول جارتنا إن الزوج قال، “خرب شاربك صدام خليت الخبز حصرة علينا”، تشير الخياطة إنه قال ذلك تحت تأثير الكحول، بينما يصمت الرجال كل الرجال ما إن يصل الحديث عن الرجل نفسه.
أول ما تسرّب من منزلنا
لم يكن الأمر إلا شجاراً بسيطاً بين الأب والأم، إنه سوء الفهم الذي يحصل عادة بين المتزوجين، من خصال الحياة الزوجية إنها تستديم بالشجار كما يرى البعض، في اليوم التالي عدنا من المدرسة وكان الجميع من حولي يتهامس وكأن شيئاً ما قد حصل، التفتُّ إلى القميص ثم الحقيبة وصولاً إلى الحذاء، لا شيء يثير الريبة أو الشك، لا شيء متسخاً أو نشازاً، سألتُ، ماذا هناك؟ أجاب أحدهم، البارحة “أبوك تعارك وي أمك” اليس هذا صحيحاً؟ نعم قلت؛ لكن من سرب ذلك؟ من أخرج صراخ الغرفة إلى المدرسة؟ هل قفز من الشباك إلى الشارع وصولاً إلى الصف الثاني “ب”، غاضباً عدت إلى البيت، منطوياً داخل علبة من الشك والخجل، كيف عرف الجميع بذلك؟ خيالات الزقاق المليء بالدعاء والثرثرة لا تنتهي، في الظهيرة وأثناء دوران الكرة على الإسفلت، عرفت أن ابنة عمّي سربت أخبار البيت إلى ابنة الجيران، التي سربته بدورها إلى أحد إخوتها، والذي لم يكن لديه أيّ حديث في المدرسة غير ما حصل في غرفة أبي وأُمي.