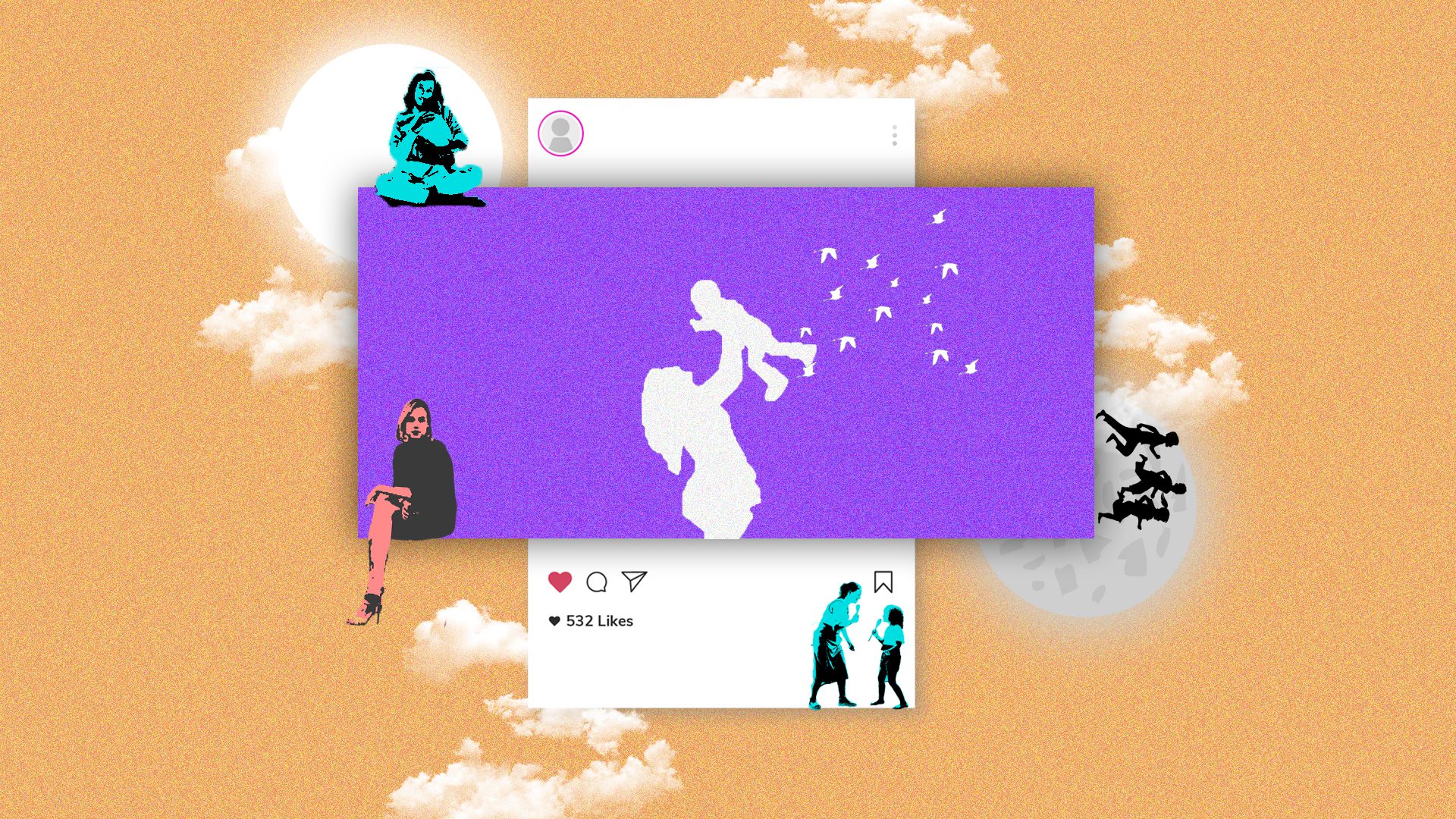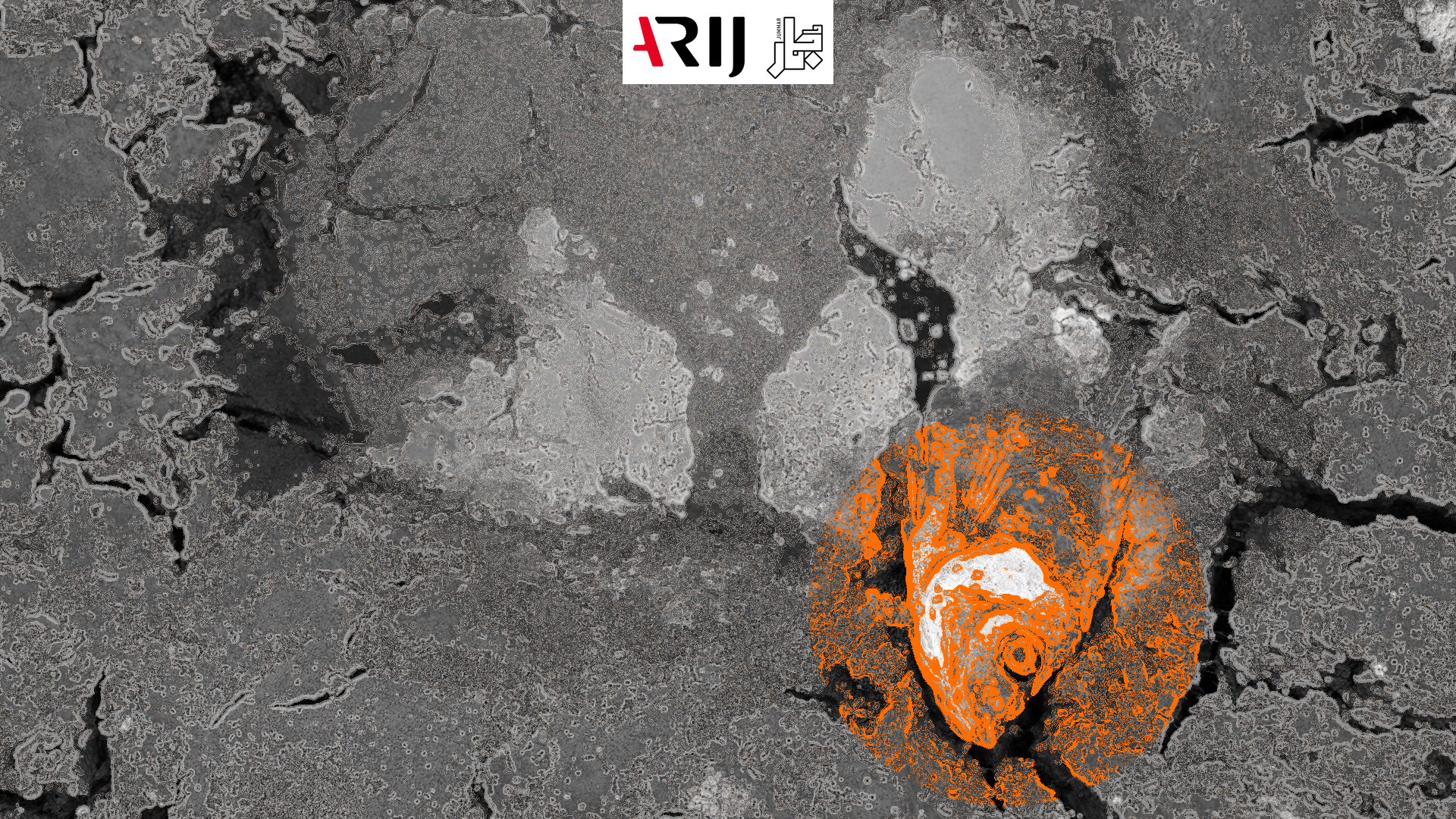"الأمهات والأمومة وإنستغرام".. عن تحدّيات "التربية السليمة" في العراق
28 أيلول 2023
لطالما شكَّلت نصائح الجدّات وفيديوهات التربية بمثابة "الوخز" في جسدي، وخاصة عندما أشعر بأن النصيحة أكبر من قدراتي، فهل هي عقدة الذنب الملازمة للأمومة؟ وهل نربّي صغارنا كأمهات شابات، كما ربّت جدّاتنا أبناءهن وبناتهن في بيئة مصممة لتكون ساحة حرب؟ "الأمهات والأمومة وانستغرام".. عن تحدّيات "التربية السليمة" في العراق.
نربي صغارنا كأمهات شابات في عراق اليوم كما ربّت جداتنا أبناءهن وبناتهن في بيئة مصممة منذ مئات السنين لتكون ساحة حرب؛ مرة من أجل العقيدة ومرة من أجل القومية ومرات من أجل حروب عبثية لا طائل منها.. متوترة ومأزومة وغير متقبلة لاختلاف أفرادها.
باتت الكثير من “أمهات اليوم” يتابعن على “إنستغرام” عدداً لا يستهان به من الحسابات التي تدعو لاتباع طرق مختلفة لتربية الأطفال. تتحدد الغالبية العظمى من هذه البرامج بمنهجين: منهج التربية التقليدية القائمة على الثواب والعقاب، ومنهج التربية الحديثة القائمة على المحاورة والتفاعل بين المربي/ة والطفل.
لا تولّد هذه الحسابات تنافسات على الربح بين صناع المحتوى فحسب، بل تنافساً بين الأمهات على من تكون الأم الأكثر مثالية، ما يجعل من الحيز الافتراضي بيئة سامة لهن لا مساحة آمنة ليشاركن هموم التربية وأعباءها وسبل مواجهة تحدياتها.
بين “الماجدات” و”المثاليات”
“نستمد أمومتنا من أمهاتنا.. إما بتقليدها أو معارضتها”، تقول إيمان مرسال في كتابها “عن الأمومة وأشباحها”، والأم العراقية مثالاً لذلك.
يتمايز نموذج الأم العراقية بين حقبة وحقبة وفقاً للظروف التي واجهتها في تربية أطفالها.
فمثلاً اتسمت حقبة حكم البعث بإدامة رفد المنظومة العسكرية بالأفراد وحرقهم في حروب داخلية وخارجية، غالباً ما كانت عبثية. تطلّب تحقيق هذا الهدف برمجة الأمهات لكي ينتجن الأولاد الذكور تحديداً، وإعطاءهن مكانة مميزة في حياتهم ومماتهم عندما يصبحن أمهات الشهداء، لدرجة منح النظام لقب “الأم المثالية” لمن فقدن أبناءهن في الحرب، أي دون أن يقدرن حتى على ممارسة دور الأمومة!
عملت أمهاتنا على التكيّف قدر الإمكان مع نظام قمعي للحفاظ على أطفالهن، بيد أنه ودون أن يشعرن كن يقدمن أولادهن له بسخاء عبر مشاركتهن في ترسيخ مفهوم الأم العراقية “الماجدة” التي تزغرد عندما تثكل بأولادها في حروب عبثية. كما كانت الأم التي شغلت أكثر من “وظيفة” في خدمة النظام لكي تحظى باعتبار المجتمع، كأن تكون أماً لجنود عدة أو موظفة أو عاملة وأماً في الوقت نفسه أو مشاركة بالحرب عبر دعم أفراد الجيش وغيره. أي كل من تضحي من أجل النظام الذي فصّل أمومتها وفق مفهوم العسكرة واعتبر الأم والطفل مجرد أشياء أو مفاعيل.

خلق جيل “الماجدات” جيلاً من الأمهات على شاكلتهن في الغالب، وإن اختلف النظام القمعي الذي تحيا به الأمهات “الجدد”. فرفض العسكرة ما يزال ممنوعاً على الأم، بل وما يزال تمجيدها هو السائد، حيث مجرد عدم رغبة الأم بدفع ابنها لهذه الحرب أو تلك، يعني وصمها بالتخاذل ووصفه بالجبن. مفهوم الأم التي تهلّل لشهادة ابنها عالق في الأذهان لدرجة أن الكثير من أمهات الشهداء بعد الحرب الطائفية وحرب “داعش” كن غير قادرات على التعبير عن ألمهن النفسي، فبمجرد أن يتكلمن تكتم أصواتهن بعبارات من قبيل “أحمدي الله مات شهيد”، “مات وهو يدافع عن وطنه”، “مات وهو ينفذ فتوى السيد”. يعني ذلك أن جيل الأمهات الجدد ما يزلن يواجهن تحديات حينما يرفضن همس الجهاد في آذان أطفالهن أو رفض إغوائهم بالمال والسيطرة للانتماء إلى المليشيات.
كما تواجه أمهات اليوم تحديّات أخرى كثيرة بعيداً عن ساحات الحروب، حيث هناك رفضهن لكراهية النساء في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك الخوف من التحرش الذي لا يستتبعه عقاب ويتطلب من الأم أن تتعلم كيف تحمي أطفالها بنفسها وليس دولتهم، وهناك رغبتها في إخراجهم إلى الحياة أسوياء نفسياً فلا يعيشون ما عاشته هي في ظل “أم الحصار” التي خيم عليها القلق والتوتر وتجلى بالتعنيف والقسوة.
بين أمهاتنا والأمهات اللواتي صرنا، دخلت السوشيال ميديا لاعباً جديداً على خط الأمومة، حيث تنتشر على إنستغرام مقاطع توجه للأسس المثالية للتربية وهي متنوعة بين العراقية منها كنور اكرم والعربية منها كغزل البغدادي وجاسم المطوع وطارق السويدان، وهناك حسابات أجنبية تكون عادة مترجمة.1
تتأرجح طرق التربية التي تقدمها هذه الشخصيات بين الأسلوب المحافظ والحديث، من رهاب الغرب إلى الحث على تقبل الآخر المختلف كلياً. منهم من درس التربية بشكل منهجي وعلمي، ومنهم من درسها بشكل مقتضب ليُدرِّس هو التربية، ومنهم من غير المنجبين الذين لم يمروا بتجربة التربية، وهناك من خاضها فارتأى تحويل تجربته الشخصية إلى محتوى عن التربية ونشره.
فغزل البغدادي، سورية مقيمة في بريطانيا، تجهز ابنتها تربوياً لمجتمع غير المجتمع العربي، وطارق السويدان، رجل الدين الإماراتي والمهتم بالتنمية البشرية، هدفه لإخراج جيل “يفتخر به رسول الله”، أما نور أكرم، وهي عراقية من كربلاء، فلها أفكار وتطلعات مختلفة عن مجتمعها وسياقاته، وهناك منصة baby melons التابعة لإيمان بطيخة وهي سورية مقيمة في كندا.
ما نلحظه من كل هذه الأمثلة أن كل صناع المحتوى على الانستغرام باتوا الحاكم الرقيب على الأمهات، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هؤلاء يربين تحت ظل عقائد وتعقيدات الواقع الاجتماعي والسياسي العراقي.
تعافين ثم ربين..
في ظل دولة ترفعت وأنفت عن الاهتمام بالصحة النفسية لشعبها أو المبالاة بالارتقاء بمستواهم التربوي أو الاخلاقي عبر مؤسساتها، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً الانستغرام، المصدر الرئيسي لتعلم وتلقي المجتمع للمعلومات حول التربية والصحة النفسية.
يستطيع من يتابع هذه القنوات أن يشخّص مثلاً الاسم والوصف المرضي للتصرفات والمشاعر التي نعيشها في حياتنا اليومية. عادة ما تحيل هذه الفيديوهات “التعليمية” الضائقة النفسية التي يمر بها البالغون إلى مرحلة الطفولة وتوضح كيف تؤثر على علاقاتهم مع من حولهم، ومنهم أطفالهم.
عادة ما تقف هذه الفيديوهات عند هذا الحد، ليتساءل المشاهد عن سبل إيجاد الحل وقد تشخصت -فرضاً- الحالة النفسية الآن، فيكون الرد عادة على شاكلة “إذا أردت تعلم المزيد من المعلومات أو معالجة ما أنت فيه بإمكانك الالتحاق بدوراتنا أو دروسنا أو الاتصال بنا لمعالجتك عن بُعد”.
وعلى المسار نفسه وبشكل موازٍ، هناك فيديوهات التثقيف نحو التربية “المثالية” التي يغرق بها إنستغرام الأمهات خانقاً إياهن وهو يوضح لهن كيف أن سلوكيات تربوية يقمن بها تكون غير صائبة أو مضرة نفسياً، ويجب استبدالها بأخرى لكي لا يصاب الطفل بعقد نفسية في الكبر وتؤثر على شكل حياته، متبوعة عادة بملاحظات تحثك إذا أردتِ تعلم المزيد بعيداً عن حالة التعلم العشوائي التي وجدت نفسك مغرقة بها على الالتحاق بكورسات التربية التي يقدمها هؤلاء.
حالة التوازي بين هذين الخطين، أي خط يدعو للتشافي من عقد الطفولة، وآخر للتربية الجيدة لكي “لا تؤسس لعُقد طفولة كما فعل والداك بك”، دفعت إلى ظهور موجة من الأمهات المترددات والخائفات من اتباع أساليب تظهرها تلك الفيديوهات على أنها مصدر معاناتهن اليوم كأمهات بعدما كانت قد اتُبعت نحوهن وهن بنات، ولن يسمحن لأنفسهن أن يجعلن أطفالهن يعانون جراءها أيضاً.

تقف الأم في حالة صراع دائم لتحصيل الاستقلالية التي يتطلبها هذا النوع من التربية. استقلالية تكون شبه معدومة في السياق العراقي، فغالبية الأمهات يعشن في أسرٍ ممتدة، تكون مهمة التربية فيها موزعة بين الأجداد والأعمام وزوجات الأعمام والعمات وغيرهم على اختلافهم. إلى جانب ذلك، فهناك المؤسسات التربوية والتعليمية التي غالباً ما تهدم ما تبذله الأم من جهد تربوي، بسبب التوجيه المدرسي العنيف أو الاهمال أو أفول التوجيه الواعي لسلوكيات الأطفال غير السليمة وانعدام الرقابة على قضايا التحرش الجنسي بينهم.
إن منظومة التعليم بشكلها التجاري الحالي غير بناءة، حيث تمنح شهادات دون تعليم حقيقي أو متابعة تربوية.
يتشارك في عملية تكوين الصورة المثالية للأمومة أكثر من مؤثِر ونظام، لكن دخول السوشيال ميديا كمؤثِر يوميّ هو ما استجد، فمثلاً قد تعتقد الكنة التي انفصلت عن عائلة زوجها وظفرت ببيت صغير لتربي طفلها بمعزل عن تأثير الأجداد وتدخلهم بتربيته بمجرد تحقق الانفصال المكاني أنها حرة بتربيته، ولكن أشباحهم موجودة على هاتفها طوال الوقت. فدفع صناع المحتوى التربوي الأمهات ليرتدين رداء الأمومة المثالية، ما هو إلا تجسيد لهم عن بُعد لدرجة أن مجتمع الأمهات نفسه صار مجتمعَ تنافس ومزايدات بمن تكون أم مثالية، بالرغم من كثرة المشتركات وتعددهن.
هل نحن أمهات جيدات أم سيئات؟
لطالما شكلت نصائح الجدات وفيديوهات التربية بمثابة “الوخز” في جسدي، وخاصة عندما أشعر بأن النصيحة أكبر من قدراتي، فهل هي عقدة الذنب الملازمة للأمومة؟
كنت قد سألت أكثر من أم زميلة لي في رحلة الأمومة فيما إذا كانت فيديوهات التربية المتعددة والمتنوعة في الاتجاهات والرؤى تشكل عليها ضغطاً نفسياً، فنفين ذلك بل وأشرن أنه وعلى العكس تماماً فهذه الفيديوهات تساعد في عملية التربية التي عبرن عنها بطرق مختلفة مثل “المهمة الأصعب على الإطلاق”، “مسؤولية ورسالة قيمة”، “عطاء بدون مقابل”.
لكن عند سؤالهن فيما إذا كن يسألن أنفسهن باستمرار ما إذا كنّ أمهات جيدات، تبين أن جميعهن سألن السؤال ذاته. تقول إحدى الأمهات، “أسأل نفسي لكن بلا إجابة.. دائما أسأل نفسي وأؤنبها، وخاصة بعد مشاهدة فيديوهات تدين أفعالاً كنت أمارسها بشكل طبيعي في التربية.. كل يوم قبل أن أنام أسأل نفسي هذا السؤال وخاصة إذا كان يوماً صعباً فشعور التأنيب لا يفارقني”.
وما هي التربية السليمة؟ فثمة نماذج لأطفال كانت أمهاتهن حريصات على التربية المثالية نشؤوا ليكونوا مترددين خائفين من ارتكاب أي خطأ، حتى ولو كان أثناء تمرين أو نشاط، حد أن كثراً منهم باتوا انعزاليين ولا يتحدثون بكثرة؛ وهذا أمر شهدته من خلال عملي في مجال إدارة رياض الأطفال.
ما يفاقم كل هذا هو أن التربية السليمة مهمة تقع على عاتق الأم بالدرجة الأساس، وهذا اعتقاد اجتماعي تروجه مقاطع التربية على الانستغرام، بما فيها الأجنبية أيضاً. حيث نجد أن غالبيتها موجهة إلى النساء الأمهات، وليس إلى الآباء، وهذا يعني ضمنياً بأن أعباء التربية لا الإنجاب فقط تقع على عاتق الأم، وهي المسؤولة الأولى عن تلك المهمة وكل فشل فيها هو بسبب تقصير أو إهمال منها.
ولذلك فإن التأنيب يرافقننا نحن الأمهات عند الإفراط في مشاهدة مقاطع التربية. الأمهات يواجهن ضغطا نفسياً بسبب تلك المقاطع لكنهن لا يعرفنه على أنه “ضغط”، وقد يكون عدم الاعتراف بهذا الضغط نابعاً من الفيديوهات نفسها كما عبرت إحدى الأمهات، التي تعمد إلى إيصال فكرة للأمهات أن التربية الصحيحة سحر بين أيديهم/ن، ومن تتجاهلها فهي تقدم رعاية وتربية “عادية”، لا تربية سليمة.
وهكذا فإن عدم الوصول إلى مستوى تلك المقاطع بات يشكل ضغطاً على الأمهات لأنهن يمارسن التربية بشكل “عادي” ولا يبذلن جهداً بما يكفي. إن اللعب على الوتر النفسي للأمهات يضر الطفل والأم في المقام الأول، كما يضر المجتمع الذي يصدرون له تلك المنتجات البشرية ويحرصون على أن تكون عالية الجودة “مثالية”.
التربية ليست فعلاً شخصياً بل سياسياً
ثمة هموم عديدة تتقاسمها الأمهات، مثل المعضلة ما بين تشجيع وقبول لجوء أطفالهن للعنف في الدفاع عن النفس سواء في المدرسة أو الشارع، وإلا عُدّ الطفل غير مُقدر ومُحترم بين أقرانه، وبين استخدام الأسلوب السلمي وتجاهل البيئة المحيطة التي يعيش فيها. وهناك رهاب المثلية (الهوموفوبيا) الذي تركز عليه أغلب الحسابات وطرق التعامل معها، وكذلك آليات الحماية من العنف الجنسي وغيرها.
هموم الأمهات المشتركة يجعل من مسألة التربية مسألة ذات بعد سياسي أكثر منه شخصياً كونها من نصيب ملايين النساء لأسباب متشابهة: الخوف من عراك الصبيان الطبيعي في مرحلتهم العمرية لكي لا يصل إلى قضاء العشيرة ودفع فصول تصل إلى الملايين، والخوف من التحرش الجنسي وتربية العقد النفسية في نفوس أطفالهن أو الخوف من العنف المدرسي بدون حماية من الدولة والخوف من الالتحاق بالمليشيات أو الانجرار إلى البغاء بين الفتيات أو انتشار المخدرات.
كما أن المسؤولية المشتركة ما بين الأهل ومؤسسات المجتمع والدولة في حماية الأطفال وتأمين بيئة سليمة لنموهم، هي تعبير واضح للبعد السياسي للتربية. إذ أن إحدى وظائف الدولة هو توفير الحماية للأطفال، من التحرش مثلاً، عبر ترجمة ما وقعت عليه في اتفاقية حقوق الطفل وذكرته في دستورها إلى قوانين ومؤسسات إنفاذ قوانين ونظم تعليمية قادرة أن ترسخه لدى الأطفال والمجتمع.

لكن حسابات الانستغرام عن التربية التنافسية جعلت من موضوع حماية الطفل همّاً شخصياً وفردياً بالنسبة للأم، وبالتالي فعليها مواجهته والاطلاع عليه وفهمه لحماية صغيرها.
فمثلاً ووفق طارق سويدان -وهو باحث وكاتب وداعية إسلامي وليس مختص تربية- يجب أن تكون التربية تغيير عقول وخلق قدرات قيادية لا “مجرد” رعاية. يستهين صاحب قناة توجيه تربوي بالرعاية كوظيفة تستنزف وقت النساء، كما يقدم نصائح لا تمت بصلة لسياق الأم أو طفلها، متناسياً أن عملية التربية هي عملية تفاعلية بين الأم والطفل والمحيط، وليس بين الأم والطفل فحسب.
التربية الجيدة والمناسبة لصاحب/ة الفيديو ممن تعيش مع طفلها تحت سقف واحد هو مناسب لها ولتاريخها النفسي والأسري ولقابلياتها هي. أما طرقنا في التربية نحن كأمهات فتحكمها قدراتنا وخبراتنا الحياتية التي تتفاعل يومياً مع محيط نحاول به نقل المهارات الأمثل في التعامل والسلوك من جيل إلى آخر وفق واقعنا وسياقنا، لا باقتباس واتباع تقنيات تربية تفترض الاستقرار المادي والسياسي والاقتصادي في بيئة الطفل. تقنيات تفترض أن الأم مخيرة في اختيار أساليب التربية وفي اختيار الأب، ومخيرة بين العمل وتركه وحرة ومالكة لأدوات خارقة تحمي بها طفلها من النزف من أجل ميليشيا أو حركة سياسية، بل ومدربة لتكون أماً مختصة نفسية في غاية الهدوء.. وكأن الأمهات من كوكب آخر وأمومتهن وافدة من الانستغرام.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
نربي صغارنا كأمهات شابات في عراق اليوم كما ربّت جداتنا أبناءهن وبناتهن في بيئة مصممة منذ مئات السنين لتكون ساحة حرب؛ مرة من أجل العقيدة ومرة من أجل القومية ومرات من أجل حروب عبثية لا طائل منها.. متوترة ومأزومة وغير متقبلة لاختلاف أفرادها.
باتت الكثير من “أمهات اليوم” يتابعن على “إنستغرام” عدداً لا يستهان به من الحسابات التي تدعو لاتباع طرق مختلفة لتربية الأطفال. تتحدد الغالبية العظمى من هذه البرامج بمنهجين: منهج التربية التقليدية القائمة على الثواب والعقاب، ومنهج التربية الحديثة القائمة على المحاورة والتفاعل بين المربي/ة والطفل.
لا تولّد هذه الحسابات تنافسات على الربح بين صناع المحتوى فحسب، بل تنافساً بين الأمهات على من تكون الأم الأكثر مثالية، ما يجعل من الحيز الافتراضي بيئة سامة لهن لا مساحة آمنة ليشاركن هموم التربية وأعباءها وسبل مواجهة تحدياتها.
بين “الماجدات” و”المثاليات”
“نستمد أمومتنا من أمهاتنا.. إما بتقليدها أو معارضتها”، تقول إيمان مرسال في كتابها “عن الأمومة وأشباحها”، والأم العراقية مثالاً لذلك.
يتمايز نموذج الأم العراقية بين حقبة وحقبة وفقاً للظروف التي واجهتها في تربية أطفالها.
فمثلاً اتسمت حقبة حكم البعث بإدامة رفد المنظومة العسكرية بالأفراد وحرقهم في حروب داخلية وخارجية، غالباً ما كانت عبثية. تطلّب تحقيق هذا الهدف برمجة الأمهات لكي ينتجن الأولاد الذكور تحديداً، وإعطاءهن مكانة مميزة في حياتهم ومماتهم عندما يصبحن أمهات الشهداء، لدرجة منح النظام لقب “الأم المثالية” لمن فقدن أبناءهن في الحرب، أي دون أن يقدرن حتى على ممارسة دور الأمومة!
عملت أمهاتنا على التكيّف قدر الإمكان مع نظام قمعي للحفاظ على أطفالهن، بيد أنه ودون أن يشعرن كن يقدمن أولادهن له بسخاء عبر مشاركتهن في ترسيخ مفهوم الأم العراقية “الماجدة” التي تزغرد عندما تثكل بأولادها في حروب عبثية. كما كانت الأم التي شغلت أكثر من “وظيفة” في خدمة النظام لكي تحظى باعتبار المجتمع، كأن تكون أماً لجنود عدة أو موظفة أو عاملة وأماً في الوقت نفسه أو مشاركة بالحرب عبر دعم أفراد الجيش وغيره. أي كل من تضحي من أجل النظام الذي فصّل أمومتها وفق مفهوم العسكرة واعتبر الأم والطفل مجرد أشياء أو مفاعيل.

خلق جيل “الماجدات” جيلاً من الأمهات على شاكلتهن في الغالب، وإن اختلف النظام القمعي الذي تحيا به الأمهات “الجدد”. فرفض العسكرة ما يزال ممنوعاً على الأم، بل وما يزال تمجيدها هو السائد، حيث مجرد عدم رغبة الأم بدفع ابنها لهذه الحرب أو تلك، يعني وصمها بالتخاذل ووصفه بالجبن. مفهوم الأم التي تهلّل لشهادة ابنها عالق في الأذهان لدرجة أن الكثير من أمهات الشهداء بعد الحرب الطائفية وحرب “داعش” كن غير قادرات على التعبير عن ألمهن النفسي، فبمجرد أن يتكلمن تكتم أصواتهن بعبارات من قبيل “أحمدي الله مات شهيد”، “مات وهو يدافع عن وطنه”، “مات وهو ينفذ فتوى السيد”. يعني ذلك أن جيل الأمهات الجدد ما يزلن يواجهن تحديات حينما يرفضن همس الجهاد في آذان أطفالهن أو رفض إغوائهم بالمال والسيطرة للانتماء إلى المليشيات.
كما تواجه أمهات اليوم تحديّات أخرى كثيرة بعيداً عن ساحات الحروب، حيث هناك رفضهن لكراهية النساء في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك الخوف من التحرش الذي لا يستتبعه عقاب ويتطلب من الأم أن تتعلم كيف تحمي أطفالها بنفسها وليس دولتهم، وهناك رغبتها في إخراجهم إلى الحياة أسوياء نفسياً فلا يعيشون ما عاشته هي في ظل “أم الحصار” التي خيم عليها القلق والتوتر وتجلى بالتعنيف والقسوة.
بين أمهاتنا والأمهات اللواتي صرنا، دخلت السوشيال ميديا لاعباً جديداً على خط الأمومة، حيث تنتشر على إنستغرام مقاطع توجه للأسس المثالية للتربية وهي متنوعة بين العراقية منها كنور اكرم والعربية منها كغزل البغدادي وجاسم المطوع وطارق السويدان، وهناك حسابات أجنبية تكون عادة مترجمة.1
تتأرجح طرق التربية التي تقدمها هذه الشخصيات بين الأسلوب المحافظ والحديث، من رهاب الغرب إلى الحث على تقبل الآخر المختلف كلياً. منهم من درس التربية بشكل منهجي وعلمي، ومنهم من درسها بشكل مقتضب ليُدرِّس هو التربية، ومنهم من غير المنجبين الذين لم يمروا بتجربة التربية، وهناك من خاضها فارتأى تحويل تجربته الشخصية إلى محتوى عن التربية ونشره.
فغزل البغدادي، سورية مقيمة في بريطانيا، تجهز ابنتها تربوياً لمجتمع غير المجتمع العربي، وطارق السويدان، رجل الدين الإماراتي والمهتم بالتنمية البشرية، هدفه لإخراج جيل “يفتخر به رسول الله”، أما نور أكرم، وهي عراقية من كربلاء، فلها أفكار وتطلعات مختلفة عن مجتمعها وسياقاته، وهناك منصة baby melons التابعة لإيمان بطيخة وهي سورية مقيمة في كندا.
ما نلحظه من كل هذه الأمثلة أن كل صناع المحتوى على الانستغرام باتوا الحاكم الرقيب على الأمهات، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هؤلاء يربين تحت ظل عقائد وتعقيدات الواقع الاجتماعي والسياسي العراقي.
تعافين ثم ربين..
في ظل دولة ترفعت وأنفت عن الاهتمام بالصحة النفسية لشعبها أو المبالاة بالارتقاء بمستواهم التربوي أو الاخلاقي عبر مؤسساتها، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً الانستغرام، المصدر الرئيسي لتعلم وتلقي المجتمع للمعلومات حول التربية والصحة النفسية.
يستطيع من يتابع هذه القنوات أن يشخّص مثلاً الاسم والوصف المرضي للتصرفات والمشاعر التي نعيشها في حياتنا اليومية. عادة ما تحيل هذه الفيديوهات “التعليمية” الضائقة النفسية التي يمر بها البالغون إلى مرحلة الطفولة وتوضح كيف تؤثر على علاقاتهم مع من حولهم، ومنهم أطفالهم.
عادة ما تقف هذه الفيديوهات عند هذا الحد، ليتساءل المشاهد عن سبل إيجاد الحل وقد تشخصت -فرضاً- الحالة النفسية الآن، فيكون الرد عادة على شاكلة “إذا أردت تعلم المزيد من المعلومات أو معالجة ما أنت فيه بإمكانك الالتحاق بدوراتنا أو دروسنا أو الاتصال بنا لمعالجتك عن بُعد”.
وعلى المسار نفسه وبشكل موازٍ، هناك فيديوهات التثقيف نحو التربية “المثالية” التي يغرق بها إنستغرام الأمهات خانقاً إياهن وهو يوضح لهن كيف أن سلوكيات تربوية يقمن بها تكون غير صائبة أو مضرة نفسياً، ويجب استبدالها بأخرى لكي لا يصاب الطفل بعقد نفسية في الكبر وتؤثر على شكل حياته، متبوعة عادة بملاحظات تحثك إذا أردتِ تعلم المزيد بعيداً عن حالة التعلم العشوائي التي وجدت نفسك مغرقة بها على الالتحاق بكورسات التربية التي يقدمها هؤلاء.
حالة التوازي بين هذين الخطين، أي خط يدعو للتشافي من عقد الطفولة، وآخر للتربية الجيدة لكي “لا تؤسس لعُقد طفولة كما فعل والداك بك”، دفعت إلى ظهور موجة من الأمهات المترددات والخائفات من اتباع أساليب تظهرها تلك الفيديوهات على أنها مصدر معاناتهن اليوم كأمهات بعدما كانت قد اتُبعت نحوهن وهن بنات، ولن يسمحن لأنفسهن أن يجعلن أطفالهن يعانون جراءها أيضاً.

تقف الأم في حالة صراع دائم لتحصيل الاستقلالية التي يتطلبها هذا النوع من التربية. استقلالية تكون شبه معدومة في السياق العراقي، فغالبية الأمهات يعشن في أسرٍ ممتدة، تكون مهمة التربية فيها موزعة بين الأجداد والأعمام وزوجات الأعمام والعمات وغيرهم على اختلافهم. إلى جانب ذلك، فهناك المؤسسات التربوية والتعليمية التي غالباً ما تهدم ما تبذله الأم من جهد تربوي، بسبب التوجيه المدرسي العنيف أو الاهمال أو أفول التوجيه الواعي لسلوكيات الأطفال غير السليمة وانعدام الرقابة على قضايا التحرش الجنسي بينهم.
إن منظومة التعليم بشكلها التجاري الحالي غير بناءة، حيث تمنح شهادات دون تعليم حقيقي أو متابعة تربوية.
يتشارك في عملية تكوين الصورة المثالية للأمومة أكثر من مؤثِر ونظام، لكن دخول السوشيال ميديا كمؤثِر يوميّ هو ما استجد، فمثلاً قد تعتقد الكنة التي انفصلت عن عائلة زوجها وظفرت ببيت صغير لتربي طفلها بمعزل عن تأثير الأجداد وتدخلهم بتربيته بمجرد تحقق الانفصال المكاني أنها حرة بتربيته، ولكن أشباحهم موجودة على هاتفها طوال الوقت. فدفع صناع المحتوى التربوي الأمهات ليرتدين رداء الأمومة المثالية، ما هو إلا تجسيد لهم عن بُعد لدرجة أن مجتمع الأمهات نفسه صار مجتمعَ تنافس ومزايدات بمن تكون أم مثالية، بالرغم من كثرة المشتركات وتعددهن.
هل نحن أمهات جيدات أم سيئات؟
لطالما شكلت نصائح الجدات وفيديوهات التربية بمثابة “الوخز” في جسدي، وخاصة عندما أشعر بأن النصيحة أكبر من قدراتي، فهل هي عقدة الذنب الملازمة للأمومة؟
كنت قد سألت أكثر من أم زميلة لي في رحلة الأمومة فيما إذا كانت فيديوهات التربية المتعددة والمتنوعة في الاتجاهات والرؤى تشكل عليها ضغطاً نفسياً، فنفين ذلك بل وأشرن أنه وعلى العكس تماماً فهذه الفيديوهات تساعد في عملية التربية التي عبرن عنها بطرق مختلفة مثل “المهمة الأصعب على الإطلاق”، “مسؤولية ورسالة قيمة”، “عطاء بدون مقابل”.
لكن عند سؤالهن فيما إذا كن يسألن أنفسهن باستمرار ما إذا كنّ أمهات جيدات، تبين أن جميعهن سألن السؤال ذاته. تقول إحدى الأمهات، “أسأل نفسي لكن بلا إجابة.. دائما أسأل نفسي وأؤنبها، وخاصة بعد مشاهدة فيديوهات تدين أفعالاً كنت أمارسها بشكل طبيعي في التربية.. كل يوم قبل أن أنام أسأل نفسي هذا السؤال وخاصة إذا كان يوماً صعباً فشعور التأنيب لا يفارقني”.
وما هي التربية السليمة؟ فثمة نماذج لأطفال كانت أمهاتهن حريصات على التربية المثالية نشؤوا ليكونوا مترددين خائفين من ارتكاب أي خطأ، حتى ولو كان أثناء تمرين أو نشاط، حد أن كثراً منهم باتوا انعزاليين ولا يتحدثون بكثرة؛ وهذا أمر شهدته من خلال عملي في مجال إدارة رياض الأطفال.
ما يفاقم كل هذا هو أن التربية السليمة مهمة تقع على عاتق الأم بالدرجة الأساس، وهذا اعتقاد اجتماعي تروجه مقاطع التربية على الانستغرام، بما فيها الأجنبية أيضاً. حيث نجد أن غالبيتها موجهة إلى النساء الأمهات، وليس إلى الآباء، وهذا يعني ضمنياً بأن أعباء التربية لا الإنجاب فقط تقع على عاتق الأم، وهي المسؤولة الأولى عن تلك المهمة وكل فشل فيها هو بسبب تقصير أو إهمال منها.
ولذلك فإن التأنيب يرافقننا نحن الأمهات عند الإفراط في مشاهدة مقاطع التربية. الأمهات يواجهن ضغطا نفسياً بسبب تلك المقاطع لكنهن لا يعرفنه على أنه “ضغط”، وقد يكون عدم الاعتراف بهذا الضغط نابعاً من الفيديوهات نفسها كما عبرت إحدى الأمهات، التي تعمد إلى إيصال فكرة للأمهات أن التربية الصحيحة سحر بين أيديهم/ن، ومن تتجاهلها فهي تقدم رعاية وتربية “عادية”، لا تربية سليمة.
وهكذا فإن عدم الوصول إلى مستوى تلك المقاطع بات يشكل ضغطاً على الأمهات لأنهن يمارسن التربية بشكل “عادي” ولا يبذلن جهداً بما يكفي. إن اللعب على الوتر النفسي للأمهات يضر الطفل والأم في المقام الأول، كما يضر المجتمع الذي يصدرون له تلك المنتجات البشرية ويحرصون على أن تكون عالية الجودة “مثالية”.
التربية ليست فعلاً شخصياً بل سياسياً
ثمة هموم عديدة تتقاسمها الأمهات، مثل المعضلة ما بين تشجيع وقبول لجوء أطفالهن للعنف في الدفاع عن النفس سواء في المدرسة أو الشارع، وإلا عُدّ الطفل غير مُقدر ومُحترم بين أقرانه، وبين استخدام الأسلوب السلمي وتجاهل البيئة المحيطة التي يعيش فيها. وهناك رهاب المثلية (الهوموفوبيا) الذي تركز عليه أغلب الحسابات وطرق التعامل معها، وكذلك آليات الحماية من العنف الجنسي وغيرها.
هموم الأمهات المشتركة يجعل من مسألة التربية مسألة ذات بعد سياسي أكثر منه شخصياً كونها من نصيب ملايين النساء لأسباب متشابهة: الخوف من عراك الصبيان الطبيعي في مرحلتهم العمرية لكي لا يصل إلى قضاء العشيرة ودفع فصول تصل إلى الملايين، والخوف من التحرش الجنسي وتربية العقد النفسية في نفوس أطفالهن أو الخوف من العنف المدرسي بدون حماية من الدولة والخوف من الالتحاق بالمليشيات أو الانجرار إلى البغاء بين الفتيات أو انتشار المخدرات.
كما أن المسؤولية المشتركة ما بين الأهل ومؤسسات المجتمع والدولة في حماية الأطفال وتأمين بيئة سليمة لنموهم، هي تعبير واضح للبعد السياسي للتربية. إذ أن إحدى وظائف الدولة هو توفير الحماية للأطفال، من التحرش مثلاً، عبر ترجمة ما وقعت عليه في اتفاقية حقوق الطفل وذكرته في دستورها إلى قوانين ومؤسسات إنفاذ قوانين ونظم تعليمية قادرة أن ترسخه لدى الأطفال والمجتمع.

لكن حسابات الانستغرام عن التربية التنافسية جعلت من موضوع حماية الطفل همّاً شخصياً وفردياً بالنسبة للأم، وبالتالي فعليها مواجهته والاطلاع عليه وفهمه لحماية صغيرها.
فمثلاً ووفق طارق سويدان -وهو باحث وكاتب وداعية إسلامي وليس مختص تربية- يجب أن تكون التربية تغيير عقول وخلق قدرات قيادية لا “مجرد” رعاية. يستهين صاحب قناة توجيه تربوي بالرعاية كوظيفة تستنزف وقت النساء، كما يقدم نصائح لا تمت بصلة لسياق الأم أو طفلها، متناسياً أن عملية التربية هي عملية تفاعلية بين الأم والطفل والمحيط، وليس بين الأم والطفل فحسب.
التربية الجيدة والمناسبة لصاحب/ة الفيديو ممن تعيش مع طفلها تحت سقف واحد هو مناسب لها ولتاريخها النفسي والأسري ولقابلياتها هي. أما طرقنا في التربية نحن كأمهات فتحكمها قدراتنا وخبراتنا الحياتية التي تتفاعل يومياً مع محيط نحاول به نقل المهارات الأمثل في التعامل والسلوك من جيل إلى آخر وفق واقعنا وسياقنا، لا باقتباس واتباع تقنيات تربية تفترض الاستقرار المادي والسياسي والاقتصادي في بيئة الطفل. تقنيات تفترض أن الأم مخيرة في اختيار أساليب التربية وفي اختيار الأب، ومخيرة بين العمل وتركه وحرة ومالكة لأدوات خارقة تحمي بها طفلها من النزف من أجل ميليشيا أو حركة سياسية، بل ومدربة لتكون أماً مختصة نفسية في غاية الهدوء.. وكأن الأمهات من كوكب آخر وأمومتهن وافدة من الانستغرام.