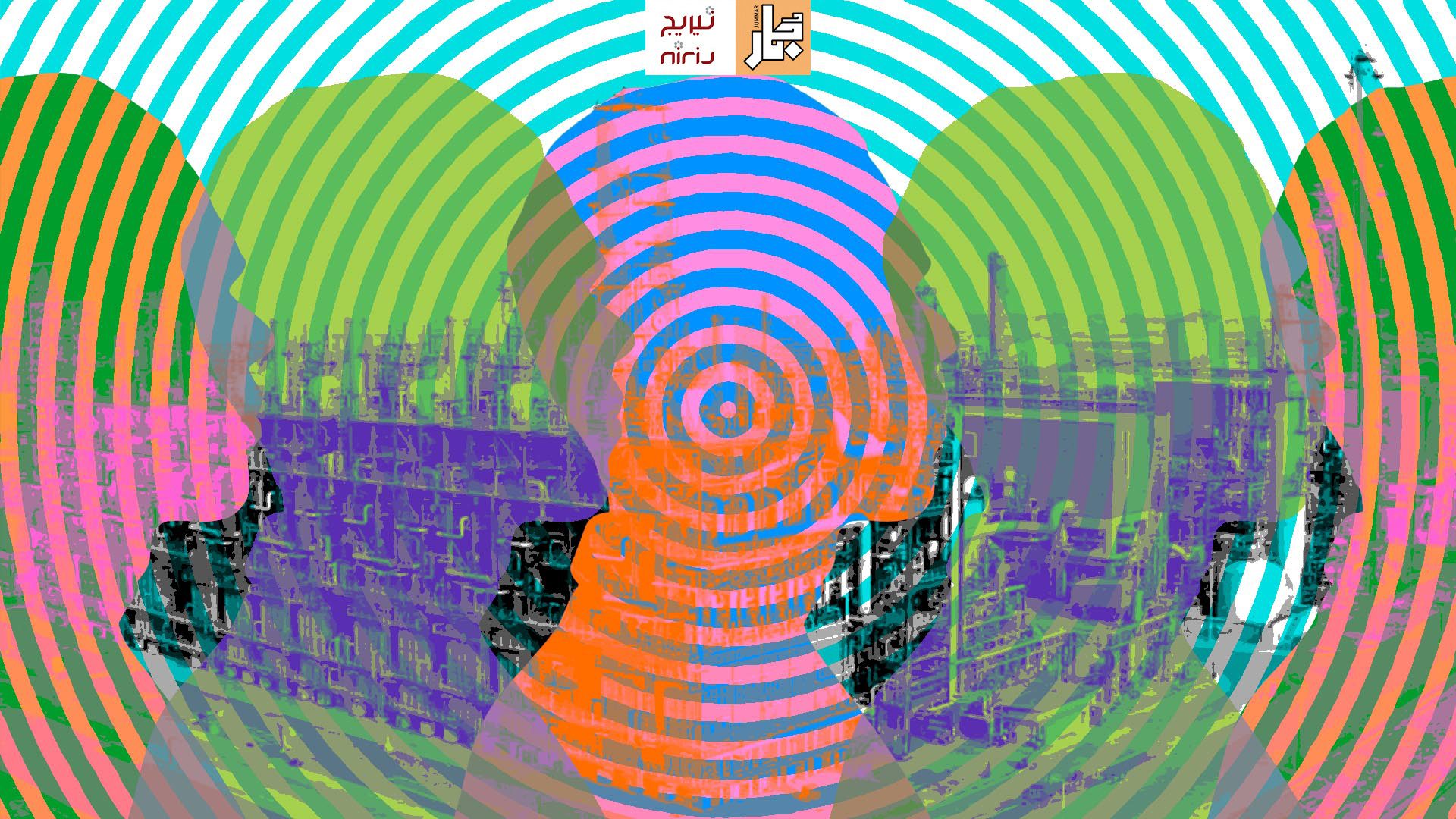المنع والتَّحريم.. عن رغباتٍ وملذاتٍ مطرودة
09 تشرين الثاني 2022
لا شك أن من ينام فوق آلةٍ ضخمة من المحرمات والوصايا والفضائِل الشرّيرة، من الصعب أن ينتهي به الأمر متصالحاً مع قدراتهِ الخارقة على الانتهاك والتمرد والكسر والقفز..
لسنا سوى مجموعة من المكبوتين الذين يجتمعون حولَ الكلمات من أجل الانتصابِ والضياع داخل كيس من الملذات المليء بالتحريم والمحاذير”، هذا ما قلته لمجموعةٍ من الأصدقاء، تعقيباً على كلامٍ كثير، ووسط نوع نادر من الإصغاء، قاطعني أحدهم: “هل تعتقد أن هذا الكبْت يمكنُ أن يُعالج”؟
لا شك أن من ينام فوق آلةٍ ضخمة من المحرمات والوصايا والفضائِل الشرّيرة، من الصعب أن ينتهي به الأمر متصالحاً مع قدراتهِ الخارقة على الانتهاك والتمرد والكسر والقفز. نحن حيواناتٌ مربوطة من الفك والأرجل، مقتادين إلى سجونِ الخير ومقدرٌ لنا أن نُصبح جبلاً من جليدٍ مطمور بالماء ولم يخرج منه سوى القليل، لذا عادة تصدم سفن الحياة بنا وتتحطم وتنهار.
لم أكن دقيقاً في تلك المحادثة، لكنني راجعتها في اليوم التالي، محاولاً البحث في حياتي أو حياة الآخرين عن المتع التي لم تكتمل.. عن الرغبات التي دُفنت في رملِ الفضيلة. رغبات كان مصيرها النسيان والتلاشي، لكنها تتكور كلّ ما مرَّ الزمن، لتصبح ثقباً أسودَ نضيع داخله كما لو أننا غير موجودين. ما هي مادة تلك الرغبة، كيف تبدأ وكيف تتضخم وكيف تتسرب إلى الحياة على شكلِ ردودِ فعل غير محسوبة؟
هل أنا أعاني حتى اللحظة من تلك الرغبات التي لم يكتب لها النجاح؟ هل أبدو معافى الآن وتحت جلدي مقبرة من الأحلام المقموعة؟ هل يبدو جيداً التحدث عن ذلك الممر الضيق المعتم في حياتي؟ هل أنا الوحيد الذي تعرض لهذا القمع الرمزيّ؟ هل أنا أكثرهم تحريراً وآن الأوان كي أتحدث؟ كلها أسئلة عادة يضعها المرء محاولاً التخلص من عبء الماضي، أو عبء عيون الآخرين وهي تراقب.
رغبة عبور سور المدرسة
لا أتذكر من المدرسة سوى القليل، القليل الذي يكاد لا يرى، معلمٌ هنا، معلمة هناك، نتيجة امتحان هنا، صديق هناك في المدرسة التي لم تعد موجودة، ركض هنا، ومشهد هناك.. لكنني لو طلب مني تذكر أكثر ما كنت أرغب به، لن أتردد في الحديث عن تلك النزعة الشرّيرة في عبور سور المدرسة رفقة أكثر الطلاب جسارة وتمرداً، من أجل الذهاب إلى قاعة الألعاب الإلكترونية، أو من أجل إكمال فصل كرة القدم الذي يبدو لذيذاً خارج المدرسة، حيث الوقت مفتوح مثل فم.. والأهداف أكثر جدية وأهمية.
لم يكن السور عالياً، وليس هناك ما يعيق عبوري، لا جسدي ولا عصا أستاذ صلاح، لكن الحبل الذي كان يشدني للخلف ويمنع إتمام تلك العملية هو الرب، الذي يحاسب الأشرار والمتسربين من المدرسة. لقد كان الحبل الأكثر جدية، فليس لدى والدي سلوك عنيف تجاه حركات من النوع هذا. بالمجمل، أبي متسامح متفهم وأمي ليس عنيفة للحد القاسي. كان لدي تصور طفولي أن الجنة لمن يدرسون ويخضعون للنظام التعليمي، والنار مكرسة لأولئك الذين عبروا السور تواً.. لقد كان ذلك انتصاري الرمزيّ عليهم، هنيئاً لكم اليوم اللعب، غدا سوف تشوى أجسادكم، فيما نتمتع ببطيخ الجنة وتفاح الآلهة.

لكن ومع مرور الأيام، بدأت اشك في ذلك السيناريو، فمن المضحك أن سور المدرسة هو الذي يفصل أهل الجنة عن أهل النار. وليس تلك سوى حكاية خيالية، ابتدعها طفل لا يقوى على ترك الصف المدرسي لحضور صف يعلم المرء كرة القدم والركض وطرق الأبواب ثم الهرب دون وجهة.
ربما لا أرغب الآن في عبور سور المدرسة، لكن العملية باتت أكثر تعقيداً، غالباً أجد نفسي مُتحمساً لعبور سور الوظيفة وتقديم استقالة، أو مستاءً من الوضع ومحاولاً عبور سور البلد. ربما خضع السور لسلسلةٍ من التغيرات وصار يمثل الآن سور العمل والوطن. وعادة اسأل، إذا كان ذلك العبور مرهونا بالجنة والنار، لم لا أعبر الأسوار الآن؟ هل أنا أخائف في الحالتين؟ ربما، ربما هذا هو الصواب، أو التفسير الأكثر منطقية.
لقد شهدت غرائب في التحريمِ والمنع
يقال إن الشيخ دخل إلى منزل الأجداد، ووجد تلفازاً فطلب بحياء وتردد أن ترتدي النسوة الحجاب حين يخرج رجل غريب على التلفاز! بعده بعقود، جاء إلى المنزل نفسه، رجل في عقده الثالث، ليخبر نساء المنزل عن العذاب في انتظارهن جراء مشاهدتهن “الستلايت”.. ومذاك جر حبل التحريم ليشمل النساء اللواتي يملكن هواتف محمولة، وثمة حكايات أخذت طريقها إلى التطبيق فيما تلاشى غيرها وضاع في غمرة الحياة.
معادة تطور الحياة ليس جديداً، وليس من الغريب أن نذكر أن المدارس قد حرمت على النساء في زمنٍ ما، وحرم ركوب القطار في مصر مثلاً وقيل فيها “أتتركون حمير الله وتركبون الشمندفر”، وغيرها من القصص.
لكن ثمة نوعا من التحريم والمنع حدث في وقت قريب. تحريم كنت شاهداً عليه وكنت جزءاً من تفاصيله.
نهاية التسعينيات انتقلت عمتي إلى منزل الزوج، وبعدها بمدة ليست طويلة، جاءا إلى منزل جدتي وكان جزءاً من الطقس أن تُنصب مائدة على شرف العريسين الجديدين. كان الاحتفاء بها واضحاً، فقد استعد الجميع من أجل تحضير المائدة، لكن ما حصل لم يكن في الحسبان، فخلال تلك الفترة القصيرة التي قضتها في منزل الزوج حرم عليها: الطرشي (المخلل)، والآيس كريم المصنوع من مادة الثعلبية، والسمك من نوع صبور، والجبن الذي على شكل مثلث.. وكلها أشياء لم تكن محرمة في بيت أهلها. لقد جاءت بأفكار غريبة ومثيرة حتى أجبرت العائلة أخيراً على عدم تقديم الطرشي مع الطعام! كانت كل هذه التحريمات بناء على فتوى المرجع الشيعي السيد محمد محمد صادق الصدر، الذي كانت عائلة زوجها تتبعه وتقلده، فانصهرت في ذلك المزاج المختلف عن مزاج أهلها.. وأنا الطفل الصغير لم أسمع قبل زواجها عن تحريم الطرشي مثلاً!
في أيام المدرسة الإعدادية بدأ الهاتف المحمول يصبح متاحاً للشباب، فامتلك بعض منا أجهزة محمولة، قسم منها فيه كاميرا، فيما كان القسم الآخر جهاز بسيط يتصل فحسب. وإذ كان بعض الشباب ذوو ميول ديني، فكان شغلهم الشاغل الخوض في الحدود بين الحرام والحلال. ومن أغرب ما أشيع في تلك الفترة بيننا، إن الجهاز الذي فيها كاميرا استخدامه مكروه، ثم خفتت تلك النبرة، لتصبح فيما بعد أن الجهاز الذي فيه “رام” (كرت ذاكرة) مكروه، وكل ذلك كان يستهدف شيئا واحدا وهو قمع الرام الذي يمكن أن يستخدم لغرض مشاهدة الأفلام الإباحية. والأكثر غرابة أن أحد الشباب امتنع عن شراء “رام” من شابٍ آخر في المدرسة، لأن الرام الذي بصدد شرائه دنس سابقاً وتم تحميل أفلام إباحية فيه، وذلك بعد سنوات من انتشار الهواتف وأصبحت من بديهيات النقاش في ذلك.

في أيام العنف الطائفي في العراق، ما بين 2005 إلى 2007، شهدت العديد من مناطق بغداد أنواعاً من التحريم من قبل الجماعات المسيطرة على هذه المناطق، طبقته ما تعرف بـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. ومن بين المحرمات التي شاعت في تلك الفترة: ارتداء النعال أبو الأصبع، البرمودة، استخدام الخيط لإزالة الشعر بالنسبة للشباب، استخدام المكياج بالنسبة للنساء.. وتعرض العديد من الناس لعقابٍ مباشر جراء مخالفته تلك التعليمات التي كانت تصدر بشكلٍ دوري.
أحياناً تلتفت لحياتك بشكلٍ عفوي، لمراقبة مفصلٍ ما، وربما سوف تدهش نتيجة مشاهدتك ما حصل. لقد تحملنا ونحن شبان كلّ هذا التحريم، كل هذا المنع والترويض، كلّ هذا القمع والعنف الذي مورس ضدنا كأفراد ومجتمع، قمع -بدونه- كان يمكن لحياتنا أن تكون غير ما هي عليه الآن!
ماذا فعلت بك الرأسمالية!
لا تخلو المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة وذات المساحة الشعبية، من نمو نوع من النساء اللواتي يثرن حفيظة الوجهاء وأهل الفضيلة، والمراقبون السريون الذي ينصبون أنفسهم دعاة وسط الناس. تلك هن النساء الشبقيات بشكلٍ أدق، اللواتي يواعدن رجلين أو أكثر في آن واحد. ليس هناك موقف واحد تجاه هؤلاء النسوة، اللواتي لا يتوانين في الشتم والسباب ورمي الكلمات التي “لا تقال حتى في حمام”، على حد التعبير الشائع. مع ذلك فثمة حضور قوي لهن.. منهن من أخرسها الزمن ومنهن من أسكتها السوط الديني الذي تكاثر في العقدين الآخرين، خصوصاً في المناطق الشعبية.
من جملة تلك النساء، أذكر جيداً ميادة التي كتبت عنها فيما مضى: “بقعة زيت على قميص العدم”، يمكن أن تضعها عبارة تقولها بنت في الثامنة عشرة ترى الرجال كلهم في ابن الجيران.

عبارة لا تخلو من الغضب ورائحة السرير يتداولها الناس في السر، وتصبح سجادة يتوضأ من أجلها العشاق بشعرهم المدهون بالحصار، وبناطيلهم التي تكنس شارع الحاجات المستعملة.
فكان أن قالت ميادة لأحدهم “لك أحبك بكد نار كسي”.. وأصبح حلم عشاق عام 1997 أن تبادر فتاة لإطلاق لافتة مثل هذه لهم.
في ذلك الزمن العدمي كان الحصول على حبة الانتعاش تلك أكثر ندرة من وجود إنسان مهذب الآن..
تزوجت ميادة فيما بعد برجل كبير في السن لا يكترث لتلك الروح المتفوقة من الجذب والإغواء..
“الكلمات في الجنس تفوق لذة الجنس نفسه”، هذا ما قاله رجل الذي سمع العبارة فيما بعد.
وبالانتقال من ميادة إلى بدرية لا يبدو أن ثمة ما يميز الثانية عن الأولى، إلا أن الثانية باتت بمرور الرجال تبيع ساعات وفقا للمزاج والرغبة وبشكل سري وخفي بيد أن الجميع كان يعرف ذلك!
بدرية ليست جميلة ولا قبيحة، بدرية ليست سوى جسد شهي يطل من الباب الضيق الأسود، لتدعو الرجل الذي يقف في الركن، لتبيع له ما يرغب. الغريب بالأمر أن أول مرة سمعت كلمة رأسمالية كانت في مجلس شبه عشائري، حيث قال أحد الجالسين في حلقة الرجال: “هذه الرأسمالية خربت الحياة، كلشي صار ينباع حتى جسد النساء”، وقفز ذهني مباشرة وقتها إلى بدرية، ورددت بيني وبين نفسي.. في حينها أم في وقت لاحق، “ماذا فعلت بك الرأسمالية يا كس بدرية”.
لكن الحقيقة أن لا دخل للرأسمالية في ذلك. كلّ ما في الأمر أنها أكثر قدرة من الآخرين على العبور، على الوصول إلى ما ترغب، لديها المهارة والجرأة أن تفعل ما تجده ملائماً لها، بعيداً عن التوصيفات التي يطلقها الآخرين، وبعيداً عن الاعتبارات التي أوقفت حياة الكثيرين. بدرية أكثر جنوناً بالحياة من غيرها، أكثر جدية في تلبية رغبتها، أكثر حدة في تنفيذ أوامرها، لا ممر ضيقاً أسود لديها تخفي فيه رغبتها، ربما هي الآن أكثر تصالحا مع نفسها من غيرها، ربما من يدري؟
ميادة وبدرية هما المثال الأكثر جدية عن الخوض بالحياة بكليتها، هما الأكثر قمعاً لكلب التكرار والخضوع وهو ينبح خلفهما. ففي حياة كلّ فرد نماذج من نوعين، نوع محافظ يمكنه أن يكبت حتى رغبته في شرب الماء حفاظاً على النهر، ونوع يمكنه أن يحرك المياه الراكدة ويفجر فئة جديدة من الأسئلة: هل المواجهة مع المجتمع خلاص من الكبت؟ هل الملذات تستحق صورة مشوشة يرسمها من حولنا عنا؟ ماذا فعلت الحياة لاحقاً بميادة وبدرية؟ هل كانت حياتهما مشوهة أم حياة قامعيهما؟ هل نحن الخائفون بسمعتنا الحسنة أفضل حالاً منهم؟ أسئلة تنثرها حياة الخائفين وحياة العابرين لسور الفضائل محاولين إيجاد حياة لا تتيحها الأعراف والقيم والوصايا.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
لسنا سوى مجموعة من المكبوتين الذين يجتمعون حولَ الكلمات من أجل الانتصابِ والضياع داخل كيس من الملذات المليء بالتحريم والمحاذير”، هذا ما قلته لمجموعةٍ من الأصدقاء، تعقيباً على كلامٍ كثير، ووسط نوع نادر من الإصغاء، قاطعني أحدهم: “هل تعتقد أن هذا الكبْت يمكنُ أن يُعالج”؟
لا شك أن من ينام فوق آلةٍ ضخمة من المحرمات والوصايا والفضائِل الشرّيرة، من الصعب أن ينتهي به الأمر متصالحاً مع قدراتهِ الخارقة على الانتهاك والتمرد والكسر والقفز. نحن حيواناتٌ مربوطة من الفك والأرجل، مقتادين إلى سجونِ الخير ومقدرٌ لنا أن نُصبح جبلاً من جليدٍ مطمور بالماء ولم يخرج منه سوى القليل، لذا عادة تصدم سفن الحياة بنا وتتحطم وتنهار.
لم أكن دقيقاً في تلك المحادثة، لكنني راجعتها في اليوم التالي، محاولاً البحث في حياتي أو حياة الآخرين عن المتع التي لم تكتمل.. عن الرغبات التي دُفنت في رملِ الفضيلة. رغبات كان مصيرها النسيان والتلاشي، لكنها تتكور كلّ ما مرَّ الزمن، لتصبح ثقباً أسودَ نضيع داخله كما لو أننا غير موجودين. ما هي مادة تلك الرغبة، كيف تبدأ وكيف تتضخم وكيف تتسرب إلى الحياة على شكلِ ردودِ فعل غير محسوبة؟
هل أنا أعاني حتى اللحظة من تلك الرغبات التي لم يكتب لها النجاح؟ هل أبدو معافى الآن وتحت جلدي مقبرة من الأحلام المقموعة؟ هل يبدو جيداً التحدث عن ذلك الممر الضيق المعتم في حياتي؟ هل أنا الوحيد الذي تعرض لهذا القمع الرمزيّ؟ هل أنا أكثرهم تحريراً وآن الأوان كي أتحدث؟ كلها أسئلة عادة يضعها المرء محاولاً التخلص من عبء الماضي، أو عبء عيون الآخرين وهي تراقب.
رغبة عبور سور المدرسة
لا أتذكر من المدرسة سوى القليل، القليل الذي يكاد لا يرى، معلمٌ هنا، معلمة هناك، نتيجة امتحان هنا، صديق هناك في المدرسة التي لم تعد موجودة، ركض هنا، ومشهد هناك.. لكنني لو طلب مني تذكر أكثر ما كنت أرغب به، لن أتردد في الحديث عن تلك النزعة الشرّيرة في عبور سور المدرسة رفقة أكثر الطلاب جسارة وتمرداً، من أجل الذهاب إلى قاعة الألعاب الإلكترونية، أو من أجل إكمال فصل كرة القدم الذي يبدو لذيذاً خارج المدرسة، حيث الوقت مفتوح مثل فم.. والأهداف أكثر جدية وأهمية.
لم يكن السور عالياً، وليس هناك ما يعيق عبوري، لا جسدي ولا عصا أستاذ صلاح، لكن الحبل الذي كان يشدني للخلف ويمنع إتمام تلك العملية هو الرب، الذي يحاسب الأشرار والمتسربين من المدرسة. لقد كان الحبل الأكثر جدية، فليس لدى والدي سلوك عنيف تجاه حركات من النوع هذا. بالمجمل، أبي متسامح متفهم وأمي ليس عنيفة للحد القاسي. كان لدي تصور طفولي أن الجنة لمن يدرسون ويخضعون للنظام التعليمي، والنار مكرسة لأولئك الذين عبروا السور تواً.. لقد كان ذلك انتصاري الرمزيّ عليهم، هنيئاً لكم اليوم اللعب، غدا سوف تشوى أجسادكم، فيما نتمتع ببطيخ الجنة وتفاح الآلهة.

لكن ومع مرور الأيام، بدأت اشك في ذلك السيناريو، فمن المضحك أن سور المدرسة هو الذي يفصل أهل الجنة عن أهل النار. وليس تلك سوى حكاية خيالية، ابتدعها طفل لا يقوى على ترك الصف المدرسي لحضور صف يعلم المرء كرة القدم والركض وطرق الأبواب ثم الهرب دون وجهة.
ربما لا أرغب الآن في عبور سور المدرسة، لكن العملية باتت أكثر تعقيداً، غالباً أجد نفسي مُتحمساً لعبور سور الوظيفة وتقديم استقالة، أو مستاءً من الوضع ومحاولاً عبور سور البلد. ربما خضع السور لسلسلةٍ من التغيرات وصار يمثل الآن سور العمل والوطن. وعادة اسأل، إذا كان ذلك العبور مرهونا بالجنة والنار، لم لا أعبر الأسوار الآن؟ هل أنا أخائف في الحالتين؟ ربما، ربما هذا هو الصواب، أو التفسير الأكثر منطقية.
لقد شهدت غرائب في التحريمِ والمنع
يقال إن الشيخ دخل إلى منزل الأجداد، ووجد تلفازاً فطلب بحياء وتردد أن ترتدي النسوة الحجاب حين يخرج رجل غريب على التلفاز! بعده بعقود، جاء إلى المنزل نفسه، رجل في عقده الثالث، ليخبر نساء المنزل عن العذاب في انتظارهن جراء مشاهدتهن “الستلايت”.. ومذاك جر حبل التحريم ليشمل النساء اللواتي يملكن هواتف محمولة، وثمة حكايات أخذت طريقها إلى التطبيق فيما تلاشى غيرها وضاع في غمرة الحياة.
معادة تطور الحياة ليس جديداً، وليس من الغريب أن نذكر أن المدارس قد حرمت على النساء في زمنٍ ما، وحرم ركوب القطار في مصر مثلاً وقيل فيها “أتتركون حمير الله وتركبون الشمندفر”، وغيرها من القصص.
لكن ثمة نوعا من التحريم والمنع حدث في وقت قريب. تحريم كنت شاهداً عليه وكنت جزءاً من تفاصيله.
نهاية التسعينيات انتقلت عمتي إلى منزل الزوج، وبعدها بمدة ليست طويلة، جاءا إلى منزل جدتي وكان جزءاً من الطقس أن تُنصب مائدة على شرف العريسين الجديدين. كان الاحتفاء بها واضحاً، فقد استعد الجميع من أجل تحضير المائدة، لكن ما حصل لم يكن في الحسبان، فخلال تلك الفترة القصيرة التي قضتها في منزل الزوج حرم عليها: الطرشي (المخلل)، والآيس كريم المصنوع من مادة الثعلبية، والسمك من نوع صبور، والجبن الذي على شكل مثلث.. وكلها أشياء لم تكن محرمة في بيت أهلها. لقد جاءت بأفكار غريبة ومثيرة حتى أجبرت العائلة أخيراً على عدم تقديم الطرشي مع الطعام! كانت كل هذه التحريمات بناء على فتوى المرجع الشيعي السيد محمد محمد صادق الصدر، الذي كانت عائلة زوجها تتبعه وتقلده، فانصهرت في ذلك المزاج المختلف عن مزاج أهلها.. وأنا الطفل الصغير لم أسمع قبل زواجها عن تحريم الطرشي مثلاً!
في أيام المدرسة الإعدادية بدأ الهاتف المحمول يصبح متاحاً للشباب، فامتلك بعض منا أجهزة محمولة، قسم منها فيه كاميرا، فيما كان القسم الآخر جهاز بسيط يتصل فحسب. وإذ كان بعض الشباب ذوو ميول ديني، فكان شغلهم الشاغل الخوض في الحدود بين الحرام والحلال. ومن أغرب ما أشيع في تلك الفترة بيننا، إن الجهاز الذي فيها كاميرا استخدامه مكروه، ثم خفتت تلك النبرة، لتصبح فيما بعد أن الجهاز الذي فيه “رام” (كرت ذاكرة) مكروه، وكل ذلك كان يستهدف شيئا واحدا وهو قمع الرام الذي يمكن أن يستخدم لغرض مشاهدة الأفلام الإباحية. والأكثر غرابة أن أحد الشباب امتنع عن شراء “رام” من شابٍ آخر في المدرسة، لأن الرام الذي بصدد شرائه دنس سابقاً وتم تحميل أفلام إباحية فيه، وذلك بعد سنوات من انتشار الهواتف وأصبحت من بديهيات النقاش في ذلك.

في أيام العنف الطائفي في العراق، ما بين 2005 إلى 2007، شهدت العديد من مناطق بغداد أنواعاً من التحريم من قبل الجماعات المسيطرة على هذه المناطق، طبقته ما تعرف بـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. ومن بين المحرمات التي شاعت في تلك الفترة: ارتداء النعال أبو الأصبع، البرمودة، استخدام الخيط لإزالة الشعر بالنسبة للشباب، استخدام المكياج بالنسبة للنساء.. وتعرض العديد من الناس لعقابٍ مباشر جراء مخالفته تلك التعليمات التي كانت تصدر بشكلٍ دوري.
أحياناً تلتفت لحياتك بشكلٍ عفوي، لمراقبة مفصلٍ ما، وربما سوف تدهش نتيجة مشاهدتك ما حصل. لقد تحملنا ونحن شبان كلّ هذا التحريم، كل هذا المنع والترويض، كلّ هذا القمع والعنف الذي مورس ضدنا كأفراد ومجتمع، قمع -بدونه- كان يمكن لحياتنا أن تكون غير ما هي عليه الآن!
ماذا فعلت بك الرأسمالية!
لا تخلو المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة وذات المساحة الشعبية، من نمو نوع من النساء اللواتي يثرن حفيظة الوجهاء وأهل الفضيلة، والمراقبون السريون الذي ينصبون أنفسهم دعاة وسط الناس. تلك هن النساء الشبقيات بشكلٍ أدق، اللواتي يواعدن رجلين أو أكثر في آن واحد. ليس هناك موقف واحد تجاه هؤلاء النسوة، اللواتي لا يتوانين في الشتم والسباب ورمي الكلمات التي “لا تقال حتى في حمام”، على حد التعبير الشائع. مع ذلك فثمة حضور قوي لهن.. منهن من أخرسها الزمن ومنهن من أسكتها السوط الديني الذي تكاثر في العقدين الآخرين، خصوصاً في المناطق الشعبية.
من جملة تلك النساء، أذكر جيداً ميادة التي كتبت عنها فيما مضى: “بقعة زيت على قميص العدم”، يمكن أن تضعها عبارة تقولها بنت في الثامنة عشرة ترى الرجال كلهم في ابن الجيران.

عبارة لا تخلو من الغضب ورائحة السرير يتداولها الناس في السر، وتصبح سجادة يتوضأ من أجلها العشاق بشعرهم المدهون بالحصار، وبناطيلهم التي تكنس شارع الحاجات المستعملة.
فكان أن قالت ميادة لأحدهم “لك أحبك بكد نار كسي”.. وأصبح حلم عشاق عام 1997 أن تبادر فتاة لإطلاق لافتة مثل هذه لهم.
في ذلك الزمن العدمي كان الحصول على حبة الانتعاش تلك أكثر ندرة من وجود إنسان مهذب الآن..
تزوجت ميادة فيما بعد برجل كبير في السن لا يكترث لتلك الروح المتفوقة من الجذب والإغواء..
“الكلمات في الجنس تفوق لذة الجنس نفسه”، هذا ما قاله رجل الذي سمع العبارة فيما بعد.
وبالانتقال من ميادة إلى بدرية لا يبدو أن ثمة ما يميز الثانية عن الأولى، إلا أن الثانية باتت بمرور الرجال تبيع ساعات وفقا للمزاج والرغبة وبشكل سري وخفي بيد أن الجميع كان يعرف ذلك!
بدرية ليست جميلة ولا قبيحة، بدرية ليست سوى جسد شهي يطل من الباب الضيق الأسود، لتدعو الرجل الذي يقف في الركن، لتبيع له ما يرغب. الغريب بالأمر أن أول مرة سمعت كلمة رأسمالية كانت في مجلس شبه عشائري، حيث قال أحد الجالسين في حلقة الرجال: “هذه الرأسمالية خربت الحياة، كلشي صار ينباع حتى جسد النساء”، وقفز ذهني مباشرة وقتها إلى بدرية، ورددت بيني وبين نفسي.. في حينها أم في وقت لاحق، “ماذا فعلت بك الرأسمالية يا كس بدرية”.
لكن الحقيقة أن لا دخل للرأسمالية في ذلك. كلّ ما في الأمر أنها أكثر قدرة من الآخرين على العبور، على الوصول إلى ما ترغب، لديها المهارة والجرأة أن تفعل ما تجده ملائماً لها، بعيداً عن التوصيفات التي يطلقها الآخرين، وبعيداً عن الاعتبارات التي أوقفت حياة الكثيرين. بدرية أكثر جنوناً بالحياة من غيرها، أكثر جدية في تلبية رغبتها، أكثر حدة في تنفيذ أوامرها، لا ممر ضيقاً أسود لديها تخفي فيه رغبتها، ربما هي الآن أكثر تصالحا مع نفسها من غيرها، ربما من يدري؟
ميادة وبدرية هما المثال الأكثر جدية عن الخوض بالحياة بكليتها، هما الأكثر قمعاً لكلب التكرار والخضوع وهو ينبح خلفهما. ففي حياة كلّ فرد نماذج من نوعين، نوع محافظ يمكنه أن يكبت حتى رغبته في شرب الماء حفاظاً على النهر، ونوع يمكنه أن يحرك المياه الراكدة ويفجر فئة جديدة من الأسئلة: هل المواجهة مع المجتمع خلاص من الكبت؟ هل الملذات تستحق صورة مشوشة يرسمها من حولنا عنا؟ ماذا فعلت الحياة لاحقاً بميادة وبدرية؟ هل كانت حياتهما مشوهة أم حياة قامعيهما؟ هل نحن الخائفون بسمعتنا الحسنة أفضل حالاً منهم؟ أسئلة تنثرها حياة الخائفين وحياة العابرين لسور الفضائل محاولين إيجاد حياة لا تتيحها الأعراف والقيم والوصايا.