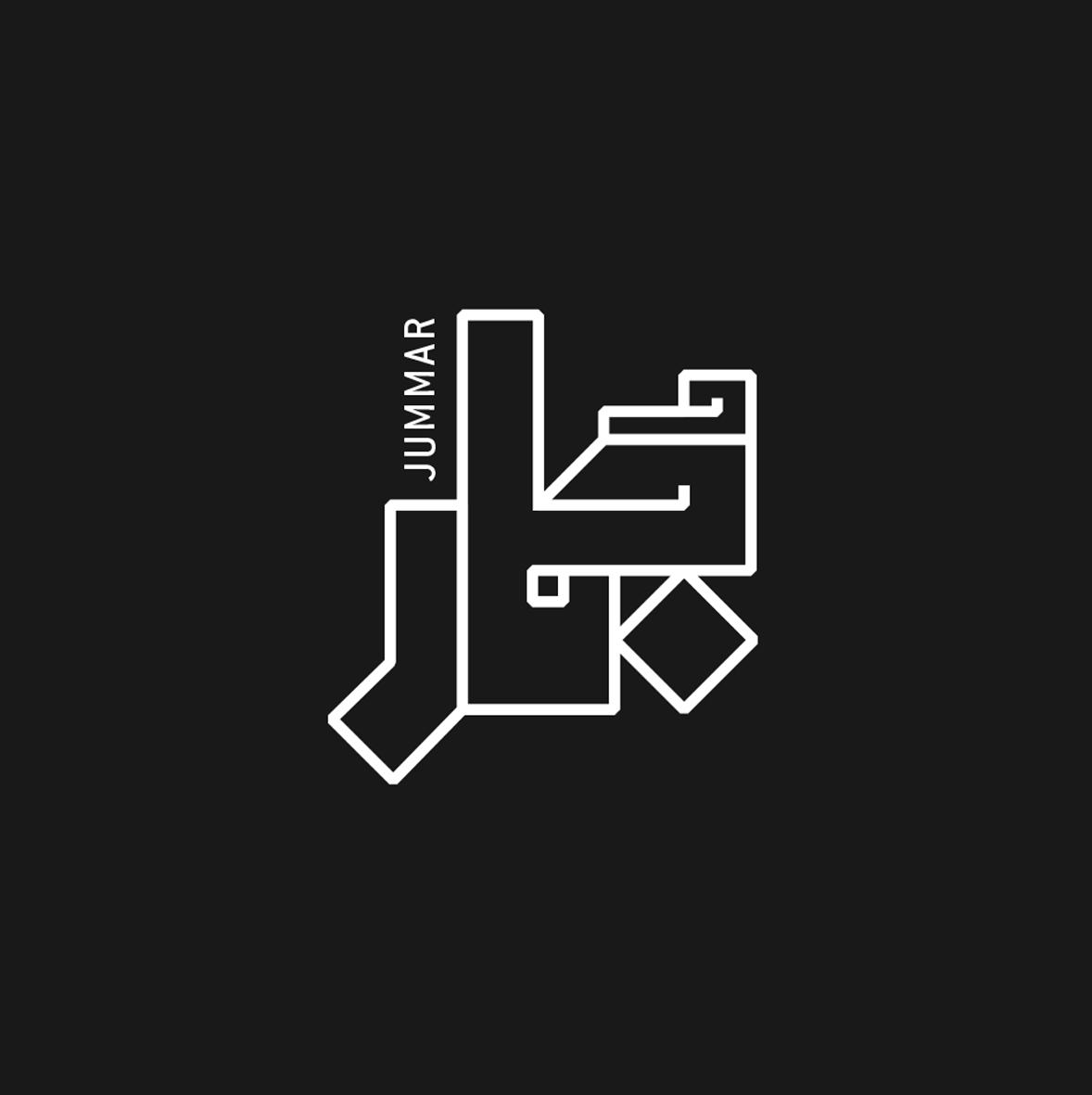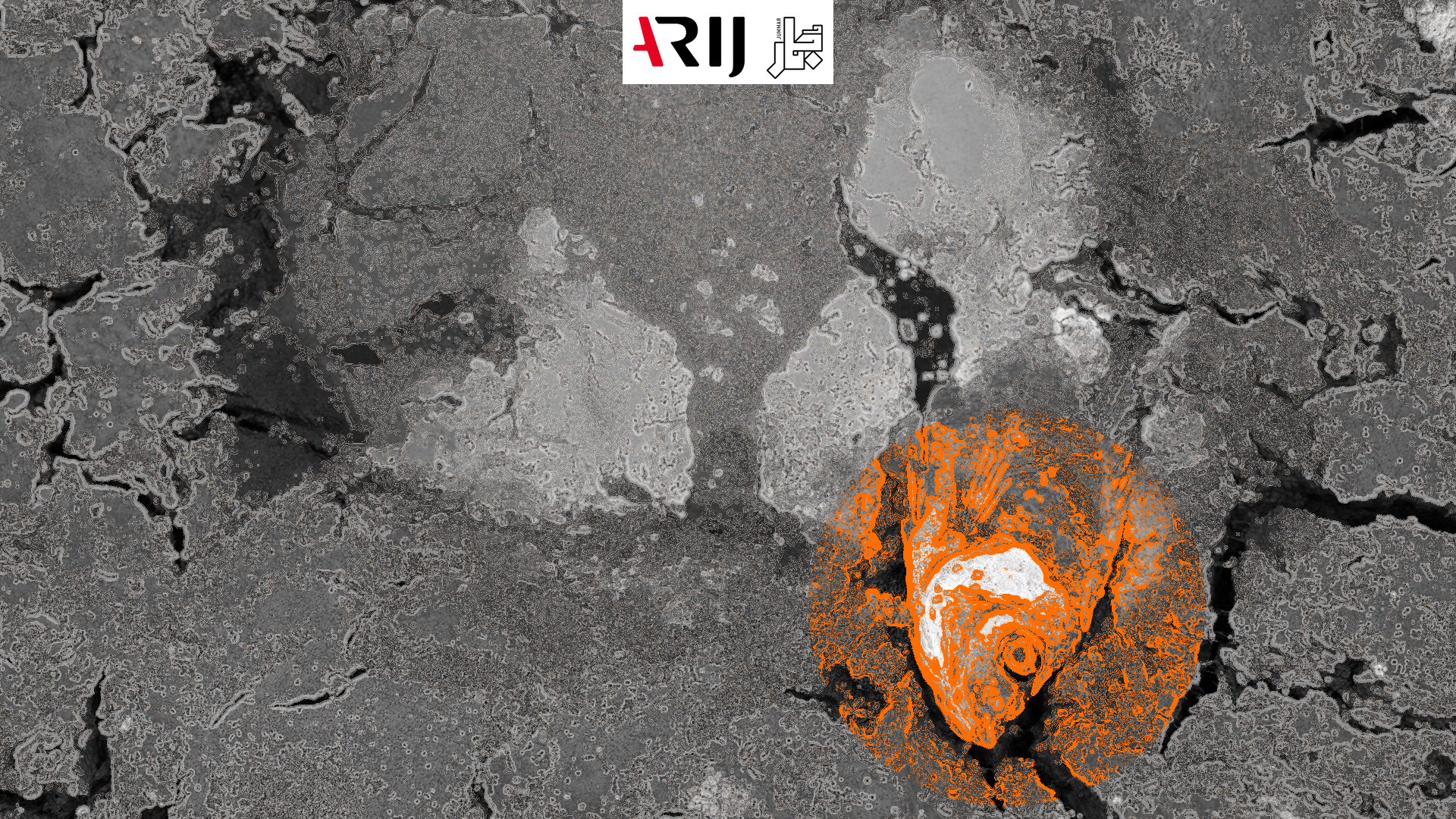صور وصخام صدام في ذاكرة خمسة كُتّاب: الديكتاتور كـ"ريد فلاك"
09 نيسان 2024
من أول نستلة وحتى التواليت والحب... لُعن العراقيون بذكريات صدام حسين ونظامه وأفعالهما، ونعود هنا بالذاكرة، مع كُتاب من أجيال مختلفة، إلى صور وصخام البعث..
صدام أكبر ريد فلاك
ماري برهان
أيّ عاشقين في ذروة حبهما وأحلامهما الورديّة يبدآن بتخيّل أسماء أبنائهم، ربما يختار الرجل اسم فتاة يرتبط عنده بأول حب، أو بأمه أو بامرأة أثّرت به، أما اسم الصبي فيكون على اسم أبيه أو جده أو حتى شخص عزيز فقده، ليُبعَث من جديد.
لكن أن يكون لابنك اسم هتلر أو أبو بكر البغدادي أو إبليس، أو أن تكون فتاتك الصغيرة غولدا مائير مثلاً، لهو ضرب من الخبل. أي حظ سيولد به، وأي حياة تتبصر بها له؟!
تتفاخر إحدى معارفي، وهي تروي لنا كيف أنقذها الريس من والدها، الضخم وذي الوجه “المكشر 24 ساعة”، الذي أطاعت تجاعيد وجهه تلك، الريس عندما ابتسم، وذلك على الرغم من انه وجد قصيدة حب في خزانتها وبين ملابسها الداخلية.
كانت تخبئ صورة لها، وقد طبعتها بقبلة من شفتيها بالحمرة السحرية وعليها “بَرِش صابون” -بدلاً عن العطر الذي لا يملك أحد ثمنه في الحصار- وإلى جانب الصورة قصيدة حب، تمتدح فيها عضلات وطول وهيبة الزي الزيتوني.
صرخَ “بنت الكلب هي إلمن؟”. تقول إنها لم تعرف لماذا قالت “لبابا صدام.. للريس والله يا ابوية”.
انقذتها هذه الجملة من الضرب، بل حتى من الذبح. لم يتجرأ الأب أن يصرخ مرة ثانية، بل سكت وخاف أن يمزقها رغم أن اسم صدام لم يُذكر في القصيدة.
فكّرَ الأب، ربما، إن مسّ القصيدة فإنه ابنته ستكتب فيه تقرير ويروح بين الرجلين. أو ربما إذا ضربها وتذهب للمدرسة ستقول لـ”ست” سوسن البعثية، ضربني بسبب قصيدة للريس!
تخيّلَ الاستخبارات في بيته يسألونه “تهين الريس ولك؟”، ربما تخيل رأسه على المشنقة ومن تحته جسده المزرق من التعذيب.
بعد أن مرّ شريط تعذيبه أمامه، قبّلها واحتضنها وعاد لغرفته وأقفل الباب، والدها الذي لم يعانقها ابداً ولا حتى في الأعياد، يقبلها الآن خوفاً من “الرئيس” وتكريماً له.
بعد ان نجت العاشقة من “صوندة” والدها، نذرت لله إن هي رزقت بصبي، فتسميه صدام حسين.
وقد فعلت.
لم تكن المرأة الشخص الوحيد الذي “يمتلك صدام”، فأحد أقاربي أصابته الجلطة وهو يشهد “الأب القائد” يُعدَم. ولحبه الشديد فيه، سمى مولوده اسماً مركباً “صدام حسين المجيد”.
أتساءل، حينما كبر صدام حسين، الذي ولد بعد عام 2003، وينعم بكندا وترف الحياة والحقوق والخيرات التي منع منها أبناء الحصار، بل وأغلب أبناء جيله، كيف شَعر وأن اسمهُ على اسمِ طاغيةٍ دمّر وقتل شباباً وصغاراً، ونهب وجوّع شعب بأكمله؟ الآن وقد بلغ العشرين، هل يضع صورة صدام ومن خلفه أسد كخلفية لهاتفه الحديث، ويتباكى على “الريس” مثل حال كثيرين ولدوا بعد 2003. هل يستميت بالدفاع عن “الهيبة” لدرجة تعهير من يحاول تبيان حقيقته؟
وربما “صدام حسين المجيد” الكندي، سيرغب بتسمية ابنه عدي، كما أراد حبيبي السابق أن يسمي ابننا، ليناديه الناس “أبو سرحان”، كما نودي “الأستاذ”!
كدت أفقد صوابي. تخيّلت نفسي أنا وكشكول أفكاري داخل نظام البعث.
ما أثار غضبي، أن كلانا من جيل لم يعش حقبة صدام، إذ كان هو طفل وأنا قطعة لحم في بطن أمي زمن حكمه. دخلنا في نقاش طويل محاولة إقناعه بجرائم صدام ومقاتله، عارضة كل الأدلة والبراهين.
لكنه بقي مصراً على رغبته، وأكد أنه سيتنازل عن حبنا، لكن عن عدي لا وألف لا.
تقززت وأنا أفكر بوجود عدي برحمي، أنا النسوية والعلمانية “الخابصة الدنيا”، بحسب وصفهم، سيكون اسم ابني عدي وسأكون أم عدي.
فكرت كيف ستكون ضربة قاضية وسأصبح “ميمز” أمام بعض زملائي الذين ما أن دخلت الجامعة حتى تخرجي منها، وقد خضت معهم حوارات ونقاشات طويلة عن جرائمه -بل حتى مع عائلتي- كيف سيكون تكوّر بطني وأنا أحمل عدي بداخلي! يييمه!
بعد مرور سنة، وبينما أنا سعيدة أثناء تعرفي على شخص مثلي “خابص الدنيا”، وأراه في مقدمة كل ورشة عن خطاب الكراهية أو حقوق الإنسان. اقسم أمامي أنه يرى صدام مجرماً، وانه صحيح من عشيرة صدام نفسها، لكنه لا يعترف به أبداً.
لم أشك بقسمه حتى وهو يستخدم “سيتكرات” عدي في محادثاتنا، وظننت انه نوع من الهزل. لكن يبدو أن حب صدام يأتي بلا بصيرة وتفكير، إذ وجدت في مكتبته صورة لصدام بجانب صورة جيفارا وماركس -وهي مصيبة أخرى غضضت البصر عنها-، وحين سألته عن السبب، قال انه صحيح يكره صدام، لكنه يحترمه كرجل حرب. اجبته بـ هااا؟ العفو؟؟
كان هذا أكبر “ريد فلاك” أواجهه في حياتي. وقلت في نفسي “صخام الصخمج ماري”، وقررت أن لا أولد صدام وابنه من جديد، و”طز” بالحب.
بتوقيت الرئيس
ميزر كمال
عام 2001، أعلنت أمانة بغداد عن مشروع “ساعة القائد صدام حسين”، وهو مركز للزمن، لكنه بتوقيت الرئيس، المشروع يضم برج “ساعة القائد”، ومتحف تُجمع فيه إنجازات الرئيس، وحدائق تحيط بالبرج والمتحف؛ لكن المثير للغرابة والضحك والزيج، هي فلسفة المشروع، القائمة على استبدال الزمن كله، وحذف التوقيت، شكلاً ومفهوماً، كيف؟ تُستبدل الساعات باسم الرئيس وألقابه، فتشير العقارب إلى اثني عشر لقباً هم: صدام حسين، والفارس، والرفيق، والمناضل، والرئيس، والقائد، وبطل التحرير، والمجاهد، والقدوة، وباني العراق، وصانع النصر، ورجل السلام.
الزمن بتوقيت القائد 12 ساعة فقط، وهكذا تدور الحياة في العراق، فمثلاً، حين يريد العراقي تحديد موعد ما، الخامسة والنصف مثلاً، يقول لصاحبه: موعدنا على الرئيس والنصف.
من السهل تجاوز فكرة أن المشروع غبي، لكن، من الصعب عبور اللحظة التي خرج بها ذلك المشروع، وما تعنيه في بلد ترتبط أسباب نجاة الفرد والجماعة فيه، بأسباب الرئيس، وحده لا شريك له.
كيف ينجو الإنسان من هذا الفخ؟ إنه يتطلب الهروب أو الموت؛ لكن كثيراً من العراقيين اخترعوا طريقةً أخرى، ليست جراحية مثل الطريقة الأمريكية، لكنها كانت كافية وضرورية للنجاة؛ إنها “الحيلة”، أن تجلس في الفخ وتلعب به، وتحمله في البيت والشارع والمؤسسة، هكذا مر الوقت من لحظة “الساعة السودة” عام 1979، حتى الساعة الأسود منها، عام 2003.
في ليلة فارغة من أي شيء مثير، حكى لي خالد شاحوذ، وكان أواخر سنوات الحصار يعمل سائق تكسي، في كراج اللاجئين الأكراد، على أطراف مدينة الرمادي، أنه في غروب أحد تلك الأيام شحيحة “العِبرِّيّة”، دخل رجل كردي إلى الكراج، واتفقا على “كروة حوض”، يتمتع الكردي بالخصوصية، ويأخذ خالد أجرة “التقبيطة”. كانت في حينها 250 ديناراً للنفر.
معسكر اللاجئين الأكراد كانت تديره “الأمم المتحدة” لكنه أمنياً يخضع لإدارة الفرقة الحزبية ومركز الشرطة، وكانا في البناية نفسها، عند مدخل المعسكر الوحيد، هناك حيث تقف صورة كبيرة لصدام حسين، وهو يرتدي الزي الكردي، ويرفع رأسه كأنه ينظر إلى الجبل.
في الطريق تجاذب خالد والراكب أطراف الحديث، لكنهم عند مدخل المعسكر تجاذبوا الياقات، عندما أعطى الراكب لخالد ورقة ميتين وخمسين دينار واحدة، فرماها خالد بوجهه وصرخ به: اتفقنا على تقبيطة حوض! شنو تنطيني ميتين وخمسين! ازرب بيها.
هنا يتذكر خالد ويضحك، “لعبني صح” ويصف كيف التقط الراكب ورقة الميتين وخمسين ونظر بها ثم نظر إلى خالد وقال، “يزرب بيها! انت يزرب عالريس؟ إلا يشتكي عليك بالفرقة”. لكن خالد -من حلاوة روحه- استعاد الورقة وقبلها ونافس الكردي على حب الرئيس، وانتهت السالفة بتنازله عن كلفة التقبيطة كلها، لينجو، ونجا الراكب بتوفير ألف دينار للأيام المقبلة.
ربما، وفي ليلة فارغة كذلك، حكى ذلك الكردي لأصحابه ذلك الموقف، وضحكوا حتى بدت نواجذهم، مثلما فعلنا أنا وخالد، إنها الحيلة التي تنجو بها وتضحك منها، لكن، في حينها كانت طريقةً فعالة لدفع زمن الرئيس إلى الأمام، وإن كان يوماً بيوم.
صورة صدام حسين كانت سبباً للنجاة والموت على حد سواء، إنها شكل الإله في مخيال حزب البعث، يضعونها في كل شيء، ومن هذه الأشياء صدورنا. في السنوات التي سبقت سقوطه، كان الحزب يطبع صورة الرئيس على تيشيرت أبيض، ويوزعها على الطلبة في المدارس.
مرةً، طلب صديقي مهند مساعدتي، كان خائفاً من دخول مدرستنا في شفت دوام البنات، ليوصل لفة بيض وبطاطا لأخته هند، في الصف الرابع ابتدائي، خوفه كان بسبب “ست عواطف” الرفيقة العتيدة، والمديرة القاسية، لم تكن تسمح أبداً بدخول غير النساء إلى المدرسة خلال الدوام، حتى لو كان الرجل من العائلة.
كناً صبياناً حينها، لكننا طورنا “أداة الحيلة” في تلك الأيام؛ دخلت إلى البيت وارتديت التيشيرت الأبيض وامتلأ صدري بوجه القائد، وأخذت اللفة ودخلت إلى المدرسة، كانت ست عواطف تحمل عصاها وتتمشى في الممر، فتوجهت إليها وأنا أحمل سندويتش البيض والبطاطا والرئيس.
عندما اقتربُت منها ورأت القائد يضحك بوجهها؛ سمحت لي بتمرير اللفة إلى هند. في رأسها، كانت صورة صدام حسين أكبر من تعليماتها الصارمة، وجوع هند، وخوفي، لذلك سمحت لي بدخول المدرسة. كانت تعلم أنها حيلة، لكنها كانت مثلنا، واقعةً في الفخ وتلعب به.
اشترينا تلفزيوناً في ليلة الاحتلال
ماهر العكيلي
قبل الاحتلال بعامين، هاجرتُ رضيعاً بين ذراعي أمي إلى سوريا، وسكنا منطقة مخيم اليرموك الجامعة للمهاجرين من مختلف البلدان المتضررة، خليط من العراقيين والفلسطينيين والسودانيين وغيرهم من جنسيات مختلفة.
في لحظة الاحتلال، سَمِعَتْ أمي الأخبار التي تتناقلها الأصوات الصارخة في الشارع من نافذة غرفة المعيشة، كان هناك جو من الخوف، فأسرعت للتسوق تحسباً لأزمة مواد واقتصاد، وكان على رأس قائمتها حليب لرضيعها، أنا.
كانت الشوارع قد امتلأت بأصوات مذيعي نشرات الأخبار، والأغاني الوطنية، لكن رحلة أمي للتسوق، كانت تهدأ من قلقها على البلاد، والأقارب، والمصير.
“صادفت واحد عراقي يحاول يحجي وي ابو المسواك، يكلة اريد كيلو بتيتة وذاك ما يفتهمة!، كتلة كلة بطاطا لا تكلة بتيتة” تقول مبتسمة.
وسط هذا الصخب، لم يكن لدينا ستلايت، وتناقل الأحداث عبر السوق وشبابيك الحارة لم يعد كافياً.
اتصل والدي “بابو الستالايت”، الذي كان لديه يوم مزدحم من الطلبات لمشاهدة الحرب على العراق، لذا اضطرت العائلة أن تنتظر “سراها” في الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل.
لم تغمض العائلة عينها، عراقيون في الخارج يشاهدون عراقيين في الداخل يتحدثون عن الأوضاع ويرسلون أخبارهم الشخصيّة إلى من يهمه الأمر.
“جانوا يوكفون كدام الكامرة وياخذون المايك من المذيع، وينطون تحديث عن الوضع العائلي بالتلفزيون لأن جانت هاي الطريقة الأسرع انه يعرفون اهلهم خارج العراق بأحوالهم”، يقول أبي.
في تلك الليلة، سهرت أمي مع التلفاز الذي يجول في أنحاء العراق. كانت ساحة الفردوس خالية من التمثال المعروف لصدام حسين، هو المنظر الاكثر غرابة لها. “طلع واحد بساحة الفردوس يحاول يطمئن عائلته وكال: لا يظل بالكم احنا زينين بس اختكم وكع القصف على بيتها وانطتكم عمرها”.
كنت أريد النساتل يا صدام
يحيى عصام
عندما ولدتُ عام 1984، كانت قد مضت خمس سنوات على استيلاء صدام حسين على السلطة المطلقة في العراق، ولا أتذكر بالضبط متى عرفت هذا الرجل باسمه وشكله ومنصبه، لكنني أتذكر تماماً التحذيرات المشددة التي كنت أتلقاها من أمي وأبي عندما كنت طفلاً، بشأن عدم التحدث بسيرته خارج المنزل سلباً أو إيجاباً، وعدم ذكره إلا تحت تسمية “السيد الريّس” إذا اقتضت الضرورة التحدث عنه، والامتناع تماماً عن لفظ اسمه بشكل مجرد.
وأتذكر أيضاً درساً في كتاب القراءة للصف الثاني الابتدائي على ما أظن، عنوانه “رئيسنا يزورنا”، وهو قصة أطفال مطلوب من التلاميذ دراستها في إطار متطلبات تقوية التهجئة والقراءة لديهم، تتحدث عن تلميذ يعود من المدرسة إلى منزله مغموراً بالسعادة، ولما تسأله أمه عن سبب سعادته يطلب منها أن تخّمن، فتعدد أكثر من سبب تخميني، لكنه يخبرها في النهاية بأن كل تخميناتها خاطئة، وأن سبب سعادته هو زيارة “الرئيس القائد صدام حسين” إلى مدرسته ورؤيته إياه.
ذاكرتي الطفولية الضعيفة في تلك الأيام لا تخبرني الآن إن كنت قد عرفت صدام حسين عبر هذا الدرس أم قبله، لكنني على أي حال لم يكن يراودني شعور تجاهه سوى الخوف، بسبب التحذيرات المتكررة من الوالدين إزاء التحدث عنه مع أي أحد.
وأحسب أن تحذيرات الوالدين كانت أول بذرة زرعت في نفسي للرعب الصّدامي الذي توارثه العراقيون من 1979 حتى 2003، وقد نمت هذه البذرة وتجذرت يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة مع تكاثر القصص المخيفة التي أسمعها باستمرار عن أساليب أجهزة أمن النظام في التعذيب والقتل، وكيف أنها قد تطول أي شخص لمجرد انتقاده صدام أو ذكره بتهكم.
شعور الخوف من صدام التحق به سريعاً شعور كرهه. كرهتُ صدام لأنه جعلني أصارع ضيم الحصار الاقتصادي في كل أيام الطفولة والمراهقة، لأسباب حارت الدنيا في فهمها.
كنت في التسعينيات محروماً -مثل ملايين العراقيين- من الخبز الأبيض النظيف واللحوم والدجاج والبيض والأجبان والقشطة وكثير من أصناف الفواكه، إذ أتذكر جيداً أن آخر حبة موز تناولتها في حياتي كانت سنة 1989، ولم أتذوق هذه الفاكهة مرة أخرى إلا بعد سقوط النظام في 2003.
لا أنسى ذلك اليوم من أيام الابتدائية عندما أخرج زميل لوح شوكولا -يسمى نستلة في العراق- ليتناوله في إحدى الاستراحات بين الدروس، فانقض عليه التلاميذ ليأخذوه منه عنوة، ففر هارباً بأقصى ما يملك من سرعة وهم يركضون خلفه حتى أنقذه مدير المدرسة من كربته.
هذه النستلة كانت من علامة “جبري” العالمية، وهي لم تكن متوفرة في أسواق العراق في ذلك الحين، فقد كانت كنزاً ثميناً جلبه والد الزميل من الأردن التي سافر إليها لأغراض تخص عمله الحكومي.
لم تقتصر رداءة المعيشة على المأكل والنساتل والبيبسي كولا، وإنما شملت الملبس ووسائل النقل والخدمات ومستلزمات التعليم، فقد قضيتُ كل سنوات الدراسة المتوسطة الثلاث جالساً على الأرض المكسوة بتراب سميك، في صفوف شبابيكها مخلوعة وهواء الشتاء القارس يملأ أرجاءها، أمام مدرّسين غاضبين ومتوترين وناقمين، لأنهم عندما ينتهي دوامهم في المدرسة يذهبون بالحافلة الكريهة “التاتا” إلى العمل في بسطات ودكاكين صغيرة ليتمكنوا من إعالة أسرهم التي لا تعيلها رواتبهم المتدنية جداً.
لم تكن في ذلك الزمن مولدات أهلية في العراق، فكان انقطاع الكهرباء في الصيف يعني قضاء بضع ساعات في الجحيم، بينما صدام وحاشيته يتنعمون في أفخم القصور التي يشاهدها الناس يومياً من نوافذ السيارات المتهالكة المضطرين لركوبها.
كل ذلك وغيره كثير مما لا يتسع المقام لذكره، كان يدفعني إلى التساؤل: من هو صدام؟ ولماذا نتحمل كل هذا الخراء من أجل أن يبقى حاكماً مرفهاً يقتل كل من يسأله عن سبب الجوع والخراب واحتراق الرجال في الجبهات؟
طر تُ فرحاً عندما انتهى صدام، لكنني سرعان ما بدأت أهبط في لحظات الفوضى والانفلات وتقاسم السلطة طائفياً، ورحت أقول لنفسي وللآخرين: “أخشى أننا مقبلون على ما هو أسوأ من صدام، أو ما هو ليس بالأفضل على أقل تقدير”.
الآن عندما أشاهد صدام في اليوتيوب، تفتنني هيبته ولغة جسده، لكنني أتذكر دائماً كيف جعل طفولتي خالية من النساتل والملابس الجميلة والألعاب، ومليئة بأصوات القصف والصواريخ وصافرات الإنذار، فتُقمع أي محاولة من القلب ليهيم في هواه.
تواليت صدام مو ذهب!
حسين فاضل
العراقيون، كلهم جربوا أذاهم، كانت جدتي تقول. فكل واحد له قصة مع العتوي، أو أحد عتاويه التي يربيها ويُسمنها ويطلقها زيتونية بشوارب ثخينة في الشوارع.
لكن هل فكرت تلك المرأة، المحاطة بدخان سيجارتها على الدوام، أنها ستكون يوماً في بيت العتوي الأكبر؟ صدام حسين المجيد، قائد الثورة والأمة و”صخام وجوهنا”، كما كانت تردد؟
بالأحرى أن تقف بنحولها أمام مقعد تواليته، حائرة مستنجدة وهي، في تلك اللحظة، كل ما أرادته وفكّرت فيه هو إطلاق المياه من مثانتها؟
ونحن، ماذا سنقول؟ هل نقول إن جدتنا لم تستطع التبول في تواليت صدام حسين؟ تعسرت مثانتها هناك، وكانت تضحك عندما روت الحادثة؟ “هل كانت جدتكم بعثية”؟ سيقول الناس؟ هل كانت رفيقة؟ ماجدة وزّعت رؤوس أبناءها على سفرة الحروب التي فرشها صدام، وأجبر الكل على الجلوس عليها؟
هل نقول إن جدتنا، التي عرفناها ترتدي الأسود ولا شيء غيره، سَخَرت من منظر التواليت الغربي الذي يبدو ككرسي يكسر العظام ويُضمِر العضلات في حمام الرئيس، وفي قصره المرمري؟
نحكي كيف راعها البول وقوفاً، وفضلت حبس اليوريا في مثانتها، على أن تفعلَ فعلةً كل أباليس الدنيا لا تفعلها؟ ربما نضيف عليها لمحة كوميدية؛ ونقول (بيبي “كمبصت” على تواليت صدام حسين الذهبي؟)، وننهي بهذه الجملة القصّة كلها.
لكنها لم تقل انه ذهبي. كانت هذه المعلومة بالنسبة لها شديدة الحساسية، وكأنها الحقيقة الوحيدة الاكيدة التي حصلت عليها في حياتها. “طلع مو ذهب”.
أبيض، قالت.
يلمع، أكدت.
قالت أيضاً، إن الحمام يشبه غرف الجلوس في مسلسلات التلفزيون، فقد كان يضم سجادة سميكة، وورد على المغسلة والأرض، وضوء خافت.
روت أن التحرك داخل حمام صدام حسين يتطلب حيل رجل يأكل غزلاناً ويكاون الكون كل أيامه، كما يفعل صدام، مختصرة نظامه الغذائي وجدول أعماله اليومية، كرئيس لجمهورية العراق، وسجّان لسكّانه.
هل نقول إن جدتنا شاهدت تواليت صدام حسين، ويضيف كل منا حكايته؟
بعضنا، حتماً، سيكذب.
سيدّعي أنها أُسِرت لأنها تظاهرت ضد البعث الذي سرقت حروبه ابنها، سيقول بعضنا ايضاً، إنها سُحبت من منزلها عنوة من دون شحاطتها الجلدية، ولم يُسمح لها بأخذ دوائها، ومن ثم صفّت مع آخرين كدروع بشرية في قصور ومنازل صدام حسين.
لكن هذه روايات. تفاصيل غير مهمة لم تروِها جدتي وهي عائدة من قضاء ليلة في قصر صدام حسين عام 1998. وقفت أمام الباب وفي يدها برتقالة.
لم ير أحد منا تلك البرتقالة، لكننا دائماً سمعناها تتحدث عنها. قالت إن عتوي المنطقة نادى على النساء وأطفالهن، وقال لهن إن الرئيس يريد رؤيتهن ودعوتهن إلى العشاء فوراً.
كانت سُفرة، غصباً على الجميع، الجلوس إليها.
“لم نتعش”، و”لم نتبول مثل الأوادم”، ولم نحصل إلا على برتقالة. والحقيقة هي إن الحمام الذي رأته، لم يكن ذهباً، كان أبيض عكس أيامنا المصخمة، قالت.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
صدام أكبر ريد فلاك
ماري برهان
أيّ عاشقين في ذروة حبهما وأحلامهما الورديّة يبدآن بتخيّل أسماء أبنائهم، ربما يختار الرجل اسم فتاة يرتبط عنده بأول حب، أو بأمه أو بامرأة أثّرت به، أما اسم الصبي فيكون على اسم أبيه أو جده أو حتى شخص عزيز فقده، ليُبعَث من جديد.
لكن أن يكون لابنك اسم هتلر أو أبو بكر البغدادي أو إبليس، أو أن تكون فتاتك الصغيرة غولدا مائير مثلاً، لهو ضرب من الخبل. أي حظ سيولد به، وأي حياة تتبصر بها له؟!
تتفاخر إحدى معارفي، وهي تروي لنا كيف أنقذها الريس من والدها، الضخم وذي الوجه “المكشر 24 ساعة”، الذي أطاعت تجاعيد وجهه تلك، الريس عندما ابتسم، وذلك على الرغم من انه وجد قصيدة حب في خزانتها وبين ملابسها الداخلية.
كانت تخبئ صورة لها، وقد طبعتها بقبلة من شفتيها بالحمرة السحرية وعليها “بَرِش صابون” -بدلاً عن العطر الذي لا يملك أحد ثمنه في الحصار- وإلى جانب الصورة قصيدة حب، تمتدح فيها عضلات وطول وهيبة الزي الزيتوني.
صرخَ “بنت الكلب هي إلمن؟”. تقول إنها لم تعرف لماذا قالت “لبابا صدام.. للريس والله يا ابوية”.
انقذتها هذه الجملة من الضرب، بل حتى من الذبح. لم يتجرأ الأب أن يصرخ مرة ثانية، بل سكت وخاف أن يمزقها رغم أن اسم صدام لم يُذكر في القصيدة.
فكّرَ الأب، ربما، إن مسّ القصيدة فإنه ابنته ستكتب فيه تقرير ويروح بين الرجلين. أو ربما إذا ضربها وتذهب للمدرسة ستقول لـ”ست” سوسن البعثية، ضربني بسبب قصيدة للريس!
تخيّلَ الاستخبارات في بيته يسألونه “تهين الريس ولك؟”، ربما تخيل رأسه على المشنقة ومن تحته جسده المزرق من التعذيب.
بعد أن مرّ شريط تعذيبه أمامه، قبّلها واحتضنها وعاد لغرفته وأقفل الباب، والدها الذي لم يعانقها ابداً ولا حتى في الأعياد، يقبلها الآن خوفاً من “الرئيس” وتكريماً له.
بعد ان نجت العاشقة من “صوندة” والدها، نذرت لله إن هي رزقت بصبي، فتسميه صدام حسين.
وقد فعلت.
لم تكن المرأة الشخص الوحيد الذي “يمتلك صدام”، فأحد أقاربي أصابته الجلطة وهو يشهد “الأب القائد” يُعدَم. ولحبه الشديد فيه، سمى مولوده اسماً مركباً “صدام حسين المجيد”.
أتساءل، حينما كبر صدام حسين، الذي ولد بعد عام 2003، وينعم بكندا وترف الحياة والحقوق والخيرات التي منع منها أبناء الحصار، بل وأغلب أبناء جيله، كيف شَعر وأن اسمهُ على اسمِ طاغيةٍ دمّر وقتل شباباً وصغاراً، ونهب وجوّع شعب بأكمله؟ الآن وقد بلغ العشرين، هل يضع صورة صدام ومن خلفه أسد كخلفية لهاتفه الحديث، ويتباكى على “الريس” مثل حال كثيرين ولدوا بعد 2003. هل يستميت بالدفاع عن “الهيبة” لدرجة تعهير من يحاول تبيان حقيقته؟
وربما “صدام حسين المجيد” الكندي، سيرغب بتسمية ابنه عدي، كما أراد حبيبي السابق أن يسمي ابننا، ليناديه الناس “أبو سرحان”، كما نودي “الأستاذ”!
كدت أفقد صوابي. تخيّلت نفسي أنا وكشكول أفكاري داخل نظام البعث.
ما أثار غضبي، أن كلانا من جيل لم يعش حقبة صدام، إذ كان هو طفل وأنا قطعة لحم في بطن أمي زمن حكمه. دخلنا في نقاش طويل محاولة إقناعه بجرائم صدام ومقاتله، عارضة كل الأدلة والبراهين.
لكنه بقي مصراً على رغبته، وأكد أنه سيتنازل عن حبنا، لكن عن عدي لا وألف لا.
تقززت وأنا أفكر بوجود عدي برحمي، أنا النسوية والعلمانية “الخابصة الدنيا”، بحسب وصفهم، سيكون اسم ابني عدي وسأكون أم عدي.
فكرت كيف ستكون ضربة قاضية وسأصبح “ميمز” أمام بعض زملائي الذين ما أن دخلت الجامعة حتى تخرجي منها، وقد خضت معهم حوارات ونقاشات طويلة عن جرائمه -بل حتى مع عائلتي- كيف سيكون تكوّر بطني وأنا أحمل عدي بداخلي! يييمه!
بعد مرور سنة، وبينما أنا سعيدة أثناء تعرفي على شخص مثلي “خابص الدنيا”، وأراه في مقدمة كل ورشة عن خطاب الكراهية أو حقوق الإنسان. اقسم أمامي أنه يرى صدام مجرماً، وانه صحيح من عشيرة صدام نفسها، لكنه لا يعترف به أبداً.
لم أشك بقسمه حتى وهو يستخدم “سيتكرات” عدي في محادثاتنا، وظننت انه نوع من الهزل. لكن يبدو أن حب صدام يأتي بلا بصيرة وتفكير، إذ وجدت في مكتبته صورة لصدام بجانب صورة جيفارا وماركس -وهي مصيبة أخرى غضضت البصر عنها-، وحين سألته عن السبب، قال انه صحيح يكره صدام، لكنه يحترمه كرجل حرب. اجبته بـ هااا؟ العفو؟؟
كان هذا أكبر “ريد فلاك” أواجهه في حياتي. وقلت في نفسي “صخام الصخمج ماري”، وقررت أن لا أولد صدام وابنه من جديد، و”طز” بالحب.
بتوقيت الرئيس
ميزر كمال
عام 2001، أعلنت أمانة بغداد عن مشروع “ساعة القائد صدام حسين”، وهو مركز للزمن، لكنه بتوقيت الرئيس، المشروع يضم برج “ساعة القائد”، ومتحف تُجمع فيه إنجازات الرئيس، وحدائق تحيط بالبرج والمتحف؛ لكن المثير للغرابة والضحك والزيج، هي فلسفة المشروع، القائمة على استبدال الزمن كله، وحذف التوقيت، شكلاً ومفهوماً، كيف؟ تُستبدل الساعات باسم الرئيس وألقابه، فتشير العقارب إلى اثني عشر لقباً هم: صدام حسين، والفارس، والرفيق، والمناضل، والرئيس، والقائد، وبطل التحرير، والمجاهد، والقدوة، وباني العراق، وصانع النصر، ورجل السلام.
الزمن بتوقيت القائد 12 ساعة فقط، وهكذا تدور الحياة في العراق، فمثلاً، حين يريد العراقي تحديد موعد ما، الخامسة والنصف مثلاً، يقول لصاحبه: موعدنا على الرئيس والنصف.
من السهل تجاوز فكرة أن المشروع غبي، لكن، من الصعب عبور اللحظة التي خرج بها ذلك المشروع، وما تعنيه في بلد ترتبط أسباب نجاة الفرد والجماعة فيه، بأسباب الرئيس، وحده لا شريك له.
كيف ينجو الإنسان من هذا الفخ؟ إنه يتطلب الهروب أو الموت؛ لكن كثيراً من العراقيين اخترعوا طريقةً أخرى، ليست جراحية مثل الطريقة الأمريكية، لكنها كانت كافية وضرورية للنجاة؛ إنها “الحيلة”، أن تجلس في الفخ وتلعب به، وتحمله في البيت والشارع والمؤسسة، هكذا مر الوقت من لحظة “الساعة السودة” عام 1979، حتى الساعة الأسود منها، عام 2003.
في ليلة فارغة من أي شيء مثير، حكى لي خالد شاحوذ، وكان أواخر سنوات الحصار يعمل سائق تكسي، في كراج اللاجئين الأكراد، على أطراف مدينة الرمادي، أنه في غروب أحد تلك الأيام شحيحة “العِبرِّيّة”، دخل رجل كردي إلى الكراج، واتفقا على “كروة حوض”، يتمتع الكردي بالخصوصية، ويأخذ خالد أجرة “التقبيطة”. كانت في حينها 250 ديناراً للنفر.
معسكر اللاجئين الأكراد كانت تديره “الأمم المتحدة” لكنه أمنياً يخضع لإدارة الفرقة الحزبية ومركز الشرطة، وكانا في البناية نفسها، عند مدخل المعسكر الوحيد، هناك حيث تقف صورة كبيرة لصدام حسين، وهو يرتدي الزي الكردي، ويرفع رأسه كأنه ينظر إلى الجبل.
في الطريق تجاذب خالد والراكب أطراف الحديث، لكنهم عند مدخل المعسكر تجاذبوا الياقات، عندما أعطى الراكب لخالد ورقة ميتين وخمسين دينار واحدة، فرماها خالد بوجهه وصرخ به: اتفقنا على تقبيطة حوض! شنو تنطيني ميتين وخمسين! ازرب بيها.
هنا يتذكر خالد ويضحك، “لعبني صح” ويصف كيف التقط الراكب ورقة الميتين وخمسين ونظر بها ثم نظر إلى خالد وقال، “يزرب بيها! انت يزرب عالريس؟ إلا يشتكي عليك بالفرقة”. لكن خالد -من حلاوة روحه- استعاد الورقة وقبلها ونافس الكردي على حب الرئيس، وانتهت السالفة بتنازله عن كلفة التقبيطة كلها، لينجو، ونجا الراكب بتوفير ألف دينار للأيام المقبلة.
ربما، وفي ليلة فارغة كذلك، حكى ذلك الكردي لأصحابه ذلك الموقف، وضحكوا حتى بدت نواجذهم، مثلما فعلنا أنا وخالد، إنها الحيلة التي تنجو بها وتضحك منها، لكن، في حينها كانت طريقةً فعالة لدفع زمن الرئيس إلى الأمام، وإن كان يوماً بيوم.
صورة صدام حسين كانت سبباً للنجاة والموت على حد سواء، إنها شكل الإله في مخيال حزب البعث، يضعونها في كل شيء، ومن هذه الأشياء صدورنا. في السنوات التي سبقت سقوطه، كان الحزب يطبع صورة الرئيس على تيشيرت أبيض، ويوزعها على الطلبة في المدارس.
مرةً، طلب صديقي مهند مساعدتي، كان خائفاً من دخول مدرستنا في شفت دوام البنات، ليوصل لفة بيض وبطاطا لأخته هند، في الصف الرابع ابتدائي، خوفه كان بسبب “ست عواطف” الرفيقة العتيدة، والمديرة القاسية، لم تكن تسمح أبداً بدخول غير النساء إلى المدرسة خلال الدوام، حتى لو كان الرجل من العائلة.
كناً صبياناً حينها، لكننا طورنا “أداة الحيلة” في تلك الأيام؛ دخلت إلى البيت وارتديت التيشيرت الأبيض وامتلأ صدري بوجه القائد، وأخذت اللفة ودخلت إلى المدرسة، كانت ست عواطف تحمل عصاها وتتمشى في الممر، فتوجهت إليها وأنا أحمل سندويتش البيض والبطاطا والرئيس.
عندما اقتربُت منها ورأت القائد يضحك بوجهها؛ سمحت لي بتمرير اللفة إلى هند. في رأسها، كانت صورة صدام حسين أكبر من تعليماتها الصارمة، وجوع هند، وخوفي، لذلك سمحت لي بدخول المدرسة. كانت تعلم أنها حيلة، لكنها كانت مثلنا، واقعةً في الفخ وتلعب به.
اشترينا تلفزيوناً في ليلة الاحتلال
ماهر العكيلي
قبل الاحتلال بعامين، هاجرتُ رضيعاً بين ذراعي أمي إلى سوريا، وسكنا منطقة مخيم اليرموك الجامعة للمهاجرين من مختلف البلدان المتضررة، خليط من العراقيين والفلسطينيين والسودانيين وغيرهم من جنسيات مختلفة.
في لحظة الاحتلال، سَمِعَتْ أمي الأخبار التي تتناقلها الأصوات الصارخة في الشارع من نافذة غرفة المعيشة، كان هناك جو من الخوف، فأسرعت للتسوق تحسباً لأزمة مواد واقتصاد، وكان على رأس قائمتها حليب لرضيعها، أنا.
كانت الشوارع قد امتلأت بأصوات مذيعي نشرات الأخبار، والأغاني الوطنية، لكن رحلة أمي للتسوق، كانت تهدأ من قلقها على البلاد، والأقارب، والمصير.
“صادفت واحد عراقي يحاول يحجي وي ابو المسواك، يكلة اريد كيلو بتيتة وذاك ما يفتهمة!، كتلة كلة بطاطا لا تكلة بتيتة” تقول مبتسمة.
وسط هذا الصخب، لم يكن لدينا ستلايت، وتناقل الأحداث عبر السوق وشبابيك الحارة لم يعد كافياً.
اتصل والدي “بابو الستالايت”، الذي كان لديه يوم مزدحم من الطلبات لمشاهدة الحرب على العراق، لذا اضطرت العائلة أن تنتظر “سراها” في الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل.
لم تغمض العائلة عينها، عراقيون في الخارج يشاهدون عراقيين في الداخل يتحدثون عن الأوضاع ويرسلون أخبارهم الشخصيّة إلى من يهمه الأمر.
“جانوا يوكفون كدام الكامرة وياخذون المايك من المذيع، وينطون تحديث عن الوضع العائلي بالتلفزيون لأن جانت هاي الطريقة الأسرع انه يعرفون اهلهم خارج العراق بأحوالهم”، يقول أبي.
في تلك الليلة، سهرت أمي مع التلفاز الذي يجول في أنحاء العراق. كانت ساحة الفردوس خالية من التمثال المعروف لصدام حسين، هو المنظر الاكثر غرابة لها. “طلع واحد بساحة الفردوس يحاول يطمئن عائلته وكال: لا يظل بالكم احنا زينين بس اختكم وكع القصف على بيتها وانطتكم عمرها”.
كنت أريد النساتل يا صدام
يحيى عصام
عندما ولدتُ عام 1984، كانت قد مضت خمس سنوات على استيلاء صدام حسين على السلطة المطلقة في العراق، ولا أتذكر بالضبط متى عرفت هذا الرجل باسمه وشكله ومنصبه، لكنني أتذكر تماماً التحذيرات المشددة التي كنت أتلقاها من أمي وأبي عندما كنت طفلاً، بشأن عدم التحدث بسيرته خارج المنزل سلباً أو إيجاباً، وعدم ذكره إلا تحت تسمية “السيد الريّس” إذا اقتضت الضرورة التحدث عنه، والامتناع تماماً عن لفظ اسمه بشكل مجرد.
وأتذكر أيضاً درساً في كتاب القراءة للصف الثاني الابتدائي على ما أظن، عنوانه “رئيسنا يزورنا”، وهو قصة أطفال مطلوب من التلاميذ دراستها في إطار متطلبات تقوية التهجئة والقراءة لديهم، تتحدث عن تلميذ يعود من المدرسة إلى منزله مغموراً بالسعادة، ولما تسأله أمه عن سبب سعادته يطلب منها أن تخّمن، فتعدد أكثر من سبب تخميني، لكنه يخبرها في النهاية بأن كل تخميناتها خاطئة، وأن سبب سعادته هو زيارة “الرئيس القائد صدام حسين” إلى مدرسته ورؤيته إياه.
ذاكرتي الطفولية الضعيفة في تلك الأيام لا تخبرني الآن إن كنت قد عرفت صدام حسين عبر هذا الدرس أم قبله، لكنني على أي حال لم يكن يراودني شعور تجاهه سوى الخوف، بسبب التحذيرات المتكررة من الوالدين إزاء التحدث عنه مع أي أحد.
وأحسب أن تحذيرات الوالدين كانت أول بذرة زرعت في نفسي للرعب الصّدامي الذي توارثه العراقيون من 1979 حتى 2003، وقد نمت هذه البذرة وتجذرت يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة مع تكاثر القصص المخيفة التي أسمعها باستمرار عن أساليب أجهزة أمن النظام في التعذيب والقتل، وكيف أنها قد تطول أي شخص لمجرد انتقاده صدام أو ذكره بتهكم.
شعور الخوف من صدام التحق به سريعاً شعور كرهه. كرهتُ صدام لأنه جعلني أصارع ضيم الحصار الاقتصادي في كل أيام الطفولة والمراهقة، لأسباب حارت الدنيا في فهمها.
كنت في التسعينيات محروماً -مثل ملايين العراقيين- من الخبز الأبيض النظيف واللحوم والدجاج والبيض والأجبان والقشطة وكثير من أصناف الفواكه، إذ أتذكر جيداً أن آخر حبة موز تناولتها في حياتي كانت سنة 1989، ولم أتذوق هذه الفاكهة مرة أخرى إلا بعد سقوط النظام في 2003.
لا أنسى ذلك اليوم من أيام الابتدائية عندما أخرج زميل لوح شوكولا -يسمى نستلة في العراق- ليتناوله في إحدى الاستراحات بين الدروس، فانقض عليه التلاميذ ليأخذوه منه عنوة، ففر هارباً بأقصى ما يملك من سرعة وهم يركضون خلفه حتى أنقذه مدير المدرسة من كربته.
هذه النستلة كانت من علامة “جبري” العالمية، وهي لم تكن متوفرة في أسواق العراق في ذلك الحين، فقد كانت كنزاً ثميناً جلبه والد الزميل من الأردن التي سافر إليها لأغراض تخص عمله الحكومي.
لم تقتصر رداءة المعيشة على المأكل والنساتل والبيبسي كولا، وإنما شملت الملبس ووسائل النقل والخدمات ومستلزمات التعليم، فقد قضيتُ كل سنوات الدراسة المتوسطة الثلاث جالساً على الأرض المكسوة بتراب سميك، في صفوف شبابيكها مخلوعة وهواء الشتاء القارس يملأ أرجاءها، أمام مدرّسين غاضبين ومتوترين وناقمين، لأنهم عندما ينتهي دوامهم في المدرسة يذهبون بالحافلة الكريهة “التاتا” إلى العمل في بسطات ودكاكين صغيرة ليتمكنوا من إعالة أسرهم التي لا تعيلها رواتبهم المتدنية جداً.
لم تكن في ذلك الزمن مولدات أهلية في العراق، فكان انقطاع الكهرباء في الصيف يعني قضاء بضع ساعات في الجحيم، بينما صدام وحاشيته يتنعمون في أفخم القصور التي يشاهدها الناس يومياً من نوافذ السيارات المتهالكة المضطرين لركوبها.
كل ذلك وغيره كثير مما لا يتسع المقام لذكره، كان يدفعني إلى التساؤل: من هو صدام؟ ولماذا نتحمل كل هذا الخراء من أجل أن يبقى حاكماً مرفهاً يقتل كل من يسأله عن سبب الجوع والخراب واحتراق الرجال في الجبهات؟
طر تُ فرحاً عندما انتهى صدام، لكنني سرعان ما بدأت أهبط في لحظات الفوضى والانفلات وتقاسم السلطة طائفياً، ورحت أقول لنفسي وللآخرين: “أخشى أننا مقبلون على ما هو أسوأ من صدام، أو ما هو ليس بالأفضل على أقل تقدير”.
الآن عندما أشاهد صدام في اليوتيوب، تفتنني هيبته ولغة جسده، لكنني أتذكر دائماً كيف جعل طفولتي خالية من النساتل والملابس الجميلة والألعاب، ومليئة بأصوات القصف والصواريخ وصافرات الإنذار، فتُقمع أي محاولة من القلب ليهيم في هواه.
تواليت صدام مو ذهب!
حسين فاضل
العراقيون، كلهم جربوا أذاهم، كانت جدتي تقول. فكل واحد له قصة مع العتوي، أو أحد عتاويه التي يربيها ويُسمنها ويطلقها زيتونية بشوارب ثخينة في الشوارع.
لكن هل فكرت تلك المرأة، المحاطة بدخان سيجارتها على الدوام، أنها ستكون يوماً في بيت العتوي الأكبر؟ صدام حسين المجيد، قائد الثورة والأمة و”صخام وجوهنا”، كما كانت تردد؟
بالأحرى أن تقف بنحولها أمام مقعد تواليته، حائرة مستنجدة وهي، في تلك اللحظة، كل ما أرادته وفكّرت فيه هو إطلاق المياه من مثانتها؟
ونحن، ماذا سنقول؟ هل نقول إن جدتنا لم تستطع التبول في تواليت صدام حسين؟ تعسرت مثانتها هناك، وكانت تضحك عندما روت الحادثة؟ “هل كانت جدتكم بعثية”؟ سيقول الناس؟ هل كانت رفيقة؟ ماجدة وزّعت رؤوس أبناءها على سفرة الحروب التي فرشها صدام، وأجبر الكل على الجلوس عليها؟
هل نقول إن جدتنا، التي عرفناها ترتدي الأسود ولا شيء غيره، سَخَرت من منظر التواليت الغربي الذي يبدو ككرسي يكسر العظام ويُضمِر العضلات في حمام الرئيس، وفي قصره المرمري؟
نحكي كيف راعها البول وقوفاً، وفضلت حبس اليوريا في مثانتها، على أن تفعلَ فعلةً كل أباليس الدنيا لا تفعلها؟ ربما نضيف عليها لمحة كوميدية؛ ونقول (بيبي “كمبصت” على تواليت صدام حسين الذهبي؟)، وننهي بهذه الجملة القصّة كلها.
لكنها لم تقل انه ذهبي. كانت هذه المعلومة بالنسبة لها شديدة الحساسية، وكأنها الحقيقة الوحيدة الاكيدة التي حصلت عليها في حياتها. “طلع مو ذهب”.
أبيض، قالت.
يلمع، أكدت.
قالت أيضاً، إن الحمام يشبه غرف الجلوس في مسلسلات التلفزيون، فقد كان يضم سجادة سميكة، وورد على المغسلة والأرض، وضوء خافت.
روت أن التحرك داخل حمام صدام حسين يتطلب حيل رجل يأكل غزلاناً ويكاون الكون كل أيامه، كما يفعل صدام، مختصرة نظامه الغذائي وجدول أعماله اليومية، كرئيس لجمهورية العراق، وسجّان لسكّانه.
هل نقول إن جدتنا شاهدت تواليت صدام حسين، ويضيف كل منا حكايته؟
بعضنا، حتماً، سيكذب.
سيدّعي أنها أُسِرت لأنها تظاهرت ضد البعث الذي سرقت حروبه ابنها، سيقول بعضنا ايضاً، إنها سُحبت من منزلها عنوة من دون شحاطتها الجلدية، ولم يُسمح لها بأخذ دوائها، ومن ثم صفّت مع آخرين كدروع بشرية في قصور ومنازل صدام حسين.
لكن هذه روايات. تفاصيل غير مهمة لم تروِها جدتي وهي عائدة من قضاء ليلة في قصر صدام حسين عام 1998. وقفت أمام الباب وفي يدها برتقالة.
لم ير أحد منا تلك البرتقالة، لكننا دائماً سمعناها تتحدث عنها. قالت إن عتوي المنطقة نادى على النساء وأطفالهن، وقال لهن إن الرئيس يريد رؤيتهن ودعوتهن إلى العشاء فوراً.
كانت سُفرة، غصباً على الجميع، الجلوس إليها.
“لم نتعش”، و”لم نتبول مثل الأوادم”، ولم نحصل إلا على برتقالة. والحقيقة هي إن الحمام الذي رأته، لم يكن ذهباً، كان أبيض عكس أيامنا المصخمة، قالت.