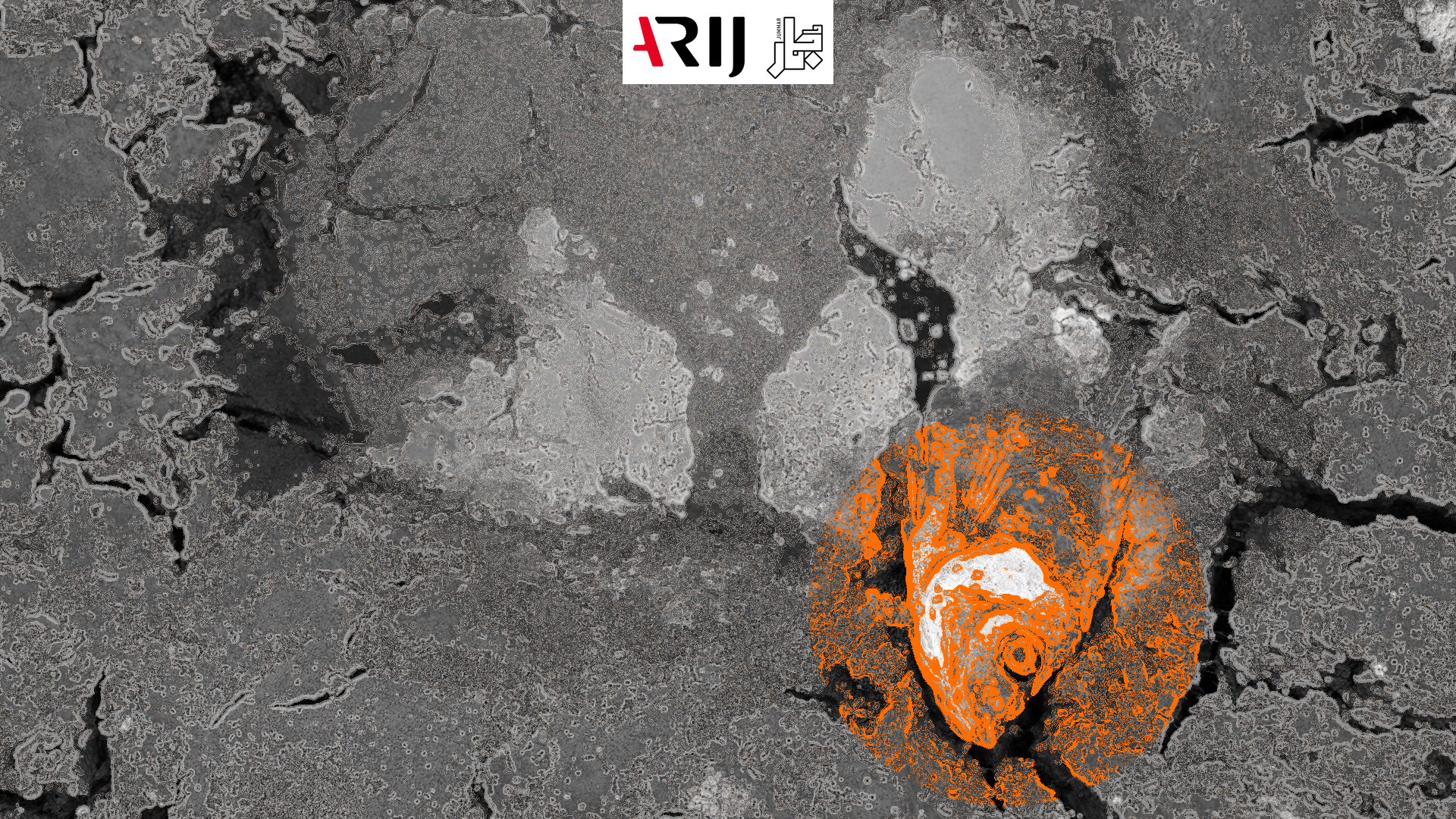حوار طويل: كيف غيّرت شيرين عسل حياة علي فاضل؟
11 آذار 2024
"نُفي" في مرحلةٍ مبكرة إلى كلية الفنون "لاجئاً"، يمرُّ بسيارته وسط العنف والقتل الطائفي، وكان يشاهد فحسب، وغيرت شيرين عسل حياته.. حوار طويل مع فاضل..
دخل المكتبة قبل المدرسة، “يلعب في كل المراكز” في كرة القدم والفن، هو الطفل الذي لم يحتفل بعيد ميلاده بسبب القصف الأمريكي على العراق عام 1991.
مهووسٌ بالقرطاسية؛ لأنه حُرِم منها في سنوات الحصار؛ الحصار الذي دخله ذلك المراهق بقميص، وخرج بالقميص نفسه؛ بعد أن غيّرت لونه الشمس. كتب الشعر مبكراً، ومبكراً أيضاً أدرك أنه شاعر سيئ.
تشكّلت شخصيته في الملعب، وسط صخب الجمهور، وكان شاهداً على سقوط السور على الجماهير. “نُفي” في مرحلةٍ مبكرة إلى كلية الفنون، “لاجئاً” كما يقول، يمرُّ بسيارته وسط العنف والقتل الطائفي، كان يشاهد فحسب؛ فهو شاهد على الأطراف المتنازعة وهي تقتل بعضها. انزوى أخيراً إلى الفن؛ بوصفه حياة بديلة.
تبدأ حياته الآن مع ورشة الكتابة، وتنتهي بها، قد يتخللها مشاهدة فيلم أو ربما لقاء هنا أو هناك.
يعرف أنّ الفن يهدم الحياة الاجتماعية، مع ذلك يمضي في الاتجاه هذا، هو الأب الذي يعامل مساعده الأول كطفل، ولا يفرّق في العمل بين الأب والأخ، يعرف أن ثَمّةَ فرقاً بين المدير والفنان؛ لكنه يؤمن أن كل ما يفعله هو من أجل المخرج الذي يريده في النهاية، المخرج علي فاضل، هكذا يريد أن يتذكره الناس.
يخشى على حرية التعبير في البلاد، وتعرض وفريقه للكثير من المشكلات الاجتماعية، ومع كل هذا فهو يحلم أن يعيش في بيت قديم بالقاهرة، أو في مزرعة على أطراف بغداد.
من أجل حوار مع علي فاضل، وقضاء بعض الوقت معه، في دردشة مفتوحة عن الحياة والفن، ذهبنا إلى موقع عمل “فريق ولاية بطيخ” لنلتقي هناك معه، علي فاضل، المخرج والممثل.
- الطفولة، المدينة الأولى، التشكّل الأول، ما هي الصور المتبقية من ذلك الطفل؟ ماذا يُحب؟ كيف يلعب؟ ماذا يفضل؟ بماذا تميّز؟
- أجمل ما في طفولتي المكتبة، كانت والدتي أمينة لمكتبة الأعظمية، ومثل أيّ أُمّ تأخذ طفلها لموقع العمل، المكتبة تلك مصدر ثقافتي الأول، أقسام المكتبة متعددة: تاريخ، أدب، فن، علوم، بدأت بالشعر، قرأت هناك: نزار قباني وبدر شاكر السياب وغيرهما.
ورغم أن بعض الكتب كانت ممنوعة لأسباب سياسية، لكن هناك، في قسم الفن، تعرفت على المسرح والسينما والتلفزيون، المكتبة غنيّة بالمصادر، غالبية قراءات تلك الطفولة أدبية وتاريخية، حققت استفادة من تلك القراءة، في الإعدادية مثلاً كُلّفت بشرح الخلافة الأموية والعباسية للطلاب، من الجانب الآخر كطفل في المنزل، ألعب كثيراً في السيارات، مهووس بشكل ما، ألعب في السيارة ثم أكسرها محاولاً فهم كيفية صنعها، كيف تدور العجلات وكيف تتكون الماكنة؟ وعند الخروج إلى الشارع، فليس هناك غير كرة القدم التي شكّلت حياتي. والدي حينها لم يكن يفضل اللعب في الشارع، كنت أضع الشارع الذي يأتي منه والدي أمامي وألعب، ما أن تدخل سيارته أول الفرع، أركض للبيت، وبينما يركن السيارة؛ أكون قد رتّبت كل شيء.

يسألني: “معقولة ذول يلعبون طوبة وانت مجنت وياهم؟”
أرد: “آني! لا ما ألعب! انت ما تقبل”.
- الطفل خلاق، والفنان كذلك، اللعب واللهو والمرح، إلى أيِّ حد تشبه ألعاب الطفولة لعبة الفن؟ هل الفنان طفل إلى الأبد؟
- أعتقد أنني لاعب جيد في كرة القدم، ألعب في كل المراكز، كما في الفن الآن، “وين ما يعوّزون يخلوني” الفنان والشاعر وأي مبدع، متى ما يموت داخله الطفل يموت إبداعه، الفرق بين الوظيفة والإبداع هو الطفولة، الطفل مبدع وخلاق، الطفولة هي عبور للحدود الشخصية والنمطية التي تتشكل في الوظيفة، الطفل يجرّب والفنان كذلك، الكثير من تجارب الطفولة أشعر أنني ما زلت أكررها، في الحصار نلعب بكرة سيئة من البلاستك فيها زوائد تخدش الأقدام، مع ذلك أحاول رميها بطريقة مستديرة مقلداً البرازيلي روبرتو كارلوس في هدفه الشهير ضد فرنسا، كانت تلك الضربة “موديل” واللاعب الجيد بيننا هو من يجرب، واللاعب غير الجيد هو من يفعل ما اعتاد على فعله الجميع، وهو بذلك لا يتطور، هو لا يجرّب الاستلام أو التسليم بطريقة جديدة، أمّا اللاعب المكتشف هو من فعل أشياء جديدة، غسان إسماعيل في أيام الكلية غضب مني وصرخ “يا أخي لا تجرّب.. العب سهل”، قلت له حينها، “السهل فعلناه كثيراً” التجريب مفتاح الإبداع سواء في كرة القدم أو في الفن.
- كيف كانت مشاعر وذكريات الصبي علي فاضل عن عام 1991 والقصف والأصوات والطائرات الأمريكية؟ أين عشت أيام الحرب؟
- القصف الأمريكي على العراق حدث في 17 كانون الثاني، فجراً، وكان ذلك اليوم هو عيد ميلادي أيضاً، كنت طفلاً مدللاً، تفكر العائلة منذ أيام كيف وأين تقيم حفل عيد ميلادي، لم نستطع الاحتفال، أوقفته القنابل، ثم دخلنا في الحصار، والفرق أنني كطفل لم أشعر بالحرب، حتى حرب إيران لم أشعر بها؛ فهي تجري في مكان بعيد على الحدود وخارج المدن، قبل القصف الأمريكي لم أكن أعرف ماذا يعني “صاروخ يضرب بناية وتُهدم”.
مربو ذلك الوقت من أعمام وجيران، وحتى معلمين، يحرصون على وضعنا خارج حديث الكبار، لم نكن نسمع الأحاديث التي تدور، أنا طفل لم أشعر بالحرب، شعرت بالحصار لأنه مسَّني شخصياً، عندما بدأت حاجاتي وملابسي تتقلص.
- شاب في الحصار، كيف عشت مرحلة تبادل القمصان بين الشباب؟ ما الذي تبقّى من تلك الحقبة؟ ما هي ذكرياتك عن تلك الأيام المتخمة بالجوع؟
- في الحصار بدأت الأشياء تُفقد “شوية شوية”، قبلها لا أعرف وقت شراء الملابس، ألبس وأخرج فحسب، بعد أيام الحصار كنت أريد الذهاب إلى المدرسة “ما عندي ملابس” شعرت بالحصار لأننا ببساطة عشنا دلال الثمانينات، أتذكر حين ذهبنا لمعرض بغداد الدولي عام 1989 أو ربما 88، وذهبنا لمهرجان بابل، حيث جاءت فرقة إسبانية، وأخرى ألمانية، وفرقة برازيلية، في معبد مردوخ، عشنا في ترف واضح، في معرض بغداد أتذكر كشك “كيت كات” تأتي خصيصاً من سويسرا، نحن الآن ضحايا “النساتل” التي نأكلها، كلها سيئة ومصنوعة في البحر، حتى الآن أتذكر غلاف الــ”كيت كات” الورقي المقوّى أحمر اللون، وتحته غطاء من السوليفان الفضي، حتى الآن أتذكر رائحتها، وانتقلنا من مرحلة بغداد التي فيها مظاهر فنية ويأتي إليها كرم مطاوع ويحيى الفخراني لتصوير فيلم بابل حبيبتي، إلى مرحلة أنني لا أملك قميصاً، والقميص الذي عشت معه لفترة نوعه سيئ، يشبه الكارتون، وألوانه باهتة، قميص تشتريه في لون ثم سرعان ما يتغير لونه لأنّه يُغسل يومياً، يفترض أنّ لونه أحمر؛ لكنه في الواقع نبيذي داكن، هذا غير توارث الملابس بيننا نحن الإخوة.
الحصار ليس فيه غني وآخر فقير، نحن من الطبقة المتوسطة وحتى لو حصلنا على بعض الأموال فلا يمكن صرفها بسهولة، خوفاً من اليوم الأسود الذي يشبه بداية ضربة الــ91، القلق والخوف تسرب إلى الأهل، خوف من المستقبل، في نهاية التسعينيات حصل تحسّن بسيط، بدأت تدخل بضائع بمستوى مقبول، لكن من عام 1991 وحتى 1998 “ما اشتريت حاجة مال اوادم” البضائع تلك لا تستحق الأموال التي ندفعها، وصلنا إلى مرحلةٍ يجب أن تشتري الكثير من الحاجات لتحصل على كيس البلاستك! حتى الكيس كان يباع، لذلك دائماً ما أقول إننا جيل يشعر بقيمة الأشياء لأننا عشنا زمن فقدانها.

أنا أُحبُّ السكريات جداً، حين دخلت “نستلة شيرين عسل” غيرت حياتي، استهلكتها بطريقة جنونية، ربما كنتُ أتناول 10 قطع في بعض الأيام، بالإضافة إلى هوسي في القرطاسية، الآن اشتري الكثير من القرطاسية، لديّ عقدة من القرطاسية التي استخدمناها في الابتدائية والمتوسطة.
في الثاني متوسط أتذكر كيف كان الدفتر عبارة عن نشارة خشب، النشارة واضحة وحين تكتب تتكسر الكلمات على سطح الدفتر المتموج، فمن كان يشتري دفتراً أبيض؟ حين يحصل أحدهم على دفتر “أبو الـ200 ورقة الأبيض” نقول ابن من هذا؟ حتى الآن لديّ رغبة بشراء ذلك الدفتر، الآن أشتري أجمل القرطاسية بدون لذة، انهيت المرحلة المتوسطة كلها بحقيبة واحدة، هذه آثار الحصار النفسية والاجتماعية.
- ظهور ملامح الاتجاهات الفنية لدى الطفل، الفنان الصغير، هل هناك مشاهد من ذلك؟ هل ظهرت الرغبة في التمثيل والعمل بالفن مبكراً؟
- في الثالث متوسط أدركت أنني شاعر سيئ، دائماً ما أرغب بالتميز في المجال الذي أدخله، وحين تأكدتُ أنني لا يمكن أن أصبح مثل أدونيس ومحمود درويش أو نزار قباني، تركت الشعر، نزار جعلني أحب الشعر.
بالنسبة للفن لا يمكن لأحد من جيلنا أن يدّعي أن لديه طموحاً فنياً غير الغناء، من يقول ذلك يكذب، لكنني انجذبت للمسرح، لم يكن لدي حلم سينمائي، أحببت المسرح بسبب محسن العلي، دخلت “بيت وخمس بيبان” في الثمانينات، كان الدخول إلى مسرح المنصور يشبه الحلم، المسرح جديد “هستوّة مطلعينة من الجيس” تشعر برقي المكان وهيبته ابتداءً من رائحة الكافتيريا، وصولاً للمقاعد الفاخرة التي لم تتبدل حتى الآن، مقاعد من جلد مميز فيها ملمس معين، من الصعب أن تقتنيها في بيتك، وهذا كان الفرق، عظمة المسرح أن كل شيء هناك غير موجود في الحياة العامة، الآن مثلاً حين تذهب لفيغاس أو الرياض، تجد أن الإضاءة التي هناك والألوان والتفاصيل غير موجودة في البيت والمدينة والأسواق، من هنا يبدأ الترفيه، يبدأ من الحدائق الخضراء، تكتشف أنك في مكان جديد كلياً، تدخل ساحة الاحتفالات والجندي المجهول والتفاصيل المهيبة تلك، تدخل فتصلك رائحة القهوة والنسكافيه والشاي، وهذه كلها بجودة ومذاق مختلف تماماً عمّا تحصل عليه في المنزل والأماكن العامة الأخرى، من هنا يبدأ الإبهار، من هذه التفاصيل.
- تحدثت عن محسن العلي وبيت وخمس بيبان، ما الذي أعجبك في تلك التجربة؟ وكيف أثّرت فيك وانعكست على عملك لاحقاً؟ وما هو مصير أبطالها في فترة الحصار؟
- من حيث الإدارة أنا متأثر بمحسن العلي، بدأت أبحث عنه حين أصبحت فناناً، أفكر كيف كان يرى التفاصيل في بيت وخمس بيبان، كان الأستاذ محسن العلي لديه فكرة، لاحقاً فهمتها حين كبرت، كان حين ينتهي العرض يُجبر الممثلين على البقاء في الكواليس، ينتظر إلى حين خروج الجمهور كله، ثم يُخرِج الممثلين بسيارة خاصة من الباب الخلفي، كان يقول لهم “انتم لازم ما تنشافون” الجمهور الذي يجلس في المقاعد الأخيرة يرى الممثلين عن بعد، سيأتي ثاني مرة للعمل وعنده طموح أن يتقدم مقعدين، وهكذا وصولاً إلى الصف الأول، لذلك أنا صُدمت حين شاهدت مكي عوّاد أيام الحصار في أحد الأحياء الصناعية ببغداد، كان الدهن قد غطّى ملابسه، مكي عواد الذي كنت أشاهده مثل إله إغريقي! أشاهده مثل فينوس بالضبط، مرسوم كما الإله وبشكل فخم، كنت طفلاً وأشاهدهم من الأسفل، كان خليل إبراهيم ضخماً جداً، حتى اعتقدت أن أحجامهم مختلفة عنّا، حين ترى فينوس “مكي عواد” في الشيخ عمر يُصلّح سيارته ويُعامل “الفيتر” -هذا حقه طبعاً- الأمر كارثي.
الحصار “خربط الطبقات”، هناك طبقات ثراؤها معنويٌ وليس مادياً، المعلم تشعر أنه أغنى رجل في العالم، قد يكون حاله بسيطاً، في الحصار أصبحنا نرى معلمينا في أسوأ الصور والظروف، هذه عشتها في المتوسطة، مع أحد الأساتذة، كان صارماً وشديداً، وكان يستعرض قوته وهيمنته على الطلاب كمعلم محترم وقوي الشخصية، تقع غرفته في ممر شعبتي، يخرج، فيرى الطلاب مذعورين وهم يركضون إلى أماكنهم قبله، الفرصة بين الدرس والآخر قليلة، خمس دقائق ربما، وهو لا يتوانى في معاقبة أي طالب يتأخر ولو لثانية، كنا نترك الماء ونركض حين نعرف أن هذا وقت حصته “اركضوا عدنا أستاذ فلان” بعد عام من هذه القوة والشخصية وجدته وديعاً في منزل صديق، يعطيه دروساً خصوصية، قال لي، “ها بابا علاوي شلونك” كان منكسراً، لماذا كان يدرّس خصوصي؟ لأنّه محتاج.

هذه المرة الأولى التي تحدثتُ فيها عن الحصار، الحصار لم يكن همّاً شخصياً، هو همُّ العراقيين، وللأمانة أقول، كعائلة كنا أفضل من الكثيرين، أعرف الكثير من الناس ممن فقدوا كرامتهم في الحصار، أدرك معنى جرح الكرامة، وأنا نجم قبل سنوات قليلة مسّ كرامتي شخص متسلط وأقوى مني، عذرت وقتها كل شخص هاجر أو عارض النظام، سواء السابق أو الحالي، أعذر كل من تمرض وأصبح حقيراً لأن مسّ الكرامة له تأثير كبير، ولا يمكن أن يُدرك بسهولة.
- هل فكرت في صناعة الفن في ذلك الوقت؟ كيف كانت تصوراتك عن الفن والعمل الفني؟ كيف كانت حياتك في التسعينيات؟ بماذا كنت تفكر؟
- في تلك الفترة أهم شيء في حياتي كرة القدم، الملعب كوّن شخصيتي، صدفة يقع بيتنا بالقرب من ملعب الشعب، ليس بيننا إلا جسر مشاة، كان الملعب رافداً مهما في تكوني الثقافي، ليس أنا فحسب، غالبية العراقيين، ثقافتهم ثقافة ملعب، والملعب يعني “هيه.. هيه.. هذا الحكم ناقص” وهذه الثقافة بالضبط تحصل الآن في الميديا، الفرق هو أن الملعب كان يسع 30 ألف شخص، الآن في الميديا حوالي 20 أو 25 مليون، الاندفاع الذي نشاهده في الميديا والسب والشتم والتخوين والتناقض كلها عشتها في الملعب أيضاً، على شكل تعليقات تطلق في الهواء، لغة التحليل وادعاء المعرفة نفسها، “ليش نزل فلان.. فلان أحسن.. التشكيلة بيها غلط” تخيّل أن الناس التي تقود العراق الآن من قادة مليشيات وفصائل غالبيتهم ثقافتهم ثقافة ملعب، يقاد العراق بهذه الثقافة، لو أردنا محاكمة جيل على الوضع الحالي علينا أن نحاكم مواليد 1972 وحتى مواليد 79، فهذا الجيل كان بعنفوان شبابه وتربى في الحصار وتربى في الملعب، وهذا ما ندفع ثمنه الآن، مع ذلك الرياضة أثّرت في شخصيتي كثيراً، جعلتني أكثر جرأة، حسب ما أتذكر مرة، سقط علينا جدار الملعب، ربما حدث ذلك عام 1997 أو 98، مات تحت الجدار قرابة 20 شخصاً، لكن النظام كان لا ينقل هكذا أخبار، الملعب كان ممتلئاً، وثمة بناء لجدار جديد، لم يتماسك بعد، سقط على رؤوسنا!
* كيف عشت لحظة 2003، المشاهد الأولى، دخول الدبابات الأمريكية، هروب الناس من بغداد؟
- كنا خارج بغداد حينها، لم نرغب بالخروج وقتها، لكن ضغط الجيران والأقارب جعلنا نغادر يومي 8 نيسان، و9 نيسان.
بمشاعر متضاربة عشت اللحظة، عمري وقتها 21 عاماً، فرح لأنني شعرت بمستقبل جديد قد بدأ، وهنا يجب أن أعترف لولا ذلك التغيير لم أكن الآن علي فاضل ولدي شركة واسم، وفي الوقت نفسه تسرّب لدي خوف من نوع ما، فنحن كما هو حال العائلات العراقية لدي في عائلتي جنود وضباط ومنتسبون وأعضاء في حزب البعث، كنت أخشى مقتلهم، مع ذلك استبشرت خيراً، لدي صديق شيوعي كبير في السن، كان يأخذني في الأيام الأولى للحرب، نأخذ جولة على صور صدام وتماثيله، كان يشير بيديه ويقول، “هاي كلها كوابيس راح تروح ونعيش حياة حلوة” صدفة هذا الصديق سكن في منطقة سيطر عليها فصيل مسلح يعاقب على الخمر، في يوم ما فتّش هذا الفصيل صندوق سيارته ووجد “شرب” أهانوه وضربوه بسبب ذلك، بعدها صادفته فقال لي، “كنت مخطئاً، كل ما أفكر به لم يحدث”. قلت له، في كلا الحالتين أنت تنظر للنظامين من الزاوية نفسها، والحقيقة أن في كل نظام ثمة إيجابيات -على قلتها- وسلبيات وكوارث.
بالمجل الوقت تغيّر، لو تنظر إلى الشلة التي كانت تحكم، من حسني مبارك إلى زين العابدين بن علي، ترى أنهم متفقون على قمع الشعوب، كان هذا النوع من الأنظمة موديل، مع ذلك كانت هناك إيجابيات حتى هذا النظام يقر بها، كانت هناك مؤسسات، لكن هذه الإيجابية لم نكن نشعر بها لأن حريتنا مسلوبة، حريتك هي جوهر حياتك، لذلك نحن نقول إن الحرية أهم مكسب حصلنا عليه من هذه العملية برمتها.
- هل هو تغيير أم احتلال؟
- أمريكا أسقطت النظام بالقوة، التعريف العلمي لهذه العملية هو “احتلال” لكنه بشكل ما تغيير، المشكلة أن التغيير فيه نتائج إيجابية وأخرى سلبية، بعد أن قلنا للاحتلال شكراً، وخرج، ما هي النتائج؟ هل الاحتلال بالقطعات عسكرية فقط؟ العراق الآن محتل دون دبابة أو طائرة، ربما الاحتلال الصريح أفضل من هذا الشكل، البلد الآن محتل، وأي طرف إقليمي أو دولي تطالبه بالتوقف عن التدخل بالعراق، يقول لك أنا هنا لمساعدتك عسكرياً وتجارياً، أليس هذا احتلال أيضاً؟
- رافقت السنوات الأولى لتغيير النظام موجات عنف لا مثيل لها، هل أثر ذلك العنف على طموحك، كيف أسهم العنف ذلك في نتاجك لاحقاً؟ كيف عشت أيام العنف تلك؟
- في عام 2001 دخلت كلية الفنون الجميلة، تعرفت على أصدقاء، وأصبحنا جماعة أو “عصابة” عشنا كما لو أننا خارج العراق، صار لدينا “لجوء” في كلية الفنون، كنت أشعر أنني “لاجئ” لا مواطن، أشعر أنني جالية في العراق، حيث كانت مجموعتنا خارج السياق، لا نتحدث في الطائفية ولا علاقة لنا بالسلاح، ليس لدينا هدف لإقصاء الآخر، بيننا محبة قائمة على مشتركات إنسانية وفنية بحتة، نمر بالعنف ولا نشارك به.
كنت الوحيد من بينهم الذي يمتلك سيارة في سنوات 2004 و2005 و2006، الصديق الأول سهم غضبان منزله في حي الجامعة، وغسان إسماعيل في شقق صدام، ومخلد راسم في السيدية، ومرتضى في منطقة التراث، كل هذه المناطق كانت مشتعلة، قتل وذبح ونحن نمرُّ في أوقات متأخرة، ونجلس في مقهى حميد في حي الجامعة، نذهب للكسرة إذا كان لدينا تمرين أو تصوير أو قراءة أو حفظ، بعدها أوصلهم كل واحد إلى منزله، وسط العنف.
- وسط الاقتتال الطائفي والعنف هل ثمة مواقف شخصية أثرت بك مباشرة؟ وكيف غير ذلك الموت وجهة نظرك؟ كيف عشت الحرب الطائفية؟
- لم يسبق أن تحدثت في الإعلام عمّا حصل لي في ذلك الوقت، أنا “بالطائفية انهزيت هزتين” الأولى كانت نتيجة لمقتل شخص مقرب مني جداً، وهو من الطائفة الشيعية، قُتل في منطقة سُنّية بطريقة بشعة جداً، لمدة خمسة أيام، لم يهدأ دماغي، أقول في سري، “هناك مشكلة في هذه الطائفة السُنية” كنت بعمر خطر، 23 عاماً، مقابل ذلك كنت يوماً ما صدفة في منطقة زيّونة، نزلت عجلات وأغلقت شارع الربيعي، وأمامي أُحرق جامع شارع الربيعي، فصارت لديّ صدمة مقابِلة، الجهة التي حرقته “شيعية” لدي تصور أن الجامع أو أي مكان ديني وفيه منارة وقبة هو بيت الله، وقفت أُشاهد، كان الدخان يتصاعد من الجامع بينما قتل كل من فيه، هنا اهتزّت علاقتي بالطوائف كلها، لا يمكن بعد هذه المشاهد أن تقول هذه الطائفة جيدة وتلك سيئة، الموضوع تحول إلى جنون، الذي يسيطر على هذه الجهة وتلك وصلا إلى منطقة اللاعودة، هنا اتخذتُ قراراً وهو أن اتحدث عن أي شيء في الدنيا عدا الدين.
لا يمكن انكار الانحياز الطائفي، وهناك نُكات متبادلة، تصدر من الطرفين، لكن أن يصل الأمر حدَّ القتل، فهذا جنون.
- ما هو روتينك اليومي، ما الذي لا تستطيع أن تستغني عنه؟ ما الذي تعمله يومياً؟
- يومياتي يحكمها العمل والنظام الغذائي “الكيتو”. لدي توقيتات دقيقة في الأكل، عادة أنام في الشركة، لا أعود للبيت إلا بعد انتهاء العمل تماماً، لكن أغلب أيام السنة أنا في الشركة، أنام في الساعة الثالثة أو الرابعة فجراً، بعد إنجاز أعمالي المقررة لهذا اليوم، وأصحو في 11 صباحاً، وإذا كان لدي عمل مكثف أو موعد صباحي في الساعة الثامنة أو التاسعة يبدأ يومي، في الحقيقة أكره النوم، لدي عقدة منه، أشعر أن النوم هو تضييع للوقت، مرةً قرأت أن الإنسان يضيع ثلث عمره في النوم، من وقتها كرهته، وأشعر أن مهمتي تقليل هذا الثلث، أول شيء أفعله بعد الصحو، اختيار ملابس اليوم، لأنني سألتقي بالعديد من الناس، ولدي مواعيد معينة تحتاج أن أظهر بالشكل المناسب، مع ذلك هناك ملابس تناسب الأصدقاء والمقربين، وأخرى لمواعيد العمل الرسمية، لست صديقاً للقهوة لأنني “بزر الكعدة” المدلل الذي يحب الحلويات، فالقهوة عدوي، لكن نظامي الغذائي فرضها عليَّ، فأنا أفضل الشاي أكثر.
لا أبدأ يومي في الأكل والشرب، مباشرة أبدأ العمل مع الملتزمين، لأن الورشة فيها من هم ملتزمون جداً، وهؤلاء يأتون مبكراً، وغير الملتزمين ممن يتأخرون، نتحدث عن البارحة وماذا فكرنا، لحين الساعة 12:30، موعد الوجبة الأولى، بعدها نباشر بالكتابة في هذه الغرفة.
تأخذ الورشة يومياً من 7 الى 8 ساعات، أثناء الورشة أدير الشركة، والأمر مهلك في بعض الأحيان، تحدث أشياء تؤثر على مزاج الكتابة، في الساعة السابعة مساءً، آخر وجبة أكل لي، عادة أطلبها من المطعم، رغم أنني أحب أكل البيت، لكن طبيعة عملي تجعل الأمر مستحيلاً، أعاود الصيام المتقطع، وغير مسموح لي إلا بأشياء معينة، القهوة والشاي من دون سكر، وصودا ماء غازي فقط.
- هل هذه الورشة طوال السنة؟ وكيف تجمع بين المدير والفنان؟
- عمل الورشة طوال السنة، دائماً هنالك عمل جديد، إضافة إلى “ولاية بطيخ” طوال فترة عرضه، قبل رمضان نكتب عمل رمضان، وهكذا.
العمل مع الإدارة يحتاج إلى أعصاب، أثناء الكتابة يطلب منك عمل إداري، فتخرج من طور الفنان الذي يكتب إلى دور المدير، كان الأمر صعباً في البداية؛ لكن مع السنوات بدأتُ الاعتياد عليه.
- ماذا تقرأ؟ أي كتب تفضل، أي كاتب؟ ماذا تشاهد؟
- حتى عام 2014 كنت اقرأ بغزارة، حين دخلت التلفاز انقطعت، عدت للقراءة في 2020. شعرت أن المحتوى الثقافي لدي بدأ ينفد، أغلب قراءاتي في تخصصي.
- لو خيرت بين مجموعة كتب ماذا تفضل؟
- لو ابتعدنا عن وظيفتي علي كمخرج، أذهب لكتب تنفع في العمل أيضاً، مثلاً: علم الاجتماع، وعلم النفس. هذه الاختصاصات قريبة جداً من عملنا، اقرأ دراسات وبحوثاً قريبة عن العمل الذي أكتبه، مثلاً، حين أكتب عمل عن الأسرة، اقرأ دراسات عن الأسرة، رحلتي كقارئ بدأت بالروايات، بمرور الوقت صرت لا أفضلها، شعرت في وقت ما أنها غير مفيدة، فانهمكت في كتب الفن وعلم الجمال والعلوم المقاربة والمسرح، قرأت كثيراً في المسرح، لكنني الآن تدربت، وصرت أفضل الروايات والسيرة الذاتية.
- ماذا قرأت سابقاً؟ وما هي فائدة القراءة بسن مبكرة؟
- قرأت غالبية أعمال نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس، في الأدب الكلاسيكي قرأت الكثير في عمر مبكر، في فترة ما كنت مهتماً بجبران خليل جبران والشعر الجاهلي أيضاً، قرأت هذه النتاجات وأشعر أنني لم اقرأها بشكل جيد، بسبب عمري والوعي الذي كنت أملكه وقتها، أجبرت على إعادة قراءة بعض الأعمال، منها عمل لنجيب محفوظ “تحت المظلة” لم أكن وقتها أعرف قيمتها حتى عدت إليها ثانية، وعرفت أنها تختلف عن أغلب نتاجه الأدبي.
- هل تفضل كُتّاباً معيّنين؟ وماذا تحب في الأدب الشعبي؟
- لنقسم الاختصاصات، في الشعر كنت أحب درويش ثم تمردت عليه، كل شعراء المهجر أحبهم، وحفظت من شعرهم حتى، بالسرد غابرييل غارسيا ماركيز وأيضاً أحببت أدب الشباب ممن تخرجوا عبر الورشة التي كان يقيمها. أفضّل أدب أمريكا الجنوبية بالعموم، مع ذلك يجب ألا أكذب، أنا أنتمي للمخرجين وكتاب السيناريو، أشعر أن الكتاب والأدباء من غير جناح، في الشعر الشعبي كذلك أفضل صلاح جاهين، أحب أحمد فؤاد نجم، يستهويني الأدب الشعبي المصري، رغم أن شعرنا الشعبي أفضل، في الأدب الشعبي العراقي أفضل النَّواب.
- هل لدينا اهتمام بالأدب الشعبي؟ خصوصاً وأن ثقافتنا الشعبية كبيرة ومتنوعة، وهل تم توظيفها بشكل جيد في الفن؟
- هذا له علاقة بشكل المجتمع، وللأسف مجتمعنا لا يعتز بهويته، وأعتقد أن جزءاً من الانقسام الاجتماعي سببه الهويات الشعبية، أنا أحترم المجتمع الموصلي، فيه مسيحيون ومسلمون ويتحدثون المصلاوية، لأن بيئة الموصل أكبر من الدين، أنا مثلاً أعتز بهويتي الجنوبية وأحترمها أيضاً، أصولنا من هناك، وأريد أن اعتز بهذه الثقافة، لكن ما يحدث أن هذا الاعتزاز حين يكرّس في الفن قد يدخل ضمن عمليات الاستفزاز، هذا على مستوى الدراما، لا بد للعمل أن يمثل كل العراق، في الفيلم العملية ممكنة، لأن صناعة الفيلم قائمة على التفاصيل، في التلفاز نحن نحتاج الثقافة الأعم والأشمل، وتعبر عن الجميع.
- علاقتك بالأكل، ماذا تفضل، ماذا تحب، كيف توظف فهمك للطعام في الحياة؟ وما هي علاقة الطعام بالفن بالنسبة لك شخصياً؟
- الطعام هو من ينظم حياتنا، تبدأ الحياة مع وجبة الإفطار، أهم لحظات حياتي كانت بالتسعينات عند الساعة الخامسة عصراً، كان وقتها تلفزيون العراق بعد نهاية كل رمضان يذهب لاتحاد الإذاعات المصري ويشتري كل الأعمال التي قدمت، وصار لدينا تراكم من الأعمال الخالدة، كان النظام الشمولي يحدد وقت النوم والأكل، في الساعة 12 ليلاً الكل ينام، في وقت الظهيرة كذلك، في الخامسة عصراً نصحو، وتجمعنا الوالدة على واحدة من روائع الدراما العربية، سكرية، ليالي الحلمية، أبو العلا البشري، الراية البيضاء، وغيرها من الأعمال.
العوائل كانت تنام الظهر وتصحو في هذا الوقت، تفرجنا تلك الأعمال مع شاي وكعك العصر يسميه العراقيون “عصرونية” فأجمل لحظات حياتي مرتبطة بالأكل، الأم مهما كانت واعية ومثقفة تبقى مسؤوليتها معك وظيفية، يجب أن تصنع لك أكلا جيدا وتنظفك وغيرها، لذلك دائماً أقول لابني: العائلة نعمة كبيرة، والجلوس مع العائلة فرصة عظيمة، لذلك يرتبط عندي الأكل بالدراما والعائلة، شاهدنا سكرية جزئين، وبين القصرين، وربما شاهدت هذه الأعمال لاحقاً لكن المتعة تذهب بي لتذكرني بتلك الأيام، بالشاي وتفاصيل الأكل، عمري حوالي 11 أو 12 سنة، أشاهد المسلسل: هذه شخصية أبي وهذا أخي الأكبر. كانت هذه الأعمال الخالدة مصنوعة بدقة للعوائل، كتبها غالباً أسامة أنور عكاشة، لذلك هي مرتبطة عندي بالأكل.
* الزوج والابن والأب والأخ… هل ورطت العائلة بالفن؟ كيف تؤثر طبيعة عملك على حياتك الشخصية؟
- منذ أول دخولي للفن وأنا أفكر بكاظم الساهر، مثلي الأعلى في الفن والحياة كاظم، أحب أغانيه، كنت ساهرياً ولدي عضوية، وكانت سابقاً هناك كروبات، كنت أفكر كيف يهدم عائلته من أجل الفن، الفن يحتاج إلى سفر وتنقل مستمر، كاظم لم يكن يستقر، كل شهر في بلد، حفلة في لندن وأخرى في بيروت، حين دخلت الفن وعرفت هذه الالتزامات، وأن الحفلة تعني تحضيرات وبروفا وتجمع قبل مدة، وقبل أن ينتهي هذا الالتزام يبدأ التزام آخر، مع النجاح والعمل عرفت أن الفن يهدم الحياة الاجتماعية.
- يتطرف بعض الفنانين تجاه عدم دخول أبنائهم لعالم الفن، ومتى يسمح الفنان بذلك، كأب وفنان كيف ترى الفنان مخلد علي فاضل؟
- دخول مخلد للفن يشبه بقية حياته، فلم أفرض عليه أي شيء، كنت أتمنى أن يدخل “فلان مدرسة” ولم يدخلها، الآن يريد الدخول لكلية معينة أيضاً، لا أفرض عليه، اتدخل في تفاصيل معينة، منعته من الدخول لمعهد الفنون الجميلة، قلت له: “انت هسه بملعبي”، تريد أن تصبح فناناً؟ لا تدخل معهد لعدة أسباب: المعهد حالياً ليس بأفضل حالاته، والمعهد خمس سنوات، بعدها حين ترغب في إكمال الكلية سوف تكتشف أنك فقط خسرت الوقت، نصحته بالإعدادية، ثلاث سنوات فحسب، وتذهب للكلية مباشرة، ولو كان المعهد سيفيده لا شك لن أقف في طريقه، هذا ليس انتقاصاً من المعهد الذي خرّج أساطير الفن العراقي.
ما أود قوله إن مخلد دخل للفن برغبة منه، قال أريد أن أدخل ورشة كتابة، قلت له اذهب واكتب، بعد ذلك قال: هناك مجموعة شبابية تعمل على فيلم قصير، أيضاً قلت له التحق بهم.
في داخلي لم أكن أرغب بسؤاله من هم، لا أود ممارسة السلطة الأبوية عليه، أهم شيء عندي يذهب لمكان معلوم ويعود في وقت معلوم، هذا دوري كأب، في يوم ما، دخلت في نقاش فني معه، كان يتحدث بلغة وطريقة أكبر من عمره في الفن، كنت أود القول له إنني انظر لك كما لو أن عمرك 7 سنوات وليس 17 سنة، قال لي بعد ذلك أريد أن أكون مساعد مخرج متدرب معك، قلت له تعال، لكن إذا لم تكن بالمستوى ستكون هذه أول وآخر تجربة لي معك.
دخلنا أجواء العمل، كنا نتناقش طوال الوقت، أعطاني وجهات نظر غيرت مشاهد كاملة، أنا وقت العمل لا أعرف هذا ابني أو ذاك أخي، لحظة العمل عندي الأهم، من يعطيني وجهة نظر مفيدة للعمل، لا يهم، مساعد مخرج أو مخرج أو متدرب، أي شخص في “السيت عنده حجايه مهمة تفيدني” وهكذا نزل معي كمساعد مخرج متدرب في أول عمل له.
- ماذا كنت تعمل قبل أن تحترف الفن؟ ما هي المهن التي عملت فيها؟
- عملت كثيراً في الصحافة الورقية، في جريدة الدستور والنافذة وبعض المجلات، عملت لفترة طويلة، كتبت عموداً رياضياً، عملت مع الوالد في السوق الخاص بالأدوات الاحتياطية في ساحة الخلاني، عملت في معمل تصنيع الأدوات الاحتياطية، في ما يسمى بالسوق “دجة مال كير واذن محرك”، كانت إنتاج عراقي، بيتنا كان معملاً، هذا وقت الحصار، عملت أيضاً في أكشاك الاتصالات قبل 2003 في ساحة النصر والطيران والمشجر، عملت في تصريف العملة بعد 2003، كانت ساحة الفردوس أول سنوات سقوط النظام قد تحوّلت إلى سوق عملة، كانت مكاتب حديدية صغيرة يجلس عليها محولو العملة، كنت أنا من يبحث عن الزبائن المحتملين ويجلبهم لمصرفي العملة، كان لدي زبائن خاصون، حصلت في تلك الفترة على أموال جيدة، عقلي التجاري جيد.
- ماذا تفضل أن تعمل فيما لو قررت ترك العمل في الفن؟
- سأعمل في التجارة، ربما في بيع وشراء العقارات. أحب هذه المهنة جداً، أحب البناء، تبدأ بأرض ثم تصبح مكاناً للسكن، وأحب لاحقاً أن أعيش في شقة أو فيلا قديمة بالزمالك في القاهرة، أو أبني بيتنا في أطراف بغداد في الدورة أو البعيثة، اشتري دونماً، أبني جزءاً منه، والباقي أحوله لحديقة، هذا حلم حياتي، إما هنا أو هناك.
- الأصدقاء، البيئة المحيطة بك، إلى أي حد ترى أنه من الضرورة عيش الحياة مقابل التفكير بالفن؟
- النجاح والعمل والفني ينهي حياتك الاجتماعية، أنا خسرت أصدقاء عمري بسبب الفن، حالياً لا أصدقاء لدي.
- ما مدى علاقتك بالسينما وكيف تؤثر عليك؟
- علاقتي مع السينما عظيمة، أعتبرها مصدر ثقافتي الأساسي، لقد شاهدت الكثير وقرأت كثيراً عن السينما، لدي أفلام غير متوفرة حتى عبر النت، لا أفضل سينما هوليود ولا السينما التجارية، أقدرها لكن لا أحبها، ليس لدي حتى من تفضيلاتي ممثل أمريكي، ربما توم هانكس وشون بن من مئات النجوم، أحب السينما الإيطالية والإسبانية والإيرانية.
- هل يمكن أن نعرف تفضيلاتك الشخصية؟ ما هو TOP TEN الخاص بك؟ وما هي الأفلام التي شاهدتها أكثر من مرة؟
- سيكون هناك ظلمٌ كبير؛ مع ذلك سأبدأ بالمخرجين: جيوزبي تورنتوري، أصغر فرهادي، أمير كوستريكا، جامبير جانيت، جاكو فمبرمان، مجيد مجيدي، عباس كيارستمي، رغم أنني لا أنتمي إلى السينما التي ينتجها. في أمريكا أحب كوينتن تارانتينو واينا ريتو، أيضاً أحب مخرج فيلم وول ستريت، سكورسيزي، وتيم برتون مخرج السمكة الكبيرة.
عادةً، الفيلم الجيد، الذي يناسبني أعيده أكثر من مرة، فيلم المرأة المجهولة للمخرج تورنتوري ربما أكثر فيلم شاهدته في حياتي، لو أردنا توب تين للأفلام، فكل أفلامه، لكن سأختار المرأة المجهولة، إضافة إلى 1900 ومالينا، وصانع سينما باراديسو، وحتى أعد عشرة أفلام، سأختار عمل المخرج جاكو فان دورميل في عملين، مستر نو بدي، واليوم الثامن، فهذا الفيلم غير حياتي، قبل هذا الفيلم كل أصحاب متلازمة داون كنت أخشاهم، لا اقترب منهم، بعد هذا الفيلم صرت أقترب منهم، وأكون قريباً منهم.
نروح على ألمودوفار واختر منه All About My Mother، رغم أن لديه الكثير من الأعمال الجميلة، أصغر فرهادي أختار منه انفصال وفيلم الضائع، مجيد مجيدي أطفال الجنة، سأختار فيلم معتقدات وهو فيلم أرجنتيني يفترض أن يحبه كل عراقي، لأن ثقافة الاختفاء في العراق واضحة، وتتحدث قصة هذا الفيلم عن شخص لديه القدرة على معرفة أين تختفي الناس، ذلك في السبعينيات في حكم الجنرالات، فأصبح مرجعاً، يمس يد الإنسان وإن اختفى ممكن أن يبحث عنه، فيلم عظيم، في عام 2003 طبعت ووزعت وأهديت هذا الفيلم لكثير من الناس، فكما نعرف؛ العراقيون يختفون منذ الستينيات. في الأفلام البرازيلية أحب فيلم اسمه “مدينة الله”.
- ما هي الظروف الحالية لولاية بطيخ؟ وكيف تؤثر الظروف العامة على البرنامج؟
- ولاية بطيخ قصة، نحن نمر بظروف معقدة، هناك فكرة حول بثه على الميديا، وهناك قناة أبدت رغبتها به، لكني أرغب في الذهاب به إلى الميديا، لكي أبثّه بالطريقة التي تناسبني، فحين أذهب للقناة قد يؤثر عليها.
- لماذا الكوميديا تحديداً؟ من اختار ذلك؟ الظرف الاجتماعي أو الضرورة التاريخية؟
- كي لا أكذب، الكوميديا لم تكن مشروعي، كخريج فنون واقرأ عن الضحك والكوميديا بشكل علمي، لم تكن تعجبني الكوميديا العراقية، بالأخص تلك التي ظهرت بعد 2003، كنت اعتبرها كوميديا سطحية ليس فيها ما هو جديد، كنت متذوقاً للكوميديا العربية والعالمية، كنت أسأل لماذا لا نعمل مثلهم؟ عراقياً كنت أسأل لماذا تؤخذ الكوميديا هذه المنطقة، هل الكوميديا مجرد تايتل جميل والمضمون لا يرى؟
الصدفة وحدها جعلت مدير قناة الشرقية يقول لي: “انت تخربني ضحك من تحجي، ليش ما تشتغل كوميديا” أفهم الفن أنه رسالة، ويحتاج معاناة وصبراً، طرح اسمي كمقدم، بدأت الناس تتفاعل، رغم أن قسماً منهم يشعرون أن دمك ثقيل، في النهاية أكبر كوميديان بالعالم ممكن لبعض الناس أن تستثقله، هذا يبقى حسب ذوق الجمهور، بدأت اتعلم لعبة التلفزيون، الموضوع تحول: أريد فعل شيء، أريد تحدياً، والتحدي هو أن أغير نمط الكوميديا، وهذا تطلب قراراً جريئاً، أن أستقيل من الشرقية. كررتها كثيراً، لم اكتب استقالة وقتها، قدمت بوستر فيلم “هلا لوين” للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، قلت لمديري: هلا لوين، أي بمعنى “احنا وين رايحين، يعني خلص احنا باقين بالنص” كان وقتها العيش في أربيل بالنسبة لي هو توقف في منتصف الطريق، لست في دولة أوروبية ولدي جنسية، ولست في مكاني لكي أرتب حياتي، أربيل كانت بالنسبة لي فندقاً وليس مكاناً للعيش، فدخلت التحدي الذي بدأ يكبر يوماً بعد يوم، وصولاً إلى نجاحنا في الكوميديا، لكن هذا لم يكن الرهان الأساس، لذلك حين نجحت في الكوميديا عدت إلى حلمي القديم، أن أصنع دراما وسينما، والآن أعمل على ذلك، وقدمت أعمالاً بهذا المجال.

- هل ثمة علي فاضل قبل ولاية بطيخ وعلي فاضل آخر بعد ولاية بطيخ؟
- طبعاً، قبل ولاية بطيخ كان علي فاضل غير واضح ويجامل ويخاف ويستحي ويداهن، الآن أنا شخص واضح وضوحا تاما. الخجل يجعلك تخسر نقاطاً كثيرة، وهذا ما جعل الكثير من الناس تعتقد أنها ضحايا علي فاضل، وأنهم تضرروا بسببي، أنا أعذرهم ولم أعتب عليهم لأنني لم اتعامل معهم بالوضوح الكافي، من الأفضل أن تقول للآخرين كل شيء بوضوح، شكراً في أمان الله، هذا يجنبك الكثير من المشاكل، لكن حين تراعي مشاعر الآخرين، وتجامل في المحصلة سوف يعتقد الآخر أنك كنت تكذب، لم أكن بهذا الدرجة من الوضوح.
- هل السكيتج قديم؟ هل هو امتداد؟ ومتى بدأت في العمل على هذا النوع من الفن؟ من أهم المميزين في هذا الفن؟
- أول ما بدأت بمشروع الكوميديا بدأت بمشروع السكيتج، كان مشروعي في طور التحضير في 2012 وعُرض عام 2013، وظهر مشروع آخر بالتزامن معنا، أعتقد في عام 2014، لم أكن مبتكر هذا الشكل، فاستراحة الظهيرة خير دليل، لكن في هذا الزمن لم يكن هناك عمل بهذا الشكل، وأعتقد أن السكيتج ظهر عبرنا في 2014، لذلك هو امتداد، أنا تربيت على كاريكاتير واستراحة الظهيرة، ومن عشاق محمد حسين عبد الرحيم، في “الخيط والعصفور” و”أيام الإجازة” والاسكيتجات التي قدمها أعتبره عبقريا، مثلما لدينا لاعبون مميزون وفي الرسم والشعر، نقول عنهم “فلتات” فمحمد حسين عبدالرحيم وراسم الجميلي وسليم البصري، هناك تقريباً 4 أو 5 أسماء اعتبرها فلتة، سليم البصري عبقري، راسم عبقري، لدينا عديد من الممثلين الجيدين، لكن هؤلاء عباقرة، في “تحت موس الحلاق” هناك سكيتج حين يحاسبهم المدرس، راسم الجميلي “قدم أداءً لليوم نجوم الكوميديا ميكدرون يسووه”.
- من فريق طموح إلى نخبة من النجوم.. رحلة ولاية بطيخ محفوفة بالمخاطر، كيف كانت البداية؟ عملت في الولاية: مخرجاً، وممثلاً، وكاتباً، ومديراً.
- لم يبدأ ولاية بطيخ كمشروع لصناعة النجم، لم أتحدث سابقاً بهذه الطريقة، “احنا جايين نحب نوع من الكوميديا”، لم نكن نريد المنافسة ولم نتوقع أننا سننافس، أنا أفضّل هذه الكوميديا وأرفض غيرها، لنقدم كوميديا بالطريقة التي نفضلها ولا نعرف هل سننجح أم لا، لم يكن هناك طموح، أنت تحب شيئا وهناك مكان تبنّى هذا الحب “فتعال قدم الي تحبه” الطموح يبدأ مع أول نجاح، ويبدأ سؤال: لم لا؟
لا أود الكذب، مشروعي ليس الكوميديا، وحتى وإن فشلت، وقتها سأقول أقلها أنا حاولت، أنا أحاول كعلي فاضل، حتى على مباريات سبق وإن صرتُ معلقاً رياضياً، مرة واحدة في قناة الشرقية في بطولة شباب آسيا، لم يكن هناك معلق، دخلت وعلقت، كنت أعلق بشكل جيد لذلك علّقت البطولة كلها، لكن هل كنت أراهن على نفسي كمعلق؟ بالتأكيد لا.
في الكوميديا الشيء نفسه، كنت أحب نمطاً من الكوميديا وجاءت فرصة، ولو لم ينجح هذا النمط لكنت انسحبت، وحين نجحنا بدأ طموحي في تكوين فريق يحبه الجمهور، خرجت من الشرقية، خرجنا معاً أنا وأحمد البشير وكان التحدي هو أن أثبت للشرقية أإني قادر على النجاح خارج القناة، أتذكر قالوا لي: “ارجع، لأنك حين تطلب لاحقاً العودة مراح نرجعك”، قلت لهم: لن أعود، فهذا كان تحدياً أن تجد نفسك خارج المؤسسة التي بنتك، الشرقية لها الفضل، هي التي أسست مسيرتي في التلفزيون، والإعلام كمهنة تعلمته في الشرقية، وحين تتمرد على المؤسسة وتخرج، لابد أن تنجح وتثبت أنك اتخذت القرار الصحيح.
- صناعة الكوميديا تحت محاذير اجتماعية وسياسية.. كيف أثّر ذلك على مواضيع ونصوص ولاية بطيخ؟ هل تعرّض الفريق لمشكلات بسبب موضوعات البرنامج؟ وكيف تؤثر الثقافات الفرعية في قمع فن؟
- هذه الأشياء كلها تؤثر، اتحدث مع الشباب أحياناً، أقول لهم مطلوب منا كوميديا ودراما مغايرة، الآن كل الدراما تقريباً بيئتها بغداد، أريد أن أصنع مثل “تحت الوصايا” عملاً بيئته مائية، لا بدّ من الذهاب الى البصرة فهناك ميناء وسفن، وحين تخرج مثلاً شخصية سلبية تنهال التهم، “ها قصدك أهل البصرة هيج” أريد صناعة عمل في بيئة جبلية “ها قصدك الكرد هيج” وهذه تنسحب على كل العراق.
هذا للأسف أصبح طريقة تفكير، وبناء، بناء نسجه المثقف بالدرجة الأساس، لدينا مثقفون عنصريون وطائفيون، قد يزعل البعض من هذا الكلام، هل لدينا ثقافة اسمها ثقافة سومر؟ يأتي شخص يقول لك أنا سومري، أنا أفضل من في العراق، وحقيقة هذه ثقافة كريهة وعنصرية، ثقافتنا مناطقية وطائفية، بعضهم يريد أن يصنع دولة، وهذه الثقافة صنعها المثقف، كان المجتمع يتعرض للقمع، فتتحدث عن الوطنية والقومية وتضيع هويتك الصغيرة، لذلك تقاوم وتريد أن تعود لها، أبسط مثال، حين تجد أحداً من البصرة يقول لك “احنا أهل الشعر” هذه الجملة هل صنعها المواطن الطبيعي أم المثقف والشاعر هو من قالها؟ المواطن لا علاقة له، تأتي له بقصيدة من الهند جيدة فيحبها. يُقال لك أيضاً: “غير الناصرية موسكو الصغرى” فهي منبع الشيوعية، لنفترض أنها منبع الشيوعية هل ينبغي أن ندفع ثمن ذلك؟ ونلغي كل المدن الأخرى لأنها ليست مناضلة ونعتبرها متخلفة؟ هذه الثقافة هل أنتجها الشارع؟ لا. في الحقيقة هي من نتاج الشيوعيين، نحن نصدر للمواطن ثقافة “أنت أفضل شيء في العراق ما دمت من هذا المكان أو ذاك” فصار المواطن “يتعنصر” لمدينته ولشارعه، ويكتب الشاعر تبعاً لهذه الثقافة قصائده الحماسية، وصار هناك تقديس للمكان، وأنت كفنان يمكن اعتبارك طبيباً إنسانياً “لازم تفصخ المجتمع” تريد أن تنتج عملاً عن البصرة مثلاً وانتشار المخدرات فيها، وكيف أصبحت البصرة بسبب موقعها الجغرافي معبراً للمخدرات، تتعالى الأصوات بسبب هذه الثقافة “شنو قصدك اهل البصرة مدمنين؟”. في كل مكان في العالم هناك إنسان جيد وآخر سيئ، وهذا لا تحدده منطقة أو لباس أو ثقافة معينة، الشخص نفسه مرة يكون جيداً ومرة سيئاً، وتحركه الظروف، فمرة يكون داعية ومرة قاتلا، وهذا عمل الدراما، الدراما خارج حدود الخير والشر، ليس هناك مطلق، فكيف يمكن أن تتحرك الدراما والمجتمع يريد منك أن تكون “أبيض أو أسود” يجب أن أقول إن كل مدن العراق جيدة، كل مهن العراق بيضاء، كل شيء في العراق أبيض، وسط هذا الكم من المحاذير نعمل!
وصلنا مرحلة في ولاية بطيخ، لم يمر أسبوع دون مشكلة، قبل فترة كنت أتفحص الموسم الرابع وأتذكر، هذه الحلقة صارت لدينا مشكلة مع وزارة التربية، في هذا الحلقة صارت لدينا مشكلة مع فلان جهة، في هذه الحلقة مع هذه المحافظة، مع العشيرة كذا، مشكلتان حدثت لنا مع فصيل مسلح، مرة انتقدنا عمل وزارة تابعة له، ومرة أحد الممثلين قال اسماً مركباً في سياق جملة اعتيادية حيث قال “انت مو فلان الفلاني” وبالصدفة طلع هناك قيادي بهذا الفصيل بالاسم نفسه، المصريون مثلاً يكتبون هذه الأسماء، ويضعون فيها ميزة كي تكون كوميدية، والاسم الذي قلناه وقتها فيه هذه الميزة “طلع اسم حركي بهذا الفصيل ونكلبت الدنيا علينا”.
قبل أيام مرينا من مرور الكرادة ورأيت قطعة لشخص متوفٍ، اسمه مميز، عجبني الاسم، في سري قلت هذا اسم درامي، لكن لو تقوله الآن ربما تتعرض لمشكلة؟



من الممكن جداً أن ناخذه، لو مثلاً تحدثنا في مشهد عن النزاهة ونقول مثلاً: حسن نزاهة، وممكن يكون شخص حقيقةً بهذا الاسم، وهذا بالضبط الذي حدث لنا، فهذا الأمر يؤثر على الفن كله؛ وليس على الكوميديا فقط.
- هل يؤثر الصراع السياسي على صناعة الفن؟ هل الانحيازات والانقسامات تؤثر في التلقي؟
- لا يمكن الهرب من السياسة، هي من تتحكم بنا، فالصراع السياسي ينزل للشارع وللجمهور، الجمهور مقسم ومتصارع مثل صراع كرة القدم، لو تحدثنا عن برشلونة والريال، أنت ستدافع عن بيب غوارديولا لأنه سبق وأن درب برشلونة، الآن لو كنت تشجع الريال من الضروري أن لا تحب الستي لأن مدربه من برشلونة، وهذا بالضبط الذي يحصل، وهذا ما نعاني منه في الفن، الصراع السياسي ينسحب إلى كل قطاعات الحياة، حتى حين تقدم عملاً، تبدأ الانقسامات، لمن هذه القناة؟ لمن تابعة؟ لأي تيار هذا تابع؟ وهكذا، لكن الفنان حين يقدم عملاً لا يعود لأحد.
- هل لديك عمل أو حلم متوقف بسبب هذا الصراع؟
- أحلامي الفنية كلها ممنوعة الآن، حلم حياتي هو أن أقدم فيلماً سينمائياً، لدي السيناريو لكن مستحيل تقديمه، سيسبب مشكلة كبيرة.
- كيف تلقيت شخصياً حدث تشرين؟ كيف عشت تلك اللحظات؟
- لم تكن لدي معلومة عن التظاهرة، دائماً هناك جو يدفع الجمهور والشارع، الصيف عادة والكهرباء، أو بعد قانون معين أو غيرها، وقت تشرين كان غريباً، لا يوجد فيها سبب من الأسباب التقليدية، الطقس في شهر تشرين جيد، لماذا نخرج تظاهرة؟
لم يكن لدينا علم بتشرين، حتى حين نُشر عن التظاهر سألت الزملاء في العمل، الجميع أخبرني إنهم لا يعرفون شيئاً، قلنا ستكون مثل حال أي تظاهرة، اكتفينا بدور المراقب، ما استفزنا حقيقة هو طريقة تعامل القوات الأمنية مع الناس، لم يكن منطقي على الإطلاق، “اكو شيء غريب جان يصير” بدأت اللقطات تنتشر، رجل عجوز يدفع بطريقة لا إنسانية، شبان محاصرون، استفزتني تلك الطريقة، خرجت مع اثنين أو ربما ثلاثة من كادر ولاية بطيخ، لم نستطع الوصول للساحة، دخلنا من جسر السنك، وهناك فيديو شهير كنا نركض وهم خلفنا وكأننا قتلة، سابقاً حين تأتي للتظاهرة وتفعل شيئاً استفزازياً أو فعلاً كبيراً يجبر مكافحة الشغب أو الناس على صدّك، لكن هذه المرة لم نكن قد عملنا شيئاً، مجرد أننا واقفون في ساحة الخلاني، أدخلونا للسوق، كنت اسمع صوت الرصاص الحي، اسمع أصوات الرصاص وهي تخترق الحديد والأجساد، كنت في داخلي أقول: “ليش هيج مصعدين الموضوع” التفينا على شارع الرشيد من جهة النقابة ومنتدى المسرح، كنت أشاهد القمع، صُدّت المظاهرة بشكل عنيف، وهنا بدأت رغبة الجمهور تكبر، وأحرجت الدولة، توقفت التظاهرة فترة، ثم عادت بقوة بعد الزيارة، بدأت تشرين بشكلها الرسمي، وكنا من أول يوم حاضرين فيها، لما شاهدناه من قمع سابقاً.



أول أيامها كانت عرسا، عيدا لا ينتهي، تشبه “أجواء المولد” التي تقدم بالسينما المصرية، تجد هنا أناسا تتحدث، هناك من يقرأ الشعر، هنا دخانيات، عوائل ونساء وكانت هذه أجمل فترات تشرين، حين ترى الرجال كيف يدافعون عن النساء، كنا نشعر أننا عائلة واحدة وكبيرة، نساء يطبخن، نساء كبيرات في السن، كنت أشعر أننا قد صحونا أخيراً، كل ما كنا نفكر فيه سابقاً كان خاطئاً، هذه لحظة الوعي والحقيقة، بدأت الشعارات الوطنية والرغبة الحقيقية في التغيير، لكن بعد ذلك بدأ عدد الشهداء يزداد، مات شبان صاروا رموزاً في ما بعد، مثل صفاء السراي، لا أريد أن أعد أسماء لكي لا يفوتني أحد منهم، كنا نرى الحكومة وهي تتخبط، بدأت الاعتقالات التي تحدث في محيط الساحة، إضافة للاحتكاكات والضرب، ساعة هدوء وساعة يعود القمع، كان هذا الوقت المناسب للتغيير -للأسف لاحقاً لم يحدث تغيير- بعد ذلك بدأت السلطة نفسها تخترق الساحة وتؤدلجها لصالح جهات في الوقت نفسه كانت تشارك في القمع. تغلغلت بعض الجهات في الساحة ونجحت في إفشالها لاحقاً، ومع الأسف لم نحصل على النتيجة التي كنا نريدها.
- من ضمن تحديات صناعة الفن هو ما تعرض له كادر ولاية بطيخ من تهديدات، خصوصاً في أيام تشرين، هل الفنان يسهم في صناعة الثورة؟ كيف ترى تشرين وما هو موقف ولاية بطيخ منها؟
- لدي وجهة نظر قد لا يرغب في سماعها “التشرينيون” وهي غير مبنية على النتائج فقط، أنا أعتقد أن تشرين في الأساس مراحل، المرحلة الأولى هي حين خرج الجمهور من العوائل والشباب، ونحن خرجنا في هذه الفترة، بعدها بدأت تتغير تشرين، لم نكن نشعر بالتغيير الذي كان يحصل، في المرحلة الثانية بدأت تتأسس تحت تشرين خطوط وتنظيمات وخيم، كنا نعتقد أن هناك قضية لكن بعضهم للأسف كان يبيع قضيته، مع ذلك في ولاية بطيخ لدينا حرية تعبير مطلقة، فالموقف تجاه تشرين لم يكن موحداً، هناك من خرج ليوم وهناك من خرج لمدة شهر، وهناك من “عزل تشرين على ايده” ذلك بعد مقتل صفاء السراي كنت أحاول تحذيرهم من الدخانيات والرصاص، لم يكن أحد يسمع، غير مصرح لي أن أتحدث نيابة عن مواقف الأفراد، لكن كلا كان له موقفه.
- هل ستؤثر حملة الاعتقالات والأوامر القضائية التي صدرت بحق صناع المحتوى على صناعة الفن؟ هل سيفكر الصانع والمنتج الفني كثيراً خشية إدراج عمله ضمن المحتوى الهابط؟
- حسب فهمي أن العمل الجاري هو وفقاً لقانون صادر في 1969 وهذا له علاقة بالمطبوعات والمواد الإباحية، لا علاقة له بالمحتوى وصناع المحتوى، وهذا شيء حديث ويفترض أن يشرّع له قانون خاص، فالقاضي يفترض أن يصدر أمراً وفقاً للقانون، والقانون المعتمد قديم، لا أشترط مثلاً تشريع قانون، ما أقصده هو أنك إذا أردتَ تطبيق هكذا أحكام فلا بدّ أن تشرّع القانون أولاً، وهذا القانون يجب أن لا يتعارض مع الدستور “الي كاتبه انت” وحريات التعبير المكفولة به، ويتناسب مع العصر، وما جرى لا يتلاءم مع الدستور ولا مع العصر، هذا أولاً، النقطة الأخرى نحن كصناع محتوى نظهر على القنوات ولدينا جهة رقابية وهي هيئة الإعلام والاتصالات، وهي تعمل وتراقب منذ سنوات وكل ذلك في علم الجمهور، وتصدر دورية فيها تقرير كامل عن القنوات التي تبث شيئا مخالفا، وهناك تحذيرات وحتى إيقاف من قبل الهيئة، وهي التي أوقفت مسلسل الكاسر فهي الرقيب، لا أتحدث هنا عن حرية التعبير، ما اقصده كعلي فاضل هو أن لدي جهة تحاسبني وتراقبني، فهذا القانون وهذه الاعتقالات لا تشملني، ولا تشمل ممن يعملون في التلفزيون عموماً، لكن الذي جرى لا أعرف إلى أين سيستمر، ويُفترض أن تكون هيئة الإعلام أول المعترضين على هذا القانون، وتقول للدولة “انتم وين رايحين”، فهذا ليس دور الداخلية ولا الشرطة ولا الجيش، وهنا أتحدث عن الصلاحيات، أنا كهيئة دوري مراقبة المسموع والمرئي والمطبوع، لكن لو تسأل عن رأيي الشخصي، أنا مؤمن أنه لا يمكن منع أي شخص من أن يعبر -من حسابه الخاص- عما يريده، حتى لو كانت فكرة خاطئة ومسيئة، من وجهة نظري، لأنني لا أستطيع قياس مدى خطورة الفكرة التي تُقال، لو تسألني، أنا أعتقد أن السموم التي تُبث من خلال السياسيين في مواقعهم وحواراتهم المتلفزة أخطر بكثير من شخص بسيط “يذب روحه بالطين”.
- هذه إشارة مهمة، الخطاب والتحريض الطائفي مخاطره أكبر، كيف ترى تعامل المجتمع مع المحتوى الهابط؟ وهل يمكن تجنبه كما يتصور المؤيدون للحملة؟
- احترق الشارع العراقي مراراً نتيجة لقاء متلفز، يشعلون الحرائق في التلفاز، فتنعكس النتائج على الشارع، فمن الأخطر؟ المؤسف في الحملة أن الجمهور دعم الداخلية “عفية شيلوهم احبسوهم” لكن وجهة نظري، الجمهور يجب أن يحمي الضحايا، ولا يحرّض عليهم، يقول إنه خائف على ابنه من المحتوى الهابط، هذا غير منطقي، فالمحتوى الهابط ليس هو من يتكفل بتربية المجتمع، المجتمع لا يربيه صناع المحتوى، هذه كذبة صُدّرت للجمهور والجمهور تبناها. لا أياد راضي ولا علي فاضل ولا أحمد البشير يُعلمون، الأب هو من يعلم والأسرة والأخ والمدرسة، حين تجد ابنك يتابع محتوى هابطاً امنعه، أحظر ذلك المحتوى الذي تعتقده مسيئاً من هاتفه، ثم عملية منع هذا المحتوى ليست حلاً، فحين تمنع هذه البرامج والمواد كيف تمنع ابنك من مشاهدة مسلسل “ايليت” مثلاً؟ مراهقون في الثانوية حياتهم فيها كل الموبقات، كيف تمنعه مثلاً؟ تذهب لإسبانيا وتمنع تصدير العمل؟ تقول لهم هذا محتوى هابط! أم تذهب لإيطاليا أو ألمانيا وتحدد لهم هذا مباح وهذا متاح وهذا لا؟! لا يمكن حذف الأشياء التي لا تناسبك من الانترنت، طالما هناك شبكة فهناك احتمالية الدخول لأي شيء.



الاجراء السليم هو الاستمرار بعملية بناء ابنك، وأن لا تتعب من العملية التربوية، راقب هاتف ابنك، افرض عليه نوعاً من السلطة والرقابة، والمشكلة إذا كان الأب لا يعرف أنواع الرقابة المخصصة لكل عمر، ولا يعرف التسلسل الزمني لهذه الرقابة، (..) الرقابة مسؤولية الأسرة، فلماذا نحمل صناع المحتوى المسؤولية؟ وهذا أيضاً يشمل الداخلية والقضاء وهيئة الإعلام والاتصالات، الهابط العراقي يمكن إيقافه؛ لكن كيف تمنع الهابط السوري والمصري، علينا أن نسأل السؤال الأكثر أهمية، لماذا انتشر هذا المحتوى؟ تدني الذوق ليس مسؤولية صناع محتوى بسيط، هل يمكن سؤال صانع المحتوى لماذا يقود المجتمع؟ حتى نعرف، إذا كان صنّاع المحتوى يقودون وعي المجتمع فالمشكلة بعلي فاضل!
الكارثة ليست في “سعلوسة”، الكارثة بالخوف منه، ثم أنت كمواطن، جمهور هذا المحتوى، لماذا لا تلوم نفسك في البدء؟ قبل أن تثور وتؤيد الداخلية “ثور على نفسك”.
- ترى الذوق العام وغيرها أيضاً قضية خلافية، ما يبدو أخلاقياً لك، قد يكون لا أخلاقياً بالنسبة لغيرك، كيف نجتاز هذا الإشكال؟
- حقيقة هناك معانٍ فضفاضة، الأخلاق والتربية والذوق وكل ما يشملهم، لا حدود واضحة فيها، وتختلف من مجتمع لآخر، في أمريكا مثلاً فقط “لا تُخرج الأعضاء التناسلية الخاصة بك” وهذا اعتقد قانونياً، مثلاً لو هناك بنت تتحدث عبر النت وتصنع محتوى، ربما أنت تعتبرها فاضحة وأنا لا اعتبرها كذلك، ما تعتبره هابطاً ليس بالضرورة اعتبره كذلك، لو شخص رمى بنفسه في الطين ما علاقتي بذلك؟ هذه حريته الشخصية، بعض الملحدين يقولون إننا كنا معممين، هل يمكن اعتبار هذه إساءة للدين، بمجرد أن تغيرت قناعاتهم؟
- التفكير بالمسرح مستمر ودائماً هناك ما يثبت ذلك.. إلى ماذا تهدف؟ التقرب للجمهور أم الخروج من الشاشة؟
- تجربة المسرح في ولاية بطيخ ليست جديدة، توقفنا في المرة الأولى بعد توفر ظروف النجاح، وقالب المسرح نستخدمه حين نشعر أن “الاسكيج” صار مملاً، الوفرة والاستمرارية تصنعان الملل، بالإضافة لعملية الاستسهال، الآن عبر كاميرا هاتف يمكن صناعة مشهد، لكن المسرح فن معقد، وغير متاح للجميع، لذلك نريد عمل شيء خاص بنا، كنت أقول لصديقي إن مشكلة نصرت البدر سهل الألحان لدرجة أن كل الشباب ممن عملوا معه صاروا ملحنين، وصار عليه أن ينافسهم، مثلاً لو عملت مثل طالب القرغولي سيكون من الصعب تقليدك، المسرح هو لحن طالب، دخول وتحولات ومقامات، لذلك المسرح يتطلب منا تحضيراً آخر، وطريقة كتابة أخرى، وبناء مختلف، في فترة ما شعرت أن الفريق فقد الشغف، وصار هناك فتور في الموسم السادس والسابع، لذلك وضعت لهم تحدياً أكبر، وبالفعل؛ من اليوم الأول عاد جو التحدي.
ما هي أبرز التحديات التي يمكن أن تجعلك توقف هذا العمل أو ذاك؟ متى تنتهي صلاحية العمل الدرامي أو التلفزيوني؟
- مجموعة من العوامل تجتمع، أولها الجدوى الاقتصادية هل نستمر في الإنتاج أم نوقف هذا العمل، وهذه نقطة بديهية في العمل، العامل الآخر هو حين أشعر أننا لم نعد نقدم الشيء الجديد، هنا لابد أن ينتهي العمل، النقطة الأخرى حين أشعر أن الفريق لم يعد لديه الشغف الكافي، وأيضاً هذه تحددها مراحل العمل، قد ينتهي العمل في فترة الورق، أو قد نحصل على الفكرة الإبداعية في الكتابة لكننا نفقد الشغف في التنفيذ، ولاية بطيخ من المفترض أن نوقفه، لكنه برنامج لديه خصوصية، رغم شعورنا منذ فترة أن ولاية بطيخ يجب أن يتوقف، لذا نحن في نقاش مستمر من أجل تغيير الممثلين الأساسيين ممن مضى على التحاقهم في البرنامج مدة طويلة، واستبدالهم بشباب جدد صغار، وصناعة مساحة لهم داخل الولاية، على اعتبار أن ولاية بطيخ مختبر ممتاز لصقل المواهب واختبارهم، وأنت أيضا تختبر شخصيتك وماذا تستطيع فعله، وإلى أي حد أنت قادر على تطوير نفسك، برنامج مستمر وأسبوعي هو مختبر، لذلك اعتقد أن ولاية بطيخ مقبل على مرحلة جديدة، ربما هذا الموسم أو الموسم الذي سيليه، سيكون هناك كادر جديد بالكامل يعمل على البرنامج.



ما رأيك بحوار جمار؟
- خرجت بالفترة الأخيرة بالكثير من الحوارات خصوصاً في فترة رمضان، وتحدثت عما أنجزناه، لكن في حوار جمار تحدثنا عن كل شيء.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
دخل المكتبة قبل المدرسة، “يلعب في كل المراكز” في كرة القدم والفن، هو الطفل الذي لم يحتفل بعيد ميلاده بسبب القصف الأمريكي على العراق عام 1991.
مهووسٌ بالقرطاسية؛ لأنه حُرِم منها في سنوات الحصار؛ الحصار الذي دخله ذلك المراهق بقميص، وخرج بالقميص نفسه؛ بعد أن غيّرت لونه الشمس. كتب الشعر مبكراً، ومبكراً أيضاً أدرك أنه شاعر سيئ.
تشكّلت شخصيته في الملعب، وسط صخب الجمهور، وكان شاهداً على سقوط السور على الجماهير. “نُفي” في مرحلةٍ مبكرة إلى كلية الفنون، “لاجئاً” كما يقول، يمرُّ بسيارته وسط العنف والقتل الطائفي، كان يشاهد فحسب؛ فهو شاهد على الأطراف المتنازعة وهي تقتل بعضها. انزوى أخيراً إلى الفن؛ بوصفه حياة بديلة.
تبدأ حياته الآن مع ورشة الكتابة، وتنتهي بها، قد يتخللها مشاهدة فيلم أو ربما لقاء هنا أو هناك.
يعرف أنّ الفن يهدم الحياة الاجتماعية، مع ذلك يمضي في الاتجاه هذا، هو الأب الذي يعامل مساعده الأول كطفل، ولا يفرّق في العمل بين الأب والأخ، يعرف أن ثَمّةَ فرقاً بين المدير والفنان؛ لكنه يؤمن أن كل ما يفعله هو من أجل المخرج الذي يريده في النهاية، المخرج علي فاضل، هكذا يريد أن يتذكره الناس.
يخشى على حرية التعبير في البلاد، وتعرض وفريقه للكثير من المشكلات الاجتماعية، ومع كل هذا فهو يحلم أن يعيش في بيت قديم بالقاهرة، أو في مزرعة على أطراف بغداد.
من أجل حوار مع علي فاضل، وقضاء بعض الوقت معه، في دردشة مفتوحة عن الحياة والفن، ذهبنا إلى موقع عمل “فريق ولاية بطيخ” لنلتقي هناك معه، علي فاضل، المخرج والممثل.
- الطفولة، المدينة الأولى، التشكّل الأول، ما هي الصور المتبقية من ذلك الطفل؟ ماذا يُحب؟ كيف يلعب؟ ماذا يفضل؟ بماذا تميّز؟
- أجمل ما في طفولتي المكتبة، كانت والدتي أمينة لمكتبة الأعظمية، ومثل أيّ أُمّ تأخذ طفلها لموقع العمل، المكتبة تلك مصدر ثقافتي الأول، أقسام المكتبة متعددة: تاريخ، أدب، فن، علوم، بدأت بالشعر، قرأت هناك: نزار قباني وبدر شاكر السياب وغيرهما.
ورغم أن بعض الكتب كانت ممنوعة لأسباب سياسية، لكن هناك، في قسم الفن، تعرفت على المسرح والسينما والتلفزيون، المكتبة غنيّة بالمصادر، غالبية قراءات تلك الطفولة أدبية وتاريخية، حققت استفادة من تلك القراءة، في الإعدادية مثلاً كُلّفت بشرح الخلافة الأموية والعباسية للطلاب، من الجانب الآخر كطفل في المنزل، ألعب كثيراً في السيارات، مهووس بشكل ما، ألعب في السيارة ثم أكسرها محاولاً فهم كيفية صنعها، كيف تدور العجلات وكيف تتكون الماكنة؟ وعند الخروج إلى الشارع، فليس هناك غير كرة القدم التي شكّلت حياتي. والدي حينها لم يكن يفضل اللعب في الشارع، كنت أضع الشارع الذي يأتي منه والدي أمامي وألعب، ما أن تدخل سيارته أول الفرع، أركض للبيت، وبينما يركن السيارة؛ أكون قد رتّبت كل شيء.

يسألني: “معقولة ذول يلعبون طوبة وانت مجنت وياهم؟”
أرد: “آني! لا ما ألعب! انت ما تقبل”.
- الطفل خلاق، والفنان كذلك، اللعب واللهو والمرح، إلى أيِّ حد تشبه ألعاب الطفولة لعبة الفن؟ هل الفنان طفل إلى الأبد؟
- أعتقد أنني لاعب جيد في كرة القدم، ألعب في كل المراكز، كما في الفن الآن، “وين ما يعوّزون يخلوني” الفنان والشاعر وأي مبدع، متى ما يموت داخله الطفل يموت إبداعه، الفرق بين الوظيفة والإبداع هو الطفولة، الطفل مبدع وخلاق، الطفولة هي عبور للحدود الشخصية والنمطية التي تتشكل في الوظيفة، الطفل يجرّب والفنان كذلك، الكثير من تجارب الطفولة أشعر أنني ما زلت أكررها، في الحصار نلعب بكرة سيئة من البلاستك فيها زوائد تخدش الأقدام، مع ذلك أحاول رميها بطريقة مستديرة مقلداً البرازيلي روبرتو كارلوس في هدفه الشهير ضد فرنسا، كانت تلك الضربة “موديل” واللاعب الجيد بيننا هو من يجرب، واللاعب غير الجيد هو من يفعل ما اعتاد على فعله الجميع، وهو بذلك لا يتطور، هو لا يجرّب الاستلام أو التسليم بطريقة جديدة، أمّا اللاعب المكتشف هو من فعل أشياء جديدة، غسان إسماعيل في أيام الكلية غضب مني وصرخ “يا أخي لا تجرّب.. العب سهل”، قلت له حينها، “السهل فعلناه كثيراً” التجريب مفتاح الإبداع سواء في كرة القدم أو في الفن.
- كيف كانت مشاعر وذكريات الصبي علي فاضل عن عام 1991 والقصف والأصوات والطائرات الأمريكية؟ أين عشت أيام الحرب؟
- القصف الأمريكي على العراق حدث في 17 كانون الثاني، فجراً، وكان ذلك اليوم هو عيد ميلادي أيضاً، كنت طفلاً مدللاً، تفكر العائلة منذ أيام كيف وأين تقيم حفل عيد ميلادي، لم نستطع الاحتفال، أوقفته القنابل، ثم دخلنا في الحصار، والفرق أنني كطفل لم أشعر بالحرب، حتى حرب إيران لم أشعر بها؛ فهي تجري في مكان بعيد على الحدود وخارج المدن، قبل القصف الأمريكي لم أكن أعرف ماذا يعني “صاروخ يضرب بناية وتُهدم”.
مربو ذلك الوقت من أعمام وجيران، وحتى معلمين، يحرصون على وضعنا خارج حديث الكبار، لم نكن نسمع الأحاديث التي تدور، أنا طفل لم أشعر بالحرب، شعرت بالحصار لأنه مسَّني شخصياً، عندما بدأت حاجاتي وملابسي تتقلص.
- شاب في الحصار، كيف عشت مرحلة تبادل القمصان بين الشباب؟ ما الذي تبقّى من تلك الحقبة؟ ما هي ذكرياتك عن تلك الأيام المتخمة بالجوع؟
- في الحصار بدأت الأشياء تُفقد “شوية شوية”، قبلها لا أعرف وقت شراء الملابس، ألبس وأخرج فحسب، بعد أيام الحصار كنت أريد الذهاب إلى المدرسة “ما عندي ملابس” شعرت بالحصار لأننا ببساطة عشنا دلال الثمانينات، أتذكر حين ذهبنا لمعرض بغداد الدولي عام 1989 أو ربما 88، وذهبنا لمهرجان بابل، حيث جاءت فرقة إسبانية، وأخرى ألمانية، وفرقة برازيلية، في معبد مردوخ، عشنا في ترف واضح، في معرض بغداد أتذكر كشك “كيت كات” تأتي خصيصاً من سويسرا، نحن الآن ضحايا “النساتل” التي نأكلها، كلها سيئة ومصنوعة في البحر، حتى الآن أتذكر غلاف الــ”كيت كات” الورقي المقوّى أحمر اللون، وتحته غطاء من السوليفان الفضي، حتى الآن أتذكر رائحتها، وانتقلنا من مرحلة بغداد التي فيها مظاهر فنية ويأتي إليها كرم مطاوع ويحيى الفخراني لتصوير فيلم بابل حبيبتي، إلى مرحلة أنني لا أملك قميصاً، والقميص الذي عشت معه لفترة نوعه سيئ، يشبه الكارتون، وألوانه باهتة، قميص تشتريه في لون ثم سرعان ما يتغير لونه لأنّه يُغسل يومياً، يفترض أنّ لونه أحمر؛ لكنه في الواقع نبيذي داكن، هذا غير توارث الملابس بيننا نحن الإخوة.
الحصار ليس فيه غني وآخر فقير، نحن من الطبقة المتوسطة وحتى لو حصلنا على بعض الأموال فلا يمكن صرفها بسهولة، خوفاً من اليوم الأسود الذي يشبه بداية ضربة الــ91، القلق والخوف تسرب إلى الأهل، خوف من المستقبل، في نهاية التسعينيات حصل تحسّن بسيط، بدأت تدخل بضائع بمستوى مقبول، لكن من عام 1991 وحتى 1998 “ما اشتريت حاجة مال اوادم” البضائع تلك لا تستحق الأموال التي ندفعها، وصلنا إلى مرحلةٍ يجب أن تشتري الكثير من الحاجات لتحصل على كيس البلاستك! حتى الكيس كان يباع، لذلك دائماً ما أقول إننا جيل يشعر بقيمة الأشياء لأننا عشنا زمن فقدانها.


أنا أُحبُّ السكريات جداً، حين دخلت “نستلة شيرين عسل” غيرت حياتي، استهلكتها بطريقة جنونية، ربما كنتُ أتناول 10 قطع في بعض الأيام، بالإضافة إلى هوسي في القرطاسية، الآن اشتري الكثير من القرطاسية، لديّ عقدة من القرطاسية التي استخدمناها في الابتدائية والمتوسطة.
في الثاني متوسط أتذكر كيف كان الدفتر عبارة عن نشارة خشب، النشارة واضحة وحين تكتب تتكسر الكلمات على سطح الدفتر المتموج، فمن كان يشتري دفتراً أبيض؟ حين يحصل أحدهم على دفتر “أبو الـ200 ورقة الأبيض” نقول ابن من هذا؟ حتى الآن لديّ رغبة بشراء ذلك الدفتر، الآن أشتري أجمل القرطاسية بدون لذة، انهيت المرحلة المتوسطة كلها بحقيبة واحدة، هذه آثار الحصار النفسية والاجتماعية.
- ظهور ملامح الاتجاهات الفنية لدى الطفل، الفنان الصغير، هل هناك مشاهد من ذلك؟ هل ظهرت الرغبة في التمثيل والعمل بالفن مبكراً؟
- في الثالث متوسط أدركت أنني شاعر سيئ، دائماً ما أرغب بالتميز في المجال الذي أدخله، وحين تأكدتُ أنني لا يمكن أن أصبح مثل أدونيس ومحمود درويش أو نزار قباني، تركت الشعر، نزار جعلني أحب الشعر.
بالنسبة للفن لا يمكن لأحد من جيلنا أن يدّعي أن لديه طموحاً فنياً غير الغناء، من يقول ذلك يكذب، لكنني انجذبت للمسرح، لم يكن لدي حلم سينمائي، أحببت المسرح بسبب محسن العلي، دخلت “بيت وخمس بيبان” في الثمانينات، كان الدخول إلى مسرح المنصور يشبه الحلم، المسرح جديد “هستوّة مطلعينة من الجيس” تشعر برقي المكان وهيبته ابتداءً من رائحة الكافتيريا، وصولاً للمقاعد الفاخرة التي لم تتبدل حتى الآن، مقاعد من جلد مميز فيها ملمس معين، من الصعب أن تقتنيها في بيتك، وهذا كان الفرق، عظمة المسرح أن كل شيء هناك غير موجود في الحياة العامة، الآن مثلاً حين تذهب لفيغاس أو الرياض، تجد أن الإضاءة التي هناك والألوان والتفاصيل غير موجودة في البيت والمدينة والأسواق، من هنا يبدأ الترفيه، يبدأ من الحدائق الخضراء، تكتشف أنك في مكان جديد كلياً، تدخل ساحة الاحتفالات والجندي المجهول والتفاصيل المهيبة تلك، تدخل فتصلك رائحة القهوة والنسكافيه والشاي، وهذه كلها بجودة ومذاق مختلف تماماً عمّا تحصل عليه في المنزل والأماكن العامة الأخرى، من هنا يبدأ الإبهار، من هذه التفاصيل.
- تحدثت عن محسن العلي وبيت وخمس بيبان، ما الذي أعجبك في تلك التجربة؟ وكيف أثّرت فيك وانعكست على عملك لاحقاً؟ وما هو مصير أبطالها في فترة الحصار؟
- من حيث الإدارة أنا متأثر بمحسن العلي، بدأت أبحث عنه حين أصبحت فناناً، أفكر كيف كان يرى التفاصيل في بيت وخمس بيبان، كان الأستاذ محسن العلي لديه فكرة، لاحقاً فهمتها حين كبرت، كان حين ينتهي العرض يُجبر الممثلين على البقاء في الكواليس، ينتظر إلى حين خروج الجمهور كله، ثم يُخرِج الممثلين بسيارة خاصة من الباب الخلفي، كان يقول لهم “انتم لازم ما تنشافون” الجمهور الذي يجلس في المقاعد الأخيرة يرى الممثلين عن بعد، سيأتي ثاني مرة للعمل وعنده طموح أن يتقدم مقعدين، وهكذا وصولاً إلى الصف الأول، لذلك أنا صُدمت حين شاهدت مكي عوّاد أيام الحصار في أحد الأحياء الصناعية ببغداد، كان الدهن قد غطّى ملابسه، مكي عواد الذي كنت أشاهده مثل إله إغريقي! أشاهده مثل فينوس بالضبط، مرسوم كما الإله وبشكل فخم، كنت طفلاً وأشاهدهم من الأسفل، كان خليل إبراهيم ضخماً جداً، حتى اعتقدت أن أحجامهم مختلفة عنّا، حين ترى فينوس “مكي عواد” في الشيخ عمر يُصلّح سيارته ويُعامل “الفيتر” -هذا حقه طبعاً- الأمر كارثي.
الحصار “خربط الطبقات”، هناك طبقات ثراؤها معنويٌ وليس مادياً، المعلم تشعر أنه أغنى رجل في العالم، قد يكون حاله بسيطاً، في الحصار أصبحنا نرى معلمينا في أسوأ الصور والظروف، هذه عشتها في المتوسطة، مع أحد الأساتذة، كان صارماً وشديداً، وكان يستعرض قوته وهيمنته على الطلاب كمعلم محترم وقوي الشخصية، تقع غرفته في ممر شعبتي، يخرج، فيرى الطلاب مذعورين وهم يركضون إلى أماكنهم قبله، الفرصة بين الدرس والآخر قليلة، خمس دقائق ربما، وهو لا يتوانى في معاقبة أي طالب يتأخر ولو لثانية، كنا نترك الماء ونركض حين نعرف أن هذا وقت حصته “اركضوا عدنا أستاذ فلان” بعد عام من هذه القوة والشخصية وجدته وديعاً في منزل صديق، يعطيه دروساً خصوصية، قال لي، “ها بابا علاوي شلونك” كان منكسراً، لماذا كان يدرّس خصوصي؟ لأنّه محتاج.


هذه المرة الأولى التي تحدثتُ فيها عن الحصار، الحصار لم يكن همّاً شخصياً، هو همُّ العراقيين، وللأمانة أقول، كعائلة كنا أفضل من الكثيرين، أعرف الكثير من الناس ممن فقدوا كرامتهم في الحصار، أدرك معنى جرح الكرامة، وأنا نجم قبل سنوات قليلة مسّ كرامتي شخص متسلط وأقوى مني، عذرت وقتها كل شخص هاجر أو عارض النظام، سواء السابق أو الحالي، أعذر كل من تمرض وأصبح حقيراً لأن مسّ الكرامة له تأثير كبير، ولا يمكن أن يُدرك بسهولة.
- هل فكرت في صناعة الفن في ذلك الوقت؟ كيف كانت تصوراتك عن الفن والعمل الفني؟ كيف كانت حياتك في التسعينيات؟ بماذا كنت تفكر؟
- في تلك الفترة أهم شيء في حياتي كرة القدم، الملعب كوّن شخصيتي، صدفة يقع بيتنا بالقرب من ملعب الشعب، ليس بيننا إلا جسر مشاة، كان الملعب رافداً مهما في تكوني الثقافي، ليس أنا فحسب، غالبية العراقيين، ثقافتهم ثقافة ملعب، والملعب يعني “هيه.. هيه.. هذا الحكم ناقص” وهذه الثقافة بالضبط تحصل الآن في الميديا، الفرق هو أن الملعب كان يسع 30 ألف شخص، الآن في الميديا حوالي 20 أو 25 مليون، الاندفاع الذي نشاهده في الميديا والسب والشتم والتخوين والتناقض كلها عشتها في الملعب أيضاً، على شكل تعليقات تطلق في الهواء، لغة التحليل وادعاء المعرفة نفسها، “ليش نزل فلان.. فلان أحسن.. التشكيلة بيها غلط” تخيّل أن الناس التي تقود العراق الآن من قادة مليشيات وفصائل غالبيتهم ثقافتهم ثقافة ملعب، يقاد العراق بهذه الثقافة، لو أردنا محاكمة جيل على الوضع الحالي علينا أن نحاكم مواليد 1972 وحتى مواليد 79، فهذا الجيل كان بعنفوان شبابه وتربى في الحصار وتربى في الملعب، وهذا ما ندفع ثمنه الآن، مع ذلك الرياضة أثّرت في شخصيتي كثيراً، جعلتني أكثر جرأة، حسب ما أتذكر مرة، سقط علينا جدار الملعب، ربما حدث ذلك عام 1997 أو 98، مات تحت الجدار قرابة 20 شخصاً، لكن النظام كان لا ينقل هكذا أخبار، الملعب كان ممتلئاً، وثمة بناء لجدار جديد، لم يتماسك بعد، سقط على رؤوسنا!
* كيف عشت لحظة 2003، المشاهد الأولى، دخول الدبابات الأمريكية، هروب الناس من بغداد؟
- كنا خارج بغداد حينها، لم نرغب بالخروج وقتها، لكن ضغط الجيران والأقارب جعلنا نغادر يومي 8 نيسان، و9 نيسان.
بمشاعر متضاربة عشت اللحظة، عمري وقتها 21 عاماً، فرح لأنني شعرت بمستقبل جديد قد بدأ، وهنا يجب أن أعترف لولا ذلك التغيير لم أكن الآن علي فاضل ولدي شركة واسم، وفي الوقت نفسه تسرّب لدي خوف من نوع ما، فنحن كما هو حال العائلات العراقية لدي في عائلتي جنود وضباط ومنتسبون وأعضاء في حزب البعث، كنت أخشى مقتلهم، مع ذلك استبشرت خيراً، لدي صديق شيوعي كبير في السن، كان يأخذني في الأيام الأولى للحرب، نأخذ جولة على صور صدام وتماثيله، كان يشير بيديه ويقول، “هاي كلها كوابيس راح تروح ونعيش حياة حلوة” صدفة هذا الصديق سكن في منطقة سيطر عليها فصيل مسلح يعاقب على الخمر، في يوم ما فتّش هذا الفصيل صندوق سيارته ووجد “شرب” أهانوه وضربوه بسبب ذلك، بعدها صادفته فقال لي، “كنت مخطئاً، كل ما أفكر به لم يحدث”. قلت له، في كلا الحالتين أنت تنظر للنظامين من الزاوية نفسها، والحقيقة أن في كل نظام ثمة إيجابيات -على قلتها- وسلبيات وكوارث.
بالمجل الوقت تغيّر، لو تنظر إلى الشلة التي كانت تحكم، من حسني مبارك إلى زين العابدين بن علي، ترى أنهم متفقون على قمع الشعوب، كان هذا النوع من الأنظمة موديل، مع ذلك كانت هناك إيجابيات حتى هذا النظام يقر بها، كانت هناك مؤسسات، لكن هذه الإيجابية لم نكن نشعر بها لأن حريتنا مسلوبة، حريتك هي جوهر حياتك، لذلك نحن نقول إن الحرية أهم مكسب حصلنا عليه من هذه العملية برمتها.
- هل هو تغيير أم احتلال؟
- أمريكا أسقطت النظام بالقوة، التعريف العلمي لهذه العملية هو “احتلال” لكنه بشكل ما تغيير، المشكلة أن التغيير فيه نتائج إيجابية وأخرى سلبية، بعد أن قلنا للاحتلال شكراً، وخرج، ما هي النتائج؟ هل الاحتلال بالقطعات عسكرية فقط؟ العراق الآن محتل دون دبابة أو طائرة، ربما الاحتلال الصريح أفضل من هذا الشكل، البلد الآن محتل، وأي طرف إقليمي أو دولي تطالبه بالتوقف عن التدخل بالعراق، يقول لك أنا هنا لمساعدتك عسكرياً وتجارياً، أليس هذا احتلال أيضاً؟
- رافقت السنوات الأولى لتغيير النظام موجات عنف لا مثيل لها، هل أثر ذلك العنف على طموحك، كيف أسهم العنف ذلك في نتاجك لاحقاً؟ كيف عشت أيام العنف تلك؟
- في عام 2001 دخلت كلية الفنون الجميلة، تعرفت على أصدقاء، وأصبحنا جماعة أو “عصابة” عشنا كما لو أننا خارج العراق، صار لدينا “لجوء” في كلية الفنون، كنت أشعر أنني “لاجئ” لا مواطن، أشعر أنني جالية في العراق، حيث كانت مجموعتنا خارج السياق، لا نتحدث في الطائفية ولا علاقة لنا بالسلاح، ليس لدينا هدف لإقصاء الآخر، بيننا محبة قائمة على مشتركات إنسانية وفنية بحتة، نمر بالعنف ولا نشارك به.
كنت الوحيد من بينهم الذي يمتلك سيارة في سنوات 2004 و2005 و2006، الصديق الأول سهم غضبان منزله في حي الجامعة، وغسان إسماعيل في شقق صدام، ومخلد راسم في السيدية، ومرتضى في منطقة التراث، كل هذه المناطق كانت مشتعلة، قتل وذبح ونحن نمرُّ في أوقات متأخرة، ونجلس في مقهى حميد في حي الجامعة، نذهب للكسرة إذا كان لدينا تمرين أو تصوير أو قراءة أو حفظ، بعدها أوصلهم كل واحد إلى منزله، وسط العنف.
- وسط الاقتتال الطائفي والعنف هل ثمة مواقف شخصية أثرت بك مباشرة؟ وكيف غير ذلك الموت وجهة نظرك؟ كيف عشت الحرب الطائفية؟
- لم يسبق أن تحدثت في الإعلام عمّا حصل لي في ذلك الوقت، أنا “بالطائفية انهزيت هزتين” الأولى كانت نتيجة لمقتل شخص مقرب مني جداً، وهو من الطائفة الشيعية، قُتل في منطقة سُنّية بطريقة بشعة جداً، لمدة خمسة أيام، لم يهدأ دماغي، أقول في سري، “هناك مشكلة في هذه الطائفة السُنية” كنت بعمر خطر، 23 عاماً، مقابل ذلك كنت يوماً ما صدفة في منطقة زيّونة، نزلت عجلات وأغلقت شارع الربيعي، وأمامي أُحرق جامع شارع الربيعي، فصارت لديّ صدمة مقابِلة، الجهة التي حرقته “شيعية” لدي تصور أن الجامع أو أي مكان ديني وفيه منارة وقبة هو بيت الله، وقفت أُشاهد، كان الدخان يتصاعد من الجامع بينما قتل كل من فيه، هنا اهتزّت علاقتي بالطوائف كلها، لا يمكن بعد هذه المشاهد أن تقول هذه الطائفة جيدة وتلك سيئة، الموضوع تحول إلى جنون، الذي يسيطر على هذه الجهة وتلك وصلا إلى منطقة اللاعودة، هنا اتخذتُ قراراً وهو أن اتحدث عن أي شيء في الدنيا عدا الدين.
لا يمكن انكار الانحياز الطائفي، وهناك نُكات متبادلة، تصدر من الطرفين، لكن أن يصل الأمر حدَّ القتل، فهذا جنون.
- ما هو روتينك اليومي، ما الذي لا تستطيع أن تستغني عنه؟ ما الذي تعمله يومياً؟
- يومياتي يحكمها العمل والنظام الغذائي “الكيتو”. لدي توقيتات دقيقة في الأكل، عادة أنام في الشركة، لا أعود للبيت إلا بعد انتهاء العمل تماماً، لكن أغلب أيام السنة أنا في الشركة، أنام في الساعة الثالثة أو الرابعة فجراً، بعد إنجاز أعمالي المقررة لهذا اليوم، وأصحو في 11 صباحاً، وإذا كان لدي عمل مكثف أو موعد صباحي في الساعة الثامنة أو التاسعة يبدأ يومي، في الحقيقة أكره النوم، لدي عقدة منه، أشعر أن النوم هو تضييع للوقت، مرةً قرأت أن الإنسان يضيع ثلث عمره في النوم، من وقتها كرهته، وأشعر أن مهمتي تقليل هذا الثلث، أول شيء أفعله بعد الصحو، اختيار ملابس اليوم، لأنني سألتقي بالعديد من الناس، ولدي مواعيد معينة تحتاج أن أظهر بالشكل المناسب، مع ذلك هناك ملابس تناسب الأصدقاء والمقربين، وأخرى لمواعيد العمل الرسمية، لست صديقاً للقهوة لأنني “بزر الكعدة” المدلل الذي يحب الحلويات، فالقهوة عدوي، لكن نظامي الغذائي فرضها عليَّ، فأنا أفضل الشاي أكثر.
لا أبدأ يومي في الأكل والشرب، مباشرة أبدأ العمل مع الملتزمين، لأن الورشة فيها من هم ملتزمون جداً، وهؤلاء يأتون مبكراً، وغير الملتزمين ممن يتأخرون، نتحدث عن البارحة وماذا فكرنا، لحين الساعة 12:30، موعد الوجبة الأولى، بعدها نباشر بالكتابة في هذه الغرفة.
تأخذ الورشة يومياً من 7 الى 8 ساعات، أثناء الورشة أدير الشركة، والأمر مهلك في بعض الأحيان، تحدث أشياء تؤثر على مزاج الكتابة، في الساعة السابعة مساءً، آخر وجبة أكل لي، عادة أطلبها من المطعم، رغم أنني أحب أكل البيت، لكن طبيعة عملي تجعل الأمر مستحيلاً، أعاود الصيام المتقطع، وغير مسموح لي إلا بأشياء معينة، القهوة والشاي من دون سكر، وصودا ماء غازي فقط.
- هل هذه الورشة طوال السنة؟ وكيف تجمع بين المدير والفنان؟
- عمل الورشة طوال السنة، دائماً هنالك عمل جديد، إضافة إلى “ولاية بطيخ” طوال فترة عرضه، قبل رمضان نكتب عمل رمضان، وهكذا.
العمل مع الإدارة يحتاج إلى أعصاب، أثناء الكتابة يطلب منك عمل إداري، فتخرج من طور الفنان الذي يكتب إلى دور المدير، كان الأمر صعباً في البداية؛ لكن مع السنوات بدأتُ الاعتياد عليه.
- ماذا تقرأ؟ أي كتب تفضل، أي كاتب؟ ماذا تشاهد؟
- حتى عام 2014 كنت اقرأ بغزارة، حين دخلت التلفاز انقطعت، عدت للقراءة في 2020. شعرت أن المحتوى الثقافي لدي بدأ ينفد، أغلب قراءاتي في تخصصي.
- لو خيرت بين مجموعة كتب ماذا تفضل؟
- لو ابتعدنا عن وظيفتي علي كمخرج، أذهب لكتب تنفع في العمل أيضاً، مثلاً: علم الاجتماع، وعلم النفس. هذه الاختصاصات قريبة جداً من عملنا، اقرأ دراسات وبحوثاً قريبة عن العمل الذي أكتبه، مثلاً، حين أكتب عمل عن الأسرة، اقرأ دراسات عن الأسرة، رحلتي كقارئ بدأت بالروايات، بمرور الوقت صرت لا أفضلها، شعرت في وقت ما أنها غير مفيدة، فانهمكت في كتب الفن وعلم الجمال والعلوم المقاربة والمسرح، قرأت كثيراً في المسرح، لكنني الآن تدربت، وصرت أفضل الروايات والسيرة الذاتية.
- ماذا قرأت سابقاً؟ وما هي فائدة القراءة بسن مبكرة؟
- قرأت غالبية أعمال نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس، في الأدب الكلاسيكي قرأت الكثير في عمر مبكر، في فترة ما كنت مهتماً بجبران خليل جبران والشعر الجاهلي أيضاً، قرأت هذه النتاجات وأشعر أنني لم اقرأها بشكل جيد، بسبب عمري والوعي الذي كنت أملكه وقتها، أجبرت على إعادة قراءة بعض الأعمال، منها عمل لنجيب محفوظ “تحت المظلة” لم أكن وقتها أعرف قيمتها حتى عدت إليها ثانية، وعرفت أنها تختلف عن أغلب نتاجه الأدبي.
- هل تفضل كُتّاباً معيّنين؟ وماذا تحب في الأدب الشعبي؟
- لنقسم الاختصاصات، في الشعر كنت أحب درويش ثم تمردت عليه، كل شعراء المهجر أحبهم، وحفظت من شعرهم حتى، بالسرد غابرييل غارسيا ماركيز وأيضاً أحببت أدب الشباب ممن تخرجوا عبر الورشة التي كان يقيمها. أفضّل أدب أمريكا الجنوبية بالعموم، مع ذلك يجب ألا أكذب، أنا أنتمي للمخرجين وكتاب السيناريو، أشعر أن الكتاب والأدباء من غير جناح، في الشعر الشعبي كذلك أفضل صلاح جاهين، أحب أحمد فؤاد نجم، يستهويني الأدب الشعبي المصري، رغم أن شعرنا الشعبي أفضل، في الأدب الشعبي العراقي أفضل النَّواب.
- هل لدينا اهتمام بالأدب الشعبي؟ خصوصاً وأن ثقافتنا الشعبية كبيرة ومتنوعة، وهل تم توظيفها بشكل جيد في الفن؟
- هذا له علاقة بشكل المجتمع، وللأسف مجتمعنا لا يعتز بهويته، وأعتقد أن جزءاً من الانقسام الاجتماعي سببه الهويات الشعبية، أنا أحترم المجتمع الموصلي، فيه مسيحيون ومسلمون ويتحدثون المصلاوية، لأن بيئة الموصل أكبر من الدين، أنا مثلاً أعتز بهويتي الجنوبية وأحترمها أيضاً، أصولنا من هناك، وأريد أن اعتز بهذه الثقافة، لكن ما يحدث أن هذا الاعتزاز حين يكرّس في الفن قد يدخل ضمن عمليات الاستفزاز، هذا على مستوى الدراما، لا بد للعمل أن يمثل كل العراق، في الفيلم العملية ممكنة، لأن صناعة الفيلم قائمة على التفاصيل، في التلفاز نحن نحتاج الثقافة الأعم والأشمل، وتعبر عن الجميع.
- علاقتك بالأكل، ماذا تفضل، ماذا تحب، كيف توظف فهمك للطعام في الحياة؟ وما هي علاقة الطعام بالفن بالنسبة لك شخصياً؟
- الطعام هو من ينظم حياتنا، تبدأ الحياة مع وجبة الإفطار، أهم لحظات حياتي كانت بالتسعينات عند الساعة الخامسة عصراً، كان وقتها تلفزيون العراق بعد نهاية كل رمضان يذهب لاتحاد الإذاعات المصري ويشتري كل الأعمال التي قدمت، وصار لدينا تراكم من الأعمال الخالدة، كان النظام الشمولي يحدد وقت النوم والأكل، في الساعة 12 ليلاً الكل ينام، في وقت الظهيرة كذلك، في الخامسة عصراً نصحو، وتجمعنا الوالدة على واحدة من روائع الدراما العربية، سكرية، ليالي الحلمية، أبو العلا البشري، الراية البيضاء، وغيرها من الأعمال.
العوائل كانت تنام الظهر وتصحو في هذا الوقت، تفرجنا تلك الأعمال مع شاي وكعك العصر يسميه العراقيون “عصرونية” فأجمل لحظات حياتي مرتبطة بالأكل، الأم مهما كانت واعية ومثقفة تبقى مسؤوليتها معك وظيفية، يجب أن تصنع لك أكلا جيدا وتنظفك وغيرها، لذلك دائماً أقول لابني: العائلة نعمة كبيرة، والجلوس مع العائلة فرصة عظيمة، لذلك يرتبط عندي الأكل بالدراما والعائلة، شاهدنا سكرية جزئين، وبين القصرين، وربما شاهدت هذه الأعمال لاحقاً لكن المتعة تذهب بي لتذكرني بتلك الأيام، بالشاي وتفاصيل الأكل، عمري حوالي 11 أو 12 سنة، أشاهد المسلسل: هذه شخصية أبي وهذا أخي الأكبر. كانت هذه الأعمال الخالدة مصنوعة بدقة للعوائل، كتبها غالباً أسامة أنور عكاشة، لذلك هي مرتبطة عندي بالأكل.
* الزوج والابن والأب والأخ… هل ورطت العائلة بالفن؟ كيف تؤثر طبيعة عملك على حياتك الشخصية؟
- منذ أول دخولي للفن وأنا أفكر بكاظم الساهر، مثلي الأعلى في الفن والحياة كاظم، أحب أغانيه، كنت ساهرياً ولدي عضوية، وكانت سابقاً هناك كروبات، كنت أفكر كيف يهدم عائلته من أجل الفن، الفن يحتاج إلى سفر وتنقل مستمر، كاظم لم يكن يستقر، كل شهر في بلد، حفلة في لندن وأخرى في بيروت، حين دخلت الفن وعرفت هذه الالتزامات، وأن الحفلة تعني تحضيرات وبروفا وتجمع قبل مدة، وقبل أن ينتهي هذا الالتزام يبدأ التزام آخر، مع النجاح والعمل عرفت أن الفن يهدم الحياة الاجتماعية.
- يتطرف بعض الفنانين تجاه عدم دخول أبنائهم لعالم الفن، ومتى يسمح الفنان بذلك، كأب وفنان كيف ترى الفنان مخلد علي فاضل؟
- دخول مخلد للفن يشبه بقية حياته، فلم أفرض عليه أي شيء، كنت أتمنى أن يدخل “فلان مدرسة” ولم يدخلها، الآن يريد الدخول لكلية معينة أيضاً، لا أفرض عليه، اتدخل في تفاصيل معينة، منعته من الدخول لمعهد الفنون الجميلة، قلت له: “انت هسه بملعبي”، تريد أن تصبح فناناً؟ لا تدخل معهد لعدة أسباب: المعهد حالياً ليس بأفضل حالاته، والمعهد خمس سنوات، بعدها حين ترغب في إكمال الكلية سوف تكتشف أنك فقط خسرت الوقت، نصحته بالإعدادية، ثلاث سنوات فحسب، وتذهب للكلية مباشرة، ولو كان المعهد سيفيده لا شك لن أقف في طريقه، هذا ليس انتقاصاً من المعهد الذي خرّج أساطير الفن العراقي.
ما أود قوله إن مخلد دخل للفن برغبة منه، قال أريد أن أدخل ورشة كتابة، قلت له اذهب واكتب، بعد ذلك قال: هناك مجموعة شبابية تعمل على فيلم قصير، أيضاً قلت له التحق بهم.
في داخلي لم أكن أرغب بسؤاله من هم، لا أود ممارسة السلطة الأبوية عليه، أهم شيء عندي يذهب لمكان معلوم ويعود في وقت معلوم، هذا دوري كأب، في يوم ما، دخلت في نقاش فني معه، كان يتحدث بلغة وطريقة أكبر من عمره في الفن، كنت أود القول له إنني انظر لك كما لو أن عمرك 7 سنوات وليس 17 سنة، قال لي بعد ذلك أريد أن أكون مساعد مخرج متدرب معك، قلت له تعال، لكن إذا لم تكن بالمستوى ستكون هذه أول وآخر تجربة لي معك.
دخلنا أجواء العمل، كنا نتناقش طوال الوقت، أعطاني وجهات نظر غيرت مشاهد كاملة، أنا وقت العمل لا أعرف هذا ابني أو ذاك أخي، لحظة العمل عندي الأهم، من يعطيني وجهة نظر مفيدة للعمل، لا يهم، مساعد مخرج أو مخرج أو متدرب، أي شخص في “السيت عنده حجايه مهمة تفيدني” وهكذا نزل معي كمساعد مخرج متدرب في أول عمل له.
- ماذا كنت تعمل قبل أن تحترف الفن؟ ما هي المهن التي عملت فيها؟
- عملت كثيراً في الصحافة الورقية، في جريدة الدستور والنافذة وبعض المجلات، عملت لفترة طويلة، كتبت عموداً رياضياً، عملت مع الوالد في السوق الخاص بالأدوات الاحتياطية في ساحة الخلاني، عملت في معمل تصنيع الأدوات الاحتياطية، في ما يسمى بالسوق “دجة مال كير واذن محرك”، كانت إنتاج عراقي، بيتنا كان معملاً، هذا وقت الحصار، عملت أيضاً في أكشاك الاتصالات قبل 2003 في ساحة النصر والطيران والمشجر، عملت في تصريف العملة بعد 2003، كانت ساحة الفردوس أول سنوات سقوط النظام قد تحوّلت إلى سوق عملة، كانت مكاتب حديدية صغيرة يجلس عليها محولو العملة، كنت أنا من يبحث عن الزبائن المحتملين ويجلبهم لمصرفي العملة، كان لدي زبائن خاصون، حصلت في تلك الفترة على أموال جيدة، عقلي التجاري جيد.
- ماذا تفضل أن تعمل فيما لو قررت ترك العمل في الفن؟
- سأعمل في التجارة، ربما في بيع وشراء العقارات. أحب هذه المهنة جداً، أحب البناء، تبدأ بأرض ثم تصبح مكاناً للسكن، وأحب لاحقاً أن أعيش في شقة أو فيلا قديمة بالزمالك في القاهرة، أو أبني بيتنا في أطراف بغداد في الدورة أو البعيثة، اشتري دونماً، أبني جزءاً منه، والباقي أحوله لحديقة، هذا حلم حياتي، إما هنا أو هناك.
- الأصدقاء، البيئة المحيطة بك، إلى أي حد ترى أنه من الضرورة عيش الحياة مقابل التفكير بالفن؟
- النجاح والعمل والفني ينهي حياتك الاجتماعية، أنا خسرت أصدقاء عمري بسبب الفن، حالياً لا أصدقاء لدي.
- ما مدى علاقتك بالسينما وكيف تؤثر عليك؟
- علاقتي مع السينما عظيمة، أعتبرها مصدر ثقافتي الأساسي، لقد شاهدت الكثير وقرأت كثيراً عن السينما، لدي أفلام غير متوفرة حتى عبر النت، لا أفضل سينما هوليود ولا السينما التجارية، أقدرها لكن لا أحبها، ليس لدي حتى من تفضيلاتي ممثل أمريكي، ربما توم هانكس وشون بن من مئات النجوم، أحب السينما الإيطالية والإسبانية والإيرانية.
- هل يمكن أن نعرف تفضيلاتك الشخصية؟ ما هو TOP TEN الخاص بك؟ وما هي الأفلام التي شاهدتها أكثر من مرة؟
- سيكون هناك ظلمٌ كبير؛ مع ذلك سأبدأ بالمخرجين: جيوزبي تورنتوري، أصغر فرهادي، أمير كوستريكا، جامبير جانيت، جاكو فمبرمان، مجيد مجيدي، عباس كيارستمي، رغم أنني لا أنتمي إلى السينما التي ينتجها. في أمريكا أحب كوينتن تارانتينو واينا ريتو، أيضاً أحب مخرج فيلم وول ستريت، سكورسيزي، وتيم برتون مخرج السمكة الكبيرة.
عادةً، الفيلم الجيد، الذي يناسبني أعيده أكثر من مرة، فيلم المرأة المجهولة للمخرج تورنتوري ربما أكثر فيلم شاهدته في حياتي، لو أردنا توب تين للأفلام، فكل أفلامه، لكن سأختار المرأة المجهولة، إضافة إلى 1900 ومالينا، وصانع سينما باراديسو، وحتى أعد عشرة أفلام، سأختار عمل المخرج جاكو فان دورميل في عملين، مستر نو بدي، واليوم الثامن، فهذا الفيلم غير حياتي، قبل هذا الفيلم كل أصحاب متلازمة داون كنت أخشاهم، لا اقترب منهم، بعد هذا الفيلم صرت أقترب منهم، وأكون قريباً منهم.
نروح على ألمودوفار واختر منه All About My Mother، رغم أن لديه الكثير من الأعمال الجميلة، أصغر فرهادي أختار منه انفصال وفيلم الضائع، مجيد مجيدي أطفال الجنة، سأختار فيلم معتقدات وهو فيلم أرجنتيني يفترض أن يحبه كل عراقي، لأن ثقافة الاختفاء في العراق واضحة، وتتحدث قصة هذا الفيلم عن شخص لديه القدرة على معرفة أين تختفي الناس، ذلك في السبعينيات في حكم الجنرالات، فأصبح مرجعاً، يمس يد الإنسان وإن اختفى ممكن أن يبحث عنه، فيلم عظيم، في عام 2003 طبعت ووزعت وأهديت هذا الفيلم لكثير من الناس، فكما نعرف؛ العراقيون يختفون منذ الستينيات. في الأفلام البرازيلية أحب فيلم اسمه “مدينة الله”.
- ما هي الظروف الحالية لولاية بطيخ؟ وكيف تؤثر الظروف العامة على البرنامج؟
- ولاية بطيخ قصة، نحن نمر بظروف معقدة، هناك فكرة حول بثه على الميديا، وهناك قناة أبدت رغبتها به، لكني أرغب في الذهاب به إلى الميديا، لكي أبثّه بالطريقة التي تناسبني، فحين أذهب للقناة قد يؤثر عليها.
- لماذا الكوميديا تحديداً؟ من اختار ذلك؟ الظرف الاجتماعي أو الضرورة التاريخية؟
- كي لا أكذب، الكوميديا لم تكن مشروعي، كخريج فنون واقرأ عن الضحك والكوميديا بشكل علمي، لم تكن تعجبني الكوميديا العراقية، بالأخص تلك التي ظهرت بعد 2003، كنت اعتبرها كوميديا سطحية ليس فيها ما هو جديد، كنت متذوقاً للكوميديا العربية والعالمية، كنت أسأل لماذا لا نعمل مثلهم؟ عراقياً كنت أسأل لماذا تؤخذ الكوميديا هذه المنطقة، هل الكوميديا مجرد تايتل جميل والمضمون لا يرى؟
الصدفة وحدها جعلت مدير قناة الشرقية يقول لي: “انت تخربني ضحك من تحجي، ليش ما تشتغل كوميديا” أفهم الفن أنه رسالة، ويحتاج معاناة وصبراً، طرح اسمي كمقدم، بدأت الناس تتفاعل، رغم أن قسماً منهم يشعرون أن دمك ثقيل، في النهاية أكبر كوميديان بالعالم ممكن لبعض الناس أن تستثقله، هذا يبقى حسب ذوق الجمهور، بدأت اتعلم لعبة التلفزيون، الموضوع تحول: أريد فعل شيء، أريد تحدياً، والتحدي هو أن أغير نمط الكوميديا، وهذا تطلب قراراً جريئاً، أن أستقيل من الشرقية. كررتها كثيراً، لم اكتب استقالة وقتها، قدمت بوستر فيلم “هلا لوين” للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، قلت لمديري: هلا لوين، أي بمعنى “احنا وين رايحين، يعني خلص احنا باقين بالنص” كان وقتها العيش في أربيل بالنسبة لي هو توقف في منتصف الطريق، لست في دولة أوروبية ولدي جنسية، ولست في مكاني لكي أرتب حياتي، أربيل كانت بالنسبة لي فندقاً وليس مكاناً للعيش، فدخلت التحدي الذي بدأ يكبر يوماً بعد يوم، وصولاً إلى نجاحنا في الكوميديا، لكن هذا لم يكن الرهان الأساس، لذلك حين نجحت في الكوميديا عدت إلى حلمي القديم، أن أصنع دراما وسينما، والآن أعمل على ذلك، وقدمت أعمالاً بهذا المجال.



- هل ثمة علي فاضل قبل ولاية بطيخ وعلي فاضل آخر بعد ولاية بطيخ؟
- طبعاً، قبل ولاية بطيخ كان علي فاضل غير واضح ويجامل ويخاف ويستحي ويداهن، الآن أنا شخص واضح وضوحا تاما. الخجل يجعلك تخسر نقاطاً كثيرة، وهذا ما جعل الكثير من الناس تعتقد أنها ضحايا علي فاضل، وأنهم تضرروا بسببي، أنا أعذرهم ولم أعتب عليهم لأنني لم اتعامل معهم بالوضوح الكافي، من الأفضل أن تقول للآخرين كل شيء بوضوح، شكراً في أمان الله، هذا يجنبك الكثير من المشاكل، لكن حين تراعي مشاعر الآخرين، وتجامل في المحصلة سوف يعتقد الآخر أنك كنت تكذب، لم أكن بهذا الدرجة من الوضوح.
- هل السكيتج قديم؟ هل هو امتداد؟ ومتى بدأت في العمل على هذا النوع من الفن؟ من أهم المميزين في هذا الفن؟
- أول ما بدأت بمشروع الكوميديا بدأت بمشروع السكيتج، كان مشروعي في طور التحضير في 2012 وعُرض عام 2013، وظهر مشروع آخر بالتزامن معنا، أعتقد في عام 2014، لم أكن مبتكر هذا الشكل، فاستراحة الظهيرة خير دليل، لكن في هذا الزمن لم يكن هناك عمل بهذا الشكل، وأعتقد أن السكيتج ظهر عبرنا في 2014، لذلك هو امتداد، أنا تربيت على كاريكاتير واستراحة الظهيرة، ومن عشاق محمد حسين عبد الرحيم، في “الخيط والعصفور” و”أيام الإجازة” والاسكيتجات التي قدمها أعتبره عبقريا، مثلما لدينا لاعبون مميزون وفي الرسم والشعر، نقول عنهم “فلتات” فمحمد حسين عبدالرحيم وراسم الجميلي وسليم البصري، هناك تقريباً 4 أو 5 أسماء اعتبرها فلتة، سليم البصري عبقري، راسم عبقري، لدينا عديد من الممثلين الجيدين، لكن هؤلاء عباقرة، في “تحت موس الحلاق” هناك سكيتج حين يحاسبهم المدرس، راسم الجميلي “قدم أداءً لليوم نجوم الكوميديا ميكدرون يسووه”.
- من فريق طموح إلى نخبة من النجوم.. رحلة ولاية بطيخ محفوفة بالمخاطر، كيف كانت البداية؟ عملت في الولاية: مخرجاً، وممثلاً، وكاتباً، ومديراً.
- لم يبدأ ولاية بطيخ كمشروع لصناعة النجم، لم أتحدث سابقاً بهذه الطريقة، “احنا جايين نحب نوع من الكوميديا”، لم نكن نريد المنافسة ولم نتوقع أننا سننافس، أنا أفضّل هذه الكوميديا وأرفض غيرها، لنقدم كوميديا بالطريقة التي نفضلها ولا نعرف هل سننجح أم لا، لم يكن هناك طموح، أنت تحب شيئا وهناك مكان تبنّى هذا الحب “فتعال قدم الي تحبه” الطموح يبدأ مع أول نجاح، ويبدأ سؤال: لم لا؟
لا أود الكذب، مشروعي ليس الكوميديا، وحتى وإن فشلت، وقتها سأقول أقلها أنا حاولت، أنا أحاول كعلي فاضل، حتى على مباريات سبق وإن صرتُ معلقاً رياضياً، مرة واحدة في قناة الشرقية في بطولة شباب آسيا، لم يكن هناك معلق، دخلت وعلقت، كنت أعلق بشكل جيد لذلك علّقت البطولة كلها، لكن هل كنت أراهن على نفسي كمعلق؟ بالتأكيد لا.
في الكوميديا الشيء نفسه، كنت أحب نمطاً من الكوميديا وجاءت فرصة، ولو لم ينجح هذا النمط لكنت انسحبت، وحين نجحنا بدأ طموحي في تكوين فريق يحبه الجمهور، خرجت من الشرقية، خرجنا معاً أنا وأحمد البشير وكان التحدي هو أن أثبت للشرقية أإني قادر على النجاح خارج القناة، أتذكر قالوا لي: “ارجع، لأنك حين تطلب لاحقاً العودة مراح نرجعك”، قلت لهم: لن أعود، فهذا كان تحدياً أن تجد نفسك خارج المؤسسة التي بنتك، الشرقية لها الفضل، هي التي أسست مسيرتي في التلفزيون، والإعلام كمهنة تعلمته في الشرقية، وحين تتمرد على المؤسسة وتخرج، لابد أن تنجح وتثبت أنك اتخذت القرار الصحيح.
- صناعة الكوميديا تحت محاذير اجتماعية وسياسية.. كيف أثّر ذلك على مواضيع ونصوص ولاية بطيخ؟ هل تعرّض الفريق لمشكلات بسبب موضوعات البرنامج؟ وكيف تؤثر الثقافات الفرعية في قمع فن؟
- هذه الأشياء كلها تؤثر، اتحدث مع الشباب أحياناً، أقول لهم مطلوب منا كوميديا ودراما مغايرة، الآن كل الدراما تقريباً بيئتها بغداد، أريد أن أصنع مثل “تحت الوصايا” عملاً بيئته مائية، لا بدّ من الذهاب الى البصرة فهناك ميناء وسفن، وحين تخرج مثلاً شخصية سلبية تنهال التهم، “ها قصدك أهل البصرة هيج” أريد صناعة عمل في بيئة جبلية “ها قصدك الكرد هيج” وهذه تنسحب على كل العراق.
هذا للأسف أصبح طريقة تفكير، وبناء، بناء نسجه المثقف بالدرجة الأساس، لدينا مثقفون عنصريون وطائفيون، قد يزعل البعض من هذا الكلام، هل لدينا ثقافة اسمها ثقافة سومر؟ يأتي شخص يقول لك أنا سومري، أنا أفضل من في العراق، وحقيقة هذه ثقافة كريهة وعنصرية، ثقافتنا مناطقية وطائفية، بعضهم يريد أن يصنع دولة، وهذه الثقافة صنعها المثقف، كان المجتمع يتعرض للقمع، فتتحدث عن الوطنية والقومية وتضيع هويتك الصغيرة، لذلك تقاوم وتريد أن تعود لها، أبسط مثال، حين تجد أحداً من البصرة يقول لك “احنا أهل الشعر” هذه الجملة هل صنعها المواطن الطبيعي أم المثقف والشاعر هو من قالها؟ المواطن لا علاقة له، تأتي له بقصيدة من الهند جيدة فيحبها. يُقال لك أيضاً: “غير الناصرية موسكو الصغرى” فهي منبع الشيوعية، لنفترض أنها منبع الشيوعية هل ينبغي أن ندفع ثمن ذلك؟ ونلغي كل المدن الأخرى لأنها ليست مناضلة ونعتبرها متخلفة؟ هذه الثقافة هل أنتجها الشارع؟ لا. في الحقيقة هي من نتاج الشيوعيين، نحن نصدر للمواطن ثقافة “أنت أفضل شيء في العراق ما دمت من هذا المكان أو ذاك” فصار المواطن “يتعنصر” لمدينته ولشارعه، ويكتب الشاعر تبعاً لهذه الثقافة قصائده الحماسية، وصار هناك تقديس للمكان، وأنت كفنان يمكن اعتبارك طبيباً إنسانياً “لازم تفصخ المجتمع” تريد أن تنتج عملاً عن البصرة مثلاً وانتشار المخدرات فيها، وكيف أصبحت البصرة بسبب موقعها الجغرافي معبراً للمخدرات، تتعالى الأصوات بسبب هذه الثقافة “شنو قصدك اهل البصرة مدمنين؟”. في كل مكان في العالم هناك إنسان جيد وآخر سيئ، وهذا لا تحدده منطقة أو لباس أو ثقافة معينة، الشخص نفسه مرة يكون جيداً ومرة سيئاً، وتحركه الظروف، فمرة يكون داعية ومرة قاتلا، وهذا عمل الدراما، الدراما خارج حدود الخير والشر، ليس هناك مطلق، فكيف يمكن أن تتحرك الدراما والمجتمع يريد منك أن تكون “أبيض أو أسود” يجب أن أقول إن كل مدن العراق جيدة، كل مهن العراق بيضاء، كل شيء في العراق أبيض، وسط هذا الكم من المحاذير نعمل!
وصلنا مرحلة في ولاية بطيخ، لم يمر أسبوع دون مشكلة، قبل فترة كنت أتفحص الموسم الرابع وأتذكر، هذه الحلقة صارت لدينا مشكلة مع وزارة التربية، في هذا الحلقة صارت لدينا مشكلة مع فلان جهة، في هذه الحلقة مع هذه المحافظة، مع العشيرة كذا، مشكلتان حدثت لنا مع فصيل مسلح، مرة انتقدنا عمل وزارة تابعة له، ومرة أحد الممثلين قال اسماً مركباً في سياق جملة اعتيادية حيث قال “انت مو فلان الفلاني” وبالصدفة طلع هناك قيادي بهذا الفصيل بالاسم نفسه، المصريون مثلاً يكتبون هذه الأسماء، ويضعون فيها ميزة كي تكون كوميدية، والاسم الذي قلناه وقتها فيه هذه الميزة “طلع اسم حركي بهذا الفصيل ونكلبت الدنيا علينا”.
قبل أيام مرينا من مرور الكرادة ورأيت قطعة لشخص متوفٍ، اسمه مميز، عجبني الاسم، في سري قلت هذا اسم درامي، لكن لو تقوله الآن ربما تتعرض لمشكلة؟



من الممكن جداً أن ناخذه، لو مثلاً تحدثنا في مشهد عن النزاهة ونقول مثلاً: حسن نزاهة، وممكن يكون شخص حقيقةً بهذا الاسم، وهذا بالضبط الذي حدث لنا، فهذا الأمر يؤثر على الفن كله؛ وليس على الكوميديا فقط.
- هل يؤثر الصراع السياسي على صناعة الفن؟ هل الانحيازات والانقسامات تؤثر في التلقي؟
- لا يمكن الهرب من السياسة، هي من تتحكم بنا، فالصراع السياسي ينزل للشارع وللجمهور، الجمهور مقسم ومتصارع مثل صراع كرة القدم، لو تحدثنا عن برشلونة والريال، أنت ستدافع عن بيب غوارديولا لأنه سبق وأن درب برشلونة، الآن لو كنت تشجع الريال من الضروري أن لا تحب الستي لأن مدربه من برشلونة، وهذا بالضبط الذي يحصل، وهذا ما نعاني منه في الفن، الصراع السياسي ينسحب إلى كل قطاعات الحياة، حتى حين تقدم عملاً، تبدأ الانقسامات، لمن هذه القناة؟ لمن تابعة؟ لأي تيار هذا تابع؟ وهكذا، لكن الفنان حين يقدم عملاً لا يعود لأحد.
- هل لديك عمل أو حلم متوقف بسبب هذا الصراع؟
- أحلامي الفنية كلها ممنوعة الآن، حلم حياتي هو أن أقدم فيلماً سينمائياً، لدي السيناريو لكن مستحيل تقديمه، سيسبب مشكلة كبيرة.
- كيف تلقيت شخصياً حدث تشرين؟ كيف عشت تلك اللحظات؟
- لم تكن لدي معلومة عن التظاهرة، دائماً هناك جو يدفع الجمهور والشارع، الصيف عادة والكهرباء، أو بعد قانون معين أو غيرها، وقت تشرين كان غريباً، لا يوجد فيها سبب من الأسباب التقليدية، الطقس في شهر تشرين جيد، لماذا نخرج تظاهرة؟
لم يكن لدينا علم بتشرين، حتى حين نُشر عن التظاهر سألت الزملاء في العمل، الجميع أخبرني إنهم لا يعرفون شيئاً، قلنا ستكون مثل حال أي تظاهرة، اكتفينا بدور المراقب، ما استفزنا حقيقة هو طريقة تعامل القوات الأمنية مع الناس، لم يكن منطقي على الإطلاق، “اكو شيء غريب جان يصير” بدأت اللقطات تنتشر، رجل عجوز يدفع بطريقة لا إنسانية، شبان محاصرون، استفزتني تلك الطريقة، خرجت مع اثنين أو ربما ثلاثة من كادر ولاية بطيخ، لم نستطع الوصول للساحة، دخلنا من جسر السنك، وهناك فيديو شهير كنا نركض وهم خلفنا وكأننا قتلة، سابقاً حين تأتي للتظاهرة وتفعل شيئاً استفزازياً أو فعلاً كبيراً يجبر مكافحة الشغب أو الناس على صدّك، لكن هذه المرة لم نكن قد عملنا شيئاً، مجرد أننا واقفون في ساحة الخلاني، أدخلونا للسوق، كنت اسمع صوت الرصاص الحي، اسمع أصوات الرصاص وهي تخترق الحديد والأجساد، كنت في داخلي أقول: “ليش هيج مصعدين الموضوع” التفينا على شارع الرشيد من جهة النقابة ومنتدى المسرح، كنت أشاهد القمع، صُدّت المظاهرة بشكل عنيف، وهنا بدأت رغبة الجمهور تكبر، وأحرجت الدولة، توقفت التظاهرة فترة، ثم عادت بقوة بعد الزيارة، بدأت تشرين بشكلها الرسمي، وكنا من أول يوم حاضرين فيها، لما شاهدناه من قمع سابقاً.



أول أيامها كانت عرسا، عيدا لا ينتهي، تشبه “أجواء المولد” التي تقدم بالسينما المصرية، تجد هنا أناسا تتحدث، هناك من يقرأ الشعر، هنا دخانيات، عوائل ونساء وكانت هذه أجمل فترات تشرين، حين ترى الرجال كيف يدافعون عن النساء، كنا نشعر أننا عائلة واحدة وكبيرة، نساء يطبخن، نساء كبيرات في السن، كنت أشعر أننا قد صحونا أخيراً، كل ما كنا نفكر فيه سابقاً كان خاطئاً، هذه لحظة الوعي والحقيقة، بدأت الشعارات الوطنية والرغبة الحقيقية في التغيير، لكن بعد ذلك بدأ عدد الشهداء يزداد، مات شبان صاروا رموزاً في ما بعد، مثل صفاء السراي، لا أريد أن أعد أسماء لكي لا يفوتني أحد منهم، كنا نرى الحكومة وهي تتخبط، بدأت الاعتقالات التي تحدث في محيط الساحة، إضافة للاحتكاكات والضرب، ساعة هدوء وساعة يعود القمع، كان هذا الوقت المناسب للتغيير -للأسف لاحقاً لم يحدث تغيير- بعد ذلك بدأت السلطة نفسها تخترق الساحة وتؤدلجها لصالح جهات في الوقت نفسه كانت تشارك في القمع. تغلغلت بعض الجهات في الساحة ونجحت في إفشالها لاحقاً، ومع الأسف لم نحصل على النتيجة التي كنا نريدها.
- من ضمن تحديات صناعة الفن هو ما تعرض له كادر ولاية بطيخ من تهديدات، خصوصاً في أيام تشرين، هل الفنان يسهم في صناعة الثورة؟ كيف ترى تشرين وما هو موقف ولاية بطيخ منها؟
- لدي وجهة نظر قد لا يرغب في سماعها “التشرينيون” وهي غير مبنية على النتائج فقط، أنا أعتقد أن تشرين في الأساس مراحل، المرحلة الأولى هي حين خرج الجمهور من العوائل والشباب، ونحن خرجنا في هذه الفترة، بعدها بدأت تتغير تشرين، لم نكن نشعر بالتغيير الذي كان يحصل، في المرحلة الثانية بدأت تتأسس تحت تشرين خطوط وتنظيمات وخيم، كنا نعتقد أن هناك قضية لكن بعضهم للأسف كان يبيع قضيته، مع ذلك في ولاية بطيخ لدينا حرية تعبير مطلقة، فالموقف تجاه تشرين لم يكن موحداً، هناك من خرج ليوم وهناك من خرج لمدة شهر، وهناك من “عزل تشرين على ايده” ذلك بعد مقتل صفاء السراي كنت أحاول تحذيرهم من الدخانيات والرصاص، لم يكن أحد يسمع، غير مصرح لي أن أتحدث نيابة عن مواقف الأفراد، لكن كلا كان له موقفه.
- هل ستؤثر حملة الاعتقالات والأوامر القضائية التي صدرت بحق صناع المحتوى على صناعة الفن؟ هل سيفكر الصانع والمنتج الفني كثيراً خشية إدراج عمله ضمن المحتوى الهابط؟
- حسب فهمي أن العمل الجاري هو وفقاً لقانون صادر في 1969 وهذا له علاقة بالمطبوعات والمواد الإباحية، لا علاقة له بالمحتوى وصناع المحتوى، وهذا شيء حديث ويفترض أن يشرّع له قانون خاص، فالقاضي يفترض أن يصدر أمراً وفقاً للقانون، والقانون المعتمد قديم، لا أشترط مثلاً تشريع قانون، ما أقصده هو أنك إذا أردتَ تطبيق هكذا أحكام فلا بدّ أن تشرّع القانون أولاً، وهذا القانون يجب أن لا يتعارض مع الدستور “الي كاتبه انت” وحريات التعبير المكفولة به، ويتناسب مع العصر، وما جرى لا يتلاءم مع الدستور ولا مع العصر، هذا أولاً، النقطة الأخرى نحن كصناع محتوى نظهر على القنوات ولدينا جهة رقابية وهي هيئة الإعلام والاتصالات، وهي تعمل وتراقب منذ سنوات وكل ذلك في علم الجمهور، وتصدر دورية فيها تقرير كامل عن القنوات التي تبث شيئا مخالفا، وهناك تحذيرات وحتى إيقاف من قبل الهيئة، وهي التي أوقفت مسلسل الكاسر فهي الرقيب، لا أتحدث هنا عن حرية التعبير، ما اقصده كعلي فاضل هو أن لدي جهة تحاسبني وتراقبني، فهذا القانون وهذه الاعتقالات لا تشملني، ولا تشمل ممن يعملون في التلفزيون عموماً، لكن الذي جرى لا أعرف إلى أين سيستمر، ويُفترض أن تكون هيئة الإعلام أول المعترضين على هذا القانون، وتقول للدولة “انتم وين رايحين”، فهذا ليس دور الداخلية ولا الشرطة ولا الجيش، وهنا أتحدث عن الصلاحيات، أنا كهيئة دوري مراقبة المسموع والمرئي والمطبوع، لكن لو تسأل عن رأيي الشخصي، أنا مؤمن أنه لا يمكن منع أي شخص من أن يعبر -من حسابه الخاص- عما يريده، حتى لو كانت فكرة خاطئة ومسيئة، من وجهة نظري، لأنني لا أستطيع قياس مدى خطورة الفكرة التي تُقال، لو تسألني، أنا أعتقد أن السموم التي تُبث من خلال السياسيين في مواقعهم وحواراتهم المتلفزة أخطر بكثير من شخص بسيط “يذب روحه بالطين”.
- هذه إشارة مهمة، الخطاب والتحريض الطائفي مخاطره أكبر، كيف ترى تعامل المجتمع مع المحتوى الهابط؟ وهل يمكن تجنبه كما يتصور المؤيدون للحملة؟
- احترق الشارع العراقي مراراً نتيجة لقاء متلفز، يشعلون الحرائق في التلفاز، فتنعكس النتائج على الشارع، فمن الأخطر؟ المؤسف في الحملة أن الجمهور دعم الداخلية “عفية شيلوهم احبسوهم” لكن وجهة نظري، الجمهور يجب أن يحمي الضحايا، ولا يحرّض عليهم، يقول إنه خائف على ابنه من المحتوى الهابط، هذا غير منطقي، فالمحتوى الهابط ليس هو من يتكفل بتربية المجتمع، المجتمع لا يربيه صناع المحتوى، هذه كذبة صُدّرت للجمهور والجمهور تبناها. لا أياد راضي ولا علي فاضل ولا أحمد البشير يُعلمون، الأب هو من يعلم والأسرة والأخ والمدرسة، حين تجد ابنك يتابع محتوى هابطاً امنعه، أحظر ذلك المحتوى الذي تعتقده مسيئاً من هاتفه، ثم عملية منع هذا المحتوى ليست حلاً، فحين تمنع هذه البرامج والمواد كيف تمنع ابنك من مشاهدة مسلسل “ايليت” مثلاً؟ مراهقون في الثانوية حياتهم فيها كل الموبقات، كيف تمنعه مثلاً؟ تذهب لإسبانيا وتمنع تصدير العمل؟ تقول لهم هذا محتوى هابط! أم تذهب لإيطاليا أو ألمانيا وتحدد لهم هذا مباح وهذا متاح وهذا لا؟! لا يمكن حذف الأشياء التي لا تناسبك من الانترنت، طالما هناك شبكة فهناك احتمالية الدخول لأي شيء.



الاجراء السليم هو الاستمرار بعملية بناء ابنك، وأن لا تتعب من العملية التربوية، راقب هاتف ابنك، افرض عليه نوعاً من السلطة والرقابة، والمشكلة إذا كان الأب لا يعرف أنواع الرقابة المخصصة لكل عمر، ولا يعرف التسلسل الزمني لهذه الرقابة، (..) الرقابة مسؤولية الأسرة، فلماذا نحمل صناع المحتوى المسؤولية؟ وهذا أيضاً يشمل الداخلية والقضاء وهيئة الإعلام والاتصالات، الهابط العراقي يمكن إيقافه؛ لكن كيف تمنع الهابط السوري والمصري، علينا أن نسأل السؤال الأكثر أهمية، لماذا انتشر هذا المحتوى؟ تدني الذوق ليس مسؤولية صناع محتوى بسيط، هل يمكن سؤال صانع المحتوى لماذا يقود المجتمع؟ حتى نعرف، إذا كان صنّاع المحتوى يقودون وعي المجتمع فالمشكلة بعلي فاضل!
الكارثة ليست في “سعلوسة”، الكارثة بالخوف منه، ثم أنت كمواطن، جمهور هذا المحتوى، لماذا لا تلوم نفسك في البدء؟ قبل أن تثور وتؤيد الداخلية “ثور على نفسك”.
- ترى الذوق العام وغيرها أيضاً قضية خلافية، ما يبدو أخلاقياً لك، قد يكون لا أخلاقياً بالنسبة لغيرك، كيف نجتاز هذا الإشكال؟
- حقيقة هناك معانٍ فضفاضة، الأخلاق والتربية والذوق وكل ما يشملهم، لا حدود واضحة فيها، وتختلف من مجتمع لآخر، في أمريكا مثلاً فقط “لا تُخرج الأعضاء التناسلية الخاصة بك” وهذا اعتقد قانونياً، مثلاً لو هناك بنت تتحدث عبر النت وتصنع محتوى، ربما أنت تعتبرها فاضحة وأنا لا اعتبرها كذلك، ما تعتبره هابطاً ليس بالضرورة اعتبره كذلك، لو شخص رمى بنفسه في الطين ما علاقتي بذلك؟ هذه حريته الشخصية، بعض الملحدين يقولون إننا كنا معممين، هل يمكن اعتبار هذه إساءة للدين، بمجرد أن تغيرت قناعاتهم؟
- التفكير بالمسرح مستمر ودائماً هناك ما يثبت ذلك.. إلى ماذا تهدف؟ التقرب للجمهور أم الخروج من الشاشة؟
- تجربة المسرح في ولاية بطيخ ليست جديدة، توقفنا في المرة الأولى بعد توفر ظروف النجاح، وقالب المسرح نستخدمه حين نشعر أن “الاسكيج” صار مملاً، الوفرة والاستمرارية تصنعان الملل، بالإضافة لعملية الاستسهال، الآن عبر كاميرا هاتف يمكن صناعة مشهد، لكن المسرح فن معقد، وغير متاح للجميع، لذلك نريد عمل شيء خاص بنا، كنت أقول لصديقي إن مشكلة نصرت البدر سهل الألحان لدرجة أن كل الشباب ممن عملوا معه صاروا ملحنين، وصار عليه أن ينافسهم، مثلاً لو عملت مثل طالب القرغولي سيكون من الصعب تقليدك، المسرح هو لحن طالب، دخول وتحولات ومقامات، لذلك المسرح يتطلب منا تحضيراً آخر، وطريقة كتابة أخرى، وبناء مختلف، في فترة ما شعرت أن الفريق فقد الشغف، وصار هناك فتور في الموسم السادس والسابع، لذلك وضعت لهم تحدياً أكبر، وبالفعل؛ من اليوم الأول عاد جو التحدي.
ما هي أبرز التحديات التي يمكن أن تجعلك توقف هذا العمل أو ذاك؟ متى تنتهي صلاحية العمل الدرامي أو التلفزيوني؟
- مجموعة من العوامل تجتمع، أولها الجدوى الاقتصادية هل نستمر في الإنتاج أم نوقف هذا العمل، وهذه نقطة بديهية في العمل، العامل الآخر هو حين أشعر أننا لم نعد نقدم الشيء الجديد، هنا لابد أن ينتهي العمل، النقطة الأخرى حين أشعر أن الفريق لم يعد لديه الشغف الكافي، وأيضاً هذه تحددها مراحل العمل، قد ينتهي العمل في فترة الورق، أو قد نحصل على الفكرة الإبداعية في الكتابة لكننا نفقد الشغف في التنفيذ، ولاية بطيخ من المفترض أن نوقفه، لكنه برنامج لديه خصوصية، رغم شعورنا منذ فترة أن ولاية بطيخ يجب أن يتوقف، لذا نحن في نقاش مستمر من أجل تغيير الممثلين الأساسيين ممن مضى على التحاقهم في البرنامج مدة طويلة، واستبدالهم بشباب جدد صغار، وصناعة مساحة لهم داخل الولاية، على اعتبار أن ولاية بطيخ مختبر ممتاز لصقل المواهب واختبارهم، وأنت أيضا تختبر شخصيتك وماذا تستطيع فعله، وإلى أي حد أنت قادر على تطوير نفسك، برنامج مستمر وأسبوعي هو مختبر، لذلك اعتقد أن ولاية بطيخ مقبل على مرحلة جديدة، ربما هذا الموسم أو الموسم الذي سيليه، سيكون هناك كادر جديد بالكامل يعمل على البرنامج.



ما رأيك بحوار جمار؟
- خرجت بالفترة الأخيرة بالكثير من الحوارات خصوصاً في فترة رمضان، وتحدثت عما أنجزناه، لكن في حوار جمار تحدثنا عن كل شيء.