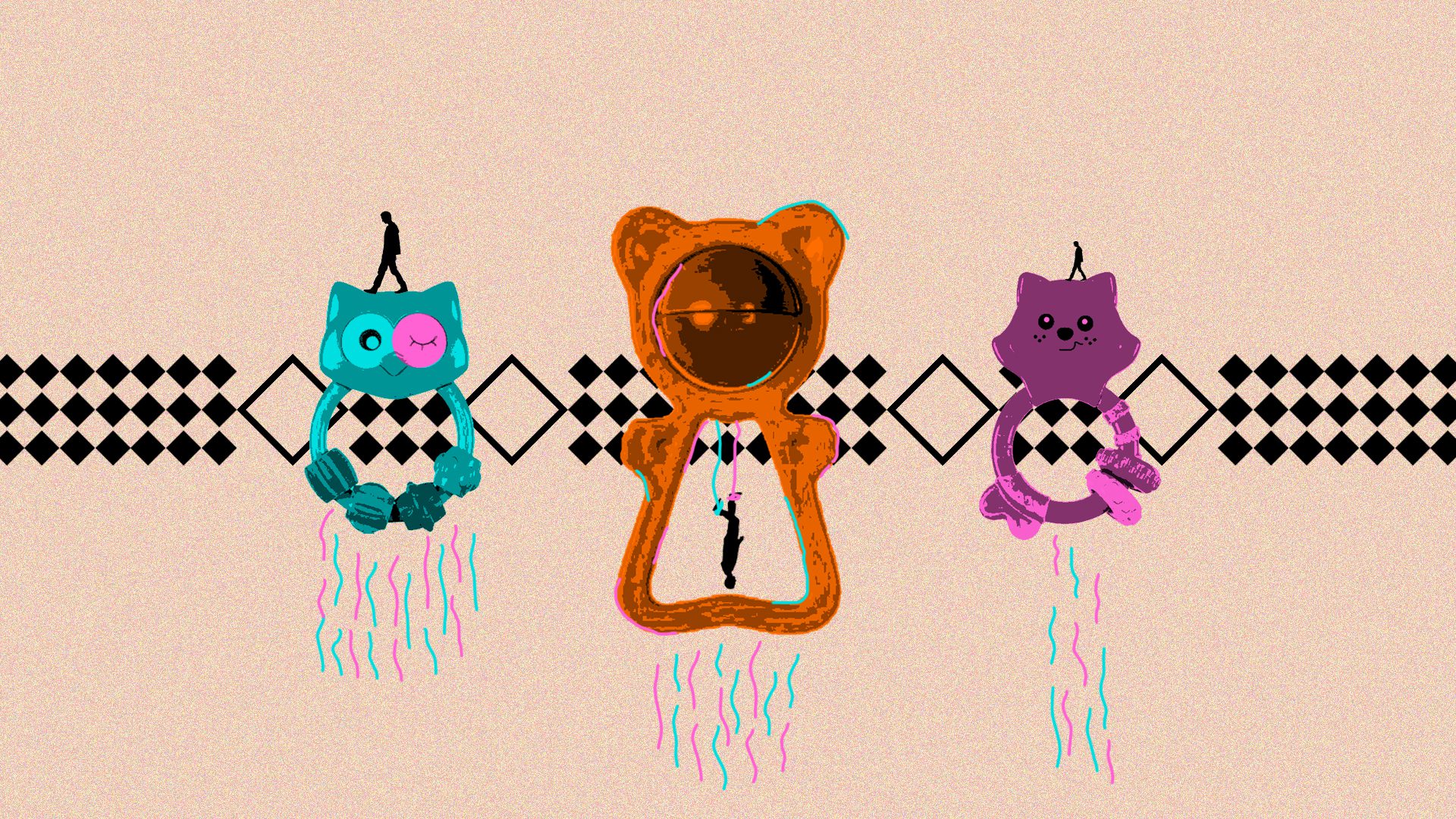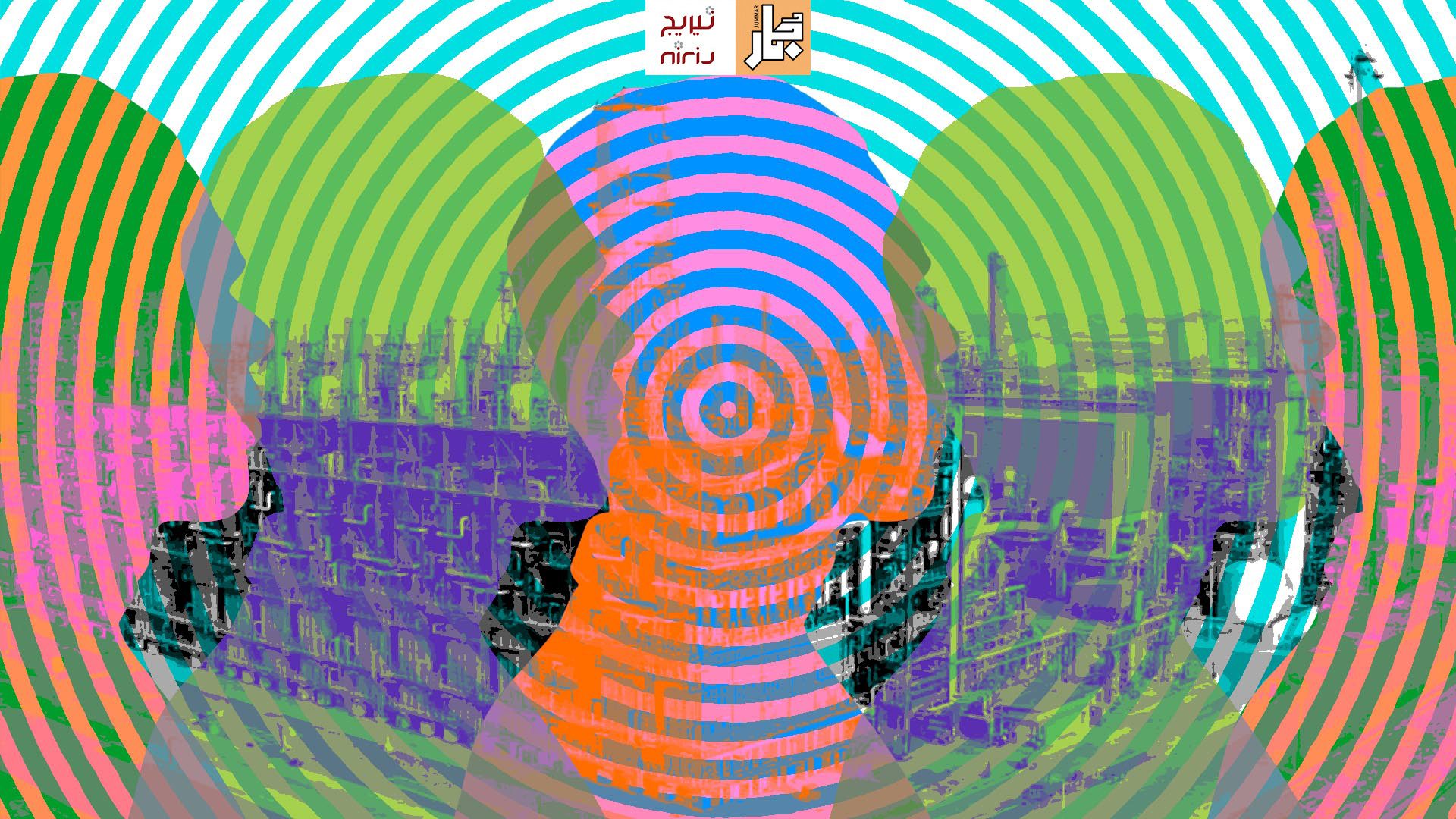يوجد لدينا خرخاشة
28 شباط 2024
يوجد لدينا خرخاشة… وهيدروكربونات ولصوص مع ذرَّة قداسة سائبة.
حينما اكتشف الآثاريون الخرخاشة في بلاد سومر ظنوا أنها رمز مقدس، أدوات كثيرة صادفتهم في المقبرة الملكية لم يعرفوا فائدتها وظلت غامضة حتى الآن. كانت الخرخاشة السومرية تتخذ أشكالاً شتى من نمور وثيران وسباع فخارية ومجوّفة؛ وفي داخلها حصاتان تصدران نغمة مبهجة تثير فضول الأطفال والآلهة معاً إذا هززتها.
قبل اكتشاف المقبرة بتسعة أعوام؛ كان تشارلز ليونارد شاباً لندنياً غرّاً مولعاً بالحفريات الآثارية والكنوز الشرقية التي ينقلها الرحالة اللصوص إلى المتاحف، ومثل أغلب الآثاريين في ذلك الزمان كان مهموماً بإثبات تفوّقه العرقي ومطاردة القصص التوراتية في بلاد الشرق. ترك عمله في متحف جامعة أكسفورد بعد أن نال شهادة في اللاهوت المسيحي، ليلتحق بتوصية من المس بيل بالأسطول البحري الذي كان وقتذاك يمخر البحر المتوسط، نزل ضيفاً عند لورنس العرب في الإسكندرية ثم التحق بالجبهة المشتعلة على الماء، وأبحر شرقاً ليفرّ من براغيث البحر التي تحب الجنود الأموات والسحب السوداء، لكن اللغم الألماني الذي اصطدم بسفينته وأغرقها خبأ له مصيراً آخر، انتشلته فرقاطة عثمانية وسفّرته إلى اسطنبول وحظيت قضية تشارلز بعناية السلطان عبد الحميد الثاني، حاكمه بتهمة التجسس وأودعه السجن لعامين!، خلال ذلك أعلن الطرفان؛ ألمانيا والحلفاء انتصارهما معاً في تلك المنازلة المائية، ولم يكن للبراغيث وزارة إعلام لتعلن النصر أيضاً.
دفعته المنافسة مع نظيره كارتر الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون إلى اكتشاف مقبرة الملكة بوابي في الناصرية بفارق شهرين بينهما فقط، حماسه الديني جعله محل تندر علم الأركيولوجيا الحديث فيما صار يعرف بــ«طوفان تشارلز»، خَمّن أنّ بقايا الحطام الخشبية التي عثر عليها في أور هي بقايا سفينة نوح والطوفان العظيم، لكن التحليلات الطيفية لعناصر القير الطيني تقول إن تلك البقايا هي لفيضان صغير حسب مختبرات جامعة بنسلفانيا الأمريكية التي انضم إلى بعثتها في ما بعد. لم يتوقف فضول المزاوجة عنده بين الهوية الدينية وهويات الأقوام البائدة في مسألة الطوفان فحسب، بل تعداها إلى تماثيل الخرفان في سومر، والخرخاشة.
الأركيولوجيا، مثل أغلب العلوم الأساسية خرجت من الكنائس والمساجد والأديرة ومكتبات الخلفاء وترجمات وزرائهم وحاشيتهم، لتخون المهد الأول وتغدر بروادها، وتفشل في إثبات التصورات الإيمانية، ومغازلة الهويات والمشاعر الشوفينية، «والعقل ما عنده صاحب» على رأي ديفيد هيوم!
أما الخروف السومري الأزرق، تلك التحفة الرابضة عند باب الملكة، فقد قال له تشارلز: أنت هو خروف إبراهيم الذي فدى به ابنه. كان مهشّماً، دخلت قرونه في وجهه وانبعجت ساقاه، أعاد تركيبه وغلّفه وبعث به إلى متحف لندن، وبعث بالنسخة الأخرى منه إلى ولاية فيلادلفيا الأمريكية، كل هذا والخروف، الذهبي ذو اللحية الفيروزية البديعة، صابر ومحتسب، يتحمل مطبات الرحلة وفضول المؤمنين وتقوّلاتهم الساذجة عنه.
في العام 2017 وقفتُ عند الخروف في متحف الآثار بجامعة بنسلفانيا، وقرأتُ بطاقة التعريف المسهبة على يمينه، التي تفيد بأن مكتشفه تشارلز قام بتجميع الخروف على هيئة الواقف على أربعة أطراف انسجاماً مع رؤيته الدينية له، لكن الخروف يقف على ساقين ويرفع النصف الأمامي من جسده ليأكل من غصن الشجرة الملحقة به، وتلمِّح البطاقة بلغة صوابيّة سياسياً متندرة على منطق تشارلز الإنجيلي كي لا تحرج المنطق الاستعماري الذي يبحث عن هويته بين الخرفان، وعن خرفانه في هوية غيره، وإذا أردت، قارئي العزيز، أن أترجم لك البطاقة بصياغتي بعد خلع الصوابيّة فهذا ملخصها: السير تشارلز ليونارد كان مخطئاً لأن علم الآثار كان في بداياته، وانعكست تصوراته على تشويه الخروف وتحويله من مجرد خروف سومري جوعان يأكل من الشجرة إلى أضحية للمقدس، وخرّب أطرافه وعبث بهويته.
الطبيعة الجيولوجية خانت تشارلز أيضاً في منافسته لإنجازات كارتر، القشرة الرسوبية للأرض العراقية ليست صديقة حميمة للآثار ولم تعمل كثلاجة لتخزينها مثلما حدث للآثار الفرعونية، وهذه سيئة وحسنة، ذابت الكثير من الكنوز وأصبحت ذاكرة الأرض ضعيفة مثل سكّانها، لكن ترسُّب الطبقات البحرية بهذا النحو ساعد في تكوين مسامات واسعة الحجم بين الصخور، وهذه عملت بكفاءة كمصائد رحيمة للهيدروكربونات، فوجد النفط مخزناً آمناً يعيش فيه، وتحت ضغط حبيس في الأعماق طبخته آلهة الصخور وسهرت على راحته، تغني له حتى ينام ويستيقظ في زماننا، ومثل مصير الخروف الأزرق، أتاه من يسيء فهمه واستخدامه، تعاقد اللصوص مع اللصوص في التراخيص، وشرعوا بتنفيس الضغط الطبقي الذي يحرس الثروات وينظم استهلاكها، وباستنزاف سوائل الأرض وزفراتها بهمجية وجشع، دون مسؤولية علمية.

يوجد لدينا خرخاشة… وهيدروكربونات ولصوص.
اللصوص هيدروكربونات أيضاً مثل كل البشر، مع ذرَّة قداسة سائبة.
والهوية خرخاشة هذه الأيام، يمكن نهبها والتربُّح بها أيضاً، غالباً ما تعاني من الاستلاب الثقافي والتلفيق، ويتم تسليحها بالألفاظ والأغنيات والثارات والعواطف المقدسة. ولأنها يافطة متحركة سيتم اختطافها وتأجيرها والتربح منها، وستظل ممنوعاً ليس من التعرف عليها فحسب، بل من مناقشتها حينما تجدها مفروضة عليك من قبل الآخر، الآخر البعيد الذي يختار لك من تكون، بعد أن يختار لك هوية خصمك وملابسه والموسيقى التصويرية التي ستصاحب المصارعة، بينما يستمتع هو بمشاهدة النزال بين هويتين ملفقتين.
يشير أناتيا سن، عالم الاقتصاد الهندي المتوّج بجائزة نوبل إلى هذه الرؤية الغربية لهويات الشعوب الشرقية في كتابه الهوية والعنف، إذ يقول إنّ الشعوب ذات الماضي الاستعماري التي اتخذت هوية نضالية جديدة مضادة للغرب اليوم ستعاني من أزمة «إدراك الهوية الارتجاعي»، وأرجو أن لا يفزعك هذا المصطلح الذي يشبه شاحنة مقلوبة في طريق خارجي.
الإدراك الارتجاعي هذا، يحدث حينما تسمح للآخر أن يعيد تشكيلك مرتين، مرة حينما يتبناك حضارياً ويدعي إرشادك الى الديمقراطية وقيمه الغربية التقدمية -غير المجانية- ومرة أخرى حينما تقرر أنت نفسك الارتداد إلى هوية محلية مزيّفة، متأثراً باحتلال أو هزيمة.
ستكون قد مررت بعملية تزييف مضاعفة، الأولى من الآخر والثانية منك شخصياً كرد فعل على التزييف الأول.
سأضرب لك مثالين -مشهورين عندك- عن مأساة الإدراك الارتجاعي للهويات والخرخاشة المصاحبة له:
خلال الأعوام الماضية تم تصنيع هوية لرقعة جغرافية تصف نفسها بالشروگية الأبيّة السمراء والمملوحة والمقاومة…. للماء.
وهي هوية مستندة في ظهورها على التأطير السلبي لها وعلى رؤية انعكاسية من الآخر عنها، الآخر الذي يشتمها ويعلن تأففه منها بأسماء مستعارة خوفاً من التصفية والاعتقال، وفي النتيجة تشكلت هوية انعزالية لم تكن موجودة، وكرد فعل على شتائم الآخر لها، قامت بالمصادقة على شتائمه وجعلتها بنوداً تعريفية عنها!، ولم تفتأ تعيّره بدورها التاريخي في حراسة عرضه، والعرض هنا ليس حاصل قسمة المساحة على الطول، بل هو أسوأ تعريف لفكرة بديهية وإنسانية ونبيلة: الدفاع عن الوطن وحراسة حدوده.
هوية صممها المهوسجية لا المفكرون، مضافة إلى رزمة هويات داخلية ومتناهية في الصغر داخل هويات أكبر، لكنها تخرخش بصخب. هوية ستتطور تدريجياً إلى طائفة داخل طائفة داخل طائفة داخل طائفة حتى تأكل الطائفة كلها، لها لون ولهجة وديانة ولغة مستحدثة وخرخاشة موحدة، وسيطرة مركزية على الإعلام والرقابة، ما دام إنتاج الهويات المقفلة مربحاً للجميع، ومخيفاً للجميع.
المثال الثاني: هوية مضادة تتشكل على استحياء في الوقت نفسه، تهدف إلى تطبيب الذات المطعونة في كبريائها، الدائخة من الركلات في كل الاتجاهات، شاب يغطي نصف وجهه بنظارة شمسية وينظر يميناً، عميقٌ من يومه ويتعمق في فراغ العمق…. العربي.
مخذول بلا ذاكرة ويبحث عن رموز غير مستهلكة تمثله دون جدوى، لكنه يقع دائماً على رموز منقرضة ومتحللة، وحبذا أن يتصور مع سيارة فخمة أو نمر في أغنية أو عباءة ويشماغ يشيران دون داعٍ إلى جغرافيته وهويته المستحدثة من جرّاء استحداث هوية المثال الأول، ودون مناسبة يعيد تحضير روح الأستاذ عدي، إمامه الغائب.
حدثت له كل النكبات والمجازر والتهجيرات لكنه لا يتعلم التسامح، ما زال وفياً إلى انطباعاته النمطية الخاطئة عن مواطنه الآخر ولا يقبل اكتشافه وقراءته دون شعور بالمركزية والفوقية التي غسلها المهيب الركن بالطشت مع ملابسه الداخلية، عارياً تحت بنادق العلوج!. تحصره الهوية الأخرى بخيارات محدودة، ولا يجد في «المنيو» غير طبق من الرجوليات البائتة من عشاء الماضي الذي لا يمضي.

هويتان ملفقتان نتجتا عن تصديقهما للآخر مانح البركات الهوياتية. لأنك لو دققت ملياً في هاتين الهويتين المدججتين بالأوهام، ستأخذك العبرة و«تستفيق ملء روحك رعشة البكاء»، سترى في الواقع كائناً بريئاً يتشبه بالضباع أو يحاول أن يتوحش على قدر المستطاع كي يخيفك، يكسر خاطرك من بؤسه، وقد يخيفك فعلاً، لكنه مذعور في الصميم، ولفق لنفسه هوية استمدها من رؤية خصومه له، وصدقها، وصدقناها نحن، وصدقها المحتل الجديد الذي صنعها، وها هو يتشكى منها، ومن صواريخها!.
والمحصلة هي العنف المتبادل الذي تخفيه شعارات التعايش الهش، ومزيد من الأسيجة العازلة وسوء الفهم المتبادل؛ والمزمن، المتعمد بالأحرى. فالهويات الملفقة خرخاشياً بهذا النحو ستقود حتماً إلى عنف.
صحيح أن.. حتى الهويات الوطنية الجامعة ملفقة أيضاً، لكنها هويات تعترف بالتعدُّد وتجد بينها وبين الآخر الذي تتعايش معه هويات متداخلة ومتشابكة، وغير مدرعة بالأسلحة ولا بالمشاعر. والتعدد والتنوع حاله حال الديمقراطية وحقوق الإنسان سيصار إلى تعريفه ظلماً كـ«وارد أمريكي»، ليعود الناس إلى جلودهم الأولى وإلى مرحلة ما قبل اختراع الخرخاشة: مناطقيون وعنصريون ومتوحشون.
هناك مساهمات غربية طبعاً في فكرة التعايش المتمدن، مثلما كان لبغداد في تأريخها القديم مساهمات في علوم الرياضيات والفيزياء والفلك خدمت العالم لدرجة أن العالم قد لن يكون كما هو الآن دونها، لكن الإيمان بالتنوع الثقافي وتنافذ الخبرات ليس ملكاً لأحد، إذ لا وجود لهوية واحدة صمدانية وصلدة، ولا وجود لهويتين أو ثلاث دون أن تتوالد بينهما ممكنات ومشتركات تحقق ذلك العقد الاجتماعي الاصطناعي الذي يسمونه «الهوية الوطنية»، وهي الهوية الزائفة الوحيدة التي تستحق التصديق في حياتنا.
لأنها هوية اتفاقية تحمي الجماعة كلها بالتساوي، وليس فئة منها، هوية يسمى فيها الدفاع عن الوطن: دفاعاً عن مواطنيه، وليس عن حاصل قسمة المساحة على الطول.
وهي هوية يناط بها «احتكار العنف» حصراً، كما يرى علم السياسة.
قصة السومريين هي خير مثال عن ادعاءات الهويّة العنفية، قالوا بحارنة وقالوا أناضوليون وهنود وقوقازيون وهنغاريون، وقال طه باقر إنهم عراقيون. علم الجينات الذي اختطفه بني صهيون يخفق في قول الزبدة، ويطيب لبعضنا إلحاق نفسه بالسومريين والآشوريين، وبعضنا يبالغ في الركون إلى الرؤية الاستعمارية التي تفيد بأنهم أقوام أوربية نزحت إلى هنا. ويبدو أننا نخشى أن نقول: لا ندري من هم السومريون.
ما ندريه هو أننا تشاركنا معهم هذه الرقعة من الأرض، كانوا هنا هذا مؤكد، خطّار مثلنا على وادي الرافدين، والخطّار لا يليق به ادعاء التأريخ كله، وتسليح جيناته الثقافية والبيولوجية بالتعصب القومي وادعاء الفرادة، وامتلاك البيت كله.
حصل تشارلز على لقب الفارس وقبله حصل أخوه على وسام الصليب المقدس مرتين، ووجدت تصوراته مكانها الملائم في «الأفلام» الهوليودية لا الحقائق، حينما استلهم سبليبرغ وجورج لوكاس شخصيته في سلسلة أفلام إنديانا جونز، وكان قد وظفه تشرتشل في لجنة «رجال المعالم» الذين سيحافظون على النصب المهمة من فرهود الألمان، اللجنة التي ستعيد البروبغاندة تسويقها من جديد بصحبة جورج كلوني في فيلم يحمل الاسم نفسه دون أن تتطرق إلى ميولاتها الدينية والانتهازية وتنقيباتها السابقة في العراق، وستضيف اللجنة في ما بعد، وقبل الفيلم، كلمة نساء لتصبح رجال ونساء المعالم، استعمالاً متأخراً لمبدأ المساواة بين المستعمر والمستعمِرة!.
فقد كانت السيدة كاثرين زوجة تشارلز، تصبغ وتمكيج جماجم الجنود السومريين الذين حرسوا قبر الملكة، كي يظهروا أشبه بجنود الرومان، لتبرهن – ياللنباهة- على أن السومريين من الإغريق البيض، يروي ذلك بول كولنز في كتابه السومريون حضارة مفقودة.
جاءت أغاثا كريستي لتكتب رواية بوليسية مفرّغة من القيمة الأدبية والإنسانية حتى، وانضمت إلى تشارلز في الموصل وتعرفت على مساعده وتزوجته، ووصفت العراقيين ممن «ساعدوها» وزوجها في أعمال الحفر الشاقة والمهلكة للبيئة والصحة بــ«صفر الوجوه، قاتمين وقذرين»!.
هل تتذكر الشاحنة التي انقلبت في فقرة سابقة من هذا المقال؟، هنا شاحنة أخرى انزلقت قبلها: نرجسية الاختلافات الصغيرة.
يرى فرويد أن زيادة التشابهات والقواسم المشتركة في مجتمع ما تزيد من احتمالية اختراع نزاعات صغيرة وسخرية متبادلة داخل الهوية نفسها، وقد تستخدم في إنتاج تناقضات أشد ضراوة من الفروقات الكبيرة، لذلك، قد تتفهم أن ص مختلف عن ع، لكن ع سيجد نفسه مختلفاً لدوداً عن ع الذي في داخله ويحمل هويته ويشاركه ميزات مظهرية ولغوية ومذهبية حتى، ويفرّخ لك ع واحد وع اثنين وع ثلاثة وهكذا مع ص، وهذه طبيعة اجتماعية عادية؛ لكن فهم التعددية بهذا الشكل وإيلاء الهويات المتناسلة منزلة سياسية في شكل الدولة سيضاعف احتمالات العنف، والفساد.
ولعل هذا هو الشق الكبير في المشروع الأمريكي الذي ترتديه الطبقة السياسية ونخبتها ومن تعثر بأذيالهم وبعض من عارضها من المثال الأول والثاني. لقد نظر المشروع إلى التعددية من زاوية جهله بطبيعة التعدد العراقي، وفهمه كما يفهم الغيتوات الأمريكية شديدة العزلة في ما بينها في الولايات الأقل ليبرالية، كما أنه لم يمكّن الديني الذي يؤمن بالتعدد مثلما مكّن الذي يؤمن بالحكم الثيوقراطي ووضع يده على منابع الثروة.

تقول كرستين غارووَي، الأستاذة المساعدة في جامعة لوس أنجلس في كتابها ألعاب الأطفال في وادي الرافدين بأنها متعجبة من العدد الهائل للخرخاشات في العراق القديم لدرجة أن بقاياها المتناثرة تنتشر في الشوارع والمعابد والبيوت، كأنها تقول كان القوم: خرخاشتك وأنت ماشي.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
حينما اكتشف الآثاريون الخرخاشة في بلاد سومر ظنوا أنها رمز مقدس، أدوات كثيرة صادفتهم في المقبرة الملكية لم يعرفوا فائدتها وظلت غامضة حتى الآن. كانت الخرخاشة السومرية تتخذ أشكالاً شتى من نمور وثيران وسباع فخارية ومجوّفة؛ وفي داخلها حصاتان تصدران نغمة مبهجة تثير فضول الأطفال والآلهة معاً إذا هززتها.
قبل اكتشاف المقبرة بتسعة أعوام؛ كان تشارلز ليونارد شاباً لندنياً غرّاً مولعاً بالحفريات الآثارية والكنوز الشرقية التي ينقلها الرحالة اللصوص إلى المتاحف، ومثل أغلب الآثاريين في ذلك الزمان كان مهموماً بإثبات تفوّقه العرقي ومطاردة القصص التوراتية في بلاد الشرق. ترك عمله في متحف جامعة أكسفورد بعد أن نال شهادة في اللاهوت المسيحي، ليلتحق بتوصية من المس بيل بالأسطول البحري الذي كان وقتذاك يمخر البحر المتوسط، نزل ضيفاً عند لورنس العرب في الإسكندرية ثم التحق بالجبهة المشتعلة على الماء، وأبحر شرقاً ليفرّ من براغيث البحر التي تحب الجنود الأموات والسحب السوداء، لكن اللغم الألماني الذي اصطدم بسفينته وأغرقها خبأ له مصيراً آخر، انتشلته فرقاطة عثمانية وسفّرته إلى اسطنبول وحظيت قضية تشارلز بعناية السلطان عبد الحميد الثاني، حاكمه بتهمة التجسس وأودعه السجن لعامين!، خلال ذلك أعلن الطرفان؛ ألمانيا والحلفاء انتصارهما معاً في تلك المنازلة المائية، ولم يكن للبراغيث وزارة إعلام لتعلن النصر أيضاً.
دفعته المنافسة مع نظيره كارتر الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون إلى اكتشاف مقبرة الملكة بوابي في الناصرية بفارق شهرين بينهما فقط، حماسه الديني جعله محل تندر علم الأركيولوجيا الحديث فيما صار يعرف بــ«طوفان تشارلز»، خَمّن أنّ بقايا الحطام الخشبية التي عثر عليها في أور هي بقايا سفينة نوح والطوفان العظيم، لكن التحليلات الطيفية لعناصر القير الطيني تقول إن تلك البقايا هي لفيضان صغير حسب مختبرات جامعة بنسلفانيا الأمريكية التي انضم إلى بعثتها في ما بعد. لم يتوقف فضول المزاوجة عنده بين الهوية الدينية وهويات الأقوام البائدة في مسألة الطوفان فحسب، بل تعداها إلى تماثيل الخرفان في سومر، والخرخاشة.
الأركيولوجيا، مثل أغلب العلوم الأساسية خرجت من الكنائس والمساجد والأديرة ومكتبات الخلفاء وترجمات وزرائهم وحاشيتهم، لتخون المهد الأول وتغدر بروادها، وتفشل في إثبات التصورات الإيمانية، ومغازلة الهويات والمشاعر الشوفينية، «والعقل ما عنده صاحب» على رأي ديفيد هيوم!
أما الخروف السومري الأزرق، تلك التحفة الرابضة عند باب الملكة، فقد قال له تشارلز: أنت هو خروف إبراهيم الذي فدى به ابنه. كان مهشّماً، دخلت قرونه في وجهه وانبعجت ساقاه، أعاد تركيبه وغلّفه وبعث به إلى متحف لندن، وبعث بالنسخة الأخرى منه إلى ولاية فيلادلفيا الأمريكية، كل هذا والخروف، الذهبي ذو اللحية الفيروزية البديعة، صابر ومحتسب، يتحمل مطبات الرحلة وفضول المؤمنين وتقوّلاتهم الساذجة عنه.
في العام 2017 وقفتُ عند الخروف في متحف الآثار بجامعة بنسلفانيا، وقرأتُ بطاقة التعريف المسهبة على يمينه، التي تفيد بأن مكتشفه تشارلز قام بتجميع الخروف على هيئة الواقف على أربعة أطراف انسجاماً مع رؤيته الدينية له، لكن الخروف يقف على ساقين ويرفع النصف الأمامي من جسده ليأكل من غصن الشجرة الملحقة به، وتلمِّح البطاقة بلغة صوابيّة سياسياً متندرة على منطق تشارلز الإنجيلي كي لا تحرج المنطق الاستعماري الذي يبحث عن هويته بين الخرفان، وعن خرفانه في هوية غيره، وإذا أردت، قارئي العزيز، أن أترجم لك البطاقة بصياغتي بعد خلع الصوابيّة فهذا ملخصها: السير تشارلز ليونارد كان مخطئاً لأن علم الآثار كان في بداياته، وانعكست تصوراته على تشويه الخروف وتحويله من مجرد خروف سومري جوعان يأكل من الشجرة إلى أضحية للمقدس، وخرّب أطرافه وعبث بهويته.
الطبيعة الجيولوجية خانت تشارلز أيضاً في منافسته لإنجازات كارتر، القشرة الرسوبية للأرض العراقية ليست صديقة حميمة للآثار ولم تعمل كثلاجة لتخزينها مثلما حدث للآثار الفرعونية، وهذه سيئة وحسنة، ذابت الكثير من الكنوز وأصبحت ذاكرة الأرض ضعيفة مثل سكّانها، لكن ترسُّب الطبقات البحرية بهذا النحو ساعد في تكوين مسامات واسعة الحجم بين الصخور، وهذه عملت بكفاءة كمصائد رحيمة للهيدروكربونات، فوجد النفط مخزناً آمناً يعيش فيه، وتحت ضغط حبيس في الأعماق طبخته آلهة الصخور وسهرت على راحته، تغني له حتى ينام ويستيقظ في زماننا، ومثل مصير الخروف الأزرق، أتاه من يسيء فهمه واستخدامه، تعاقد اللصوص مع اللصوص في التراخيص، وشرعوا بتنفيس الضغط الطبقي الذي يحرس الثروات وينظم استهلاكها، وباستنزاف سوائل الأرض وزفراتها بهمجية وجشع، دون مسؤولية علمية.

يوجد لدينا خرخاشة… وهيدروكربونات ولصوص.
اللصوص هيدروكربونات أيضاً مثل كل البشر، مع ذرَّة قداسة سائبة.
والهوية خرخاشة هذه الأيام، يمكن نهبها والتربُّح بها أيضاً، غالباً ما تعاني من الاستلاب الثقافي والتلفيق، ويتم تسليحها بالألفاظ والأغنيات والثارات والعواطف المقدسة. ولأنها يافطة متحركة سيتم اختطافها وتأجيرها والتربح منها، وستظل ممنوعاً ليس من التعرف عليها فحسب، بل من مناقشتها حينما تجدها مفروضة عليك من قبل الآخر، الآخر البعيد الذي يختار لك من تكون، بعد أن يختار لك هوية خصمك وملابسه والموسيقى التصويرية التي ستصاحب المصارعة، بينما يستمتع هو بمشاهدة النزال بين هويتين ملفقتين.
يشير أناتيا سن، عالم الاقتصاد الهندي المتوّج بجائزة نوبل إلى هذه الرؤية الغربية لهويات الشعوب الشرقية في كتابه الهوية والعنف، إذ يقول إنّ الشعوب ذات الماضي الاستعماري التي اتخذت هوية نضالية جديدة مضادة للغرب اليوم ستعاني من أزمة «إدراك الهوية الارتجاعي»، وأرجو أن لا يفزعك هذا المصطلح الذي يشبه شاحنة مقلوبة في طريق خارجي.
الإدراك الارتجاعي هذا، يحدث حينما تسمح للآخر أن يعيد تشكيلك مرتين، مرة حينما يتبناك حضارياً ويدعي إرشادك الى الديمقراطية وقيمه الغربية التقدمية -غير المجانية- ومرة أخرى حينما تقرر أنت نفسك الارتداد إلى هوية محلية مزيّفة، متأثراً باحتلال أو هزيمة.
ستكون قد مررت بعملية تزييف مضاعفة، الأولى من الآخر والثانية منك شخصياً كرد فعل على التزييف الأول.
سأضرب لك مثالين -مشهورين عندك- عن مأساة الإدراك الارتجاعي للهويات والخرخاشة المصاحبة له:
خلال الأعوام الماضية تم تصنيع هوية لرقعة جغرافية تصف نفسها بالشروگية الأبيّة السمراء والمملوحة والمقاومة…. للماء.
وهي هوية مستندة في ظهورها على التأطير السلبي لها وعلى رؤية انعكاسية من الآخر عنها، الآخر الذي يشتمها ويعلن تأففه منها بأسماء مستعارة خوفاً من التصفية والاعتقال، وفي النتيجة تشكلت هوية انعزالية لم تكن موجودة، وكرد فعل على شتائم الآخر لها، قامت بالمصادقة على شتائمه وجعلتها بنوداً تعريفية عنها!، ولم تفتأ تعيّره بدورها التاريخي في حراسة عرضه، والعرض هنا ليس حاصل قسمة المساحة على الطول، بل هو أسوأ تعريف لفكرة بديهية وإنسانية ونبيلة: الدفاع عن الوطن وحراسة حدوده.
هوية صممها المهوسجية لا المفكرون، مضافة إلى رزمة هويات داخلية ومتناهية في الصغر داخل هويات أكبر، لكنها تخرخش بصخب. هوية ستتطور تدريجياً إلى طائفة داخل طائفة داخل طائفة داخل طائفة حتى تأكل الطائفة كلها، لها لون ولهجة وديانة ولغة مستحدثة وخرخاشة موحدة، وسيطرة مركزية على الإعلام والرقابة، ما دام إنتاج الهويات المقفلة مربحاً للجميع، ومخيفاً للجميع.
المثال الثاني: هوية مضادة تتشكل على استحياء في الوقت نفسه، تهدف إلى تطبيب الذات المطعونة في كبريائها، الدائخة من الركلات في كل الاتجاهات، شاب يغطي نصف وجهه بنظارة شمسية وينظر يميناً، عميقٌ من يومه ويتعمق في فراغ العمق…. العربي.
مخذول بلا ذاكرة ويبحث عن رموز غير مستهلكة تمثله دون جدوى، لكنه يقع دائماً على رموز منقرضة ومتحللة، وحبذا أن يتصور مع سيارة فخمة أو نمر في أغنية أو عباءة ويشماغ يشيران دون داعٍ إلى جغرافيته وهويته المستحدثة من جرّاء استحداث هوية المثال الأول، ودون مناسبة يعيد تحضير روح الأستاذ عدي، إمامه الغائب.
حدثت له كل النكبات والمجازر والتهجيرات لكنه لا يتعلم التسامح، ما زال وفياً إلى انطباعاته النمطية الخاطئة عن مواطنه الآخر ولا يقبل اكتشافه وقراءته دون شعور بالمركزية والفوقية التي غسلها المهيب الركن بالطشت مع ملابسه الداخلية، عارياً تحت بنادق العلوج!. تحصره الهوية الأخرى بخيارات محدودة، ولا يجد في «المنيو» غير طبق من الرجوليات البائتة من عشاء الماضي الذي لا يمضي.

هويتان ملفقتان نتجتا عن تصديقهما للآخر مانح البركات الهوياتية. لأنك لو دققت ملياً في هاتين الهويتين المدججتين بالأوهام، ستأخذك العبرة و«تستفيق ملء روحك رعشة البكاء»، سترى في الواقع كائناً بريئاً يتشبه بالضباع أو يحاول أن يتوحش على قدر المستطاع كي يخيفك، يكسر خاطرك من بؤسه، وقد يخيفك فعلاً، لكنه مذعور في الصميم، ولفق لنفسه هوية استمدها من رؤية خصومه له، وصدقها، وصدقناها نحن، وصدقها المحتل الجديد الذي صنعها، وها هو يتشكى منها، ومن صواريخها!.
والمحصلة هي العنف المتبادل الذي تخفيه شعارات التعايش الهش، ومزيد من الأسيجة العازلة وسوء الفهم المتبادل؛ والمزمن، المتعمد بالأحرى. فالهويات الملفقة خرخاشياً بهذا النحو ستقود حتماً إلى عنف.
صحيح أن.. حتى الهويات الوطنية الجامعة ملفقة أيضاً، لكنها هويات تعترف بالتعدُّد وتجد بينها وبين الآخر الذي تتعايش معه هويات متداخلة ومتشابكة، وغير مدرعة بالأسلحة ولا بالمشاعر. والتعدد والتنوع حاله حال الديمقراطية وحقوق الإنسان سيصار إلى تعريفه ظلماً كـ«وارد أمريكي»، ليعود الناس إلى جلودهم الأولى وإلى مرحلة ما قبل اختراع الخرخاشة: مناطقيون وعنصريون ومتوحشون.
هناك مساهمات غربية طبعاً في فكرة التعايش المتمدن، مثلما كان لبغداد في تأريخها القديم مساهمات في علوم الرياضيات والفيزياء والفلك خدمت العالم لدرجة أن العالم قد لن يكون كما هو الآن دونها، لكن الإيمان بالتنوع الثقافي وتنافذ الخبرات ليس ملكاً لأحد، إذ لا وجود لهوية واحدة صمدانية وصلدة، ولا وجود لهويتين أو ثلاث دون أن تتوالد بينهما ممكنات ومشتركات تحقق ذلك العقد الاجتماعي الاصطناعي الذي يسمونه «الهوية الوطنية»، وهي الهوية الزائفة الوحيدة التي تستحق التصديق في حياتنا.
لأنها هوية اتفاقية تحمي الجماعة كلها بالتساوي، وليس فئة منها، هوية يسمى فيها الدفاع عن الوطن: دفاعاً عن مواطنيه، وليس عن حاصل قسمة المساحة على الطول.
وهي هوية يناط بها «احتكار العنف» حصراً، كما يرى علم السياسة.
قصة السومريين هي خير مثال عن ادعاءات الهويّة العنفية، قالوا بحارنة وقالوا أناضوليون وهنود وقوقازيون وهنغاريون، وقال طه باقر إنهم عراقيون. علم الجينات الذي اختطفه بني صهيون يخفق في قول الزبدة، ويطيب لبعضنا إلحاق نفسه بالسومريين والآشوريين، وبعضنا يبالغ في الركون إلى الرؤية الاستعمارية التي تفيد بأنهم أقوام أوربية نزحت إلى هنا. ويبدو أننا نخشى أن نقول: لا ندري من هم السومريون.
ما ندريه هو أننا تشاركنا معهم هذه الرقعة من الأرض، كانوا هنا هذا مؤكد، خطّار مثلنا على وادي الرافدين، والخطّار لا يليق به ادعاء التأريخ كله، وتسليح جيناته الثقافية والبيولوجية بالتعصب القومي وادعاء الفرادة، وامتلاك البيت كله.
حصل تشارلز على لقب الفارس وقبله حصل أخوه على وسام الصليب المقدس مرتين، ووجدت تصوراته مكانها الملائم في «الأفلام» الهوليودية لا الحقائق، حينما استلهم سبليبرغ وجورج لوكاس شخصيته في سلسلة أفلام إنديانا جونز، وكان قد وظفه تشرتشل في لجنة «رجال المعالم» الذين سيحافظون على النصب المهمة من فرهود الألمان، اللجنة التي ستعيد البروبغاندة تسويقها من جديد بصحبة جورج كلوني في فيلم يحمل الاسم نفسه دون أن تتطرق إلى ميولاتها الدينية والانتهازية وتنقيباتها السابقة في العراق، وستضيف اللجنة في ما بعد، وقبل الفيلم، كلمة نساء لتصبح رجال ونساء المعالم، استعمالاً متأخراً لمبدأ المساواة بين المستعمر والمستعمِرة!.
فقد كانت السيدة كاثرين زوجة تشارلز، تصبغ وتمكيج جماجم الجنود السومريين الذين حرسوا قبر الملكة، كي يظهروا أشبه بجنود الرومان، لتبرهن – ياللنباهة- على أن السومريين من الإغريق البيض، يروي ذلك بول كولنز في كتابه السومريون حضارة مفقودة.
جاءت أغاثا كريستي لتكتب رواية بوليسية مفرّغة من القيمة الأدبية والإنسانية حتى، وانضمت إلى تشارلز في الموصل وتعرفت على مساعده وتزوجته، ووصفت العراقيين ممن «ساعدوها» وزوجها في أعمال الحفر الشاقة والمهلكة للبيئة والصحة بــ«صفر الوجوه، قاتمين وقذرين»!.
هل تتذكر الشاحنة التي انقلبت في فقرة سابقة من هذا المقال؟، هنا شاحنة أخرى انزلقت قبلها: نرجسية الاختلافات الصغيرة.
يرى فرويد أن زيادة التشابهات والقواسم المشتركة في مجتمع ما تزيد من احتمالية اختراع نزاعات صغيرة وسخرية متبادلة داخل الهوية نفسها، وقد تستخدم في إنتاج تناقضات أشد ضراوة من الفروقات الكبيرة، لذلك، قد تتفهم أن ص مختلف عن ع، لكن ع سيجد نفسه مختلفاً لدوداً عن ع الذي في داخله ويحمل هويته ويشاركه ميزات مظهرية ولغوية ومذهبية حتى، ويفرّخ لك ع واحد وع اثنين وع ثلاثة وهكذا مع ص، وهذه طبيعة اجتماعية عادية؛ لكن فهم التعددية بهذا الشكل وإيلاء الهويات المتناسلة منزلة سياسية في شكل الدولة سيضاعف احتمالات العنف، والفساد.
ولعل هذا هو الشق الكبير في المشروع الأمريكي الذي ترتديه الطبقة السياسية ونخبتها ومن تعثر بأذيالهم وبعض من عارضها من المثال الأول والثاني. لقد نظر المشروع إلى التعددية من زاوية جهله بطبيعة التعدد العراقي، وفهمه كما يفهم الغيتوات الأمريكية شديدة العزلة في ما بينها في الولايات الأقل ليبرالية، كما أنه لم يمكّن الديني الذي يؤمن بالتعدد مثلما مكّن الذي يؤمن بالحكم الثيوقراطي ووضع يده على منابع الثروة.

تقول كرستين غارووَي، الأستاذة المساعدة في جامعة لوس أنجلس في كتابها ألعاب الأطفال في وادي الرافدين بأنها متعجبة من العدد الهائل للخرخاشات في العراق القديم لدرجة أن بقاياها المتناثرة تنتشر في الشوارع والمعابد والبيوت، كأنها تقول كان القوم: خرخاشتك وأنت ماشي.