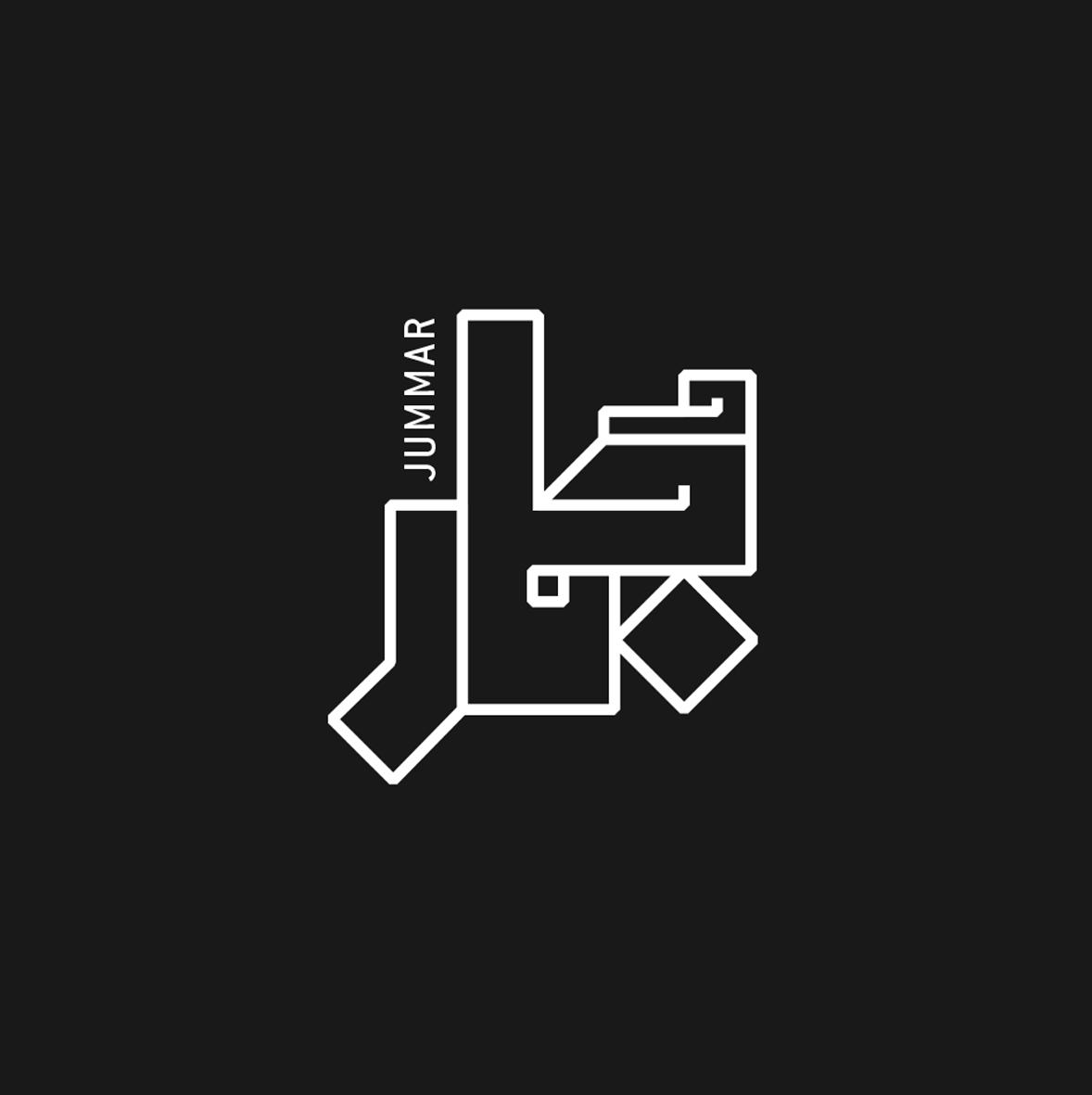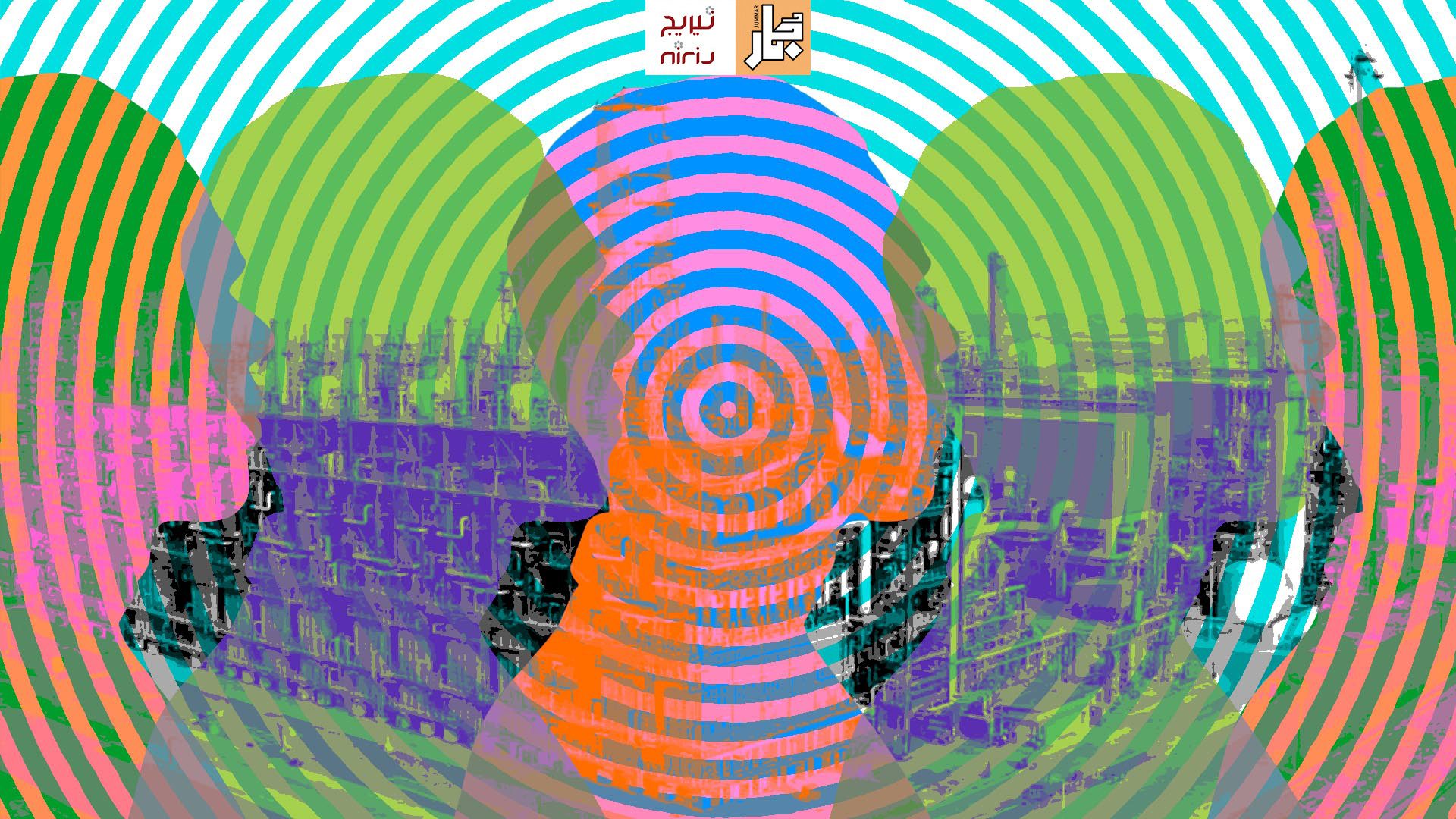"غيمة ونجمة ورازقي".. عندما أنقذتني قطط شوارع بغداد
04 نيسان 2023
تمرّدتُ على كلّ الثوابت المفروضة عليّ وحجزت بطاقة سفري وأعلنت عودتي للعراق من دون فتح المجال لتعليق من أي أحد.. لكن بغداد مدينة قاسية، أشعر فيها بالضياع، أتعثر باختياراتي وقناعاتي. عن العودة بعد اغتراب، وصعوبة العيش بحريّة، وقططٍ تُشارك في إنقاذ إنسان...
في بداية رحلتي الشاقة، قدمت لها قرباناً “علبة تونا”. كنت أراقبها من مسافة بعيدة مستلقية تحت ضوء الشمس في الخرابة، وكانت تظهر بين الحين والآخر من بين أكوام الأثاث الممزق والالكترونيات المهجورة المنثورة في كومة الزبالة المطلة على شارع أبي نؤاس وسط بغداد، حيث كنا نعيش -أو نحاول ذلك- أنا وحبيبي. كانت تظهر شاحبة الوجه ونحيلة الجسد، تنظر إلينا من بعيد وقطتاها الصغيرتان ملتصقتان بها.
احترمتها، فهي من الناجيات على هذه الأرض وفي هذه المدينة القاسية، حيث كنت أشعر بالضياع، غير واثقة من قراراتي. أتعثر باختياراتي وقناعاتي. لكن عندما أراها أنسى محنتي، ولو لوهلة. أنسى المخاوف التي تدور في رأسي ممزوجة بضجيج الشارع والمولدات ودوريات الشرطة.
كانت هذه أصوات الحياة.
أذهب إلى الدكان واشتري علبة “تونا” لأفرغها بعد ذلك على مسافة بعيدة من عائلة القطط الهاربة من البشر. كانت الأُم صاحبة الفرو الأسود والأبيض تدعو صغيراتها ليأكلن كل الطعام، وتبقى هي تنظر إليّ من بعيد. أُحدثها كمن فقد عقله وهي لا تشيل عينيها الخضراوين عني. أطلب منها المراد.. أطلب منها أن تعلمني كيف أنجو.
الأسابيع الأولى
قضيت أول أسابيعي في هذه العمارة على أبي نؤاس: امرأة عراقية غير متزوجة تحاول العيش في مدينتها، مسقط رأسها ومسقط رأس أبيها وجداتها وجداتهم، لكنني والقطة نعرف أن ليس لنا مكاناً في هذا العالم إلا قرب الحائط وبين الأكوام المنسية، نتفادى الشر ونمتن لأبسط ما نجده من خير.
رأيت الشر في نظرات الناس وأنا أبحث عن شقة أسكنها.
نمشي، حبيبي وأنا، في شوارع الكرادة حيث يعمل، نبحث عن لافتات تعرض شققاً للإيجار، نُكلِّم الحراس الذين يسألون “هاي زوجتك؟” وهم يدرسونني بتمعّن. يجيب أحياناً بنعم وأحياناً بلا. الموقف غريب، لا أنا ولا هو نعرف كيف نتعامل مع عالم خارج عالمنا الخاص، عالم الشباب الخارج عن قيود المجتمع. اختلاف رغبتنا بطريقة العيش يشكل خطراً على المجتمع كما يبدو. نصعد للطابق الفلاني ونرى الشقة الكئيبة التي يجب أن أكون متزوجة حتى أسكن فيها. نعرف ويعرف صاحبها انه لن يقبلنا، لكنه يأخذنا على “كد عقلنا” أو يتفادى الإحراج. لا أعرف، ولكنني أفهم انني غير مرحب بي. يتعاطف معنا أحد الحراس، رجل كبير في السن، يرش الحديقة والشتلات أمام مدخل عمارته. يقول “انت بنت حبابة، لكن تعرفين الموضوع صعب. المخابرات تفتش العمارات وتريد تشوف عقد الزواج”.

يذكرني الرجل بجدي الذي يرش الحديقة حتى يملأ الشارع مياهاً كل يوم، ثم يفتح باب الحديقة ويوزع حلوى على أولاد الجيران. العيش في بيت جدي أسهل من هذا كله، لكني متمسكة باختياري أن أكون مستقلة. لست وحدي في هذا المأزق. نساء عازبات وأزواج حولي يعانون المحنة نفسها. منهم من رشى الناطور بـ”ورقة” (مئة دولار) أو شاشة تلفزيون، ومنهم من “مشه أموره بعقد سيد” يحصلون عليه من إحدى درابين الكاظمية حيث يتزوج الرجال على زوجاتهم من بنات بنصف أعمارهم. لا ألوم الحراس والجيران، فكل عاش مأساته ويريد تجنب المشاكل. فهنا إذا كنت تريد امتلاك طريقتك في الحياة والدفاع عنها، فمن الأفضل أن تتحلى بالشجاعة. انا وحبيبي لا يوجد لدينا أكثر من هذا، وقد قادنا الإصرار فوجدنا هذه العمارة المتآكلة في هذا الفرع المهمل القريب من شارع ابو نؤاس.
أجّرنا شقة!
اجرنا شقة في الطابق الأرضي وأخذنا ننظفها، نكشط الأرض من طبقات الوسخ ونعيد صبغ الحائط. نفتح الشبابيك لكي يدخل إلينا بعض من دفء الشمس المعقّم، لكن حتى الشمس بأكملها تعجز عن تعقيم تراكمات الدمار في هذا المكان. تظهر القطة وصغيراتها يلعبن، تنظر إليّ بعينيها الساحرتين بينما تأكل صغيراتها حتى التخمة من “التونا” التي أسكبها من الشباك. قطة عراقية مُعنّفة من أطفال الحي المعنفين من آبائهم المعنفين من الضابط والشرطي المعنف.
أٌلقي السلام يومياً على جنود في السيطرة القريبة. أمر بها في طريق عودتي من شراء الخضراوات أو من المشي في الحدائق أمام نهر دجلة. في أحد الأيام، سار خلفي رئيس عرفاء الجنود وتتبعني حتى مدخل العمارة. دقّ الباب بعد أن دخلت وعندما فتحت له كان ينظر خلفي داخل الشقة. “تفضل؟” قلت، لم يكن ينظر إلى عيني أبداً. سألني:
- من يسكن هنا؟
- – أنا وحدي، كذبت.
- بس اسم المستأجر عندي (فلان) وقال اسم رجل.
- – آني نازلة عنده مؤقتاً، ألّفت القصة في لحظتها.
تخيفني نظراته أكثر مما يخيفني القانون. فهو يبدو كما -تقول بيبي- “حاك جلده على مشكلة”. نتناقش أنا وهو لبرهة، لا أدري ما الذي شفع لي في الأخير! ربما هدوئي والجرأة المصطنعة التي أحمي نفسي بها!
يذهب، ولكنه لن ينساني.
العيش مع الحرس!
أيامي تلك مليئة بالقلق. الحرس يفتعلون المشاكل بين يوم وآخر. واصدقائي لهم مشاكلهم الخاصة. بغداد ليست مدينة يسهل العيش فيها. أحاكي نفسي وأحاكي القطط. تعوّدت أن أواجه الحياة وحدي. تتصل أمي فأقول لها أن كل شيء على ما يرام، لأنها لن تفهم حياتي. لا ألومها على ذلك فهي عاشت مآسيها من حروب حزب البعث إلى الحصار الوحشي الذي فرضه العالم على العراق. لم تكن لأمي الفرصة أن تثور على الأول والتالي، وتعيش على مزاجها. فهي حملت بي وولدتني تحت قصف عام 1991. أما أنا فأختار ألا أكون أماً لأن المستقبل يقلقني، لا أرى شيئا مبشرا فيه. يغرُّبنا اختلاف مشاكلنا عن بعض، لكننا نحاول إيجاد مشترك نتكئ عليه. تواسيني القطط، الصغيرات صرن يدخلن الشقة عبر “السيم” الممزق من شباكي، يأكلن ويهربن عن العالم الذي لا يرحمهن ولا يرحمني. هنا سوف أطعم ثلاثة أجيال من عائلة القطط واعيش لسنتين من أجمل وأصعب سنوات حياتي، وسأتزوج واحتفل وأبكي مع اصدقاء العمر، وسيعلمني العراق دروس حياة، فيعجنني ويخبزني بحرارة جحيمه.
عودة الى الوراء
قبل ثلاث سنوات كنت قد تمرّدت على كل الثوابت المفروضة علي وحجزت بطاقة سفري وأعلنت عودتي للعراق من دون فتح المجال لتعليق من أي أحد. كنت غاضبة في عشرينات عمري، لم أعرف وقتها لِمَ، لكنني كنت مستعدة لشن حرب على أيِّ شخص يقف في طريقي.
كان عاما 2016 و2017. عندما أتطرق لموضوع زيارة بغداد، تردّ عائلتي بجواب كلاسيكي جاهز يسحبونه من أطراف ألسنتهم: “الوضع مو زين”.

ربما لأني عاشرت صديقات فلسطينيات طيلة اغترابي، فقد كانت فكرة “العودة” محصّنة في زمرة المبادئ التي أمشي حاملة إياها على ظهري: العودة للوطن. مخاض سامٍ، يستحق النضال من أجله، فمن حقنا العيش مع شعب يشبهنا، نتشارك معه الحلوة والمرة. لكن داخل العائلات العراقية، وخاصة التي كانت حولي في تلك السنوات، لا أحد يعود.
الناجي لا ينظر وراءه لأن المنظر مؤلم.
من يعدن هن الجدات فقط. أولئك النسوة اللواتي يردن بيع بيوتهن أو إكمال معاملة. نساء “الأوّل” اللاتي لا يخفن شيئاً، ولا أحد يتجرأ على قول “لا” لهن. بالإضافة بالطبع إلى رجال تغطيهم هالة الشبهة، عندما يكون المرء بحضرتهم يشعر بدبق الدناءة يلطخ جسده. رجال صارت لديهم أموال طائلة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ولا يفهم أحد كيف!
لا يعود للعراق حولي غيرهم.
لكن ها أنا بعد سنوات أعود إلى بغداد وأعيش في الكرادة وابدأ بتكوين صداقات جديدة تمدّني بالطاقة لمعايشة الواقع. بدأت صداقتي مع دكتور أحمد في عيادته البسيطة وسط بيوت الكرادة التي تُهدّم هي وحدائقها كل يوم لتشيّد بدلها بيوت بلا حدائق ولا نخل. عيادة الدكتور صغيرة ومكتظة بأغراض الحيوانات. تأتي له بنات الجادرية مع قططهن المدللة ويأتي مطيرجية أبو نؤاس حاملين طيورهم على صدورهم، ويأتي أبو الغاز راكباً عربة يجرها حصانه البني ورفيقه الكلب العجوز الذي لا يفارقه وهم يدورون شوارع الكرادة كل يوم.
لا يأخذ الدكتور أجوراً ممن يأتون له بحيوانات الشارع المتضررة من قسوة وعشوائية المدينة. الناس مثل أحمد كثيرون في بغداد. يعملون في زواياهم الآمنة، ولا ينجو أحد ولن ينجو من دون هؤلاء وطيبتهم. يذكروني بوالدي الذي لا ينافس حجم عصبيته إلا حجم طيبة قلبه. تذكرني هذه النزعة المألوفة بأنني أنتمي إلى هذه “الكاع” وليس لأي مكان آخر. يضع الدكتور أحمد صحن طعام خارج عيادته لعتوي مرقط سمين، يترصد الطعام من على السياجات ويقفز بين الدراجات النارية التي تحاول تفادي السيطرات بين الفروع الهادئة، ليلقي نظرة تُضحِك الدكتور ويشبع عند الباب ثم يهرب.
تسكن صديقتي المقربة في الجادرية، ليس بعيداً. تأخذني بسيارتها بين الحين والآخر لنطوف في شوارع بغداد. نغني مع المذياع ونصعد جسر الجادرية من دون وجهة، نغني مع المزيقات التي تنتظر العرسان ونشاهد أحياناً سباقات سيارات يقيمها شباب تحت الجسر، “يفحطون” انتفاضاً على العالم الصاخب حولهم. أعرف الصديقة منذ سنوات من خلال عملنا في مجال حقوق المرأة. فعندما عدت للعراق في عام 2018 كنت أعمل في منظمة نسوية عراقية، أترجم تقارير وأكتب نصوصا تخص عملهم لمانحين يمولون بالوقت ذاته كل المؤسسات الدولية التي دمرت العراق. “بعدين سوو علينا فضل واعطونا بعض المال نعيد به بناء ما دمر”.
كان العالم ومازال يربكني.
كان بيت بيبي وجدو، وقتها، مكاناً هادئاً فيه صورٌ قديمة وغرفة أبي وكتب جدي المرصوصة على طول الجدران. حديقتنا التي جلست تحت شجرة “التكي” فيها ونمت على حشيشها أيام انقطاع الكهرباء في طفولتي. أشياء أتذكرها وأخرى أتعرف عليها من جديد.
كانت عودتي إلى بيت جدي وأنا تاركة خلفي عمل المنظمات بعد أقل من سنة بداية عمر جديد قد قررت فيه، بكل طيش الشباب، أن أكتب تاريخ حياتي كما أريد. رحبا، بيبي وجدو، بعودتي. الحفيدة الوحيدة التي رفضت الغربة، لكن المفاوضات اليومية كانت تعيد لي اختناق المراهقة.
لا ألومهما، فقد كبر أولادهما واعتقدوا أنهم انتهوا من مأساة المسؤولية، حتى خرجت لهم من حلم بعيد. أُريد حرية شخصية وخرق مخاوف متوارثة و، و، و. هاجرت عائلتي وقت الحصار وبيبي وجدو كأنهما ما زالا يعيشان الحرب. يخافان من كل شيء حولهم. كنت أحب النوم ليلاً على المرجوحة في الحديقة. أحلم تحت ضوء القمر، لكن جدتي تجبرني على الدخول. تقول لي إن الحرامية سيتشقلبون من فوق سياجنا ويخطفونك من حديقتنا. فأدخل. وبعد أن تعود للنوم افتح الباب لرزوقي، قطي الصغير الذي يحب الجلوس تحت ورد الرازقي ذات الرائحة الفريدة، يعرف أن عليه السكوت لئلا يكشفوننا وينقلب البيت فوق رأسينا. نصعد أنا وهو فجراً إلى السطح. يقفز من مكانات لا أتوقعها، ويركض إلى الشارع ملتفتاً للخلف وكأنه يقول لي، “يله روحي نامي”.

رزوقي كان يركض من رأس الشارع عندما يراني أنزل من التاكسي عائدة من العمل أو من لقاء أصدقاء. يعرف أني جلبت له علبة سردين، يأكلها في ركن من الحديقة ثم يأتي لينام عند قدمي. هكذا قضينا تلك الأيام، حاملين لبعضنا ورود المحبة والنجاة. كان رزوقي أول وردة في حياتي البغدادية الجديدة.
بدأت تشرين
عندما بدأت تظاهرات تشرين الأول عام ٢٠١٩، أنفق جدي أيامه يشاهد التلفاز. يرقب الأخبار وهو يبكي ويقرأ الأدعية لهذا البلد الذي لا نعرف كيف ننجو فيه. عرفت حينها أني لا يمكن أن أكون هنا، في بيته، لأنه وجدتي إذا علما أنني كنت في الساحات كل يوم، لا أعلم ماذا سيحدث لهما.
أنا معتادة على الترحال. عندما بدأت التظاهرات، كانت صديقتي تملأ سيارتها بالأكل والأدوية لتنقلها كل يوم إلى ساحة التحرير.
تركت بيت جدّيَّ وعشت مع صديقتي وعائلتها الصغيرة متطفلة على حياتهم. أنام على الكنبة عندها، وعلى الأرض تنام متظاهرات أُخريات. كنا لاجئات عند هذه الإنسانة الشجاعة.
انتهت الثورة وبدأت مأساة “كورونا”. سافرت، ثم عدت، وها أنا أسكن في الكرادة، أحاول أن أعيد زرع جذوري في التربة الخصبة لبلاد الرافدين. أصدقاء غادروا البلاد خوفاً من الاغتيال، وآخرون تراجعوا إلى دواخلهم يقلبون الخسائر وخيبات الأمل. يوماً ما، ذهبت للقاء صديق في قهوة جديدة في الجادرية بين مقرات عصائب أهل الحق، كانت القهوة مليئة بشباب وشابات يتسكّعون في بقعة صغيرة بعيدة عن أعين الناس. تأخرنا بالحديث ونحن نتكلم عن المستقبل. “ابقى لو اروح؟ شسوي؟” سألني صديقي عن الهجرة وأنا حقاً لا اعرف الإجابة. تحيرني دائماً مآزقنا، فنحن نريد أن نكون هنا لكن كل شيء هنا يرفضنا. هل نموت -جسدياً، معنوياً، نفسياً- من أجل البقاء؟
تداهمني الأسئلة وانا خارجة من المقهى أبحث عن تكسي يأخذني للبيت. قرب السيطرة سمعت صوت بكاء قطة صغيرة. رآني أحد الشرطة اتلفت يميناً وشمالاً فقال إن القطة نائمة تحت عجلة السيارة. كائن منكوش أصغر من كف يدي. حملتها فقال لي إن أختها موجودة أيضاً. سالت الشرطي إذا كان لديه صندوق آخذ فيها القطط، فطار من الفرحة وقفز يبحث في كومة ما حتى وجد صندوق معلبات معجون طمامة، “الله جابچ، الله رحم بيهم، رح يموتن هنا” قال لي انه يطعمهم الگيمر من البارحة ولكنهن لا يأكلن ويواصلن البكاء طول الوقت.
قدّرت عمر القطتين بأسبوعين أو أقل. قال الشرطي إن أحد سكان البيوت الفخمة في الجادرية رماهما هنا حتى لا تعثر أمهما عليهما وتعيدهما إلى حديقته حيث يعكر صوتهما مزاج حضرته. طلبت من التاكسي التوقف عند صيدلية، اشتريت منها “سرنجات” وحليبا خاليا من اللاكتوز.
كلما كاد الحزن أن يقتلني، كانت قطط الشارع تنقذني من أفكاري.
هلهلت صديقتي عندما رأتني بعد أشهر من حياة الكتمان نحاول فيها البقاء خارج رادار الحكومة (والمجتمع والعائلة)، تزوجنا أنا وحبيبي. وهي تضحك وتسب مؤسسة الزواج. نحن مع مبادئنا المرفوضة نحاول العيش في هذا العالم في نهاية المطاف. فنلقى مثالياتنا أحياناً في الشط لكي نرى الغد ونحن أحياء. يأتي قط رمادي إلى عتبة باب بيتها المفتوح يمسح نفسه على سيقاننا وهو يتحايل علينا من أجل الطعام. تضحك صديقتي وهي تضع له قطعة طعام وتقول “كبروا خصاويه، باچر يصير واحد ذكوري يفتر يعنف المنطقة”.
بعد زواجي، صار الحرس على طريق البيت لا يزعجوني. تركوني وشأني حتى أنهم صاروا يكلمونني عن الحيوانات لأنهم يروني أتوقف في منتصف الشارع أُلاعبها.

في يوم ما، رآني أحد الحراس احمل آلة العود وأنا عائدة من درس في مدرسة مصطفى زاير في الأعظمية، طلب مني العزف على الآلة المعلقة على كتفي. هو رجل ذو هيئة رقيقة، يعزف موسيقى حساسة ويتكلم كأنه يطبطب بقطنة على جرح. لا أعرف كيف وصل به الحال ان ينتسب للسلك العسكري، ولكنه العراق، حيث يضيع آلاف الشباب في الانعطافات التشكيلية المطبوعة على الخاكي. تبتلع القيافة والبيريه حياتهم كوحش ذي ألف روح، قصة ألف وليلة لا تنتهي شهرزاد عن مواصلة رويها. أنامله تسحر العود، تظهر قطتان شقراوان من خلفه، تمشيان نحوي من دون خوف، لاحقتاني حتّى مطبخ شقتي لتأكلان حصتهما من السمك المسگوف. سماهم صديقنا: نجمة وغيمة. ومثل الدليل في سماء الصحراء المرعبة، أنقذتني تلك القطتان من الإحباط والحزن الذي ملأ أيامي تلك.
كبرت غيمة!
كبرت الشقراوان بسرعة. كانت غيمة أصغر ووجهها معبر. تتصرف بمزاج أرستقراطي. لا تنوح من أجل الطعام، فهي تعرف أن رزقها قادم. تدخل البيت وتلتوي أمام “الصوپة” أو في حضني. تراقبني وأنا منحنية على الحاسوب أكتب أو أُترجم أو أحل لغزا ما على الطاولة. تنظر إليّ مكسورة الخاطر لأني أقضي وقتي بهذا الهراء.
فهمت غيمة حقيقة أعمق بكثير عن بساطة الحياة. غيمة الأرستقراطية لم تكن تهتم لأحد البتة، تحب النوم غالباً كأنها تعيش في عالم أحلامها في مكان جميل فيه نهر مليء بالسمك وسماء مليئة بالطيور. تعيش في احلامها ببغداد احلامنا. اما نجمة فاتضح بعد فترة انه بالحقيقة نجم. وبعد ذلك بفترة ترك اسمه الأول والثاني وصار يعرف في الحي بـ”پابلو” تيمنا ببابلو اسكوبار. بابلو كان عصابچي بكل معنى الكلمة، يصرخ من أجل الطعام ويا ويل من يترك باب المطبخ مفتوحاً، فهو لا يشبع، يتسلق كل شيء ليصل إلى ما يريد، يفرش ساقيه وراءه وينام على بطنه على السرير، يرهب القطط الصغيرات في المنطقة. لا يسلم أحد منه، ولا شيء، لا ستارة معلقة، ولا شاشة حاسوب. مشاكس محبوب. كل اصدقائنا يحبون غيمة وبابلو، يلاعبونهما حين نجتمع جميعنا لنشاهد فيلما او ندخن باكيتات لا تعد ولا تحصى من السجائر ونحن نطلع من موضوع وندخل في آخر وقطط الشارع بين أرجلنا. ثم يرميهما أحدهم من الشباك لأنهما أصبحا مزعجين، فيلتفان حول العمارة وينوحان عند الباب.
هم متظاهرون ونحن كلنا متظاهرون سابقون، فيرق قلبنا عليهم. نعيش هكذا، مع حب شديد وضحك ولعب مع حيوانات تلاعبنا كأنها تريد إنقاذنا من مآسينا. علمتني نجمة بتقبلها للواقع أن لا اسأل لِمَ أنا في هذا المكان وما دوري فيه، بل أن أكون فيه فحسب، فأنا خلقت فيه وكبرت فيه ولا جدوى من إيجاد معنى أو سبب لذلك.
أتذكر القطة الأم كلما أنظر للسياج الذي يفصلنا عن الخرابة الكبيرة. اختفت تلك الجميلة وتعلمت تقبل كل الأفكار المحزنة بعد رحيلها، فبعض أحزاننا لن نجد لها نهاية أبداً. نرميها في نهر دجلة لكي يأخذها بعيداً لتلتهمها الوحوش الأزلية في شط العرب والخليج، تشبك المواجع أرواحنا بالمدينة والنهر. الخرابة أُزيحت عنها النفايات وصارت تجيء وفوداً يلبس أفرادها بدلاتٍ وأحذية تلمع. يأتون للفرع مع شخص، كما يبدو، ليحاولوا إقناعه بشراء الأرض.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
في بداية رحلتي الشاقة، قدمت لها قرباناً “علبة تونا”. كنت أراقبها من مسافة بعيدة مستلقية تحت ضوء الشمس في الخرابة، وكانت تظهر بين الحين والآخر من بين أكوام الأثاث الممزق والالكترونيات المهجورة المنثورة في كومة الزبالة المطلة على شارع أبي نؤاس وسط بغداد، حيث كنا نعيش -أو نحاول ذلك- أنا وحبيبي. كانت تظهر شاحبة الوجه ونحيلة الجسد، تنظر إلينا من بعيد وقطتاها الصغيرتان ملتصقتان بها.
احترمتها، فهي من الناجيات على هذه الأرض وفي هذه المدينة القاسية، حيث كنت أشعر بالضياع، غير واثقة من قراراتي. أتعثر باختياراتي وقناعاتي. لكن عندما أراها أنسى محنتي، ولو لوهلة. أنسى المخاوف التي تدور في رأسي ممزوجة بضجيج الشارع والمولدات ودوريات الشرطة.
كانت هذه أصوات الحياة.
أذهب إلى الدكان واشتري علبة “تونا” لأفرغها بعد ذلك على مسافة بعيدة من عائلة القطط الهاربة من البشر. كانت الأُم صاحبة الفرو الأسود والأبيض تدعو صغيراتها ليأكلن كل الطعام، وتبقى هي تنظر إليّ من بعيد. أُحدثها كمن فقد عقله وهي لا تشيل عينيها الخضراوين عني. أطلب منها المراد.. أطلب منها أن تعلمني كيف أنجو.
الأسابيع الأولى
قضيت أول أسابيعي في هذه العمارة على أبي نؤاس: امرأة عراقية غير متزوجة تحاول العيش في مدينتها، مسقط رأسها ومسقط رأس أبيها وجداتها وجداتهم، لكنني والقطة نعرف أن ليس لنا مكاناً في هذا العالم إلا قرب الحائط وبين الأكوام المنسية، نتفادى الشر ونمتن لأبسط ما نجده من خير.
رأيت الشر في نظرات الناس وأنا أبحث عن شقة أسكنها.
نمشي، حبيبي وأنا، في شوارع الكرادة حيث يعمل، نبحث عن لافتات تعرض شققاً للإيجار، نُكلِّم الحراس الذين يسألون “هاي زوجتك؟” وهم يدرسونني بتمعّن. يجيب أحياناً بنعم وأحياناً بلا. الموقف غريب، لا أنا ولا هو نعرف كيف نتعامل مع عالم خارج عالمنا الخاص، عالم الشباب الخارج عن قيود المجتمع. اختلاف رغبتنا بطريقة العيش يشكل خطراً على المجتمع كما يبدو. نصعد للطابق الفلاني ونرى الشقة الكئيبة التي يجب أن أكون متزوجة حتى أسكن فيها. نعرف ويعرف صاحبها انه لن يقبلنا، لكنه يأخذنا على “كد عقلنا” أو يتفادى الإحراج. لا أعرف، ولكنني أفهم انني غير مرحب بي. يتعاطف معنا أحد الحراس، رجل كبير في السن، يرش الحديقة والشتلات أمام مدخل عمارته. يقول “انت بنت حبابة، لكن تعرفين الموضوع صعب. المخابرات تفتش العمارات وتريد تشوف عقد الزواج”.

يذكرني الرجل بجدي الذي يرش الحديقة حتى يملأ الشارع مياهاً كل يوم، ثم يفتح باب الحديقة ويوزع حلوى على أولاد الجيران. العيش في بيت جدي أسهل من هذا كله، لكني متمسكة باختياري أن أكون مستقلة. لست وحدي في هذا المأزق. نساء عازبات وأزواج حولي يعانون المحنة نفسها. منهم من رشى الناطور بـ”ورقة” (مئة دولار) أو شاشة تلفزيون، ومنهم من “مشه أموره بعقد سيد” يحصلون عليه من إحدى درابين الكاظمية حيث يتزوج الرجال على زوجاتهم من بنات بنصف أعمارهم. لا ألوم الحراس والجيران، فكل عاش مأساته ويريد تجنب المشاكل. فهنا إذا كنت تريد امتلاك طريقتك في الحياة والدفاع عنها، فمن الأفضل أن تتحلى بالشجاعة. انا وحبيبي لا يوجد لدينا أكثر من هذا، وقد قادنا الإصرار فوجدنا هذه العمارة المتآكلة في هذا الفرع المهمل القريب من شارع ابو نؤاس.
أجّرنا شقة!
اجرنا شقة في الطابق الأرضي وأخذنا ننظفها، نكشط الأرض من طبقات الوسخ ونعيد صبغ الحائط. نفتح الشبابيك لكي يدخل إلينا بعض من دفء الشمس المعقّم، لكن حتى الشمس بأكملها تعجز عن تعقيم تراكمات الدمار في هذا المكان. تظهر القطة وصغيراتها يلعبن، تنظر إليّ بعينيها الساحرتين بينما تأكل صغيراتها حتى التخمة من “التونا” التي أسكبها من الشباك. قطة عراقية مُعنّفة من أطفال الحي المعنفين من آبائهم المعنفين من الضابط والشرطي المعنف.
أٌلقي السلام يومياً على جنود في السيطرة القريبة. أمر بها في طريق عودتي من شراء الخضراوات أو من المشي في الحدائق أمام نهر دجلة. في أحد الأيام، سار خلفي رئيس عرفاء الجنود وتتبعني حتى مدخل العمارة. دقّ الباب بعد أن دخلت وعندما فتحت له كان ينظر خلفي داخل الشقة. “تفضل؟” قلت، لم يكن ينظر إلى عيني أبداً. سألني:
- من يسكن هنا؟
- – أنا وحدي، كذبت.
- بس اسم المستأجر عندي (فلان) وقال اسم رجل.
- – آني نازلة عنده مؤقتاً، ألّفت القصة في لحظتها.
تخيفني نظراته أكثر مما يخيفني القانون. فهو يبدو كما -تقول بيبي- “حاك جلده على مشكلة”. نتناقش أنا وهو لبرهة، لا أدري ما الذي شفع لي في الأخير! ربما هدوئي والجرأة المصطنعة التي أحمي نفسي بها!
يذهب، ولكنه لن ينساني.
العيش مع الحرس!
أيامي تلك مليئة بالقلق. الحرس يفتعلون المشاكل بين يوم وآخر. واصدقائي لهم مشاكلهم الخاصة. بغداد ليست مدينة يسهل العيش فيها. أحاكي نفسي وأحاكي القطط. تعوّدت أن أواجه الحياة وحدي. تتصل أمي فأقول لها أن كل شيء على ما يرام، لأنها لن تفهم حياتي. لا ألومها على ذلك فهي عاشت مآسيها من حروب حزب البعث إلى الحصار الوحشي الذي فرضه العالم على العراق. لم تكن لأمي الفرصة أن تثور على الأول والتالي، وتعيش على مزاجها. فهي حملت بي وولدتني تحت قصف عام 1991. أما أنا فأختار ألا أكون أماً لأن المستقبل يقلقني، لا أرى شيئا مبشرا فيه. يغرُّبنا اختلاف مشاكلنا عن بعض، لكننا نحاول إيجاد مشترك نتكئ عليه. تواسيني القطط، الصغيرات صرن يدخلن الشقة عبر “السيم” الممزق من شباكي، يأكلن ويهربن عن العالم الذي لا يرحمهن ولا يرحمني. هنا سوف أطعم ثلاثة أجيال من عائلة القطط واعيش لسنتين من أجمل وأصعب سنوات حياتي، وسأتزوج واحتفل وأبكي مع اصدقاء العمر، وسيعلمني العراق دروس حياة، فيعجنني ويخبزني بحرارة جحيمه.
عودة الى الوراء
قبل ثلاث سنوات كنت قد تمرّدت على كل الثوابت المفروضة علي وحجزت بطاقة سفري وأعلنت عودتي للعراق من دون فتح المجال لتعليق من أي أحد. كنت غاضبة في عشرينات عمري، لم أعرف وقتها لِمَ، لكنني كنت مستعدة لشن حرب على أيِّ شخص يقف في طريقي.
كان عاما 2016 و2017. عندما أتطرق لموضوع زيارة بغداد، تردّ عائلتي بجواب كلاسيكي جاهز يسحبونه من أطراف ألسنتهم: “الوضع مو زين”.


ربما لأني عاشرت صديقات فلسطينيات طيلة اغترابي، فقد كانت فكرة “العودة” محصّنة في زمرة المبادئ التي أمشي حاملة إياها على ظهري: العودة للوطن. مخاض سامٍ، يستحق النضال من أجله، فمن حقنا العيش مع شعب يشبهنا، نتشارك معه الحلوة والمرة. لكن داخل العائلات العراقية، وخاصة التي كانت حولي في تلك السنوات، لا أحد يعود.
الناجي لا ينظر وراءه لأن المنظر مؤلم.
من يعدن هن الجدات فقط. أولئك النسوة اللواتي يردن بيع بيوتهن أو إكمال معاملة. نساء “الأوّل” اللاتي لا يخفن شيئاً، ولا أحد يتجرأ على قول “لا” لهن. بالإضافة بالطبع إلى رجال تغطيهم هالة الشبهة، عندما يكون المرء بحضرتهم يشعر بدبق الدناءة يلطخ جسده. رجال صارت لديهم أموال طائلة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ولا يفهم أحد كيف!
لا يعود للعراق حولي غيرهم.
لكن ها أنا بعد سنوات أعود إلى بغداد وأعيش في الكرادة وابدأ بتكوين صداقات جديدة تمدّني بالطاقة لمعايشة الواقع. بدأت صداقتي مع دكتور أحمد في عيادته البسيطة وسط بيوت الكرادة التي تُهدّم هي وحدائقها كل يوم لتشيّد بدلها بيوت بلا حدائق ولا نخل. عيادة الدكتور صغيرة ومكتظة بأغراض الحيوانات. تأتي له بنات الجادرية مع قططهن المدللة ويأتي مطيرجية أبو نؤاس حاملين طيورهم على صدورهم، ويأتي أبو الغاز راكباً عربة يجرها حصانه البني ورفيقه الكلب العجوز الذي لا يفارقه وهم يدورون شوارع الكرادة كل يوم.
لا يأخذ الدكتور أجوراً ممن يأتون له بحيوانات الشارع المتضررة من قسوة وعشوائية المدينة. الناس مثل أحمد كثيرون في بغداد. يعملون في زواياهم الآمنة، ولا ينجو أحد ولن ينجو من دون هؤلاء وطيبتهم. يذكروني بوالدي الذي لا ينافس حجم عصبيته إلا حجم طيبة قلبه. تذكرني هذه النزعة المألوفة بأنني أنتمي إلى هذه “الكاع” وليس لأي مكان آخر. يضع الدكتور أحمد صحن طعام خارج عيادته لعتوي مرقط سمين، يترصد الطعام من على السياجات ويقفز بين الدراجات النارية التي تحاول تفادي السيطرات بين الفروع الهادئة، ليلقي نظرة تُضحِك الدكتور ويشبع عند الباب ثم يهرب.
تسكن صديقتي المقربة في الجادرية، ليس بعيداً. تأخذني بسيارتها بين الحين والآخر لنطوف في شوارع بغداد. نغني مع المذياع ونصعد جسر الجادرية من دون وجهة، نغني مع المزيقات التي تنتظر العرسان ونشاهد أحياناً سباقات سيارات يقيمها شباب تحت الجسر، “يفحطون” انتفاضاً على العالم الصاخب حولهم. أعرف الصديقة منذ سنوات من خلال عملنا في مجال حقوق المرأة. فعندما عدت للعراق في عام 2018 كنت أعمل في منظمة نسوية عراقية، أترجم تقارير وأكتب نصوصا تخص عملهم لمانحين يمولون بالوقت ذاته كل المؤسسات الدولية التي دمرت العراق. “بعدين سوو علينا فضل واعطونا بعض المال نعيد به بناء ما دمر”.
كان العالم ومازال يربكني.
كان بيت بيبي وجدو، وقتها، مكاناً هادئاً فيه صورٌ قديمة وغرفة أبي وكتب جدي المرصوصة على طول الجدران. حديقتنا التي جلست تحت شجرة “التكي” فيها ونمت على حشيشها أيام انقطاع الكهرباء في طفولتي. أشياء أتذكرها وأخرى أتعرف عليها من جديد.
كانت عودتي إلى بيت جدي وأنا تاركة خلفي عمل المنظمات بعد أقل من سنة بداية عمر جديد قد قررت فيه، بكل طيش الشباب، أن أكتب تاريخ حياتي كما أريد. رحبا، بيبي وجدو، بعودتي. الحفيدة الوحيدة التي رفضت الغربة، لكن المفاوضات اليومية كانت تعيد لي اختناق المراهقة.
لا ألومهما، فقد كبر أولادهما واعتقدوا أنهم انتهوا من مأساة المسؤولية، حتى خرجت لهم من حلم بعيد. أُريد حرية شخصية وخرق مخاوف متوارثة و، و، و. هاجرت عائلتي وقت الحصار وبيبي وجدو كأنهما ما زالا يعيشان الحرب. يخافان من كل شيء حولهم. كنت أحب النوم ليلاً على المرجوحة في الحديقة. أحلم تحت ضوء القمر، لكن جدتي تجبرني على الدخول. تقول لي إن الحرامية سيتشقلبون من فوق سياجنا ويخطفونك من حديقتنا. فأدخل. وبعد أن تعود للنوم افتح الباب لرزوقي، قطي الصغير الذي يحب الجلوس تحت ورد الرازقي ذات الرائحة الفريدة، يعرف أن عليه السكوت لئلا يكشفوننا وينقلب البيت فوق رأسينا. نصعد أنا وهو فجراً إلى السطح. يقفز من مكانات لا أتوقعها، ويركض إلى الشارع ملتفتاً للخلف وكأنه يقول لي، “يله روحي نامي”.


رزوقي كان يركض من رأس الشارع عندما يراني أنزل من التاكسي عائدة من العمل أو من لقاء أصدقاء. يعرف أني جلبت له علبة سردين، يأكلها في ركن من الحديقة ثم يأتي لينام عند قدمي. هكذا قضينا تلك الأيام، حاملين لبعضنا ورود المحبة والنجاة. كان رزوقي أول وردة في حياتي البغدادية الجديدة.
بدأت تشرين
عندما بدأت تظاهرات تشرين الأول عام ٢٠١٩، أنفق جدي أيامه يشاهد التلفاز. يرقب الأخبار وهو يبكي ويقرأ الأدعية لهذا البلد الذي لا نعرف كيف ننجو فيه. عرفت حينها أني لا يمكن أن أكون هنا، في بيته، لأنه وجدتي إذا علما أنني كنت في الساحات كل يوم، لا أعلم ماذا سيحدث لهما.
أنا معتادة على الترحال. عندما بدأت التظاهرات، كانت صديقتي تملأ سيارتها بالأكل والأدوية لتنقلها كل يوم إلى ساحة التحرير.
تركت بيت جدّيَّ وعشت مع صديقتي وعائلتها الصغيرة متطفلة على حياتهم. أنام على الكنبة عندها، وعلى الأرض تنام متظاهرات أُخريات. كنا لاجئات عند هذه الإنسانة الشجاعة.
انتهت الثورة وبدأت مأساة “كورونا”. سافرت، ثم عدت، وها أنا أسكن في الكرادة، أحاول أن أعيد زرع جذوري في التربة الخصبة لبلاد الرافدين. أصدقاء غادروا البلاد خوفاً من الاغتيال، وآخرون تراجعوا إلى دواخلهم يقلبون الخسائر وخيبات الأمل. يوماً ما، ذهبت للقاء صديق في قهوة جديدة في الجادرية بين مقرات عصائب أهل الحق، كانت القهوة مليئة بشباب وشابات يتسكّعون في بقعة صغيرة بعيدة عن أعين الناس. تأخرنا بالحديث ونحن نتكلم عن المستقبل. “ابقى لو اروح؟ شسوي؟” سألني صديقي عن الهجرة وأنا حقاً لا اعرف الإجابة. تحيرني دائماً مآزقنا، فنحن نريد أن نكون هنا لكن كل شيء هنا يرفضنا. هل نموت -جسدياً، معنوياً، نفسياً- من أجل البقاء؟
تداهمني الأسئلة وانا خارجة من المقهى أبحث عن تكسي يأخذني للبيت. قرب السيطرة سمعت صوت بكاء قطة صغيرة. رآني أحد الشرطة اتلفت يميناً وشمالاً فقال إن القطة نائمة تحت عجلة السيارة. كائن منكوش أصغر من كف يدي. حملتها فقال لي إن أختها موجودة أيضاً. سالت الشرطي إذا كان لديه صندوق آخذ فيها القطط، فطار من الفرحة وقفز يبحث في كومة ما حتى وجد صندوق معلبات معجون طمامة، “الله جابچ، الله رحم بيهم، رح يموتن هنا” قال لي انه يطعمهم الگيمر من البارحة ولكنهن لا يأكلن ويواصلن البكاء طول الوقت.
قدّرت عمر القطتين بأسبوعين أو أقل. قال الشرطي إن أحد سكان البيوت الفخمة في الجادرية رماهما هنا حتى لا تعثر أمهما عليهما وتعيدهما إلى حديقته حيث يعكر صوتهما مزاج حضرته. طلبت من التاكسي التوقف عند صيدلية، اشتريت منها “سرنجات” وحليبا خاليا من اللاكتوز.
كلما كاد الحزن أن يقتلني، كانت قطط الشارع تنقذني من أفكاري.
هلهلت صديقتي عندما رأتني بعد أشهر من حياة الكتمان نحاول فيها البقاء خارج رادار الحكومة (والمجتمع والعائلة)، تزوجنا أنا وحبيبي. وهي تضحك وتسب مؤسسة الزواج. نحن مع مبادئنا المرفوضة نحاول العيش في هذا العالم في نهاية المطاف. فنلقى مثالياتنا أحياناً في الشط لكي نرى الغد ونحن أحياء. يأتي قط رمادي إلى عتبة باب بيتها المفتوح يمسح نفسه على سيقاننا وهو يتحايل علينا من أجل الطعام. تضحك صديقتي وهي تضع له قطعة طعام وتقول “كبروا خصاويه، باچر يصير واحد ذكوري يفتر يعنف المنطقة”.
بعد زواجي، صار الحرس على طريق البيت لا يزعجوني. تركوني وشأني حتى أنهم صاروا يكلمونني عن الحيوانات لأنهم يروني أتوقف في منتصف الشارع أُلاعبها.



في يوم ما، رآني أحد الحراس احمل آلة العود وأنا عائدة من درس في مدرسة مصطفى زاير في الأعظمية، طلب مني العزف على الآلة المعلقة على كتفي. هو رجل ذو هيئة رقيقة، يعزف موسيقى حساسة ويتكلم كأنه يطبطب بقطنة على جرح. لا أعرف كيف وصل به الحال ان ينتسب للسلك العسكري، ولكنه العراق، حيث يضيع آلاف الشباب في الانعطافات التشكيلية المطبوعة على الخاكي. تبتلع القيافة والبيريه حياتهم كوحش ذي ألف روح، قصة ألف وليلة لا تنتهي شهرزاد عن مواصلة رويها. أنامله تسحر العود، تظهر قطتان شقراوان من خلفه، تمشيان نحوي من دون خوف، لاحقتاني حتّى مطبخ شقتي لتأكلان حصتهما من السمك المسگوف. سماهم صديقنا: نجمة وغيمة. ومثل الدليل في سماء الصحراء المرعبة، أنقذتني تلك القطتان من الإحباط والحزن الذي ملأ أيامي تلك.
كبرت غيمة!
كبرت الشقراوان بسرعة. كانت غيمة أصغر ووجهها معبر. تتصرف بمزاج أرستقراطي. لا تنوح من أجل الطعام، فهي تعرف أن رزقها قادم. تدخل البيت وتلتوي أمام “الصوپة” أو في حضني. تراقبني وأنا منحنية على الحاسوب أكتب أو أُترجم أو أحل لغزا ما على الطاولة. تنظر إليّ مكسورة الخاطر لأني أقضي وقتي بهذا الهراء.
فهمت غيمة حقيقة أعمق بكثير عن بساطة الحياة. غيمة الأرستقراطية لم تكن تهتم لأحد البتة، تحب النوم غالباً كأنها تعيش في عالم أحلامها في مكان جميل فيه نهر مليء بالسمك وسماء مليئة بالطيور. تعيش في احلامها ببغداد احلامنا. اما نجمة فاتضح بعد فترة انه بالحقيقة نجم. وبعد ذلك بفترة ترك اسمه الأول والثاني وصار يعرف في الحي بـ”پابلو” تيمنا ببابلو اسكوبار. بابلو كان عصابچي بكل معنى الكلمة، يصرخ من أجل الطعام ويا ويل من يترك باب المطبخ مفتوحاً، فهو لا يشبع، يتسلق كل شيء ليصل إلى ما يريد، يفرش ساقيه وراءه وينام على بطنه على السرير، يرهب القطط الصغيرات في المنطقة. لا يسلم أحد منه، ولا شيء، لا ستارة معلقة، ولا شاشة حاسوب. مشاكس محبوب. كل اصدقائنا يحبون غيمة وبابلو، يلاعبونهما حين نجتمع جميعنا لنشاهد فيلما او ندخن باكيتات لا تعد ولا تحصى من السجائر ونحن نطلع من موضوع وندخل في آخر وقطط الشارع بين أرجلنا. ثم يرميهما أحدهم من الشباك لأنهما أصبحا مزعجين، فيلتفان حول العمارة وينوحان عند الباب.
هم متظاهرون ونحن كلنا متظاهرون سابقون، فيرق قلبنا عليهم. نعيش هكذا، مع حب شديد وضحك ولعب مع حيوانات تلاعبنا كأنها تريد إنقاذنا من مآسينا. علمتني نجمة بتقبلها للواقع أن لا اسأل لِمَ أنا في هذا المكان وما دوري فيه، بل أن أكون فيه فحسب، فأنا خلقت فيه وكبرت فيه ولا جدوى من إيجاد معنى أو سبب لذلك.
أتذكر القطة الأم كلما أنظر للسياج الذي يفصلنا عن الخرابة الكبيرة. اختفت تلك الجميلة وتعلمت تقبل كل الأفكار المحزنة بعد رحيلها، فبعض أحزاننا لن نجد لها نهاية أبداً. نرميها في نهر دجلة لكي يأخذها بعيداً لتلتهمها الوحوش الأزلية في شط العرب والخليج، تشبك المواجع أرواحنا بالمدينة والنهر. الخرابة أُزيحت عنها النفايات وصارت تجيء وفوداً يلبس أفرادها بدلاتٍ وأحذية تلمع. يأتون للفرع مع شخص، كما يبدو، ليحاولوا إقناعه بشراء الأرض.