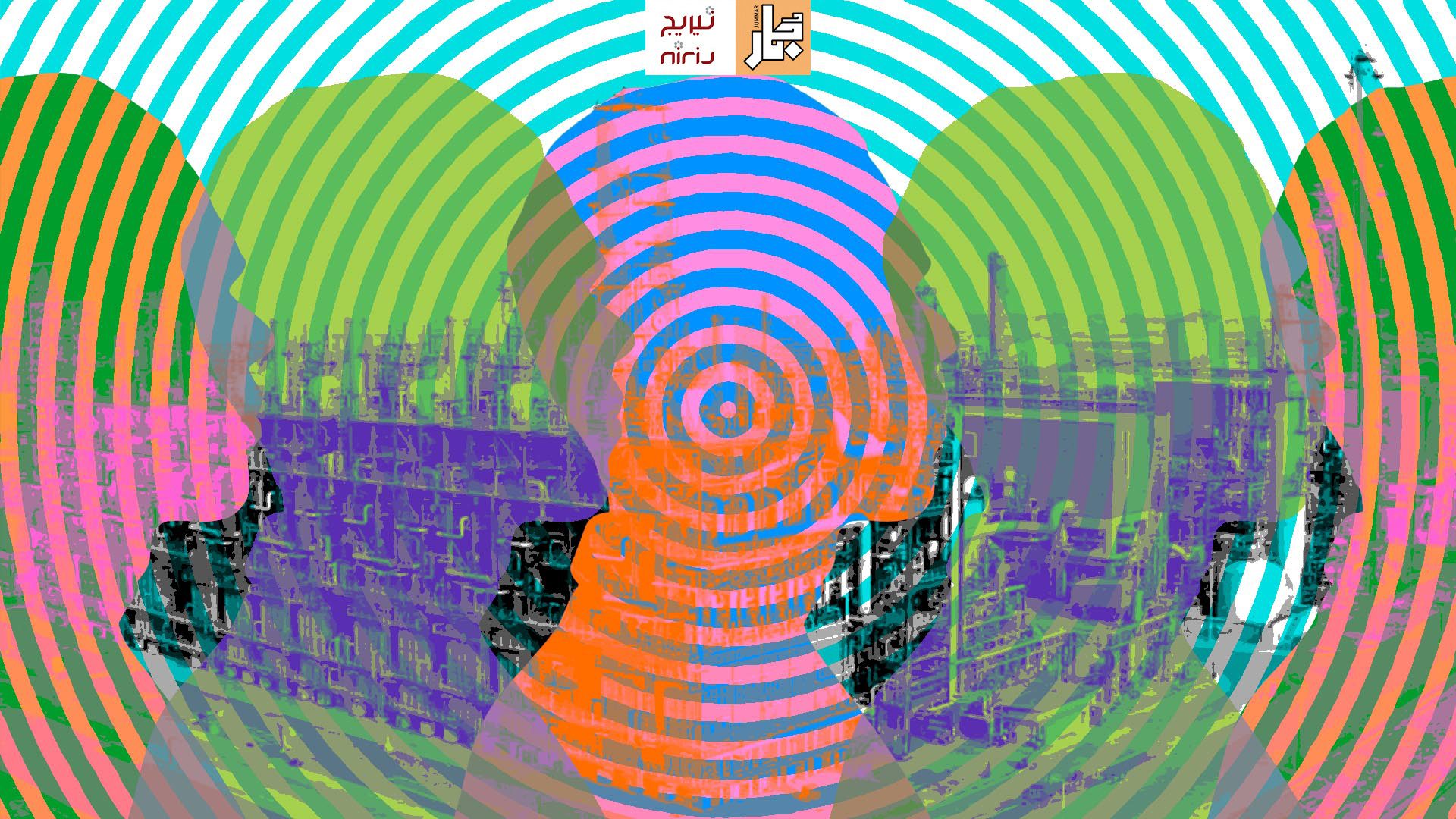أَخويّة الصليب والطخماخ!
26 آب 2023
عزيزي أبو علّاوي، تحيّة طيّبة وبعد، يبدو أنك لم تفهم بعد اللعبة التي نصّبها المارينز في جهازك، التي يسمونها «ديمقراطية»، ألا ترى أن لا أحد يلعب معك؟ ألم تلاحظ أنك لا تفوز في اللعبة غافلاً عن كونك تُلاعِبُ نفسك فقط؟ عن أخوية الصليب والطخماخ!
يعيش الإنسان الشيعي الشعائري علاقة رومانسية من طرف واحد مع التراث المسيحي ورعايا الكنيسة العراقية الشرقية، هي بالأحرى علاقة «ميانة» ثقيلة الظل، تشبه أن تستعير كل شوية شيئاً من مطبخ الجيران، ثم تبالغ قليلاً وتستعير الجيران أنفسهم، والجيران لا يتذمرون ولا يشتكون، لأنك ببساطة أبو علّاوي صاحب البيت و«ملّاچ» التريلة التي تقطر خلفها باقي عربات السيرك الطائفي الجميل! وترى أن أبو مايكل «ما يزعل وما يكول شي» لأن ديانته هي المحبة! ويسمح لك أن تقترض منه حتى مريم -أم الإله- وتوظفها لتكنس للزائرين كما تقول اللطمية، كما أن أبو مايكل يبادر بنفسه بطبخ القيمة ويتبرك بحكّاكة الجدر، دون أن تنتبه إلى أن أبو مايكل الذي سطوت على مشاعره ومساحته واستأجرت حتى تراثه الديني، لا بل حتى الملابس الداخلية لقصص أبطاله التوراتيين، لا يقوى على أن يقول لك لا.
أبو مايكل، لا تتيّسر له رفاهية الاختلاف معك حتى في درجة الميانة والسماجة التي تتطفل بها على أدبياته، أبو مايكل يخوض معك حواراً غير متكافئ من ناحية قدرته المحدودة على فتح فمه، إذا ما قورنت بالامتياز الاجتماعي الذي تتمتع به – كأبو علّاوي- في قدرتك الهائلة على فتح فمك إلى أقصى ما تستطيعه عضلات صماخك؛ وقول كل ما تريد وما لا تريد، وما سوف تريد.

يذكرني الخيال غير المسؤول لنجوم الشعائر الحسينية بقصة قصيرة وجريئة نشرها الراحل فهد الأسدي في تسعينيات الحصار والقائد المؤمن، اسمها «الراضوع»، والراضوع هي أفعى مخيفة في مجاهيل أهوار العراق الجنوبي تعض الجواميس وتمتص أحشاءها ولا تترك القريّة إلا بعد أن تسمع صوت الناعي والنائحة. في القصة، يحدث أن تلد امرأة ولداً لا يكف عن الصراخ طلباً للحليب، تضع أمه ثديها في فمه فيقوم بشفط حليب صدرها حتى آخره قبل أن يشفط أمه كلها، يبتلعها ويبتلع بعدها أخوته وأخواته، يأتون له بنساء القرية كي يرضعنه فيقوم بابتلاعهن واحدة تلو الأخرى، وهكذا حتى يأتي الرضيع الذي اسموه الراضوع لأنه صار أفعى هائلة، على رضع وشفط وابتلاع كل شيء حوله، فلا يبقى غيره في القرية. وكانت كناية القاص الأسدي واضحة، ابتلاع صدام حسين للعراق والعراقيين، راضوعاً لا يشبع ولا يتوقف عن احتكار كل شيء وصبغ المجال العام بلونه الزيتوني الكالح. ويبدو أن لكل زمان راضوعا، ولكل راضوع عراقاً.
كان أبو المثل العراقي لئيماً حينما اخترع المثل القائل «عيسى بدينه وموسى بدينه» لأنه أخفى الجزء المضمر من تلك الحكمة الديمقراطية الرشيدة! الجزء المحذوف والذي ستختل موسيقى الكلام لو جهرنا به، لكنك تسمعه رغم ذلك، مدوياً «عيسى بدينه وموسى بدينه… والدين عند الله الإسلام، وكلاهما يبكي على الحسين ويخدم الزوار ويهرس الحمص بالطخماخ»، فالمثل لا يعني أن نحترم أديان بعضنا ومذاهبهم كما يبدو، بل أن نرضعها ونشفطها حتى آخر قطرة دم، فالديمقراطية هي حكم الغالب والأغلبية كما نريد أن نفهم، والأيام دول بين الناس، يوم لك ويوم عليك، ولا يهمنا إن كنت قد تعاصر اللحظة التي هي «يوم عليك»، الديمقراطية في وعينا المستلب هي عملية اضطهاد قدرية ولا شيء غير ذلك، ولا يسعنا أن نفهم أن هذه اللعبة الثأرية يجب أن تتوقف عند لحظة ما، وأن نتخلى عن منطق اليوم الذي عليك والذي لك، لأنها بلاد يعيش فوقها بشر، وليست كرخانة يتناوب عليها شفتان من القواويد.
كان المسلم الشيعي محظوظاً أكثر من أي مسلم آخر من ناحية عناية مذهبه بالفنون، بينما كانت الأصوليات المذهبية الأخرى متشددة مع الموسيقى والمسرح كما أنها حرّمت التصوير وقطعت بذلك جذور تطور الفنون المرئية وتلقيها، ومثلما كانت الكاثوليكية متسامحة مع المسرح واستخدمته لاغراضها التبشيرية والوعظية مع باقي الفنون التعبيرية، وهو الأمر الذي أثر في ما بعد بازدهار فن المسرح أباً للفنون، كان التشيّع قد وظّف الفن والإمتاع والتسلية في «نشر المصيبة» الزينبية، غير أن كل ذلك كان محكوماً بسياق المعارضة التاريخية والعيش كجماعة سريّة مطعونة في ولائها داخل الإمبراطوريات السنيّة المضطهِدة لرعاياها الشيعة في آن، والمتملقة لهم في آن آخر. وكان الولاة العثمانيون يمنعون الزيارات أو يسمحون بها حسب محرار العلاقة مع الدولة الصفوية. مع ذلك فالمدونات الرسمية حذفت لحظات التعذيب السادي الذي تعرض له الشيعة من تقطيع وحرق واغتصاب، مع أن هذه اللحظات هي الشفرة المفقودة التي تفسر الكثير من انفعالاتنا ورواسبنا وعلاقة مكوناتنا ببعضها. والشعائر لم تتخذ طابعاً احتجاجياً في أغلبها ولم تكن كما هي اليوم، باذخة وجماهيرية، لكن اللمسة السلطانية التي أضافها السلاطين القاجاريون على مسرح التشابيه وإكسسواراته جعلته أليَق بالقصور ومقصورات المسرح الفارهة حيث يجلس الملوك للفرجة على العباس قطيع الكفين فاتك الحُسن! وعلى تلك اللقطة الماستر سين: الشمر الأسود «القبيح» جالساً على صدر الحسين الوسيم الأبيض! ذي العيون الخضر الكحيلة والأنف الروماني المستدق، الشبيه بالسلطان وعائلته، إذ يفترض بالحسين أن لا يُشبه العراقيين.
يشاهدون تراجيديا جُون الأسود وهو يحتفل بعبوديته ويزدري قوميته وجسده ورائحته، ويقول للحسين هذا المونولوج المؤسف وغير الأخلاقي: «إن ريحي لنتن وإن حسبي للئيم وإن لوني لأسود، فتنفّس علي في الجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني..»! طبعاً، لا نطلب من رجل عاش في القرن السابع الميلادي أن يكون مناهضاً للعنصرية قارئاً لنظريات فرانز فانون وأنجليا دافيس؛ لكن هذا خطاب لا يجعل من الملحمة إنسانية على الإطلاق، بل يؤدي إلى نقيضها، ويتركها بلا تحديث ملائم لتطور حاجات الإنسان المعاصر واكتشافه لحقوقه، أين ولى المجددون يا حوزة علي!.

يجلس السلطان ليتفرج ويتسلى ويتملق شعبه، مثلما تجلس الملكة فكتوريا في مقصورة المسرح الملكي «دروري لين» وهي تستمتع بمسرحية عطيل أو هاملت لشكسبير.
وهكذا عادت الشعائر سلطانية كما بدأت. وخرجت من كونها عزاءً للمظلومين إلى كونها تسلية للأباطرة والفاسدين.
ليس جديراً بالشعائر الحسينية أن تصبح سلطانية، لأنها معنية بالرفض والاحتجاج على السلطة الجائرة بالمقام الأول، وبلغتنا المعاصرة فإن ذلك يجعلها تقف على دكة المراقبين والمقومين لأداء الحكومات، لا أن تجلس على الكرسي وتُوزِّع الحقائب الوزارية، لا يوجد في الملحمة الحسينية نهاية سعيدة، ولا يحصل الحسين ولا أصحابه على مكافأة أو منصب في آخر القصة، وضع السيناريست الشعبي والديني نهايات مفتوحة للقصة على الموت، لا يوجد انتصارات ولا مكاسب ولا سلطة، وإذا كنت استخدمتها لبلوغ السلطة فقد يدلّ ذلك على رؤيتك لها كقصة فاشلة للوصول إلى الحكم.
لماذا إذن ينتصر الحسينيون في زماننا ويحتفلون بعاشوراء كرمزية لحياتهم اليومية! ما هو الحيف الذي وقع عليهم؟ ومن هو السلطان الجائر الذي ينتفضون عليه! إذا كانوا قد ابتلعوا البلاد وعقول العباد. لكن، هناك دائماً يزيد افتراضي مجهّز لتحقيق خلطة المظلومية، ويزيدنا هذه المرّة هو الشعب! معادلة معكوسة تماماً لكل ما تفيد به أدبيات ملحمة عاشوراء، الحسين بالمقلوب، الحسين يتدلى منكوساً من السقف ويصلب من جديد، والزمن يعود للوراء، يلتقط الحسين رأسه ثم سيفه ودرعه ويعود للمخيّم ويخطب بأصحابه: انتصرنا، قولوا لغاندي أن يكتب تعلمت من الحسين كيف أكون ظالماً فأنتصر.
يقول أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة كولومبيا حميد دباشي في كتابه «التشيّع: ديانة الاحتجاج» إنّ التشيع روحية إدانة واحتجاج تنجح حينما تكون في موضع المجابهة والحرب لكنها تفشل وتخسر شرعيتها في موضع السلطة. وأقول، شعائر مصممة «لاستجلاب الدمعة» بكل الطرق، المشروعة كالاستفزاز العاطفي أو غير المشروعة مثل قرص الأطفال، لكنها غير مصمّمة على «استجلاب السعادة» والانجازات الخدمية، لذلك تتفاقم أحوالنا سوءاً كلما صار السياسي شعائرياً في كل حالاته، لأن الشعائرية أنسب للمحتج، وهذا لا يعني بالضرورة الإيمان بالمقولة الضغائنية التي يتبناها خصوم السياسي الشعائري في أن «الشيعة لم يخلقوا للحكم»، فعلاوة على الحمولة الطائفية والتمييزية التي شحنت بها لافتات مثل هذه، لا يبدو أن قائلها الذي يرى نفسه «مخلوقاً للحكم والرياسة» يندل صول چعابه! لأن الحديث ليس عن جينات ذلك السياسي ومدركاته وعاداته الموروثة والجبرية، بل عن سياسة مرحلية يمر بها وقد يخرج منها، إذا شاء، والحديث هو عن استخدام شعبوي وانتهازي لمعانٍ بعضها نبيل.

نسخ الذهن الروائي للواقعة حكاية عذابات العذراء وهي على حمارها هاربة من جنود القيصر إلى مصر، في زينب المسبيّة من أرض العراق إلى أرض الشام، وكما كانت المعجزات تحدث لمريم وهي ترضع صغيرها «الرب» في رحلة هروبها، وتخلّف وراءها شاهداً او معلماً سيتحول إلى قرية في ما بعد، كان طريق الشام عامراً بالقصص والتعاطف الكبير الذي يبديه الرهبان في صوامعهم الصحراوية، ومثلما كان العباس في لوحات التراث يحارب بسيفين ويبعثر أعداءه اللانهائيين، كان القديس فليوباتير الذي تلقبه الكنيسة الأرثوذكسية بأبي سيفين، قد تسلّم سيفاً من الملاك ميكائيل وأباد كتيبة من جنود روما دفاعاً عن مسيحيته، ومثلما كان جُون الأسود توّاباً ناقماً على لون بشرته فادياً الحسين وعائلته بنفسه على استحياء من شدة شعوره بالبؤس والضعة، كان القديس موسى الأسود الذي بدأ حياته شقاوة قاطعاً للطريق؛ قد قدّم نفسه عروساً للرب تكفيراً عن جرائمه و«لونه» الأسود.
هنالك توأمة روحية بين المسيحية المشرقية والتشيّع، ليس مهماً أي التوأمين خرج باكراً، لكن مسارات الخيال التاريخي والشعائري تتقاطع في نقطة ما وتتداخل بين الأمم والجغرافيات.
في عام 2014 الميلادي كان فرناندو فيلوني قائداً لكتيبة الفرسان الخاصة بحماية القبر المقدس في الفاتيكان، حيث الصخرة التي صلب عليها المسيح كما يُعتقد. وفي أوج اضطهاد الدواعش للمسيحيين في العراق، فكّر في دراسة تاريخ العراقيين، المسيحيين منهم، وكان أن ابتعثه البابا لأجل الحوار مع الزعماء والوجهاء، ليبدأ بالبحث عن تأريخ الكنيسة العراقية القديمة منذ زمن الرسل، فجاء كتابه «الكنيسة في العراق» توثيقاً مطوّلاًَ ودقيقاً لاضطهادات تلك الأقلية عبر العصور، منذ ممالك العرب والمغول والأتراك والصفويين، وخلص إلى أن المسيحيين العراقيين هم من بقايا نسل شهداء الكنيسة المشرقية التي أبادتها الامبراطوريات بدءاً من الرومان وحتى أسود الخلافة.
وليس بخافٍ على أحد، كيف استعملت الأحزاب الأوروبية اليمينية وصحافة البروبغاندا الأمريكية بطاقة «إبادة المسيحيين في العراق» في تصعيد خطابها العنصري ضد المهاجرين وتصنيع صورة ظلامية لكل ما هو شرقي و«عراقي»، ويضاف إلى ذلك المناخ تَطوُّر خطاب متطرف داخل بعض الكنائس العراقية الصغيرة المهاجرة من العراق، كلام عن غزو العرب الأجلاف للعراق وابتلاعه، وكيف أن العراق أرض سريانية كلدانية شوهها «المعدان»! مع رشة بهارات آثارية تربط بين الآشوريين القدامى وشعب الكنيسة العراقية، وهو تصور لا يدعمه علم الأركيولوجيا ولا الدراسات الآثارية المعاصرة.
طوّق مرشحو ترمب أنفسهم بالمؤمنين بهذا النوع من الأفيون الثقافي، فسانده وهتف له الكثير من أمريكيي الشتات العراقي السرياني، ولما فاز الرجل أصدر قراراً بحظر دخول العراقيين، وهو القرار الذي يسميه خصوم ترمب «قرار حظر المسلمين» ويرفعونه أمامه كلما أبدى تملقاً للمسلمين ورجال دينهم وملوكهم. ولمّا دخل القرار حيّز التنفيذ، وقع ضحيته أول من وقع، المسيحيون العراقيون الذين وُعدوا بتخليصهم من العرب! باتوا أياماً في المطارات دون إذن بالدخول، أو تم ترحيل بعضهم من البلاد الأمريكية، في مفارقة مؤسية، والحاصل أن المسيحي العراقي الهارب من الجحيم هو في حسابات ترمب ما زال عراقياً -إرهابي محتمل- يتعرض لكل ما يتعرض له العراقيون، الرؤية المركزية الغربية توحدنا!
عزيزي أبو علّاوي، تحية طيبة وبعد، يبدو أنك لم تفهم بعد اللعبة التي نصّبها المارينز في جهازك، التي يسمونها «ديمقراطية»، ألا ترى أن لا أحد يلعب معك؟ ألم تلاحظ أنك لا تفوز في اللعبة غافلاً عن كونك تلاعب نفسك فقط؟ الديمقراطية ليس أن يحترم الآخر عقائدك وشعائرك، بل تعني أكثر أن تحترم أنت عقائد الآخر الذي يعيش معك، أن لا تستغل ضعف لحظته التاريخية وتسرق منه حتى «الإله» وأمه وتحبسهما في حسينيّتك.
والمهم أن تصدّق أن حُسينك وعبّاسك لا يتذكرهما أحد وهو في الكنيسة، ومريم لا تواسي الزهراء إلا في رواياتك، لكل فرد إله و«حوراء إنسيّة» وقديسون فائضون وملغيون وآخرون مستحدثون، ولن ينقص شيئاً من قدر ملحمتك إذا لم يعبأ بها أحد؛ وينبغي أن لا يكون ذلك مهماً عندك.

يشتكي أبو علاوي من الهجوم الانتقائي ضده ويقول «لماذا يستهدف العالم الشيعة فقط في شعائرهم دون غيرهم»، فأجيبه «ليس العالم، هذا خطاب داخلي وحبّاب من حبال المضيف».
فيقول لي «وهل للطوائف الأخرى حبال مضيف حبّابة تنتقدها من أفرادها مثل الحبال التي عندنا؟».
سرحْت قليلاً، تجشأت، سعلت، وحوقلت وبسملت، وقلت «نتأمل ذلك!، لكن هذا شأن اقترح عليك أن تناقشه مع زميلك العلماني المتنور الطائفي السني الجميل الفرانكفوني أبو القعقاع چاك راسو».
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
يعيش الإنسان الشيعي الشعائري علاقة رومانسية من طرف واحد مع التراث المسيحي ورعايا الكنيسة العراقية الشرقية، هي بالأحرى علاقة «ميانة» ثقيلة الظل، تشبه أن تستعير كل شوية شيئاً من مطبخ الجيران، ثم تبالغ قليلاً وتستعير الجيران أنفسهم، والجيران لا يتذمرون ولا يشتكون، لأنك ببساطة أبو علّاوي صاحب البيت و«ملّاچ» التريلة التي تقطر خلفها باقي عربات السيرك الطائفي الجميل! وترى أن أبو مايكل «ما يزعل وما يكول شي» لأن ديانته هي المحبة! ويسمح لك أن تقترض منه حتى مريم -أم الإله- وتوظفها لتكنس للزائرين كما تقول اللطمية، كما أن أبو مايكل يبادر بنفسه بطبخ القيمة ويتبرك بحكّاكة الجدر، دون أن تنتبه إلى أن أبو مايكل الذي سطوت على مشاعره ومساحته واستأجرت حتى تراثه الديني، لا بل حتى الملابس الداخلية لقصص أبطاله التوراتيين، لا يقوى على أن يقول لك لا.
أبو مايكل، لا تتيّسر له رفاهية الاختلاف معك حتى في درجة الميانة والسماجة التي تتطفل بها على أدبياته، أبو مايكل يخوض معك حواراً غير متكافئ من ناحية قدرته المحدودة على فتح فمه، إذا ما قورنت بالامتياز الاجتماعي الذي تتمتع به – كأبو علّاوي- في قدرتك الهائلة على فتح فمك إلى أقصى ما تستطيعه عضلات صماخك؛ وقول كل ما تريد وما لا تريد، وما سوف تريد.

يذكرني الخيال غير المسؤول لنجوم الشعائر الحسينية بقصة قصيرة وجريئة نشرها الراحل فهد الأسدي في تسعينيات الحصار والقائد المؤمن، اسمها «الراضوع»، والراضوع هي أفعى مخيفة في مجاهيل أهوار العراق الجنوبي تعض الجواميس وتمتص أحشاءها ولا تترك القريّة إلا بعد أن تسمع صوت الناعي والنائحة. في القصة، يحدث أن تلد امرأة ولداً لا يكف عن الصراخ طلباً للحليب، تضع أمه ثديها في فمه فيقوم بشفط حليب صدرها حتى آخره قبل أن يشفط أمه كلها، يبتلعها ويبتلع بعدها أخوته وأخواته، يأتون له بنساء القرية كي يرضعنه فيقوم بابتلاعهن واحدة تلو الأخرى، وهكذا حتى يأتي الرضيع الذي اسموه الراضوع لأنه صار أفعى هائلة، على رضع وشفط وابتلاع كل شيء حوله، فلا يبقى غيره في القرية. وكانت كناية القاص الأسدي واضحة، ابتلاع صدام حسين للعراق والعراقيين، راضوعاً لا يشبع ولا يتوقف عن احتكار كل شيء وصبغ المجال العام بلونه الزيتوني الكالح. ويبدو أن لكل زمان راضوعا، ولكل راضوع عراقاً.
كان أبو المثل العراقي لئيماً حينما اخترع المثل القائل «عيسى بدينه وموسى بدينه» لأنه أخفى الجزء المضمر من تلك الحكمة الديمقراطية الرشيدة! الجزء المحذوف والذي ستختل موسيقى الكلام لو جهرنا به، لكنك تسمعه رغم ذلك، مدوياً «عيسى بدينه وموسى بدينه… والدين عند الله الإسلام، وكلاهما يبكي على الحسين ويخدم الزوار ويهرس الحمص بالطخماخ»، فالمثل لا يعني أن نحترم أديان بعضنا ومذاهبهم كما يبدو، بل أن نرضعها ونشفطها حتى آخر قطرة دم، فالديمقراطية هي حكم الغالب والأغلبية كما نريد أن نفهم، والأيام دول بين الناس، يوم لك ويوم عليك، ولا يهمنا إن كنت قد تعاصر اللحظة التي هي «يوم عليك»، الديمقراطية في وعينا المستلب هي عملية اضطهاد قدرية ولا شيء غير ذلك، ولا يسعنا أن نفهم أن هذه اللعبة الثأرية يجب أن تتوقف عند لحظة ما، وأن نتخلى عن منطق اليوم الذي عليك والذي لك، لأنها بلاد يعيش فوقها بشر، وليست كرخانة يتناوب عليها شفتان من القواويد.
كان المسلم الشيعي محظوظاً أكثر من أي مسلم آخر من ناحية عناية مذهبه بالفنون، بينما كانت الأصوليات المذهبية الأخرى متشددة مع الموسيقى والمسرح كما أنها حرّمت التصوير وقطعت بذلك جذور تطور الفنون المرئية وتلقيها، ومثلما كانت الكاثوليكية متسامحة مع المسرح واستخدمته لاغراضها التبشيرية والوعظية مع باقي الفنون التعبيرية، وهو الأمر الذي أثر في ما بعد بازدهار فن المسرح أباً للفنون، كان التشيّع قد وظّف الفن والإمتاع والتسلية في «نشر المصيبة» الزينبية، غير أن كل ذلك كان محكوماً بسياق المعارضة التاريخية والعيش كجماعة سريّة مطعونة في ولائها داخل الإمبراطوريات السنيّة المضطهِدة لرعاياها الشيعة في آن، والمتملقة لهم في آن آخر. وكان الولاة العثمانيون يمنعون الزيارات أو يسمحون بها حسب محرار العلاقة مع الدولة الصفوية. مع ذلك فالمدونات الرسمية حذفت لحظات التعذيب السادي الذي تعرض له الشيعة من تقطيع وحرق واغتصاب، مع أن هذه اللحظات هي الشفرة المفقودة التي تفسر الكثير من انفعالاتنا ورواسبنا وعلاقة مكوناتنا ببعضها. والشعائر لم تتخذ طابعاً احتجاجياً في أغلبها ولم تكن كما هي اليوم، باذخة وجماهيرية، لكن اللمسة السلطانية التي أضافها السلاطين القاجاريون على مسرح التشابيه وإكسسواراته جعلته أليَق بالقصور ومقصورات المسرح الفارهة حيث يجلس الملوك للفرجة على العباس قطيع الكفين فاتك الحُسن! وعلى تلك اللقطة الماستر سين: الشمر الأسود «القبيح» جالساً على صدر الحسين الوسيم الأبيض! ذي العيون الخضر الكحيلة والأنف الروماني المستدق، الشبيه بالسلطان وعائلته، إذ يفترض بالحسين أن لا يُشبه العراقيين.
يشاهدون تراجيديا جُون الأسود وهو يحتفل بعبوديته ويزدري قوميته وجسده ورائحته، ويقول للحسين هذا المونولوج المؤسف وغير الأخلاقي: «إن ريحي لنتن وإن حسبي للئيم وإن لوني لأسود، فتنفّس علي في الجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني..»! طبعاً، لا نطلب من رجل عاش في القرن السابع الميلادي أن يكون مناهضاً للعنصرية قارئاً لنظريات فرانز فانون وأنجليا دافيس؛ لكن هذا خطاب لا يجعل من الملحمة إنسانية على الإطلاق، بل يؤدي إلى نقيضها، ويتركها بلا تحديث ملائم لتطور حاجات الإنسان المعاصر واكتشافه لحقوقه، أين ولى المجددون يا حوزة علي!.


يجلس السلطان ليتفرج ويتسلى ويتملق شعبه، مثلما تجلس الملكة فكتوريا في مقصورة المسرح الملكي «دروري لين» وهي تستمتع بمسرحية عطيل أو هاملت لشكسبير.
وهكذا عادت الشعائر سلطانية كما بدأت. وخرجت من كونها عزاءً للمظلومين إلى كونها تسلية للأباطرة والفاسدين.
ليس جديراً بالشعائر الحسينية أن تصبح سلطانية، لأنها معنية بالرفض والاحتجاج على السلطة الجائرة بالمقام الأول، وبلغتنا المعاصرة فإن ذلك يجعلها تقف على دكة المراقبين والمقومين لأداء الحكومات، لا أن تجلس على الكرسي وتُوزِّع الحقائب الوزارية، لا يوجد في الملحمة الحسينية نهاية سعيدة، ولا يحصل الحسين ولا أصحابه على مكافأة أو منصب في آخر القصة، وضع السيناريست الشعبي والديني نهايات مفتوحة للقصة على الموت، لا يوجد انتصارات ولا مكاسب ولا سلطة، وإذا كنت استخدمتها لبلوغ السلطة فقد يدلّ ذلك على رؤيتك لها كقصة فاشلة للوصول إلى الحكم.
لماذا إذن ينتصر الحسينيون في زماننا ويحتفلون بعاشوراء كرمزية لحياتهم اليومية! ما هو الحيف الذي وقع عليهم؟ ومن هو السلطان الجائر الذي ينتفضون عليه! إذا كانوا قد ابتلعوا البلاد وعقول العباد. لكن، هناك دائماً يزيد افتراضي مجهّز لتحقيق خلطة المظلومية، ويزيدنا هذه المرّة هو الشعب! معادلة معكوسة تماماً لكل ما تفيد به أدبيات ملحمة عاشوراء، الحسين بالمقلوب، الحسين يتدلى منكوساً من السقف ويصلب من جديد، والزمن يعود للوراء، يلتقط الحسين رأسه ثم سيفه ودرعه ويعود للمخيّم ويخطب بأصحابه: انتصرنا، قولوا لغاندي أن يكتب تعلمت من الحسين كيف أكون ظالماً فأنتصر.
يقول أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة كولومبيا حميد دباشي في كتابه «التشيّع: ديانة الاحتجاج» إنّ التشيع روحية إدانة واحتجاج تنجح حينما تكون في موضع المجابهة والحرب لكنها تفشل وتخسر شرعيتها في موضع السلطة. وأقول، شعائر مصممة «لاستجلاب الدمعة» بكل الطرق، المشروعة كالاستفزاز العاطفي أو غير المشروعة مثل قرص الأطفال، لكنها غير مصمّمة على «استجلاب السعادة» والانجازات الخدمية، لذلك تتفاقم أحوالنا سوءاً كلما صار السياسي شعائرياً في كل حالاته، لأن الشعائرية أنسب للمحتج، وهذا لا يعني بالضرورة الإيمان بالمقولة الضغائنية التي يتبناها خصوم السياسي الشعائري في أن «الشيعة لم يخلقوا للحكم»، فعلاوة على الحمولة الطائفية والتمييزية التي شحنت بها لافتات مثل هذه، لا يبدو أن قائلها الذي يرى نفسه «مخلوقاً للحكم والرياسة» يندل صول چعابه! لأن الحديث ليس عن جينات ذلك السياسي ومدركاته وعاداته الموروثة والجبرية، بل عن سياسة مرحلية يمر بها وقد يخرج منها، إذا شاء، والحديث هو عن استخدام شعبوي وانتهازي لمعانٍ بعضها نبيل.


نسخ الذهن الروائي للواقعة حكاية عذابات العذراء وهي على حمارها هاربة من جنود القيصر إلى مصر، في زينب المسبيّة من أرض العراق إلى أرض الشام، وكما كانت المعجزات تحدث لمريم وهي ترضع صغيرها «الرب» في رحلة هروبها، وتخلّف وراءها شاهداً او معلماً سيتحول إلى قرية في ما بعد، كان طريق الشام عامراً بالقصص والتعاطف الكبير الذي يبديه الرهبان في صوامعهم الصحراوية، ومثلما كان العباس في لوحات التراث يحارب بسيفين ويبعثر أعداءه اللانهائيين، كان القديس فليوباتير الذي تلقبه الكنيسة الأرثوذكسية بأبي سيفين، قد تسلّم سيفاً من الملاك ميكائيل وأباد كتيبة من جنود روما دفاعاً عن مسيحيته، ومثلما كان جُون الأسود توّاباً ناقماً على لون بشرته فادياً الحسين وعائلته بنفسه على استحياء من شدة شعوره بالبؤس والضعة، كان القديس موسى الأسود الذي بدأ حياته شقاوة قاطعاً للطريق؛ قد قدّم نفسه عروساً للرب تكفيراً عن جرائمه و«لونه» الأسود.
هنالك توأمة روحية بين المسيحية المشرقية والتشيّع، ليس مهماً أي التوأمين خرج باكراً، لكن مسارات الخيال التاريخي والشعائري تتقاطع في نقطة ما وتتداخل بين الأمم والجغرافيات.
في عام 2014 الميلادي كان فرناندو فيلوني قائداً لكتيبة الفرسان الخاصة بحماية القبر المقدس في الفاتيكان، حيث الصخرة التي صلب عليها المسيح كما يُعتقد. وفي أوج اضطهاد الدواعش للمسيحيين في العراق، فكّر في دراسة تاريخ العراقيين، المسيحيين منهم، وكان أن ابتعثه البابا لأجل الحوار مع الزعماء والوجهاء، ليبدأ بالبحث عن تأريخ الكنيسة العراقية القديمة منذ زمن الرسل، فجاء كتابه «الكنيسة في العراق» توثيقاً مطوّلاًَ ودقيقاً لاضطهادات تلك الأقلية عبر العصور، منذ ممالك العرب والمغول والأتراك والصفويين، وخلص إلى أن المسيحيين العراقيين هم من بقايا نسل شهداء الكنيسة المشرقية التي أبادتها الامبراطوريات بدءاً من الرومان وحتى أسود الخلافة.
وليس بخافٍ على أحد، كيف استعملت الأحزاب الأوروبية اليمينية وصحافة البروبغاندا الأمريكية بطاقة «إبادة المسيحيين في العراق» في تصعيد خطابها العنصري ضد المهاجرين وتصنيع صورة ظلامية لكل ما هو شرقي و«عراقي»، ويضاف إلى ذلك المناخ تَطوُّر خطاب متطرف داخل بعض الكنائس العراقية الصغيرة المهاجرة من العراق، كلام عن غزو العرب الأجلاف للعراق وابتلاعه، وكيف أن العراق أرض سريانية كلدانية شوهها «المعدان»! مع رشة بهارات آثارية تربط بين الآشوريين القدامى وشعب الكنيسة العراقية، وهو تصور لا يدعمه علم الأركيولوجيا ولا الدراسات الآثارية المعاصرة.
طوّق مرشحو ترمب أنفسهم بالمؤمنين بهذا النوع من الأفيون الثقافي، فسانده وهتف له الكثير من أمريكيي الشتات العراقي السرياني، ولما فاز الرجل أصدر قراراً بحظر دخول العراقيين، وهو القرار الذي يسميه خصوم ترمب «قرار حظر المسلمين» ويرفعونه أمامه كلما أبدى تملقاً للمسلمين ورجال دينهم وملوكهم. ولمّا دخل القرار حيّز التنفيذ، وقع ضحيته أول من وقع، المسيحيون العراقيون الذين وُعدوا بتخليصهم من العرب! باتوا أياماً في المطارات دون إذن بالدخول، أو تم ترحيل بعضهم من البلاد الأمريكية، في مفارقة مؤسية، والحاصل أن المسيحي العراقي الهارب من الجحيم هو في حسابات ترمب ما زال عراقياً -إرهابي محتمل- يتعرض لكل ما يتعرض له العراقيون، الرؤية المركزية الغربية توحدنا!
عزيزي أبو علّاوي، تحية طيبة وبعد، يبدو أنك لم تفهم بعد اللعبة التي نصّبها المارينز في جهازك، التي يسمونها «ديمقراطية»، ألا ترى أن لا أحد يلعب معك؟ ألم تلاحظ أنك لا تفوز في اللعبة غافلاً عن كونك تلاعب نفسك فقط؟ الديمقراطية ليس أن يحترم الآخر عقائدك وشعائرك، بل تعني أكثر أن تحترم أنت عقائد الآخر الذي يعيش معك، أن لا تستغل ضعف لحظته التاريخية وتسرق منه حتى «الإله» وأمه وتحبسهما في حسينيّتك.
والمهم أن تصدّق أن حُسينك وعبّاسك لا يتذكرهما أحد وهو في الكنيسة، ومريم لا تواسي الزهراء إلا في رواياتك، لكل فرد إله و«حوراء إنسيّة» وقديسون فائضون وملغيون وآخرون مستحدثون، ولن ينقص شيئاً من قدر ملحمتك إذا لم يعبأ بها أحد؛ وينبغي أن لا يكون ذلك مهماً عندك.



يشتكي أبو علاوي من الهجوم الانتقائي ضده ويقول «لماذا يستهدف العالم الشيعة فقط في شعائرهم دون غيرهم»، فأجيبه «ليس العالم، هذا خطاب داخلي وحبّاب من حبال المضيف».
فيقول لي «وهل للطوائف الأخرى حبال مضيف حبّابة تنتقدها من أفرادها مثل الحبال التي عندنا؟».
سرحْت قليلاً، تجشأت، سعلت، وحوقلت وبسملت، وقلت «نتأمل ذلك!، لكن هذا شأن اقترح عليك أن تناقشه مع زميلك العلماني المتنور الطائفي السني الجميل الفرانكفوني أبو القعقاع چاك راسو».