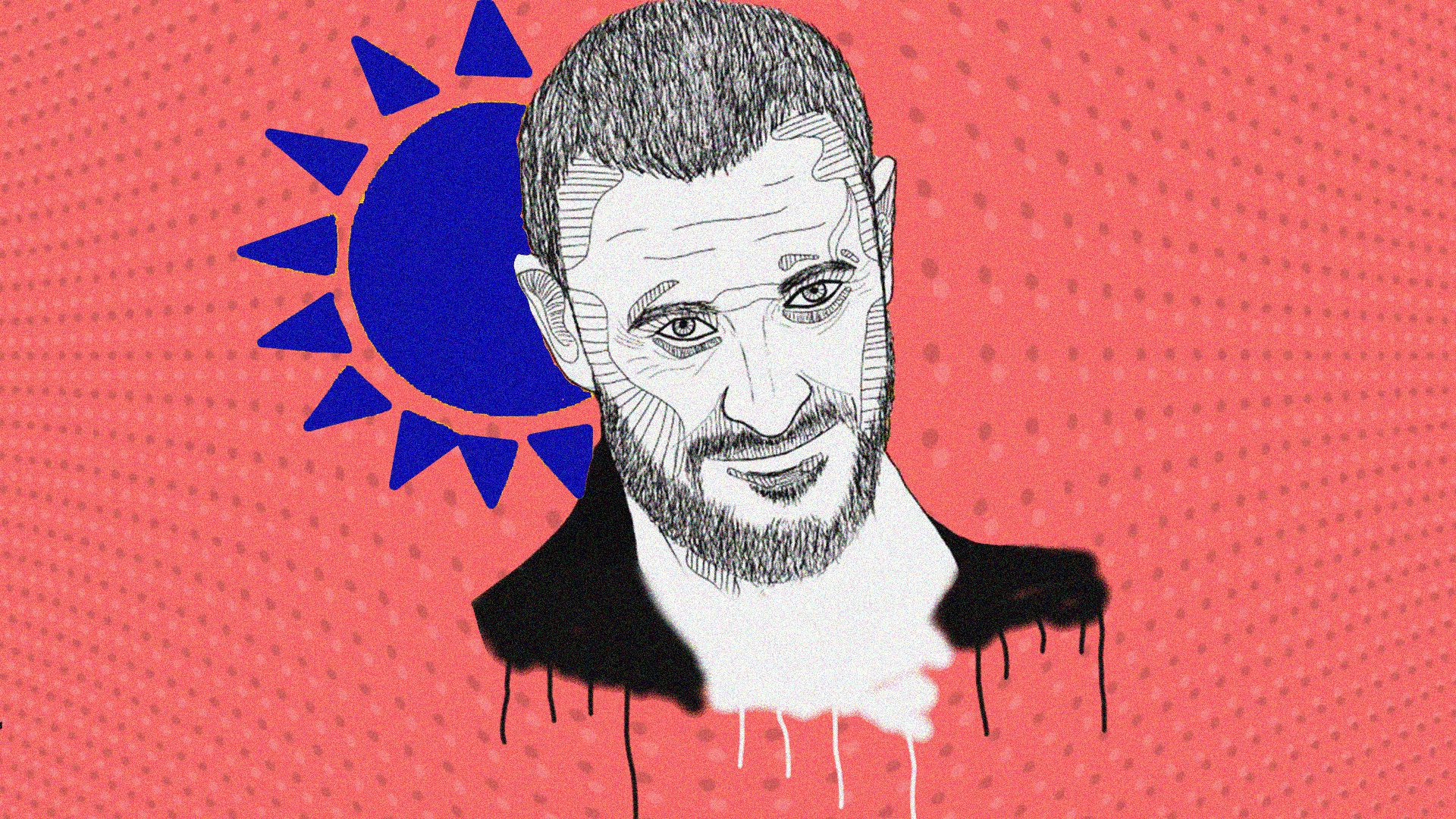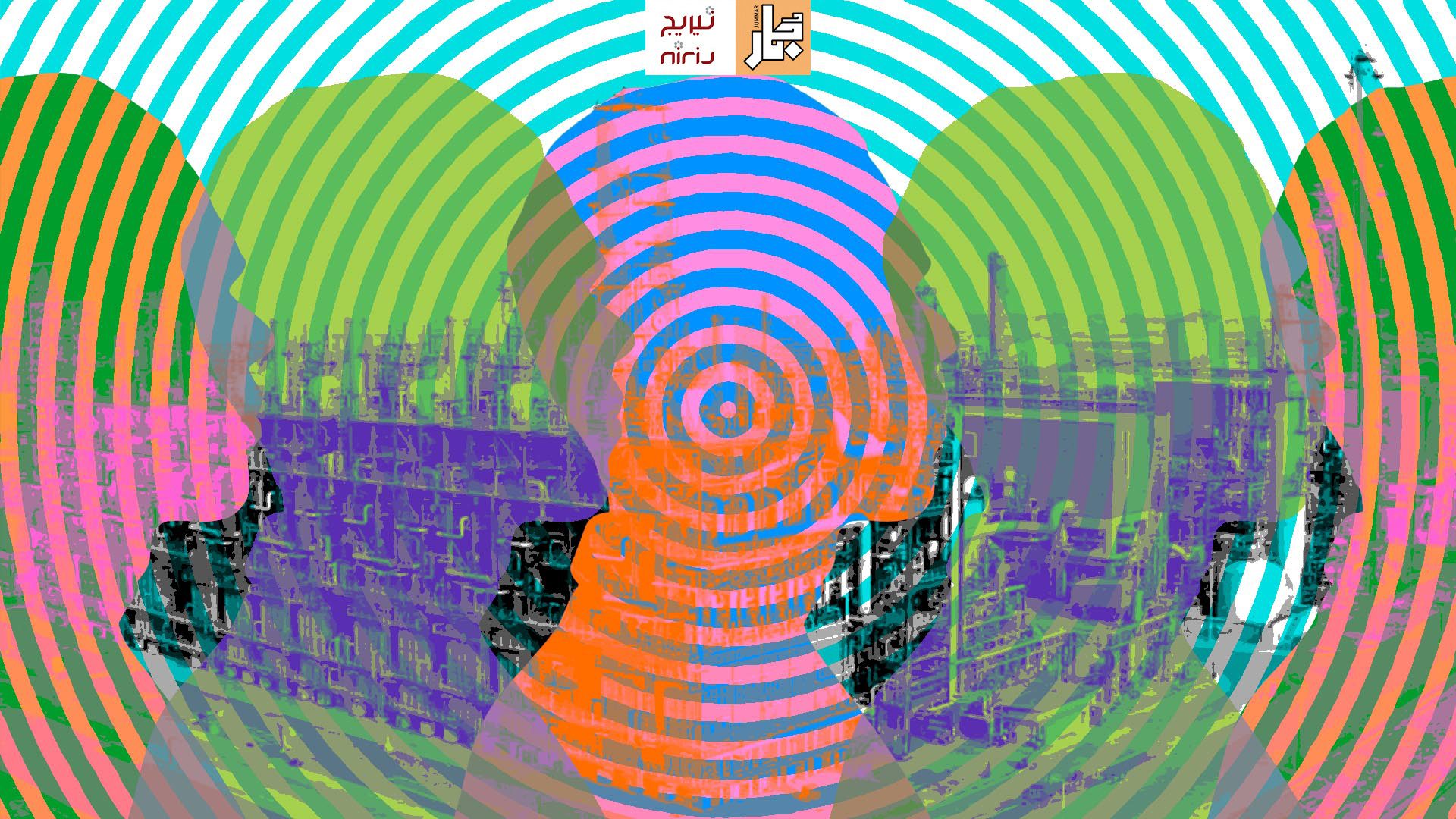الساهريون.. عشاقٌ وفّر لهم كاظم الساهر "الخبز بالكاسيت"
11 شباط 2024
من الحصار والجوع، من القصف والمعاناة، ينطلق ساهريّون ليرووا لنا حكايتهم مع معشوقهم ومطربهم المفضل: كاظم الساهر.
قبل أن تولد صراعات: احتلال/ تغيير، شيعي/ سني، التيار/ المالكي، ميسي/ رونالدو، تشريني/ إطاري… إلخ، كان ثمة صراع يجري بين الشبان، صراع أبطاله فنانون عراقيون، وعلى الأقل هذا ما كان يجري في عائلتي، فقد انقسمت العائلة بين محبي كاظم الساهر ومحبي حاتم العراقي.
تقول أختي من خلف الجدار لبنت عمي من أجل الإغاظة وإشعال الصراع، “حاتم أبو النفط”. تردّ عليها بنت العم: “كاظم أبو الغاز، كاظم أبو حنج”.
كان في المنزل ثلاثة ساهريين، وواحدة من محبي حاتم.
لتلك الحقبة أبطال قليلون، ومقلدون كثر، قلدوا قصة شعر كاظم الساهر، والسن المكسور لحاتم العراقي، قلدوا ملابسهم، وتصرفاتهم، وكل ما يخصهم تقريباً.
لم يأخذ هذا الجدال الكثير، فقد انتهى ما أن تغيرت الحياة كلياً بعد عام 2003، انشغل الساهريون والحاتميون بالسياسة، توارى كثير منهم، بينما اصطف بعضهم مع التيارات الدينية والسياسية التي تشكلت في ما بعد.
دخل الجدال العراقي في آفاق جديدة، لم تعد الحياة تتمحور حول الفنانين، لقد بدأ عصر سياسي بامتياز، عصر أبطاله قادة كتل ورؤساء أحزاب وتيارات، عصر انتهى معه آخر صراع لجيل “الطيبين” كما صار يطلق عليهم لاحقاً، رغم كونها تسمية لا تتسم بالدقة، لكن من يتصارعون من أجل الفن، طيبون بامتياز.

التسعينيات حقبة كان كاظم الساهر أبرز مؤثريها عراقياً، أثثها بالأغاني والغزل والقمصان الحرير والأناقة والصوت السحري، حقبة الراديو والكاسيت، ما جعل شريحة واسعة من الشبان تتأثر به، خصوصاً من سكنة المدن الشعبية والمحافظات الجنوبية، ظهر كاظم في حياتهم كبطل شاب ومبدع وسيم يغني باللغة الفصحى غالباً، ويختار من الحب والمرأة موضوعاتٍ لأغانيه.
من هناك، من الحصار والجوع، من القصف والمعاناة، انطلق الساهريون ليرووا لنا حكايتهم مع معشوقهم ومطربهم المفضل.

كانت الناصرية لا يصل إليها بث تلفزيون الشباب إلا عبر مجموعة إجراءات تتعلق في شراء أريل من نوع معين، جلبنا الأريل بعد عناء، لكن كاظم الساهر لم يظهر!
أشيع وقتها أن عدي صدام منع ظهوره، فلم يتبق أمامي إلا المسجل فهو الحليف الوحيد الذي يمكنه جلب صوت كاظم، بقيت والدتي لفترة طويلة تجمع الأموال كي تشتري لي مسجل قيثارة أحمر اللون معه هيدفون يعمل “تك واحد” -بأذن واحدة-، عائلة تقاتل من أجل توفير وجبة ثانية، وأمي تفكر في مراهق يحب مطرباً، هذه العاطفة العميقة ربطتني إلى الأبد به، واشتريت لاحقاً غالبية كاسيتات الساهر وعبد الحليم، هذا وقت كان فيه إخوتي يرون أن هذا فن مائع وأنثوي.
بسبب الحصار تحوّلنا من عائلة توزع السجائر لكل الناصرية إلى صبيان نبيع الجرك لأجل قوتنا اليومي، أصرخ في الأزقة: جرك جرك أبو السمسم/ وفي داخلي أقول: “أثيرها بيا صورة حتى المرايا ملت/ البست أشكال ألوان وهي ما مرة انتبهت… إلخ”، لشدة تعلقي بالأغنية.
أغاني التسعينيات لم تناسبني حين بدأت تنتشر على نطاق واسع، بقيت مخلصاً لكاظم الساهر وعبد الحليم، “علمني حبك / زيديني عشقاً” وغيرها من أغاني الساهر التي صاغت علاقتي بالحياة، ذلك الترف والعزل، المرأة في تلك الأغاني كائن رائع وحيوي وشفاف.
المعادلة أصبحت في داخلي أن ثمة فناً راقياً ومتفوقاً وفناً شعبياً، من هناك تشكلت لديَّ رؤية أن الفن التسعيني وقع في فخ الشعبية وتنازل عن القيمة العليا للفن، قد تكون هذه الرؤية نخبوية لكنني بسببها بدأت أهتم باللغة العربية والشعر الفصيح وتشكلت أول ملامح انحيازاتي الفنية.
بدأت أحب النساء وفقا لأغاني كاظم وشعر كريم العراقي ونزار قباني، أنا صنيعة هذه الأغاني، وسط الحصار والجوع ورائحة الباعة المتجولين الذين كنت منهم، اسمع “نوارة عمري مروحتي قنديلي فوح بساتيني/ مدي لي جسرا من رائحة الليمون/ وضعيني مشطا عاجيا في عتمة شعرك وانسيني/ من أجلك أعددت رثائي وتركت التاريخ ورائي”.
“بائع جرك مراهق بالناصرية وفي وقت الحصار وصل إليه الساهر”، حين أفكر بهذه الجملة، يستمر مهند حيّال بالقول، اعرف إلى أي حد هذا الفنان استطاع أن يؤثر، إلى أي حدّ هو مخلص للفن، ويعرف ماذا يقدم، ماذا يُحبّ الناس وكيف يمكن الوصول إليهم.

قبل أن أعرف الغناء وماذا يعني الفن، وصلنا بيت جدي، وكان هناك مجموعة كبيرة من الناس في باب منزلهم، سألت أبي: “بابا هاي شكو”، قال الأب: “لازم كاظم الساهر جاي وي عمك فراس للبيت”، دخلنا غرفة الضيوف وشاهدته يعزف ويغني، تعلقت بذلك الحب الذي جمع الناس حوله. شاهدته وهو ينحني على العود، يحتضن تلك الآلة كما لو أنها طفل.
بمرور الأيام اكتشف أنني أحب أغنية اسمها “ها حبيبي”، أحببت اللحن، كنت صغيرة بالكاد أتذكر قصف القوات الامريكية على العراق عام 1998، لكنني لا أنسى أبدا أننا في تلك الأيام حين يصدر صوت “الغارة” تشغل والدتي المسجل لنستمع إلى كاظم الساهر وننسى صوت الحرب.
امتد الأمر معي حتى سافرنا إلى ليبيا، كان الليبيون يشعرون بالدهشة حين يعرفون أننا نعرف كاظم شخصياً، الشعب الليبي يعشق كاظم بشكل لا يمكن تصوّره، من عجائب الدنيا لدى بعض الليبيين كاظم الساهر، كل ما يعرفه الليبي عن العراق وقت كنت هناك: صدام حسين وكاظم الساهر فقط.
حين بدأ يتشكل لدي وعي شخصي، بدأت أجمع مصروفي اليومي، من أجل أن أوفر مبلغا لشراء شريط كاسيت لكاظم الساهر، أتصور أن لدي كل أشرطة كاظم في بيتنا بمدينة ترهونة في ليبيا، لكنني فقدتها كلها، لأنني عدت إلى بغداد في زيارة ولم أعد ثانية إلى ليبيا.
كاظم ليس شخصاً عادياً في حياتي، حين أعرف أن هناك شخصاً يحب أغاني كاظم الساهر، أعرف أن هذا سيكون صديقي، هناك صلة ما بيني وبين كل من يحب غناء كاظم.
بالمقابل، أفشل دائماً في توصيف كاظم، أفشل في التعبير، أول شخص أحببته في حياتي كتب لي مقطعاً من أغنية: أشهد أن امرأة.
قبل مغادرتنا بغداد، كنت صغيرة أشعر أن بيتنا قصر كبير، غرفة الضيوف واسعة في نهايتها جهاز تلفاز متوسط الحجم، بين مسلسل العصر والبرنامج المسائي، ثمة فقرة غنائية منوعة يتذكرها العراقيون، وهذه الفقرة من الممكن تقطع في أية لحظة.
كرهت صدام حسين ليس بسبب جرائمه أو أفعاله كما هو الحال مع معظم العراقيين، كرهته في طفولتي لأنه كان يقطع أغنية كاظم الساهر ليظهر في خطاباته المتكررة، وهذا حدث أكثر من مرة، حسب ما أتذكر.
الأكثر تطرفاً من ذلك، أني كنت أبكي حين يظهر فنان آخر على التلفاز غير كاظم، لقد شكل الساهر ذائقتي في الفن والغناء، لا يمكن أن أكون محبة للغناء بهذا الشكل لولا كاظم الساهر.

لا يمكن أن نمدّ الحلم أبعد من صوت الراديو. جهاز صغير أسميه “راديون”، التلفاز ليس متوفراً، لقد سلب الحصار تلك الرفاهية، بل جعل تلك الشاشة مستحيلة، من ذلك الصوت دخلت عالم كاظم الساهر، أسمع ما توفر من ذلك الغزل والحب في قرية صغيرة على أطراف الكوت اسمها “المصندك”، ولأن القرية تلك ليس فيها دكان أو حتى حانوت صغير، كنت أحتال على البطارية حين تنفد وتستهلك ولم تعد قادرة على نقل صوت الساهر، أقوم بوضعها داخل قوري ماء حتى تنتفخ وتعود إلى العمل لنصف يوم أو يوم. ولم أكن أسميها كما الآن “بطارية”، كنا نسميها “باتريات”.
من ذلك الجهاز الصغير، عرفت إذاعة BBC، ومونت كارلو، أتذكر المذيعة صاحبة الصوت الجميل كابي لطيف وهي تصدح بـ”الراديون”، المكان المناسب لوضع الجهاز الذي يضم كل هذه الأصوات هو الجيب الجانبي للدشداشة، من الجيب يخرج صوت: “دكيت باب الجار”، “ضمني على صدرك” وغيرها.
عندما بثت أغنية “نزلت للبحر تتشمس الحلوة”، كان الراديو الخاص بي معطلاً، سمعت كلماتها للمرة الأولى من طفل بعمري أسمه ضيدان خلف، لا أعرف أين هو الآن، رحل مع الأيام وبقيت تلك الأغنية ترحل بي صوب حنجرته، ربما لا يعلم ضيدان الآن أين ذهبت بنا الشمس، بعد أن غادر الكثير من سكان قريتنا للمدن، المدن التي تقتل البراءة الأولى، تقتل التلقي المرهف لـ”سلامتك من الــ آه”.
في اليوم التالي لتعطّل الراديو دخل “دوّار” لقريتنا الحدودية مع محافظة ميسان، والدوّار هو بائع متجول يستبدل الأشياء بأخرى، لدى الدوّار أشياء كثيرة، حلوى وغيرها من الأشياء، كانت لديّ مهمة البحث عن “قندرة لاستيك” مزقها الزمن أو المشي غيرت لونها الشمس، وجدت أخيراً ضالتي، لكن تبقى عملية التفاوض مع الدوّار من اجل إقناعه أن هذه القندرة استحق بدلاً عنها بوستر صغير فيه صورة الساهر وأغنية نزلت للبحر مكتوبة باللون الأحمر. بعد عناء حصلت على البوستر وحفظت “نزلت للبحر” كاملة رغم أني لم أعرف البحر بعد، ولم ألتق بضفافه يوماً. لقد زرع بي الساهر بحراً متخيلاً وامرأة مفقودة وكلمات كان يندر استخدمها في قرية “المصندك” الواقعة بين الكوت والعمارة، فمن يقول هناك لزوجته أو لحبيبته: “ها حبيبي مو على بعضك أحسك”.



-1-
لا يمكن أن أنام دون أن أقلب “لا يا صديقي” على وجهي الكاسيت، اشتريت مسجلاً من أجل كاظم الساهر، سمعت عبارة “تسجيلات كاظم الساهر/ المنصور شارع 14 رمضان… إلخ”.
في اليوم التالي، انطلقت أنا الصبي مع صديقي من مدينة الثورة، ركبنا مصلحة رقم 71، التي تذهب إلى الميدان، ثم ركبنا مصلحة ربما رقمها 57 التي تذهب إلى المنصور، وقفنا في باب تسجيلات كاظم الساهر من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الــ4 عصراً من أجل لقاء الساهر، اشترينا كاسيت عام 92 نزلت للبحر، سلمنا على كاظم ورجعنا.
– 2-
عرض مسلسل الرحال، في الحلقة الرابعة مات جدي، ومن عادتنا أن يغلق التلفاز حزنا لمدة عام كامل على الأقل، جريمة تشغيل التلفاز في بيت الميت لا تضاهيها جريمة، لكنني حرصت على مشاهدة مسلسل بطلها كاظم، نقلت التلفاز إلى غرفة أمي سراً، وكنا نتغطى، أختي وأنا والتلفاز في البطانية ونضع الصوت على أقلّ درجة من أجل متابعة الحلقات، وبهذه الطريقة السرية شاهدت بقية المسلسل، لم يكن يعلم أبي أننا في وفاة والده كنا شغوفين بكاظم إلى هذا الحد.
– 3-
ظهر الساهر في مهرجان بابل، بزيّ لا يمكن نسيانه، بنطال قماش نيلي، وقميص أصفر ونيلي تحته تشريت أسود، كنت طالباً في إعدادية قتيبة للبنين، لم أذهب إلى المدرسة دون تقليد هذا اللبس بالضبط، ولأن الخياط لم يجد الطريقة المناسبة لعمل القميص، فصلت قميصاً أصفر ورصعه بقماش نيلي، كل ذلك من أجل أن يقال لي: “أنت لابس مثل كاظم الساهر”.
– 4-
لم انسحب من الساهر تدريجياً كما حصل مع بقية الشباب، انخرطت بالموجة الدينية التي انتشرت منتصف التسعينيات، تنكرت لهذا الشغف بين ليلة وضحاها، لم أسمعه لمدة عقد كامل، لاعتقادي أن صوته حرام، انتهت تلك الرحلة الساهرية على يد تعاليم أخذتها حتى أقصاها، بعد ذلك تصالحت مع الساهر، الآن أسمعه بشكل يومي، تعويضا عما فاتني، “لقضاء ما في الذمة” لديّ في السيارة كل أقراصه، مع ذلك تؤلمني الطريقة التي تركته فيها سابقاً.



كنت طفلاً حين انفصل عمّي عن حبيبته لأسباب اجتماعية، بعد انتشار خبر الحب منع جدي ابنه عن حبيبته، فجلس في غرفته لمدة يوم كامل يسمع أغنية “لا تحرموني”، على وقعها يبكي ويصرخ.. من هناك تشكلت أول تصوراتي عن كاظم الساهر.
كنا عائلة ساهرية، بيت عمي الآخر لديهم كاسيتات كاظم، بدأ من هناك يتشكل ذوقي وانحيازي له، بعد ذلك منع الساهر من الظهور في القنوات وكان الحصول على أغانيه صعباً، بقينا نسمع كاظم عبر الكاسيت فقط، ولأننا عائلة تضررت من الحصار لم نكن نسمع أغنية “تذكر” إلا مع البكاء، أنا وأبناء عمومتي، كل هذه الأغاني سمعتها تحت تأثير الآخرين، لكني أعتقد أن ألبوم حبيبتي والمطر هو أول خيار شخصي لي مع كاظم، تفاعلت معه بشكل آخر وشخصي إلى حد كبير.
أحببت إشارات ابنة الجيران وتخيّلها كما هي المرأة في أغاني كاظم، كانت أول هدية تبادلتها معها هو كاسيت كاظم الساهر، بدأت أحب على طريقة حافية القدمين، حتى الرسائل التي كنت أكتبها بالفصيح، كنت أشعر أن أغاني كاظم موجهة لكل امرأة أحبها، وارتفع الشغف حتى وصل بي الأمر لمحاولة جمع القصص التي تكمن خلف هذه الأغاني خصوصا أغنية “أنا وليلى”، لعقد من الزمن كنت أحب وأغازل على طريقة كاظم الساهر، واعتقد أن كاظم هو من علمني كيف أحب بطريقة شفافة ومرهفة وخالية من الأذى والسلوك العنيف.
جيل كامل في مدينة الثورة تربى بهذه الطريقة، عشقنا وافترقنا على طريقته، لقد أسهم عبر أغانيه في صياغة طرق للزعل وللرضا وللحب وللعناد وغيرها من تفاصيل الحب.



أول حفل حضرته لكاظم الساهر في مسرح المنصور، غنى وقتها عابر سبيل ولا يا صديقي، كان يرتدي “جاكيت أحمر”، وصل لمقطع: “خوفي من خوفي ليكبر”، كل الجمهور وقف، بينما كاظم يتمشى ورأسه للأسفل، بقي يعيد في الجملة، بينما كنا واقفين نبكي معه.
من “معلم على الصدمات كلبي” عرفت كريم العراقي، وقتها قال تحية لشاعرها، كاظم كل ذكرياتنا في ذلك العقد، كاظم نقش التسعينيات، انتقلت معه من ذلك الحفل، إلى حفل المسرح الوطني ربما عام 1996، غنى هناك مدرسة الحب، كان يرتدي “جاكيت أبيض”، لا يمكن نسيان تلك التفاصيل، حين غنى “بغداد” أحد رجال تشريفات الحفل وضع يده على وجهه وبدأ يصرخ، بينما صرخت: آه يا كاظم، التفت إلى أبي وشعرت بالخجل من شدة الانفعال الذي كنت فيه، وأعتقد أن كل عاشقات الساهر يحبونه بطريقة: آه يا كاظم.
في إحدى حفلاته في بابل، ولأنها حفلة تذاكرها رخيصة وصل أبناء عمي المسرح منذ السادسة صباحاً، كان شعب كامل يغني خلفه، تأثر الشباب في طريقة لبسه وطريقة حديثه.
كاظم فرحة العراقيين في وقت الحصار غنى لنا: “يا ليل لا تنتهي… توني ابتديت الغزل”، خلاصة الحياة التسعينية القاسية تتجسد بشغف مئات الآلاف من العراقيين به، كان ضدّاً نوعياً لبؤس الحياة وفقرها، يشاع أن أم كلثوم أسهمت في جعل المصريين ينسون نكبة حزيران، وأكاد أن أرى أن كاظم خفف من عبء الحصار.
نحن جيل عاش دون كهرباء ولا تقنيات، لم نكن نملك سوى الكاسيت الذي يربطنا بصوته، صرنا مراهقات وجاءت الرسائل الورقية المذيلة بتوقيع عشاق على طريقة “مدرسة الحب وأشهد وزيديني عشقا”، كبرنا قليلا أصبح العشاق يشهدون بأن لا امرأة إلا أنت، لنختم عقد التسعينيات بليلى، حيث تحولت كل العاشقات إلى ليلى، كل من يترك حبيبته يوصمها بـ”ليلى”، صرنا صورة ليلى الخائنة، بالحصار دفع الآباء الكثير من بناتهم للارتباط بمن يملك المال، وصارت الحبيبة ليلى التي تركض خلف “البهرج الخداع”.
تحوّل الخطاب من ليس هناك امرأة إلا أنت، إلى ليلى، هكذا ختم عقدنا الساهري، بكل هذا الكم من المشاعر والأغاني والانفعالات، عقدٌ لا يمكن تسميته إلا بعقد كاظم الساهر.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
قبل أن تولد صراعات: احتلال/ تغيير، شيعي/ سني، التيار/ المالكي، ميسي/ رونالدو، تشريني/ إطاري… إلخ، كان ثمة صراع يجري بين الشبان، صراع أبطاله فنانون عراقيون، وعلى الأقل هذا ما كان يجري في عائلتي، فقد انقسمت العائلة بين محبي كاظم الساهر ومحبي حاتم العراقي.
تقول أختي من خلف الجدار لبنت عمي من أجل الإغاظة وإشعال الصراع، “حاتم أبو النفط”. تردّ عليها بنت العم: “كاظم أبو الغاز، كاظم أبو حنج”.
كان في المنزل ثلاثة ساهريين، وواحدة من محبي حاتم.
لتلك الحقبة أبطال قليلون، ومقلدون كثر، قلدوا قصة شعر كاظم الساهر، والسن المكسور لحاتم العراقي، قلدوا ملابسهم، وتصرفاتهم، وكل ما يخصهم تقريباً.
لم يأخذ هذا الجدال الكثير، فقد انتهى ما أن تغيرت الحياة كلياً بعد عام 2003، انشغل الساهريون والحاتميون بالسياسة، توارى كثير منهم، بينما اصطف بعضهم مع التيارات الدينية والسياسية التي تشكلت في ما بعد.
دخل الجدال العراقي في آفاق جديدة، لم تعد الحياة تتمحور حول الفنانين، لقد بدأ عصر سياسي بامتياز، عصر أبطاله قادة كتل ورؤساء أحزاب وتيارات، عصر انتهى معه آخر صراع لجيل “الطيبين” كما صار يطلق عليهم لاحقاً، رغم كونها تسمية لا تتسم بالدقة، لكن من يتصارعون من أجل الفن، طيبون بامتياز.

التسعينيات حقبة كان كاظم الساهر أبرز مؤثريها عراقياً، أثثها بالأغاني والغزل والقمصان الحرير والأناقة والصوت السحري، حقبة الراديو والكاسيت، ما جعل شريحة واسعة من الشبان تتأثر به، خصوصاً من سكنة المدن الشعبية والمحافظات الجنوبية، ظهر كاظم في حياتهم كبطل شاب ومبدع وسيم يغني باللغة الفصحى غالباً، ويختار من الحب والمرأة موضوعاتٍ لأغانيه.
من هناك، من الحصار والجوع، من القصف والمعاناة، انطلق الساهريون ليرووا لنا حكايتهم مع معشوقهم ومطربهم المفضل.


كانت الناصرية لا يصل إليها بث تلفزيون الشباب إلا عبر مجموعة إجراءات تتعلق في شراء أريل من نوع معين، جلبنا الأريل بعد عناء، لكن كاظم الساهر لم يظهر!
أشيع وقتها أن عدي صدام منع ظهوره، فلم يتبق أمامي إلا المسجل فهو الحليف الوحيد الذي يمكنه جلب صوت كاظم، بقيت والدتي لفترة طويلة تجمع الأموال كي تشتري لي مسجل قيثارة أحمر اللون معه هيدفون يعمل “تك واحد” -بأذن واحدة-، عائلة تقاتل من أجل توفير وجبة ثانية، وأمي تفكر في مراهق يحب مطرباً، هذه العاطفة العميقة ربطتني إلى الأبد به، واشتريت لاحقاً غالبية كاسيتات الساهر وعبد الحليم، هذا وقت كان فيه إخوتي يرون أن هذا فن مائع وأنثوي.
بسبب الحصار تحوّلنا من عائلة توزع السجائر لكل الناصرية إلى صبيان نبيع الجرك لأجل قوتنا اليومي، أصرخ في الأزقة: جرك جرك أبو السمسم/ وفي داخلي أقول: “أثيرها بيا صورة حتى المرايا ملت/ البست أشكال ألوان وهي ما مرة انتبهت… إلخ”، لشدة تعلقي بالأغنية.
أغاني التسعينيات لم تناسبني حين بدأت تنتشر على نطاق واسع، بقيت مخلصاً لكاظم الساهر وعبد الحليم، “علمني حبك / زيديني عشقاً” وغيرها من أغاني الساهر التي صاغت علاقتي بالحياة، ذلك الترف والعزل، المرأة في تلك الأغاني كائن رائع وحيوي وشفاف.
المعادلة أصبحت في داخلي أن ثمة فناً راقياً ومتفوقاً وفناً شعبياً، من هناك تشكلت لديَّ رؤية أن الفن التسعيني وقع في فخ الشعبية وتنازل عن القيمة العليا للفن، قد تكون هذه الرؤية نخبوية لكنني بسببها بدأت أهتم باللغة العربية والشعر الفصيح وتشكلت أول ملامح انحيازاتي الفنية.
بدأت أحب النساء وفقا لأغاني كاظم وشعر كريم العراقي ونزار قباني، أنا صنيعة هذه الأغاني، وسط الحصار والجوع ورائحة الباعة المتجولين الذين كنت منهم، اسمع “نوارة عمري مروحتي قنديلي فوح بساتيني/ مدي لي جسرا من رائحة الليمون/ وضعيني مشطا عاجيا في عتمة شعرك وانسيني/ من أجلك أعددت رثائي وتركت التاريخ ورائي”.
“بائع جرك مراهق بالناصرية وفي وقت الحصار وصل إليه الساهر”، حين أفكر بهذه الجملة، يستمر مهند حيّال بالقول، اعرف إلى أي حد هذا الفنان استطاع أن يؤثر، إلى أي حدّ هو مخلص للفن، ويعرف ماذا يقدم، ماذا يُحبّ الناس وكيف يمكن الوصول إليهم.


قبل أن أعرف الغناء وماذا يعني الفن، وصلنا بيت جدي، وكان هناك مجموعة كبيرة من الناس في باب منزلهم، سألت أبي: “بابا هاي شكو”، قال الأب: “لازم كاظم الساهر جاي وي عمك فراس للبيت”، دخلنا غرفة الضيوف وشاهدته يعزف ويغني، تعلقت بذلك الحب الذي جمع الناس حوله. شاهدته وهو ينحني على العود، يحتضن تلك الآلة كما لو أنها طفل.
بمرور الأيام اكتشف أنني أحب أغنية اسمها “ها حبيبي”، أحببت اللحن، كنت صغيرة بالكاد أتذكر قصف القوات الامريكية على العراق عام 1998، لكنني لا أنسى أبدا أننا في تلك الأيام حين يصدر صوت “الغارة” تشغل والدتي المسجل لنستمع إلى كاظم الساهر وننسى صوت الحرب.
امتد الأمر معي حتى سافرنا إلى ليبيا، كان الليبيون يشعرون بالدهشة حين يعرفون أننا نعرف كاظم شخصياً، الشعب الليبي يعشق كاظم بشكل لا يمكن تصوّره، من عجائب الدنيا لدى بعض الليبيين كاظم الساهر، كل ما يعرفه الليبي عن العراق وقت كنت هناك: صدام حسين وكاظم الساهر فقط.
حين بدأ يتشكل لدي وعي شخصي، بدأت أجمع مصروفي اليومي، من أجل أن أوفر مبلغا لشراء شريط كاسيت لكاظم الساهر، أتصور أن لدي كل أشرطة كاظم في بيتنا بمدينة ترهونة في ليبيا، لكنني فقدتها كلها، لأنني عدت إلى بغداد في زيارة ولم أعد ثانية إلى ليبيا.
كاظم ليس شخصاً عادياً في حياتي، حين أعرف أن هناك شخصاً يحب أغاني كاظم الساهر، أعرف أن هذا سيكون صديقي، هناك صلة ما بيني وبين كل من يحب غناء كاظم.
بالمقابل، أفشل دائماً في توصيف كاظم، أفشل في التعبير، أول شخص أحببته في حياتي كتب لي مقطعاً من أغنية: أشهد أن امرأة.
قبل مغادرتنا بغداد، كنت صغيرة أشعر أن بيتنا قصر كبير، غرفة الضيوف واسعة في نهايتها جهاز تلفاز متوسط الحجم، بين مسلسل العصر والبرنامج المسائي، ثمة فقرة غنائية منوعة يتذكرها العراقيون، وهذه الفقرة من الممكن تقطع في أية لحظة.
كرهت صدام حسين ليس بسبب جرائمه أو أفعاله كما هو الحال مع معظم العراقيين، كرهته في طفولتي لأنه كان يقطع أغنية كاظم الساهر ليظهر في خطاباته المتكررة، وهذا حدث أكثر من مرة، حسب ما أتذكر.
الأكثر تطرفاً من ذلك، أني كنت أبكي حين يظهر فنان آخر على التلفاز غير كاظم، لقد شكل الساهر ذائقتي في الفن والغناء، لا يمكن أن أكون محبة للغناء بهذا الشكل لولا كاظم الساهر.



لا يمكن أن نمدّ الحلم أبعد من صوت الراديو. جهاز صغير أسميه “راديون”، التلفاز ليس متوفراً، لقد سلب الحصار تلك الرفاهية، بل جعل تلك الشاشة مستحيلة، من ذلك الصوت دخلت عالم كاظم الساهر، أسمع ما توفر من ذلك الغزل والحب في قرية صغيرة على أطراف الكوت اسمها “المصندك”، ولأن القرية تلك ليس فيها دكان أو حتى حانوت صغير، كنت أحتال على البطارية حين تنفد وتستهلك ولم تعد قادرة على نقل صوت الساهر، أقوم بوضعها داخل قوري ماء حتى تنتفخ وتعود إلى العمل لنصف يوم أو يوم. ولم أكن أسميها كما الآن “بطارية”، كنا نسميها “باتريات”.
من ذلك الجهاز الصغير، عرفت إذاعة BBC، ومونت كارلو، أتذكر المذيعة صاحبة الصوت الجميل كابي لطيف وهي تصدح بـ”الراديون”، المكان المناسب لوضع الجهاز الذي يضم كل هذه الأصوات هو الجيب الجانبي للدشداشة، من الجيب يخرج صوت: “دكيت باب الجار”، “ضمني على صدرك” وغيرها.
عندما بثت أغنية “نزلت للبحر تتشمس الحلوة”، كان الراديو الخاص بي معطلاً، سمعت كلماتها للمرة الأولى من طفل بعمري أسمه ضيدان خلف، لا أعرف أين هو الآن، رحل مع الأيام وبقيت تلك الأغنية ترحل بي صوب حنجرته، ربما لا يعلم ضيدان الآن أين ذهبت بنا الشمس، بعد أن غادر الكثير من سكان قريتنا للمدن، المدن التي تقتل البراءة الأولى، تقتل التلقي المرهف لـ”سلامتك من الــ آه”.
في اليوم التالي لتعطّل الراديو دخل “دوّار” لقريتنا الحدودية مع محافظة ميسان، والدوّار هو بائع متجول يستبدل الأشياء بأخرى، لدى الدوّار أشياء كثيرة، حلوى وغيرها من الأشياء، كانت لديّ مهمة البحث عن “قندرة لاستيك” مزقها الزمن أو المشي غيرت لونها الشمس، وجدت أخيراً ضالتي، لكن تبقى عملية التفاوض مع الدوّار من اجل إقناعه أن هذه القندرة استحق بدلاً عنها بوستر صغير فيه صورة الساهر وأغنية نزلت للبحر مكتوبة باللون الأحمر. بعد عناء حصلت على البوستر وحفظت “نزلت للبحر” كاملة رغم أني لم أعرف البحر بعد، ولم ألتق بضفافه يوماً. لقد زرع بي الساهر بحراً متخيلاً وامرأة مفقودة وكلمات كان يندر استخدمها في قرية “المصندك” الواقعة بين الكوت والعمارة، فمن يقول هناك لزوجته أو لحبيبته: “ها حبيبي مو على بعضك أحسك”.



-1-
لا يمكن أن أنام دون أن أقلب “لا يا صديقي” على وجهي الكاسيت، اشتريت مسجلاً من أجل كاظم الساهر، سمعت عبارة “تسجيلات كاظم الساهر/ المنصور شارع 14 رمضان… إلخ”.
في اليوم التالي، انطلقت أنا الصبي مع صديقي من مدينة الثورة، ركبنا مصلحة رقم 71، التي تذهب إلى الميدان، ثم ركبنا مصلحة ربما رقمها 57 التي تذهب إلى المنصور، وقفنا في باب تسجيلات كاظم الساهر من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الــ4 عصراً من أجل لقاء الساهر، اشترينا كاسيت عام 92 نزلت للبحر، سلمنا على كاظم ورجعنا.
– 2-
عرض مسلسل الرحال، في الحلقة الرابعة مات جدي، ومن عادتنا أن يغلق التلفاز حزنا لمدة عام كامل على الأقل، جريمة تشغيل التلفاز في بيت الميت لا تضاهيها جريمة، لكنني حرصت على مشاهدة مسلسل بطلها كاظم، نقلت التلفاز إلى غرفة أمي سراً، وكنا نتغطى، أختي وأنا والتلفاز في البطانية ونضع الصوت على أقلّ درجة من أجل متابعة الحلقات، وبهذه الطريقة السرية شاهدت بقية المسلسل، لم يكن يعلم أبي أننا في وفاة والده كنا شغوفين بكاظم إلى هذا الحد.
– 3-
ظهر الساهر في مهرجان بابل، بزيّ لا يمكن نسيانه، بنطال قماش نيلي، وقميص أصفر ونيلي تحته تشريت أسود، كنت طالباً في إعدادية قتيبة للبنين، لم أذهب إلى المدرسة دون تقليد هذا اللبس بالضبط، ولأن الخياط لم يجد الطريقة المناسبة لعمل القميص، فصلت قميصاً أصفر ورصعه بقماش نيلي، كل ذلك من أجل أن يقال لي: “أنت لابس مثل كاظم الساهر”.
– 4-
لم انسحب من الساهر تدريجياً كما حصل مع بقية الشباب، انخرطت بالموجة الدينية التي انتشرت منتصف التسعينيات، تنكرت لهذا الشغف بين ليلة وضحاها، لم أسمعه لمدة عقد كامل، لاعتقادي أن صوته حرام، انتهت تلك الرحلة الساهرية على يد تعاليم أخذتها حتى أقصاها، بعد ذلك تصالحت مع الساهر، الآن أسمعه بشكل يومي، تعويضا عما فاتني، “لقضاء ما في الذمة” لديّ في السيارة كل أقراصه، مع ذلك تؤلمني الطريقة التي تركته فيها سابقاً.



كنت طفلاً حين انفصل عمّي عن حبيبته لأسباب اجتماعية، بعد انتشار خبر الحب منع جدي ابنه عن حبيبته، فجلس في غرفته لمدة يوم كامل يسمع أغنية “لا تحرموني”، على وقعها يبكي ويصرخ.. من هناك تشكلت أول تصوراتي عن كاظم الساهر.
كنا عائلة ساهرية، بيت عمي الآخر لديهم كاسيتات كاظم، بدأ من هناك يتشكل ذوقي وانحيازي له، بعد ذلك منع الساهر من الظهور في القنوات وكان الحصول على أغانيه صعباً، بقينا نسمع كاظم عبر الكاسيت فقط، ولأننا عائلة تضررت من الحصار لم نكن نسمع أغنية “تذكر” إلا مع البكاء، أنا وأبناء عمومتي، كل هذه الأغاني سمعتها تحت تأثير الآخرين، لكني أعتقد أن ألبوم حبيبتي والمطر هو أول خيار شخصي لي مع كاظم، تفاعلت معه بشكل آخر وشخصي إلى حد كبير.
أحببت إشارات ابنة الجيران وتخيّلها كما هي المرأة في أغاني كاظم، كانت أول هدية تبادلتها معها هو كاسيت كاظم الساهر، بدأت أحب على طريقة حافية القدمين، حتى الرسائل التي كنت أكتبها بالفصيح، كنت أشعر أن أغاني كاظم موجهة لكل امرأة أحبها، وارتفع الشغف حتى وصل بي الأمر لمحاولة جمع القصص التي تكمن خلف هذه الأغاني خصوصا أغنية “أنا وليلى”، لعقد من الزمن كنت أحب وأغازل على طريقة كاظم الساهر، واعتقد أن كاظم هو من علمني كيف أحب بطريقة شفافة ومرهفة وخالية من الأذى والسلوك العنيف.
جيل كامل في مدينة الثورة تربى بهذه الطريقة، عشقنا وافترقنا على طريقته، لقد أسهم عبر أغانيه في صياغة طرق للزعل وللرضا وللحب وللعناد وغيرها من تفاصيل الحب.



أول حفل حضرته لكاظم الساهر في مسرح المنصور، غنى وقتها عابر سبيل ولا يا صديقي، كان يرتدي “جاكيت أحمر”، وصل لمقطع: “خوفي من خوفي ليكبر”، كل الجمهور وقف، بينما كاظم يتمشى ورأسه للأسفل، بقي يعيد في الجملة، بينما كنا واقفين نبكي معه.
من “معلم على الصدمات كلبي” عرفت كريم العراقي، وقتها قال تحية لشاعرها، كاظم كل ذكرياتنا في ذلك العقد، كاظم نقش التسعينيات، انتقلت معه من ذلك الحفل، إلى حفل المسرح الوطني ربما عام 1996، غنى هناك مدرسة الحب، كان يرتدي “جاكيت أبيض”، لا يمكن نسيان تلك التفاصيل، حين غنى “بغداد” أحد رجال تشريفات الحفل وضع يده على وجهه وبدأ يصرخ، بينما صرخت: آه يا كاظم، التفت إلى أبي وشعرت بالخجل من شدة الانفعال الذي كنت فيه، وأعتقد أن كل عاشقات الساهر يحبونه بطريقة: آه يا كاظم.
في إحدى حفلاته في بابل، ولأنها حفلة تذاكرها رخيصة وصل أبناء عمي المسرح منذ السادسة صباحاً، كان شعب كامل يغني خلفه، تأثر الشباب في طريقة لبسه وطريقة حديثه.
كاظم فرحة العراقيين في وقت الحصار غنى لنا: “يا ليل لا تنتهي… توني ابتديت الغزل”، خلاصة الحياة التسعينية القاسية تتجسد بشغف مئات الآلاف من العراقيين به، كان ضدّاً نوعياً لبؤس الحياة وفقرها، يشاع أن أم كلثوم أسهمت في جعل المصريين ينسون نكبة حزيران، وأكاد أن أرى أن كاظم خفف من عبء الحصار.
نحن جيل عاش دون كهرباء ولا تقنيات، لم نكن نملك سوى الكاسيت الذي يربطنا بصوته، صرنا مراهقات وجاءت الرسائل الورقية المذيلة بتوقيع عشاق على طريقة “مدرسة الحب وأشهد وزيديني عشقا”، كبرنا قليلا أصبح العشاق يشهدون بأن لا امرأة إلا أنت، لنختم عقد التسعينيات بليلى، حيث تحولت كل العاشقات إلى ليلى، كل من يترك حبيبته يوصمها بـ”ليلى”، صرنا صورة ليلى الخائنة، بالحصار دفع الآباء الكثير من بناتهم للارتباط بمن يملك المال، وصارت الحبيبة ليلى التي تركض خلف “البهرج الخداع”.
تحوّل الخطاب من ليس هناك امرأة إلا أنت، إلى ليلى، هكذا ختم عقدنا الساهري، بكل هذا الكم من المشاعر والأغاني والانفعالات، عقدٌ لا يمكن تسميته إلا بعقد كاظم الساهر.