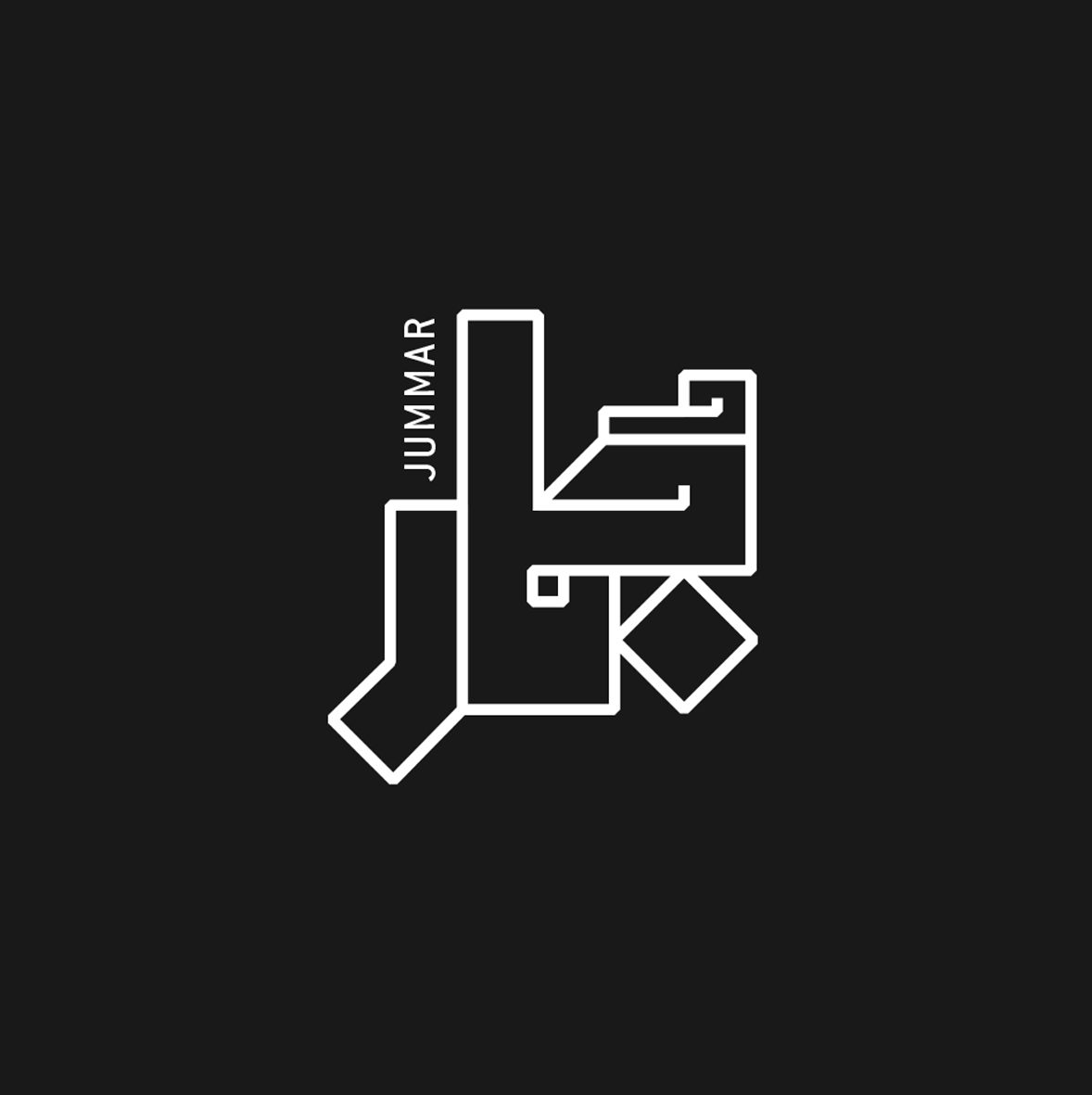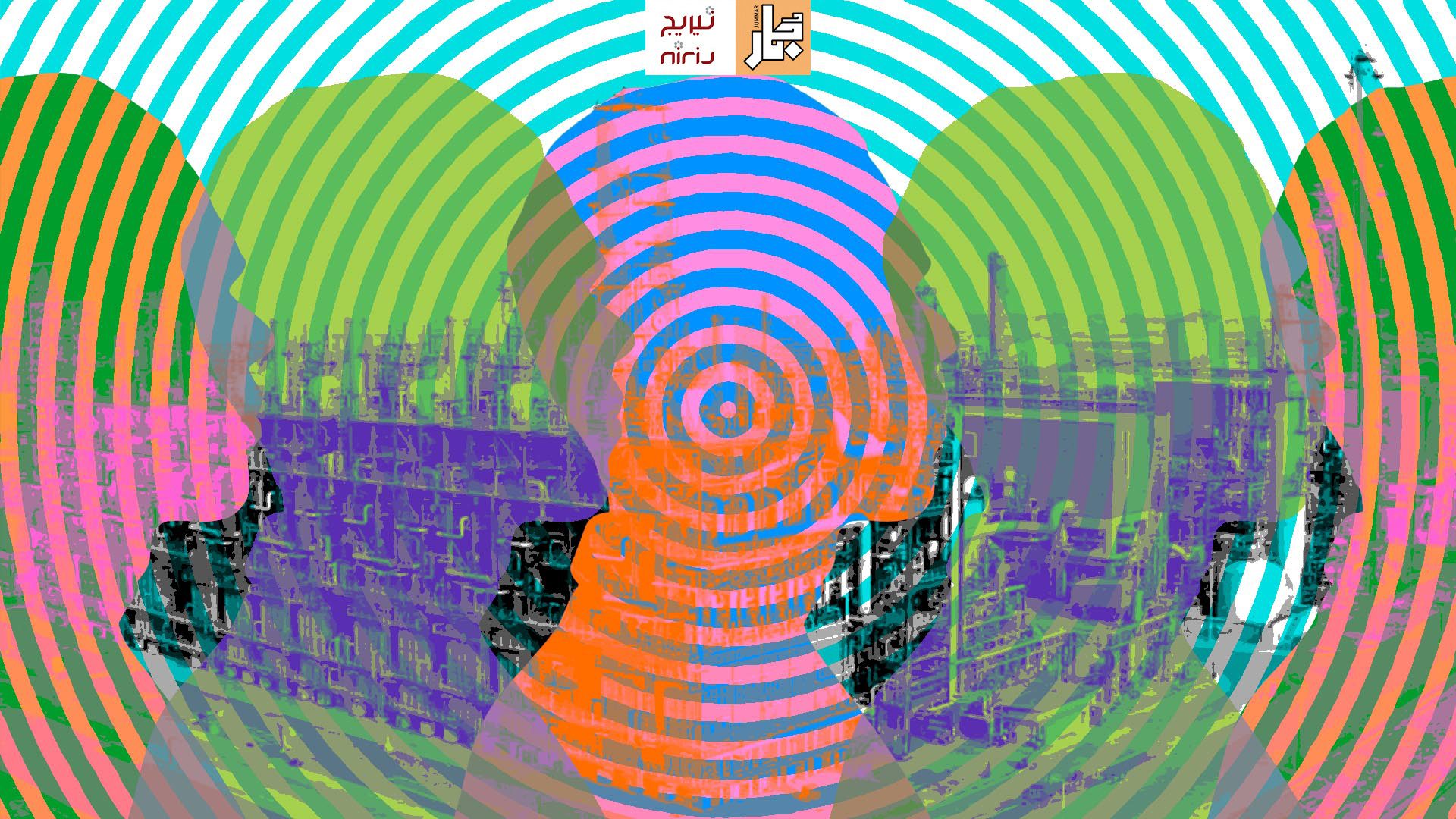الحب في مرحلة أولى جامعة: "سال دمي من أجل نظرة واحدة"
08 شباط 2024
نشأ جيل كامل من كلا الجنسين بلا فرصة حقيقية في اللقاء والتعرف على الطرف الآخر، وصار كلٌّ منهما يجهل الآخر، وانتقل ذلك معهم إلى الجامعات.. عن الحب في الجامعة وتحوّلاته..
حينما يجعلها الرجل تضحك، تشعر المرأة أنّها محمية1. هل هذا ما يفسر فعلياً اندفاع الشباب في المرحلة الأولى من الجامعة لفعل أيِّ شيء خارق للعادة؛ لكي يلفت انتباه البنت، أو محاولة جعلها تضحك؟
الحديث عن الحب في المرحلة الأولى من الجامعة، هو حديث عن الطالب العراقي، وتكوينه الاجتماعي والأكاديمي، ولكن ليس أيّ طالب؛ إنما هو ذلك الذي ارتاد المدرسة والجامعة بعد عام 1993، عن ذلك الطالب بالتحديد، وعن طرقه في التعبير عن الحب، وفرص مخالطته للجنس الآخر والتعرّف عليه في بداية الألفية الجديدة.
في عقد التسعينيات هبطت لحظة إيمانية مفاجئة على صدر صدام حسين، الرئيس الأسبق، وتحوّلت هذه اللحظة في ما بعد إلى “حملة إيمانية” نشرها في طول العراق وعرضه نائبه، عزّت الدوري، بعد الهزيمة الفادحة في حرب “عاصفة الصحراء”.
يصف فالح عبد الجبار، عالم الاجتماع العراقي، تلك اللحظة المفاجئة لصدام في كتابه “دولة الخلافة.. التقدم إلى الماضي” بأنها غيّرت الحزب والمجتمع تغييراً كبيراً، وتغيّر معهما المخيال، فالتحوّل جاء مفاجئاً للجميع، وستنطوي الحملة الإيمانية على خليط من التربية الدينية، وتحديد أشكال السلوك واللباس، وقائمة قاسية من مدوّنة عقاب جديدة.
المدوّنة تضمنت قائمة منها: قطع يد السارق، وإلقاء الناس من أسطح البنايات العالية، بتهمة اللواط، وقطع رؤوس النساء بالسيف، بتهمة الدعارة، وإطلاق سراح السجين المحكوم عليه في قضية جنائية إذا حفظ جزءاً أو أكثر من القرآن، واستمراراً للحملة، بدأت السلطة بفصل الجنسين في المدارس.
لقد نشأ جيل كامل من كلا الجنسين بلا فرصة حقيقية في اللقاء والتعرف على الطرف الآخر، وصار كلٌّ منهما يجهل الآخر، وانتقل ذلك معهم إلى الجامعات. فجأةً وبلا مقدمات وجدوا أنفسهم يلتقون ببعضهم، علناً وبشكل صريح، وهذا ما سيفرض طابع تواصل مرتبك بين الطرفين، يظهر جلياً على ثياب الطلاب وحركاتهم، وحتى أحاديثهم، كل هذه التجليات تتجه نحو الرغبة في التميّز ولفت الانتباه.
بلا تطبيقات مواعدة
على الرغم من أنّ البيئة العراقية، هي بيئة مقيّدة بالأعراف والالتزامات الدينة والاجتماعية، التي تحدُّ من فرصة الاختلاط مع الجنس الآخر، وذلك يظهر في المحافظات أكثر من بغداد لكونها العاصمة -وهذا لا يعني أنها أفضل حالاً- فقد تخلو مرافق هذه المحافظات والمدن من فرصة اللقاء مع الجنس الآخر، والاختلاط به، فالمدن مكتظة بالمطاعم والمولات، وتفتقد إلى مكان آمن للاختلاط، وعلى الرغم من ذلك كله، ومع دخول التكنلوجيا، لم يفكر أحد بتطبيقات للمواعدة، تكسر كل هذه الحدود.
يقول مثل أمريكي “إن الحب يزورنا كل عشر سنوات” وحالما تضاءل تأثير هذا المثل على المحبين، بعد ظهور أول تطبيق للمواعدة ”Matchmaker” وهو أقدم خدمة مواعدة عبر الإنترنت، بدأ عام 1986، واختصر الطريق والوقت، وصار الموقع يأخذ على عاتقه خلق الصدفة لا انتظارها، لكن في العراق، ما زال الرجال والنساء لا يملكون التحكّم في هذه الصدفة، والتقرّب منها، فلا مكان واضحاً للاختلاط غير الجامعة، حتى أنّ كثيراً من الناس صاروا يفكرون بالالتحاق في الجامعة من أجل الحب، أو البحث عنه، وكثير منهم -حتى من المتخرجين- يفكر بالعودة إلى الجامعة، من أجل الحصول على فرصة جديدة للاختلاط.
لتسيل الدماء من أجل التفاتة واحدة!
عندما تتذكر مروة (34 عاماً) ما فعلته هناك، في جامعة القادسية، تشعر أنها كانت تحت تأثير تنويم مغناطيسي، “لكن ما يهدئ روعي، ويجعلني أضحك مما فعلتهُ، بدلاً من محاسبة نفسي على ذلك، هو أننا كُلنا كنا نشترك بحفلة الغباء تلك”. وتتذكر كيف أنها في إحدى المرات وضعت “كانولة” في يدها، وتظاهرت بأنها مريضة لتكسب تعاطف الطلاب، فينتبهون لها، وعندما لم ينتبه أحد؛ سحبت “الكانولة” بقوة أمام الجميع، وتركت الدم يتدفق، وبدأت تمشي في ممر قسم العلوم، ويدها ملطخةً بدمائها، تقول عن تلك اللحظة، “لقد كان مشهداً مروعاً، كيف تحملتُ كل ذلك الألم! من أجل لفت الانتباه”.
رغم غرابة الفكرة، لكن مروة نجحت بالتقاط أحدهم، عُمَر، كان يعمل في القطاع الصحي، وله خبرة جيدة في الإسعافات الأولية. تسرد كيف تقدم نحوها، ووضع يده حيث يتدفق الدم، وضمّد جرحها، وفي اليوم التالي سأل عن حالتها الصحيّة، وبعدها ذهبت لتشكره، وهكذا بدأ الحديث، وأخذتهم التجربة إلى الادّعاء والإثارة.
“ادعيت أنّ أبي يملك مصنعاً للخشب، رغم أنّ مدينتي لا تملك حتى معمل صغير لصنع الخشب، وكنت ادّعي أنني أملك سيارة، لكنني تسببت بحادث قريب، وتركتها في التصليح” عندما أتذكر كل ذلك، وأتساءل عن الدوافع التي دفعتني لكل ذلك، أخجل من نفسي، تقول مروة.
في ما بعد، اكتشف العاشقان أنهما لا يستطيعان الاستمرار في العلاقة، وفقدا القدرة على التواصل، وانتهت قصة بدأت أولاً بالدم. لكن مروة ما زالت تتساءل، لو كان أحد آخر غير عمر قد ضمّد جرحها، هل سيكون هو حبيبها؟
بالنسبة لها فهي لم تفكر بذلك أبداً، بل على العكس، راحت تندب حظها، ودخلت في دوامة حزن عارمة، جزء كبير منها كان ملفقاً أيضاً، وللسبب ذاته، بحسب قولها، وهو جذب الانتباه، “بالطبع التقيت مع آخر يشبهني، هو أيضاً خارج من علاقة دامية، ربما أعلنا ضمنياً حينها افتتاح نادي الجروح المرموق”.
“النهاية الثانية كانت أبشع من الأولى” تصف مروة مغامرتها الثانية، وتعترف أنها كانت دائماً تُسقط أخطاء الحبيب الأول على الثاني، وهو كذلك في المقابل، يُسقط تجربته الأولى عليها، “حتى نشب بيننا عراك بالصراخ والشتائم، وانتهينا عند ذلك”.
تستدرك مروة أنها وعلى الرغم من امتلاكها شهادة دبلوم من المعهد الطبي قبل دخولها الجامعة، إلا أنها في المرحلة الأولى في كلية العلوم، تصرفت كأنها أول مرة تختلط مع الرجال، وتعزو سبب ذلك لأنها لم تعط لنفسها فرصة لتقييم علاقاتها، “كنتُ أخرج من علاقة، وأدخل في واحدة أخرى، والآن وقد مرّت عشر سنوات على تلك الذكريات، ما زلت أقيّم تلك التجربة، وأحاول فهمها، حتى بعد أن تزوجت، وأنا الآن أم لطفلتين”.
إعادة كتابة الحب على دفتر صغير
“ربما أجزم أنّ ما فعلته من حماقة لم يفعله أحد بعدي، إنّ المنطق الإنساني ليرفض ما فعلته بنفسي” يروي حازم (53 عاماً) عندما كان طالباً في كلية آداب المستنصرية، كيف سمع هند تتحدث عن رغبتها باقتناء رواية “قصة حب مجوسية” لعبد الرحمن منيف، لم يكن يجلس معها أو يرافقها، ولم يكن حتى زميلها، بل سمعها وهي تتحدث لرفاقها بينما كان هو يتلصص السمع من مسافة، متظاهراً بأنه يقرأ “الملزمة” التي كان يحملها.
“قلت في نفسي هذه فرصتك يا ولد” ولم يتأخر بذلك، ذهب إلى صديق يملك والده مكتبة، تفاوض معه، وتوصل إلى اتفاق يقضي بإعطائه ميدالية جديدة كان يملكها، مقابل أن يعيره الرواية لفترة محددة، وهكذا تمت الصفقة.
في أيام الحصار، كان سعر النسخة الأصلية من الرواية يعادل 5 دولارات في سوق الكتب، ما يعادل راتباً شهرياً لنحو ثلاثة معلمين؛ لذا قرر حازم إعادة كتابة الرواية على دفتر، “عكفت على كتابة الرواية، وكدت أنهار من التعب والسهر” لا يمكنه فعل ذلك الآن، يؤكد حازم، فهو بعمر الثالثة والخمسين لا يقوى على قراءة خمس صفحات من أيّة رواية خلال أسبوع كامل، وليس أن يكتب رواية كاملة على دفتر، كلمة كلمة وحرفاً حرفاً، لكن هذا ما يفعله الحب!
ذهب حازم في اليوم التالي، وقدّم منجزه العاطفي. يصف كيف وقفت هند لدقائق عدة تحاول استيعاب ما أخبرها به، قلّبت في الدفتر، ونظرت في وجهه، وقالت له:
- وشنو تريد هسه؟”.
“اقريها بس” هكذا أجبت “ورحلتُ عنها بطريقة دراماتيكية” يتسع خيال حازم حدّ أن يتخيل تلك اللحظة مع إضافة مونتاج عليها، وتشغيل أغنية في الباك كراوند مثلاً، لتبدو كأنها مشهد من مسلسل عراقي، من انتاج فترة التسعينيات.
التقى حازم وهند بعد سنوات طويلة، تغير العالم، وهما كذلك، وأصبحت روايات منيف بسعر سندويشة برغر، واكتشف حازم أن هند حاولت التحدث إليه بعد ذلك المشهد، لكنه كان يتحاشاها، وعرف منها أنها لم تكن تعرف عبد الرحمن منيف، ولا رواياته، وأن من تحدثت عن رغبتها بقصة الحب المجوسية كانت صديقتها، وليست هي، لكن حازم اختلطت عليه الأصوات، بينما كان يخبئ وجهه في “الملزمة” وعرف أيضاً أنها لم تحتفظ بالمخطوطة، وهكذا انتهى ذلك الحب الذي لم يبدأ.
مصاطب ملطخة بالجير
خرج العراق من الحصار، وانتهت الحملة الإيمانية، وسقط مؤسسها، ودخل العراقيون مرحلة ما بعد 2003، تغير الكثير، لكن الكبت والخوف من الحب، ظل هاجساً يسيطر على الحياة الجامعية في البلاد.
بعد 10 سنوات من لحظة الاحتلال، وفي كلية الهندسة الكهربائية بجامعة البصرة، كان معتز (32 عاماً) يحاول أن يعيش حياة جامعية مدنية، لكن عميد الكلية وفي أول يوم من تنصيبه؛ قرر قطع الأشجار في حدائق الكليات، حتى لا يجلس عاشقان تحت ظل شجرة في البصرة، وذهب أبعد من ذلك بحسب رواية معتز، “وضع الجير على كل مصاطب الجلوس في رواق الكلّية، ومنع جلوس الطلاب مع الطالبات في النادي إلا بعد أن تبرز عقد الزواج الرسمي مختوماً من المحكمة” ولم يكن هذا كافياً للعميد ذاك، فقد قرر إغلاق النادي نهائياً
بالنسبة لمعتز، فإن قصص الحب التي عرفها لم تتجاوز مواقع التواصل الاجتماعي، والنظرات البعيدة في الجامعة، يصفها بأنها كانت حياة جامعية مُمرضة وسيئة، “كنا متوترين طوال الوقت، ونشعر بالغبن، حتى أننا يوم خرجنا بمظاهرات داخل الجامعة تنديداً بتلك التصرفات، قام العميد باستدعاء الشرطة لتفريقنا” ولكن رغم ذلك استمرت مظاهرات معتز ورفاقه لعدة أيام، وضغطوا لإبعاد العميد، فتدخّل محافظ البصرة حينها، ووعد بتغيير العميد حينها، وهذا ما حدث بالفعل.
الحب الجامعي في الرواية العراقية
يُطلق على الروائيين التسعينيين تسميةً انطباعية، وهي “جيل التغيير أو القطيعة” كما يصفهم القاص محمد خضير في كتابه تاريخ زقاق، ويعني بالتغيير والقطيعة، أنها مقاطعة التجربة السردية العراقية، والبدء بطريق آخر نحو صنع أعراف جديدة للكتابة السردية.
عند المرور على تجربة هذا الجيل السردية، يمكن ملاحظة التشابه والتقارب الذي يصل إلى حد المطابقة في مواضيع ومواضع عدة، وهذا ليس شائناً، فهو جيل عاش شبابه تحت سلطة “الحملة الإيمانية” والحصار الاقتصادي الأمريكي، ومن ارتاد الجامعة منهم، فهو حتماً كان يخاف الجلوس مع حبيبته تحت شجرة، أو على مصطبة، هذا إن كانت هناك حبيبة.
المرور على نصوص تلك الحقبة، يعني المرور على كل تلك الأحلام والخيالات والكبت والخوف الذي كان متفشياً آنذاك، حيث تبدأ الملحمة الجامعية بوصف بطل الرواية الفقير الذي يحظى بلحظة اهتمام فتاة جميلة، تنتمي إلى عائلة غنية، تسكن غالباً في حي المنصور أو الجادرية، وينتهي المشهد المتخيّل بالصدفة التي تقود البطل الجامعي الفقير إلى زيارة بيت عائلة الفتاة الكبير، في توقيت سفر الوالدين، ليحظى البطل الجامعي أخيراً بقبلة ساحرة وثمينة.
في “وحدها شجرة الرمان” لسنان أنطون، يستغرق التحضير لذهاب البطل إلى بيت حبيبته ثلاثة أشهر، ويحدث هذا لأن البيت خالٍ من الرقابة الأبوية، والأهم من ذلك هو خلوه من زوجة الأب.
بعدها بثلاثة أشهر دعتني، بدون مقدمات، إلى تناول الغداء في بيتها، فسألتها عمّن سيكون هناك، فقالت:
– ليش خايف؟
ضحكت وقلت لها:
- لا، بس ممنوع السؤال؟
قالت: زوجة أبوية مسافرة للموصل وبابا بالشغل
في رواية إعجام، لسنان أيضاً، يتكرّر المشهد، ويتطابق لولا أن الحبيبة تطمئن البطل الجامعي المرتاب من وجود أهلها في المنزل عندما عرضت عليه الذهاب إلى هناك، بأنّ “بابا وماما” منفتحين.
– نكدر نروح للبيت، ونرجع لمحاضرة الفرنسي على الأربعة.
– والأهل؟
– ماكو أحد بالبيت، ماما بالدوام وبابا مسافر، وحتى لو موجودين بالبيت ترة هم منفتحين، شنو خايف؟
ورغم أنه من الجيل التسعيني للرواية العراقية، إلا أن مثل هذه المشاهد تشحّ أو تكاد تختفي من نصوص الكاتب أحمد سعداوي، وربما يعود هذا إلى كونه درس في معهد المعلمين، ولم يلتحق في الجامعة، وكذلك الكاتب حسن بلاسم، فهو قد هاجر من العراق في المرحلة الأولى لكلية الفنون، ولم يجرّب الفترة الجامعية في تلك الحقبة.
المقارنات بين تلك الحقبة، التسعينيات، وما قبلها وما بعدها أيضاً، ما زالت قائمة، ولن تنتهي، سواء في الأدب أو في نقد الأدب، والحياة كذلك، فبالنسبة للدكتور أحمد حسين الظفيري، الأكاديمي في جامعة سامراء، هنالك فرق كبير بين ما عاشه هو في أواسط التسعينيات، وما يحدث أمامه اليوم، الأحلام مختلفة، والطموح مختلف، كما يرى، فهو ينتمي إلى جيل نشأ في الحصار الاقتصادي، وكانت لقمة العيش ومواصلة الدراسة هي الهمّ الأكبر.
“لم يكن لدينا رفاهية شراء الملابس والدخول إلى كافتيريا الكلية، ونادراً ما كان الطلاب يفكرون في الزواج، ولا أتذكر وجود فتيات متزوجات معنا في الكلية” أما اليوم فالمشهد غريب جداً على الظفيري، فجزء كبير من الطلاب يدخلون الجامعة، وهم متزوجون، أو يتزوجون خلال المراحل الأولى، كما تشهد الجامعة استعراضاً واضحاً للرفاهية، استعراضاً للملابس والسيارات والهواتف النقالة، والساعات.
هذا الاختلاف يتجلّى ليس على المظاهر فقط، وإنما على اللغة أيضاً، كيف كان يعبر ذلك الجيل (جيل الحصار) عن نفسه وعن مشاعره، وكيف يعبر هذا الجيل، جيل ما بعد 2003.
يقول الدكتور بلال سمير، أستاذ الهندسة المعمارية في الجامعة التكنلوجية، إنه يرصد تغيراً واضحاً في تصرفات الألفية الجديدة، حتى طلاب المرحلة الأولى منهم، “لا يتعامل الواحد منهم بارتباك مع الآخر، أشعر أنهم تعودوا على الاختلاط أكثر من جيلنا السابق، حتى أنهم من السهل عليهم كلمة “صديقي/ صديقتي” هذه الكلمة بحسب الدكتور بلال كانت تعني “حبيبتي” على أيامهم الجامعية.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
حينما يجعلها الرجل تضحك، تشعر المرأة أنّها محمية1. هل هذا ما يفسر فعلياً اندفاع الشباب في المرحلة الأولى من الجامعة لفعل أيِّ شيء خارق للعادة؛ لكي يلفت انتباه البنت، أو محاولة جعلها تضحك؟
الحديث عن الحب في المرحلة الأولى من الجامعة، هو حديث عن الطالب العراقي، وتكوينه الاجتماعي والأكاديمي، ولكن ليس أيّ طالب؛ إنما هو ذلك الذي ارتاد المدرسة والجامعة بعد عام 1993، عن ذلك الطالب بالتحديد، وعن طرقه في التعبير عن الحب، وفرص مخالطته للجنس الآخر والتعرّف عليه في بداية الألفية الجديدة.
في عقد التسعينيات هبطت لحظة إيمانية مفاجئة على صدر صدام حسين، الرئيس الأسبق، وتحوّلت هذه اللحظة في ما بعد إلى “حملة إيمانية” نشرها في طول العراق وعرضه نائبه، عزّت الدوري، بعد الهزيمة الفادحة في حرب “عاصفة الصحراء”.
يصف فالح عبد الجبار، عالم الاجتماع العراقي، تلك اللحظة المفاجئة لصدام في كتابه “دولة الخلافة.. التقدم إلى الماضي” بأنها غيّرت الحزب والمجتمع تغييراً كبيراً، وتغيّر معهما المخيال، فالتحوّل جاء مفاجئاً للجميع، وستنطوي الحملة الإيمانية على خليط من التربية الدينية، وتحديد أشكال السلوك واللباس، وقائمة قاسية من مدوّنة عقاب جديدة.
المدوّنة تضمنت قائمة منها: قطع يد السارق، وإلقاء الناس من أسطح البنايات العالية، بتهمة اللواط، وقطع رؤوس النساء بالسيف، بتهمة الدعارة، وإطلاق سراح السجين المحكوم عليه في قضية جنائية إذا حفظ جزءاً أو أكثر من القرآن، واستمراراً للحملة، بدأت السلطة بفصل الجنسين في المدارس.
لقد نشأ جيل كامل من كلا الجنسين بلا فرصة حقيقية في اللقاء والتعرف على الطرف الآخر، وصار كلٌّ منهما يجهل الآخر، وانتقل ذلك معهم إلى الجامعات. فجأةً وبلا مقدمات وجدوا أنفسهم يلتقون ببعضهم، علناً وبشكل صريح، وهذا ما سيفرض طابع تواصل مرتبك بين الطرفين، يظهر جلياً على ثياب الطلاب وحركاتهم، وحتى أحاديثهم، كل هذه التجليات تتجه نحو الرغبة في التميّز ولفت الانتباه.
بلا تطبيقات مواعدة
على الرغم من أنّ البيئة العراقية، هي بيئة مقيّدة بالأعراف والالتزامات الدينة والاجتماعية، التي تحدُّ من فرصة الاختلاط مع الجنس الآخر، وذلك يظهر في المحافظات أكثر من بغداد لكونها العاصمة -وهذا لا يعني أنها أفضل حالاً- فقد تخلو مرافق هذه المحافظات والمدن من فرصة اللقاء مع الجنس الآخر، والاختلاط به، فالمدن مكتظة بالمطاعم والمولات، وتفتقد إلى مكان آمن للاختلاط، وعلى الرغم من ذلك كله، ومع دخول التكنلوجيا، لم يفكر أحد بتطبيقات للمواعدة، تكسر كل هذه الحدود.
يقول مثل أمريكي “إن الحب يزورنا كل عشر سنوات” وحالما تضاءل تأثير هذا المثل على المحبين، بعد ظهور أول تطبيق للمواعدة ”Matchmaker” وهو أقدم خدمة مواعدة عبر الإنترنت، بدأ عام 1986، واختصر الطريق والوقت، وصار الموقع يأخذ على عاتقه خلق الصدفة لا انتظارها، لكن في العراق، ما زال الرجال والنساء لا يملكون التحكّم في هذه الصدفة، والتقرّب منها، فلا مكان واضحاً للاختلاط غير الجامعة، حتى أنّ كثيراً من الناس صاروا يفكرون بالالتحاق في الجامعة من أجل الحب، أو البحث عنه، وكثير منهم -حتى من المتخرجين- يفكر بالعودة إلى الجامعة، من أجل الحصول على فرصة جديدة للاختلاط.
لتسيل الدماء من أجل التفاتة واحدة!
عندما تتذكر مروة (34 عاماً) ما فعلته هناك، في جامعة القادسية، تشعر أنها كانت تحت تأثير تنويم مغناطيسي، “لكن ما يهدئ روعي، ويجعلني أضحك مما فعلتهُ، بدلاً من محاسبة نفسي على ذلك، هو أننا كُلنا كنا نشترك بحفلة الغباء تلك”. وتتذكر كيف أنها في إحدى المرات وضعت “كانولة” في يدها، وتظاهرت بأنها مريضة لتكسب تعاطف الطلاب، فينتبهون لها، وعندما لم ينتبه أحد؛ سحبت “الكانولة” بقوة أمام الجميع، وتركت الدم يتدفق، وبدأت تمشي في ممر قسم العلوم، ويدها ملطخةً بدمائها، تقول عن تلك اللحظة، “لقد كان مشهداً مروعاً، كيف تحملتُ كل ذلك الألم! من أجل لفت الانتباه”.
رغم غرابة الفكرة، لكن مروة نجحت بالتقاط أحدهم، عُمَر، كان يعمل في القطاع الصحي، وله خبرة جيدة في الإسعافات الأولية. تسرد كيف تقدم نحوها، ووضع يده حيث يتدفق الدم، وضمّد جرحها، وفي اليوم التالي سأل عن حالتها الصحيّة، وبعدها ذهبت لتشكره، وهكذا بدأ الحديث، وأخذتهم التجربة إلى الادّعاء والإثارة.
“ادعيت أنّ أبي يملك مصنعاً للخشب، رغم أنّ مدينتي لا تملك حتى معمل صغير لصنع الخشب، وكنت ادّعي أنني أملك سيارة، لكنني تسببت بحادث قريب، وتركتها في التصليح” عندما أتذكر كل ذلك، وأتساءل عن الدوافع التي دفعتني لكل ذلك، أخجل من نفسي، تقول مروة.
في ما بعد، اكتشف العاشقان أنهما لا يستطيعان الاستمرار في العلاقة، وفقدا القدرة على التواصل، وانتهت قصة بدأت أولاً بالدم. لكن مروة ما زالت تتساءل، لو كان أحد آخر غير عمر قد ضمّد جرحها، هل سيكون هو حبيبها؟
بالنسبة لها فهي لم تفكر بذلك أبداً، بل على العكس، راحت تندب حظها، ودخلت في دوامة حزن عارمة، جزء كبير منها كان ملفقاً أيضاً، وللسبب ذاته، بحسب قولها، وهو جذب الانتباه، “بالطبع التقيت مع آخر يشبهني، هو أيضاً خارج من علاقة دامية، ربما أعلنا ضمنياً حينها افتتاح نادي الجروح المرموق”.
“النهاية الثانية كانت أبشع من الأولى” تصف مروة مغامرتها الثانية، وتعترف أنها كانت دائماً تُسقط أخطاء الحبيب الأول على الثاني، وهو كذلك في المقابل، يُسقط تجربته الأولى عليها، “حتى نشب بيننا عراك بالصراخ والشتائم، وانتهينا عند ذلك”.
تستدرك مروة أنها وعلى الرغم من امتلاكها شهادة دبلوم من المعهد الطبي قبل دخولها الجامعة، إلا أنها في المرحلة الأولى في كلية العلوم، تصرفت كأنها أول مرة تختلط مع الرجال، وتعزو سبب ذلك لأنها لم تعط لنفسها فرصة لتقييم علاقاتها، “كنتُ أخرج من علاقة، وأدخل في واحدة أخرى، والآن وقد مرّت عشر سنوات على تلك الذكريات، ما زلت أقيّم تلك التجربة، وأحاول فهمها، حتى بعد أن تزوجت، وأنا الآن أم لطفلتين”.
إعادة كتابة الحب على دفتر صغير
“ربما أجزم أنّ ما فعلته من حماقة لم يفعله أحد بعدي، إنّ المنطق الإنساني ليرفض ما فعلته بنفسي” يروي حازم (53 عاماً) عندما كان طالباً في كلية آداب المستنصرية، كيف سمع هند تتحدث عن رغبتها باقتناء رواية “قصة حب مجوسية” لعبد الرحمن منيف، لم يكن يجلس معها أو يرافقها، ولم يكن حتى زميلها، بل سمعها وهي تتحدث لرفاقها بينما كان هو يتلصص السمع من مسافة، متظاهراً بأنه يقرأ “الملزمة” التي كان يحملها.
“قلت في نفسي هذه فرصتك يا ولد” ولم يتأخر بذلك، ذهب إلى صديق يملك والده مكتبة، تفاوض معه، وتوصل إلى اتفاق يقضي بإعطائه ميدالية جديدة كان يملكها، مقابل أن يعيره الرواية لفترة محددة، وهكذا تمت الصفقة.
في أيام الحصار، كان سعر النسخة الأصلية من الرواية يعادل 5 دولارات في سوق الكتب، ما يعادل راتباً شهرياً لنحو ثلاثة معلمين؛ لذا قرر حازم إعادة كتابة الرواية على دفتر، “عكفت على كتابة الرواية، وكدت أنهار من التعب والسهر” لا يمكنه فعل ذلك الآن، يؤكد حازم، فهو بعمر الثالثة والخمسين لا يقوى على قراءة خمس صفحات من أيّة رواية خلال أسبوع كامل، وليس أن يكتب رواية كاملة على دفتر، كلمة كلمة وحرفاً حرفاً، لكن هذا ما يفعله الحب!
ذهب حازم في اليوم التالي، وقدّم منجزه العاطفي. يصف كيف وقفت هند لدقائق عدة تحاول استيعاب ما أخبرها به، قلّبت في الدفتر، ونظرت في وجهه، وقالت له:
- وشنو تريد هسه؟”.
“اقريها بس” هكذا أجبت “ورحلتُ عنها بطريقة دراماتيكية” يتسع خيال حازم حدّ أن يتخيل تلك اللحظة مع إضافة مونتاج عليها، وتشغيل أغنية في الباك كراوند مثلاً، لتبدو كأنها مشهد من مسلسل عراقي، من انتاج فترة التسعينيات.
التقى حازم وهند بعد سنوات طويلة، تغير العالم، وهما كذلك، وأصبحت روايات منيف بسعر سندويشة برغر، واكتشف حازم أن هند حاولت التحدث إليه بعد ذلك المشهد، لكنه كان يتحاشاها، وعرف منها أنها لم تكن تعرف عبد الرحمن منيف، ولا رواياته، وأن من تحدثت عن رغبتها بقصة الحب المجوسية كانت صديقتها، وليست هي، لكن حازم اختلطت عليه الأصوات، بينما كان يخبئ وجهه في “الملزمة” وعرف أيضاً أنها لم تحتفظ بالمخطوطة، وهكذا انتهى ذلك الحب الذي لم يبدأ.
مصاطب ملطخة بالجير
خرج العراق من الحصار، وانتهت الحملة الإيمانية، وسقط مؤسسها، ودخل العراقيون مرحلة ما بعد 2003، تغير الكثير، لكن الكبت والخوف من الحب، ظل هاجساً يسيطر على الحياة الجامعية في البلاد.
بعد 10 سنوات من لحظة الاحتلال، وفي كلية الهندسة الكهربائية بجامعة البصرة، كان معتز (32 عاماً) يحاول أن يعيش حياة جامعية مدنية، لكن عميد الكلية وفي أول يوم من تنصيبه؛ قرر قطع الأشجار في حدائق الكليات، حتى لا يجلس عاشقان تحت ظل شجرة في البصرة، وذهب أبعد من ذلك بحسب رواية معتز، “وضع الجير على كل مصاطب الجلوس في رواق الكلّية، ومنع جلوس الطلاب مع الطالبات في النادي إلا بعد أن تبرز عقد الزواج الرسمي مختوماً من المحكمة” ولم يكن هذا كافياً للعميد ذاك، فقد قرر إغلاق النادي نهائياً
بالنسبة لمعتز، فإن قصص الحب التي عرفها لم تتجاوز مواقع التواصل الاجتماعي، والنظرات البعيدة في الجامعة، يصفها بأنها كانت حياة جامعية مُمرضة وسيئة، “كنا متوترين طوال الوقت، ونشعر بالغبن، حتى أننا يوم خرجنا بمظاهرات داخل الجامعة تنديداً بتلك التصرفات، قام العميد باستدعاء الشرطة لتفريقنا” ولكن رغم ذلك استمرت مظاهرات معتز ورفاقه لعدة أيام، وضغطوا لإبعاد العميد، فتدخّل محافظ البصرة حينها، ووعد بتغيير العميد حينها، وهذا ما حدث بالفعل.
الحب الجامعي في الرواية العراقية
يُطلق على الروائيين التسعينيين تسميةً انطباعية، وهي “جيل التغيير أو القطيعة” كما يصفهم القاص محمد خضير في كتابه تاريخ زقاق، ويعني بالتغيير والقطيعة، أنها مقاطعة التجربة السردية العراقية، والبدء بطريق آخر نحو صنع أعراف جديدة للكتابة السردية.
عند المرور على تجربة هذا الجيل السردية، يمكن ملاحظة التشابه والتقارب الذي يصل إلى حد المطابقة في مواضيع ومواضع عدة، وهذا ليس شائناً، فهو جيل عاش شبابه تحت سلطة “الحملة الإيمانية” والحصار الاقتصادي الأمريكي، ومن ارتاد الجامعة منهم، فهو حتماً كان يخاف الجلوس مع حبيبته تحت شجرة، أو على مصطبة، هذا إن كانت هناك حبيبة.
المرور على نصوص تلك الحقبة، يعني المرور على كل تلك الأحلام والخيالات والكبت والخوف الذي كان متفشياً آنذاك، حيث تبدأ الملحمة الجامعية بوصف بطل الرواية الفقير الذي يحظى بلحظة اهتمام فتاة جميلة، تنتمي إلى عائلة غنية، تسكن غالباً في حي المنصور أو الجادرية، وينتهي المشهد المتخيّل بالصدفة التي تقود البطل الجامعي الفقير إلى زيارة بيت عائلة الفتاة الكبير، في توقيت سفر الوالدين، ليحظى البطل الجامعي أخيراً بقبلة ساحرة وثمينة.
في “وحدها شجرة الرمان” لسنان أنطون، يستغرق التحضير لذهاب البطل إلى بيت حبيبته ثلاثة أشهر، ويحدث هذا لأن البيت خالٍ من الرقابة الأبوية، والأهم من ذلك هو خلوه من زوجة الأب.
بعدها بثلاثة أشهر دعتني، بدون مقدمات، إلى تناول الغداء في بيتها، فسألتها عمّن سيكون هناك، فقالت:
– ليش خايف؟
ضحكت وقلت لها:
- لا، بس ممنوع السؤال؟
قالت: زوجة أبوية مسافرة للموصل وبابا بالشغل
في رواية إعجام، لسنان أيضاً، يتكرّر المشهد، ويتطابق لولا أن الحبيبة تطمئن البطل الجامعي المرتاب من وجود أهلها في المنزل عندما عرضت عليه الذهاب إلى هناك، بأنّ “بابا وماما” منفتحين.
– نكدر نروح للبيت، ونرجع لمحاضرة الفرنسي على الأربعة.
– والأهل؟
– ماكو أحد بالبيت، ماما بالدوام وبابا مسافر، وحتى لو موجودين بالبيت ترة هم منفتحين، شنو خايف؟
ورغم أنه من الجيل التسعيني للرواية العراقية، إلا أن مثل هذه المشاهد تشحّ أو تكاد تختفي من نصوص الكاتب أحمد سعداوي، وربما يعود هذا إلى كونه درس في معهد المعلمين، ولم يلتحق في الجامعة، وكذلك الكاتب حسن بلاسم، فهو قد هاجر من العراق في المرحلة الأولى لكلية الفنون، ولم يجرّب الفترة الجامعية في تلك الحقبة.
المقارنات بين تلك الحقبة، التسعينيات، وما قبلها وما بعدها أيضاً، ما زالت قائمة، ولن تنتهي، سواء في الأدب أو في نقد الأدب، والحياة كذلك، فبالنسبة للدكتور أحمد حسين الظفيري، الأكاديمي في جامعة سامراء، هنالك فرق كبير بين ما عاشه هو في أواسط التسعينيات، وما يحدث أمامه اليوم، الأحلام مختلفة، والطموح مختلف، كما يرى، فهو ينتمي إلى جيل نشأ في الحصار الاقتصادي، وكانت لقمة العيش ومواصلة الدراسة هي الهمّ الأكبر.
“لم يكن لدينا رفاهية شراء الملابس والدخول إلى كافتيريا الكلية، ونادراً ما كان الطلاب يفكرون في الزواج، ولا أتذكر وجود فتيات متزوجات معنا في الكلية” أما اليوم فالمشهد غريب جداً على الظفيري، فجزء كبير من الطلاب يدخلون الجامعة، وهم متزوجون، أو يتزوجون خلال المراحل الأولى، كما تشهد الجامعة استعراضاً واضحاً للرفاهية، استعراضاً للملابس والسيارات والهواتف النقالة، والساعات.
هذا الاختلاف يتجلّى ليس على المظاهر فقط، وإنما على اللغة أيضاً، كيف كان يعبر ذلك الجيل (جيل الحصار) عن نفسه وعن مشاعره، وكيف يعبر هذا الجيل، جيل ما بعد 2003.
يقول الدكتور بلال سمير، أستاذ الهندسة المعمارية في الجامعة التكنلوجية، إنه يرصد تغيراً واضحاً في تصرفات الألفية الجديدة، حتى طلاب المرحلة الأولى منهم، “لا يتعامل الواحد منهم بارتباك مع الآخر، أشعر أنهم تعودوا على الاختلاط أكثر من جيلنا السابق، حتى أنهم من السهل عليهم كلمة “صديقي/ صديقتي” هذه الكلمة بحسب الدكتور بلال كانت تعني “حبيبتي” على أيامهم الجامعية.