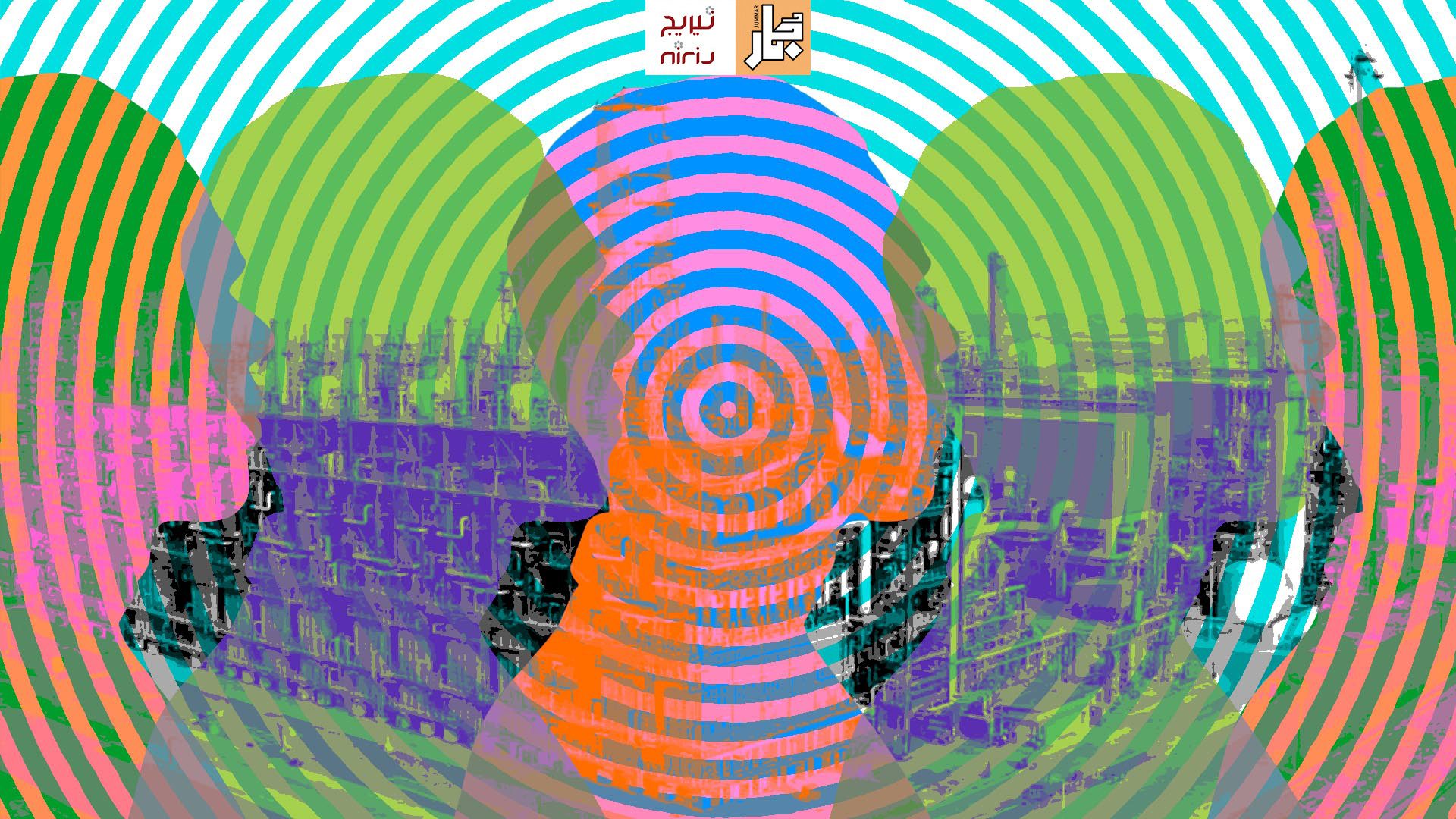أن تكون سَتيفاً نبيِّلاً
01 شباط 2024
الحملة الممنهجة والهادفة إلى تقبيح صورة العراقي في الميديا الأمريكية متجددة وليست جديدة، تعود إلى لحظة أحداث 11 سبتمبر وما قبلها.
مع أن سنوات طوالاً مرّت على هذه الحادثة؛ إلا أنها عصيّة على النسيان.
كنت في العاشرة من عمري، حقيبة مدرسية سمائية على ظهري، وفي يدي كيس فيه بيضة حمام مسلوقة بحجم الإبهام ملفوفة بخبز جيل الطيبين الأسمر؛ المشهور بقدرته العجيبة على التحول إلى شاعر داخل معدتك وظيفته إيهامها بالشبع كلما شعرت بالجوع. أبي وهو يوصلني أوقفني عند باب مدرستي، قلعة العروبة الابتدائية، هذا اسمها، ضغط على كتفي كي يمدني بكهرباء الصبر على يوم جديد في هذه الحياة، قبَّلني ومضيت إلى الداخل، لكنه ناداني لأعود عليه قبل أن أدير رأسي، وقفت أمامه من جديد ليهمس في أذني: إياك أن تكون سَتيفاً نبيِّلاً!
أومأت له موافقاً وضعتُ في زحام التلاميذ أفكر بلا هوادة عن معنى أن يكون الواحد ستيفاً نبيلاً، ولم يحدث أن سألته
مستوضحاً عن معنى السَتيف بفتح السين والنبيِّل بتشديد الياء المكسورة ولماذا يحذرني من ذلك، وما ضاعف في قلبي لهفة السؤال عن معناهما هو أنني في الأسبوع نفسه، كنت أطل من نافذة الصف على الحديقة، حيث النخلة البرحية وحولها فرّاشة المدرسة أم حسين وزوجها صاعود النخل وبستاني المدرسة، كنت أراقبه يعبث في رأس النخلة ليستخرج منها الطَلْع، أعطيتهم بيضتي المسلوقة ليعطوني عنقوداً من الطَلْع مدافاً بعسل التمر، شكرت الفرّاشة وابتسمتْ لي ومضت إلى زوجها تمسح الغبار عن أكتافه وهو يترجل من عنق عمته النخلة، لكنها، الفرّاشة، وبعد أن استدارت بظهرها وتحركت لخطوتين أو ثلاث، التفتتْ نحوي دون مقدمات، وقالت وهي تصوّب أنظارها عميقاً في وجهي: إياك ثم إياك أن تكون ستيفاً نبيلاً!

بعدها بخمس سنين أو ست، تهيأ لي أن أصبح ذبابة قواميس ومعاجم أبحث عن غريب المفردات ومعانيها، وعرفت أن «السَتيف» في لغة العرب، وحسب معجم العين للفراهيدي ومعجم الصحاح والقاموس المحيط؛ هو ابن الدرفش، تقول العرب: زق الدرفش الطعام لابنه السَتيف، والدرفش هو ابن الشخبوب، والشخبوب نبتة شتوية تنمو في صيوان أذن النعامة.
أما النبيّل؛ فهو الستيف إذا تغير لونه بعد أن تلعقه أنثى الكركدن في مواسم التزاوج، ومفرده النبلول، وهو التافه من الأمور وما لا يستأهل أن تكتب عنه مقالة!
قارئي الجميل، جُعلت فداك، أشكر لك سعة صدرك على المزاح ثقيل الدم، لا شيء في القصة أعلاه حقيقياً، باستثناء مدرسة قلعة العروبة، كما أن الطَلْع لا يخرج من البرحية، الطَلْع من فحل البرحي، أما البرحية فهي أنثى.
ثم أن جيلي الطيب، وهو مساعد أقدم جيل طيب إذا توخينا الدقة التاريخية، لا يضع الحقيبة على ظهره، كانت التچة القماشية هي الحقيبة، ولم يكن لنا ظَهر.
عراقيو ترمب، لفظت مرّة هذه العبارة أمام صديق أمريكي أبيض فضحك، ثم استدرك: “هل هناك عراقيون يحبون ترمب؟ ياله من عالم غريب”.
صديقي ذاك، وهو متظاهر عتيد ضد سياسات ترمب، الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، صادفته في أيام الانتخابات السابقة يأكل من إحدى عربات طعام الشارع يديرها رجل مغربي، وسألته عن أحواله، فأجاب: سأذهب غداً لانتخاب مجرم الحرب القادم.
ذلك لأنه يرتدي دائماً عمامة الموضوعية وروحه الثائرة، ويرى أن رئيس هذه الولايات، أياً كان، ترمب أم بايدن، هو مجرم حرب قادم، والسلام في بلاد العم سام يعني الحرب في بلاد أخرى.
على نباهته تلك؛ لم يتصور فعلاً أن العراقيين -وهم أكثر من يحتقرهم الترمبيون الأصليون- يمكن أن يكونوا ترمبيين أيضاً، بالوكالة والأصالة. ويجدها مفارقة حزينة، ولا سيّما أن الترمبية العراقية لا تقتصر على بعض الأمريكيين العراقيين منهم، بل تجدها في العراق أيضاً، في داخله، وخارجه، وتحته.
وترددت أن أقول له: أننا، العراقيين، لنا تاريخ في محبة من يضطهدنا، ولعل تاريخنا هو قصيدة طويلة عن نشدان الخلاص من المخلّص الخطأ، الذي نعرف بأن آخر همه هو تخليصنا من ضيم تسبب هو نفسه في تأسيسه واستدامته.

وهذه ليست سمة خاصة بنا، إنها دليل على أننا بشر تنطبق علينا نظريات مفارقات السلوك البشري، التي تفيد بأن الجماعة «غير المتحضرة» تشبه الفرد الانتهازي؛ تميل إلى محبة الغالب الباطش كي تضمن البقاء بواسطة الاقتراب من مصدر القوة، تخاف من المواجهة فتخضع وتسعى إلى إخضاع باقي الأفراد الذين يقاومون الخضوع، أحد المشاهد الفوتوغرافية التي التقطها المؤرخون للحظة اجتياح المغول لبغداد يقتنص تلك الحالة: كانت النساء بعد الاعتداء عليهن يقدن المغول وبحماسة بالغة إلى الآبار التي يختبئ فيها أزواجهن.
بعد حادثة المطار التي اغتال فيها ترمب؛ الإيراني قاسم سليماني والعراقي أبو مهدي المهندس، تفشت تلك الروح اليائسة التي تحتفل بجبنها، وهي ذات مخصيّة لا تقوى على إخصاب واقعها وتخليصه فتهلل لمخلصها الزائف صاحب الحلول الاصطناعية السريعة، ولأن تلك الذات اليائسة عاجزة عن التصفيق له بعد أن ينتهي من مهمته الليلية، فهي بلا أذرع، وعاجزة عن الرقص له، لأنها بلا سيقان، فالامتنان الوحيد الذي تستطيع تقديمه له هو أن تنحني له.
وامتلأت منصات التواصل بالكباب، والكباب مفردة للتشفي ابتكرتها تلك الذات الجماعية اليائسة التي تتفاعل مع الواقع بواسطة أسفل ظهرها، مع أنّ العربي يعتز تراثياً بشيمته في احترام جثامين خصومه والابتعاد عنها حال الإجهاز عليها، احتراماً لنفسه وتجسيداً لنبل الأخلاق وخصال الشهامة والفروسية، فإن التمثيل اللفظي بالجثتين لم يهدأ حتى الآن، فتخيل مدى عمق الخراب الذي أصاب الذات العراقية، إن وجدتْ!
لم أقل ذلك لصديقي.
لا خلاف على أن إيران وطاقمها التبشيري قد ساهمت في تخريب تلك الذات والانتقام منها، سحقها والاشتراك سلباً في كل مآسيها الحديثة، ومكنّت مثلما مكنّت الحكومات الأمريكية المتعاقبة الفاسدين من قيادة العراق، وساهمت في تولية أمور العراقيين لسَقط المتاع من الكوادر الاحتياط والصفوف الخلفية لأحزاب المعارضة الشيعية، ممن لا يعتزون كثيراً بفكرة الوطنية العراقية، وليست لديهم حدود واضحة تنتهي عندها ولاية الرهبر، فسماحته يدخل معهم كل الأبواب، ابتداءً بباب الثلاجة وليس انتهاءً بباب الحارة.
يلبي هذا النوع من النشطاء تعاليم الحملة اليمينية المدرعة بالأكاذيب والخطابات العنصرية.
مثلما يساهم نوع آخر في الحملة الإيرانية المدرعة هي الأخرى بالأكاذيب وجرّنا إلى حروب آخر الزمان المقدسة؛ والخرافية بقلب الفاء إلى همزة مكسورة.
والعراق وعراقيوه بلا حملة، والوطنية العراقية مستلبة وتسير عارية في شارع النظريات الدعائية بلا نظرية، لقد اختطف هؤلاء وهؤلاء فكرة الوطنية ومعنى أن تكون عراقياً.
في أجندة اليمين الأمريكي المتطرف بنود مشددة ضد إنسان العراق، وقاموا بتسميم أدمغة الكثيرين بمن فيهم عراقيون أمريكيون نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، والحملة الممنهجة والهادفة إلى تقبيح صورة العراقي في الميديا الأمريكية متجددة وليست جديدة، تعود إلى لحظة أحداث 11 سبتمبر وما قبلها، وهؤلاء أساتذة في شيطنة الآخر، والشيطنة عندهم قناع مؤقت يدورون به على وجوه خصومهم السياسيين في كل حين.
يبرع مثلاً أحد هؤلاء النشطاء في نشر الجرائم الجنائية التي يقوم بها أفراد أمريكيون من أصل عراقي، بتوصية من اللوبي اليهودي في أروقه السياسة الأمريكية الذي يموّل بسخاء ممارسات التقبيح ضد العرب بشكل عام، وبدوافع عنصرية، فترى هذا وأمثاله، ينشرون كل فترة خبراً عن قيام فلان من أصل عراقي بجريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، وهذه جرائم حقيقية ارتكبها فعلاً الأفراد المشار إليهم، غير أنّ طريقة التركيز عليها تهدف إلى تنميط صورة الشخصية العراقية بالجريمة، فيسهل إقصاؤها ونبذها وقهرها، بل، قصفها والاعتداء على سيادتها الوطنية.

والفرد يشبه بلاده، انتهاك صورته الشخصية في الخارج هي مقدمة لانتهاك بلاده وتدميرها.
ولا أحد يشبه بلاده مثلما يشبه العراقي عراقه، مزاجه موصول بانكساراتها وأفراحها، وحظه اليوم في أحوالها لا في الأبراج.
تشير الإحصائيات الموثقة إلى أن الجالية العراقية في أمريكا هي أقل الجاليات ميلاً للعنف والتعرض للاعتقال، لكن الترمبيين؛ لا يؤمنون بالرياضيات مثل إيمانهم بالخرافات الإنجيلية عن الأعراق الأخرى، ولا يريدك أن ترى نفسك ضحية له، ينبغي دائماً أن تبدو إرهابياً، ينبغي أن تبدو تلك الطفلة الحافية المصابة بالسرطان التي لا تجد مقعداً كافياً في مدرسة فقيرة بأطراف السماوة أو الرمادي مصدر تهديد لشابة بيضاء ثرية وغبية في فلوريدا! هذه هي الصورة ويجب أن تكون كذلك؛ هكذا أوهم ناخبيه، الحمامة مفترسة والذئبة وديعة، كي يصبح حضرته دائماً، بطلك المحرر، وبطلهم القومي، الذي سيعيد أمريكا عظيمة مرة أخرى، التي بالنسبة له اليوم: ليست وحشية بما يكفي.
الترمبية العراقية، على تفاهة شأنها وخمول عقلها، أداة مثالية وقليلة الكلفة لاختصار الزمن، زمن الطبخة والتحكم بموازين النفوذ، سعر زهيد تدفعه الفوقية البيضاء لشراء ما لا يقدر بثمن: الاعتزاز بالهويّة. فتحصل على بروبغانده رخيصة وهوية تجرّم نفسها ذاتياً دون تدخل! ودون جهد يذكر.
والترمبيون العراقيون يبيعون على الطريقة الفاوستية، أنفسهم للشيطان، ولكن بلا مقابل، فلا تعتب عليّ، قارئي الجميل، وأنا أتناولهم- دون أن أسميهم!- وأبذل في الحديث عنهم قسطاً من وقتك ووقتي.
“العراق جامعة هارفرد للإرهاب”، هكذا يقول ترمب في إحدى خطبه المشهورة بالخواء والتعكز على رثاثة الجماهير المتخمة بالتفسيرات الدينية للعالم، والمخدوعين بصورة الرجل الأبيض العارف بمصلحة الأسمر، أكثر من الأسمر نفسه. الكاثوليكي الرؤوم الذي يحمل صليبه على خاصرته ويطوف الشرق مخلصاً إياه من البرابرة السمر، وهذه الصورة، تعيش في أذهان الكثير من المدونين الذي يسلمون أسافل ظهورهم للفحل المخصّب لأرحامهم المهجورة، بينما ينعق فيها الغراب: وا ترامباه!، وا سيداه، أدركنا أدركنا يا بن ماريان بنت مالكوم!
وهكذا تستحيل صورة العراق وإنسانه المقهور، بملامحه الثقافية وإرثه الحضاري الذي يصادق عليه الزمن، إلى صورة سلبية ومرادفة للإرهاب، ويقولها الرئيس ولا يستحي، ولا يستخدم أدوات اللغة في الاستثناء والتبعيض وتجنب التعميم، بل يزوِّر ذات العراقي من كونه سادرا تحت مظالم الدكتاتوريات والاحتلالات إلى متجبر طاغ يجوب الآفاق بحثاً عن عملية إرهابية، وباختصار: تحويل الضحية إلى جلاد، ذاتياً، أو تطوعياً من قبل الضحيّة نفسها، الضحية التي ترى في ترمب مخلصها، وهو من لا يتردد في نسفها وتجويعها وشيطنتها بينما تحتفل بفوزه بالانتخابات، لأنها تحبه وتكره نفسها!
لا يتفق آخر أربعة رؤساء أمريكان على لفظ اسم العراق، غزوا بلاداً لا يعرفون اسمها ولا يجيدون نطقها، أرسلوا الآلاف من زعاطيطهم لغزو بلاد لا يعرفون عنوانها حتى؛ جورج بوش ينطقه i-rack، بينما يلفظه أوباما eye-rack، ويشبهه جو بايدن في طريقة النطق، لكن ترمب يلفظه هكذا i مفصولة وقصيرة، ثم راك، بعيدة وقبيحة، كلهم غير قادرين على نطق اسمه، مع ملاحظة أن ترمب لا يلفظه أصلاً، يقطّعه إلى أوصال، يفجره بلسانه قبل أن يهرسه بأنيابه.

ولا تسألني ما هو النطق الصحيح، أعرف ولن أقول لك، لأنها ليست لغتي! أنا أبتهج حينما أشاهد معلمي اللغة الإنجليزية في العراق يخطئون في تعليمهم اللغة بشكل فاضح، يخيطون ويخربطون، لأني أحب ما يقوله عالم الاجتماع الكاريبي ستيورات هال «الأسود»: أفضل ما فعلناه للغة الإنجليزية هو إننا قمنا بتخريبها.
غزوناها مثلما غزتنا، ونسفت وجودنا.
ولا يبدو أن اختلاف الألسن يشير إلى شيء في الظاهر، لكن طريقة تقطيع الكلمة وهرسها في اللسان، مطها وسحلها قد يؤشر إلى انطباع المتكلم عنها، وقد يبدو ترمب الأكثر تحقيراً للعراق وهو يلفظ اسمه، لكن هذا لا يعني أن باقي الرؤساء والمتنافسين على كرسي الرئاسة القائم لديهم صورة إيجابية ونوايا طيبة عن ازدهار العراق وتحسين صورة مواطنيه في داخل العراق وخارجه، وتحته!
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
مع أن سنوات طوالاً مرّت على هذه الحادثة؛ إلا أنها عصيّة على النسيان.
كنت في العاشرة من عمري، حقيبة مدرسية سمائية على ظهري، وفي يدي كيس فيه بيضة حمام مسلوقة بحجم الإبهام ملفوفة بخبز جيل الطيبين الأسمر؛ المشهور بقدرته العجيبة على التحول إلى شاعر داخل معدتك وظيفته إيهامها بالشبع كلما شعرت بالجوع. أبي وهو يوصلني أوقفني عند باب مدرستي، قلعة العروبة الابتدائية، هذا اسمها، ضغط على كتفي كي يمدني بكهرباء الصبر على يوم جديد في هذه الحياة، قبَّلني ومضيت إلى الداخل، لكنه ناداني لأعود عليه قبل أن أدير رأسي، وقفت أمامه من جديد ليهمس في أذني: إياك أن تكون سَتيفاً نبيِّلاً!
أومأت له موافقاً وضعتُ في زحام التلاميذ أفكر بلا هوادة عن معنى أن يكون الواحد ستيفاً نبيلاً، ولم يحدث أن سألته
مستوضحاً عن معنى السَتيف بفتح السين والنبيِّل بتشديد الياء المكسورة ولماذا يحذرني من ذلك، وما ضاعف في قلبي لهفة السؤال عن معناهما هو أنني في الأسبوع نفسه، كنت أطل من نافذة الصف على الحديقة، حيث النخلة البرحية وحولها فرّاشة المدرسة أم حسين وزوجها صاعود النخل وبستاني المدرسة، كنت أراقبه يعبث في رأس النخلة ليستخرج منها الطَلْع، أعطيتهم بيضتي المسلوقة ليعطوني عنقوداً من الطَلْع مدافاً بعسل التمر، شكرت الفرّاشة وابتسمتْ لي ومضت إلى زوجها تمسح الغبار عن أكتافه وهو يترجل من عنق عمته النخلة، لكنها، الفرّاشة، وبعد أن استدارت بظهرها وتحركت لخطوتين أو ثلاث، التفتتْ نحوي دون مقدمات، وقالت وهي تصوّب أنظارها عميقاً في وجهي: إياك ثم إياك أن تكون ستيفاً نبيلاً!

بعدها بخمس سنين أو ست، تهيأ لي أن أصبح ذبابة قواميس ومعاجم أبحث عن غريب المفردات ومعانيها، وعرفت أن «السَتيف» في لغة العرب، وحسب معجم العين للفراهيدي ومعجم الصحاح والقاموس المحيط؛ هو ابن الدرفش، تقول العرب: زق الدرفش الطعام لابنه السَتيف، والدرفش هو ابن الشخبوب، والشخبوب نبتة شتوية تنمو في صيوان أذن النعامة.
أما النبيّل؛ فهو الستيف إذا تغير لونه بعد أن تلعقه أنثى الكركدن في مواسم التزاوج، ومفرده النبلول، وهو التافه من الأمور وما لا يستأهل أن تكتب عنه مقالة!
قارئي الجميل، جُعلت فداك، أشكر لك سعة صدرك على المزاح ثقيل الدم، لا شيء في القصة أعلاه حقيقياً، باستثناء مدرسة قلعة العروبة، كما أن الطَلْع لا يخرج من البرحية، الطَلْع من فحل البرحي، أما البرحية فهي أنثى.
ثم أن جيلي الطيب، وهو مساعد أقدم جيل طيب إذا توخينا الدقة التاريخية، لا يضع الحقيبة على ظهره، كانت التچة القماشية هي الحقيبة، ولم يكن لنا ظَهر.
عراقيو ترمب، لفظت مرّة هذه العبارة أمام صديق أمريكي أبيض فضحك، ثم استدرك: “هل هناك عراقيون يحبون ترمب؟ ياله من عالم غريب”.
صديقي ذاك، وهو متظاهر عتيد ضد سياسات ترمب، الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، صادفته في أيام الانتخابات السابقة يأكل من إحدى عربات طعام الشارع يديرها رجل مغربي، وسألته عن أحواله، فأجاب: سأذهب غداً لانتخاب مجرم الحرب القادم.
ذلك لأنه يرتدي دائماً عمامة الموضوعية وروحه الثائرة، ويرى أن رئيس هذه الولايات، أياً كان، ترمب أم بايدن، هو مجرم حرب قادم، والسلام في بلاد العم سام يعني الحرب في بلاد أخرى.
على نباهته تلك؛ لم يتصور فعلاً أن العراقيين -وهم أكثر من يحتقرهم الترمبيون الأصليون- يمكن أن يكونوا ترمبيين أيضاً، بالوكالة والأصالة. ويجدها مفارقة حزينة، ولا سيّما أن الترمبية العراقية لا تقتصر على بعض الأمريكيين العراقيين منهم، بل تجدها في العراق أيضاً، في داخله، وخارجه، وتحته.
وترددت أن أقول له: أننا، العراقيين، لنا تاريخ في محبة من يضطهدنا، ولعل تاريخنا هو قصيدة طويلة عن نشدان الخلاص من المخلّص الخطأ، الذي نعرف بأن آخر همه هو تخليصنا من ضيم تسبب هو نفسه في تأسيسه واستدامته.


وهذه ليست سمة خاصة بنا، إنها دليل على أننا بشر تنطبق علينا نظريات مفارقات السلوك البشري، التي تفيد بأن الجماعة «غير المتحضرة» تشبه الفرد الانتهازي؛ تميل إلى محبة الغالب الباطش كي تضمن البقاء بواسطة الاقتراب من مصدر القوة، تخاف من المواجهة فتخضع وتسعى إلى إخضاع باقي الأفراد الذين يقاومون الخضوع، أحد المشاهد الفوتوغرافية التي التقطها المؤرخون للحظة اجتياح المغول لبغداد يقتنص تلك الحالة: كانت النساء بعد الاعتداء عليهن يقدن المغول وبحماسة بالغة إلى الآبار التي يختبئ فيها أزواجهن.
بعد حادثة المطار التي اغتال فيها ترمب؛ الإيراني قاسم سليماني والعراقي أبو مهدي المهندس، تفشت تلك الروح اليائسة التي تحتفل بجبنها، وهي ذات مخصيّة لا تقوى على إخصاب واقعها وتخليصه فتهلل لمخلصها الزائف صاحب الحلول الاصطناعية السريعة، ولأن تلك الذات اليائسة عاجزة عن التصفيق له بعد أن ينتهي من مهمته الليلية، فهي بلا أذرع، وعاجزة عن الرقص له، لأنها بلا سيقان، فالامتنان الوحيد الذي تستطيع تقديمه له هو أن تنحني له.
وامتلأت منصات التواصل بالكباب، والكباب مفردة للتشفي ابتكرتها تلك الذات الجماعية اليائسة التي تتفاعل مع الواقع بواسطة أسفل ظهرها، مع أنّ العربي يعتز تراثياً بشيمته في احترام جثامين خصومه والابتعاد عنها حال الإجهاز عليها، احتراماً لنفسه وتجسيداً لنبل الأخلاق وخصال الشهامة والفروسية، فإن التمثيل اللفظي بالجثتين لم يهدأ حتى الآن، فتخيل مدى عمق الخراب الذي أصاب الذات العراقية، إن وجدتْ!
لم أقل ذلك لصديقي.
لا خلاف على أن إيران وطاقمها التبشيري قد ساهمت في تخريب تلك الذات والانتقام منها، سحقها والاشتراك سلباً في كل مآسيها الحديثة، ومكنّت مثلما مكنّت الحكومات الأمريكية المتعاقبة الفاسدين من قيادة العراق، وساهمت في تولية أمور العراقيين لسَقط المتاع من الكوادر الاحتياط والصفوف الخلفية لأحزاب المعارضة الشيعية، ممن لا يعتزون كثيراً بفكرة الوطنية العراقية، وليست لديهم حدود واضحة تنتهي عندها ولاية الرهبر، فسماحته يدخل معهم كل الأبواب، ابتداءً بباب الثلاجة وليس انتهاءً بباب الحارة.
يلبي هذا النوع من النشطاء تعاليم الحملة اليمينية المدرعة بالأكاذيب والخطابات العنصرية.
مثلما يساهم نوع آخر في الحملة الإيرانية المدرعة هي الأخرى بالأكاذيب وجرّنا إلى حروب آخر الزمان المقدسة؛ والخرافية بقلب الفاء إلى همزة مكسورة.
والعراق وعراقيوه بلا حملة، والوطنية العراقية مستلبة وتسير عارية في شارع النظريات الدعائية بلا نظرية، لقد اختطف هؤلاء وهؤلاء فكرة الوطنية ومعنى أن تكون عراقياً.
في أجندة اليمين الأمريكي المتطرف بنود مشددة ضد إنسان العراق، وقاموا بتسميم أدمغة الكثيرين بمن فيهم عراقيون أمريكيون نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، والحملة الممنهجة والهادفة إلى تقبيح صورة العراقي في الميديا الأمريكية متجددة وليست جديدة، تعود إلى لحظة أحداث 11 سبتمبر وما قبلها، وهؤلاء أساتذة في شيطنة الآخر، والشيطنة عندهم قناع مؤقت يدورون به على وجوه خصومهم السياسيين في كل حين.
يبرع مثلاً أحد هؤلاء النشطاء في نشر الجرائم الجنائية التي يقوم بها أفراد أمريكيون من أصل عراقي، بتوصية من اللوبي اليهودي في أروقه السياسة الأمريكية الذي يموّل بسخاء ممارسات التقبيح ضد العرب بشكل عام، وبدوافع عنصرية، فترى هذا وأمثاله، ينشرون كل فترة خبراً عن قيام فلان من أصل عراقي بجريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، وهذه جرائم حقيقية ارتكبها فعلاً الأفراد المشار إليهم، غير أنّ طريقة التركيز عليها تهدف إلى تنميط صورة الشخصية العراقية بالجريمة، فيسهل إقصاؤها ونبذها وقهرها، بل، قصفها والاعتداء على سيادتها الوطنية.


والفرد يشبه بلاده، انتهاك صورته الشخصية في الخارج هي مقدمة لانتهاك بلاده وتدميرها.
ولا أحد يشبه بلاده مثلما يشبه العراقي عراقه، مزاجه موصول بانكساراتها وأفراحها، وحظه اليوم في أحوالها لا في الأبراج.
تشير الإحصائيات الموثقة إلى أن الجالية العراقية في أمريكا هي أقل الجاليات ميلاً للعنف والتعرض للاعتقال، لكن الترمبيين؛ لا يؤمنون بالرياضيات مثل إيمانهم بالخرافات الإنجيلية عن الأعراق الأخرى، ولا يريدك أن ترى نفسك ضحية له، ينبغي دائماً أن تبدو إرهابياً، ينبغي أن تبدو تلك الطفلة الحافية المصابة بالسرطان التي لا تجد مقعداً كافياً في مدرسة فقيرة بأطراف السماوة أو الرمادي مصدر تهديد لشابة بيضاء ثرية وغبية في فلوريدا! هذه هي الصورة ويجب أن تكون كذلك؛ هكذا أوهم ناخبيه، الحمامة مفترسة والذئبة وديعة، كي يصبح حضرته دائماً، بطلك المحرر، وبطلهم القومي، الذي سيعيد أمريكا عظيمة مرة أخرى، التي بالنسبة له اليوم: ليست وحشية بما يكفي.
الترمبية العراقية، على تفاهة شأنها وخمول عقلها، أداة مثالية وقليلة الكلفة لاختصار الزمن، زمن الطبخة والتحكم بموازين النفوذ، سعر زهيد تدفعه الفوقية البيضاء لشراء ما لا يقدر بثمن: الاعتزاز بالهويّة. فتحصل على بروبغانده رخيصة وهوية تجرّم نفسها ذاتياً دون تدخل! ودون جهد يذكر.
والترمبيون العراقيون يبيعون على الطريقة الفاوستية، أنفسهم للشيطان، ولكن بلا مقابل، فلا تعتب عليّ، قارئي الجميل، وأنا أتناولهم- دون أن أسميهم!- وأبذل في الحديث عنهم قسطاً من وقتك ووقتي.
“العراق جامعة هارفرد للإرهاب”، هكذا يقول ترمب في إحدى خطبه المشهورة بالخواء والتعكز على رثاثة الجماهير المتخمة بالتفسيرات الدينية للعالم، والمخدوعين بصورة الرجل الأبيض العارف بمصلحة الأسمر، أكثر من الأسمر نفسه. الكاثوليكي الرؤوم الذي يحمل صليبه على خاصرته ويطوف الشرق مخلصاً إياه من البرابرة السمر، وهذه الصورة، تعيش في أذهان الكثير من المدونين الذي يسلمون أسافل ظهورهم للفحل المخصّب لأرحامهم المهجورة، بينما ينعق فيها الغراب: وا ترامباه!، وا سيداه، أدركنا أدركنا يا بن ماريان بنت مالكوم!
وهكذا تستحيل صورة العراق وإنسانه المقهور، بملامحه الثقافية وإرثه الحضاري الذي يصادق عليه الزمن، إلى صورة سلبية ومرادفة للإرهاب، ويقولها الرئيس ولا يستحي، ولا يستخدم أدوات اللغة في الاستثناء والتبعيض وتجنب التعميم، بل يزوِّر ذات العراقي من كونه سادرا تحت مظالم الدكتاتوريات والاحتلالات إلى متجبر طاغ يجوب الآفاق بحثاً عن عملية إرهابية، وباختصار: تحويل الضحية إلى جلاد، ذاتياً، أو تطوعياً من قبل الضحيّة نفسها، الضحية التي ترى في ترمب مخلصها، وهو من لا يتردد في نسفها وتجويعها وشيطنتها بينما تحتفل بفوزه بالانتخابات، لأنها تحبه وتكره نفسها!
لا يتفق آخر أربعة رؤساء أمريكان على لفظ اسم العراق، غزوا بلاداً لا يعرفون اسمها ولا يجيدون نطقها، أرسلوا الآلاف من زعاطيطهم لغزو بلاد لا يعرفون عنوانها حتى؛ جورج بوش ينطقه i-rack، بينما يلفظه أوباما eye-rack، ويشبهه جو بايدن في طريقة النطق، لكن ترمب يلفظه هكذا i مفصولة وقصيرة، ثم راك، بعيدة وقبيحة، كلهم غير قادرين على نطق اسمه، مع ملاحظة أن ترمب لا يلفظه أصلاً، يقطّعه إلى أوصال، يفجره بلسانه قبل أن يهرسه بأنيابه.



ولا تسألني ما هو النطق الصحيح، أعرف ولن أقول لك، لأنها ليست لغتي! أنا أبتهج حينما أشاهد معلمي اللغة الإنجليزية في العراق يخطئون في تعليمهم اللغة بشكل فاضح، يخيطون ويخربطون، لأني أحب ما يقوله عالم الاجتماع الكاريبي ستيورات هال «الأسود»: أفضل ما فعلناه للغة الإنجليزية هو إننا قمنا بتخريبها.
غزوناها مثلما غزتنا، ونسفت وجودنا.
ولا يبدو أن اختلاف الألسن يشير إلى شيء في الظاهر، لكن طريقة تقطيع الكلمة وهرسها في اللسان، مطها وسحلها قد يؤشر إلى انطباع المتكلم عنها، وقد يبدو ترمب الأكثر تحقيراً للعراق وهو يلفظ اسمه، لكن هذا لا يعني أن باقي الرؤساء والمتنافسين على كرسي الرئاسة القائم لديهم صورة إيجابية ونوايا طيبة عن ازدهار العراق وتحسين صورة مواطنيه في داخل العراق وخارجه، وتحته!