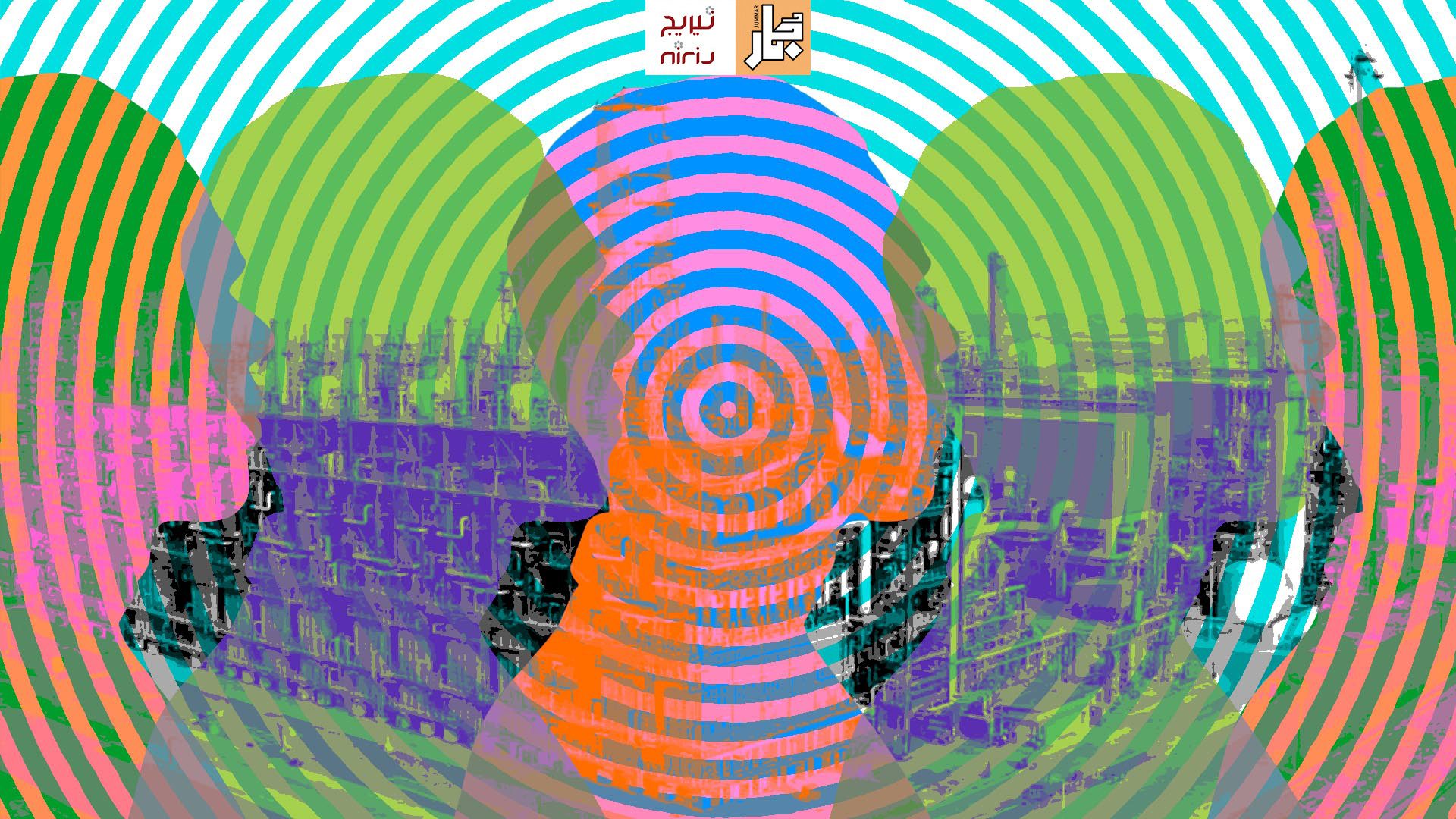السومريّون لا يطبخون الباچة
28 شباط 2023
التاريخ الذي ينبغي أن يكون بمثابة كابوس لا يناسب حياتنا الحديثة، يصرّ بعضنا على العيش فيه وتحمل الضوضاء القادمة منه، وأصوات الخيول والدخان الكثيف وصيحات الغزاة وويلات المضطهدين، ويصبح مثل الذكريات التي حتى لو نسيناها ستطفو يوماً ما على السطح دون استئذان.
«اعثر على الرؤوس مهما كان الثمن»، هذه رسالة قصيرة وصلت إلى البصرة من باريس في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، المرسل هو مدير متحف اللوڤر والمستلم هو القنصل الفرنسي السيد سارزيك. قبل ذلك بشهرين كان سارزيك قد أرسل ثلاثة تماثيل سوداء بلا رؤوس إلى المتحف، هرّبها بالقوارب بعد أن حبسها في التنانير الطينية. كان اكتشافاً فريداً لكنه بلا عنوانات ولا أسماء، لا أحد يعرف بعد هويّة الرجال الذين تمثلهم هذه الآثار، أنصاف جثامين صخرية محزوزة الرؤوس من الأكتاف ومطرّزة بكتابات طوطمية غامضة ذات حروف تشبه المسامير المبعثرة، هل هذه لغة؟ ولماذا كان هؤلاء الناس يكتبون كلماتهم بالمطرقة، لا يبدو أنهم آشوريون ولا أكديون ولا بابليون ولا مصريون. أمام سارزيك ثلاث مشكلات حتى يحل لغز الرؤوس هذا، الأولى هي أن السلطان عبد الحميد الثاني قد أصدر فرماناً يقيّد ملكية اللقى والكنوز الأثرية بالدولة العثمانية، بمعنى أن كل ما تستخرجه عمليات الحفر التي يجريها الأجانب بمساعدة أبناء العشائر على ضفاف دجلة والفرات، بحثاً عن الله والذهب وأنبياء التوراة والإنجيل!؛ ينبغي أن يبتعث مخفوراً إلى أسطنبول، لكنه وكما يحدث في كل مرّة، يطيب له أن يرسل للسلطان هدية أنيقة عمرها أربعة آلاف سنة ليغض النظر عنه وعن مستخرجاته، ولا من شاف ولا من درى.
المشكلة الثانية، هي جناب أمير الأمراء ناصر باشا السعدون، امبراطور الجنوب الذي يراقص في كفيّه دزينة برتقالات بيد واحدة: يريد أن يوسّع إمارته من جنوب ولاية بغداد وحتى الأحساء التي سيختطفها من آل سعود، ويريد أن ينقل عاصمته تدريجياً من البصرة إلى مدينة سيسميها الناصرية فيما بعد، ويريد أن يستوعب دهاء السلطان الذي أخذ منه السيادة على الجنوب مقابل منحه لقب «الباشا أمير الأمراء»، استبدل الأرض بالألقاب!، ويريد أن يسيطر على خوفه من جهاز البريد، فقد كان أمير الأمراء المنتفجي لا يصدّق التكنولوجيا، ويظن أن الأخبار التي تصله بواسطة التلغراف مجرد أكاذيب وخرافات، فلا يمكن للإنسان أن ينقل الأخبار بهذه السرعة. وكان على سارزيك أن يصبر على ناصر باشا قليلاً قبل أن يمنحه مأذونية كاملة للحفر وحماية مشروطة لكل مستخرجاته وتنقلاته.
المشكلة الثالثة هي التماثيل نفسها، كأنها تعرضت لعملية ذبح منظمة تحت التراب، هنالك قصص كثيرة يمكن تلفيقها حول هؤلاء الملوك، لكنه يبحث عن قصة صلدة يمكنها أن تصمد أمام مستشاري المتحف وهم يفكرون بكتابة كذبة مناسبة تغري الناس في زيارة المتحف والانبهار بالتماثيل الشرقية الغامضة القادمة تواً من بلاد الرافدين.
لعلّ أفضل ما يمكن تعلّمه من تمثال مكسور ومنزوع الرأس هو أن نبقى ساكنين بلا حركة مهما حدث، فلا شيء سيبقى على حاله، سيأتي من يعيد الرأس إلى مكانه ويرجع إلينا اسماءنا ذات يوم، وهذا ما حدث للملك غوديا، تقدست أسراره، الذي تبيّن أنه أحد الأشخاص الذين تجسدهم التماثيل، فقد عثر على رأسه بعد أعوام، بينما تأخر العثور على الرؤوس الأخرى، وكان على أقران الملك وبناته وكهنته وشعرائه الانتظار عشرين سنة حتى تدخل بريطانيا العراق وتحفر تحت العراقيين أكثر، ويخطب الجنرال مود في العراقيين قائلاً: جئنا لنعيد لكم أمجاد بغداد وتاريخها التليد قبل أن يخرّبها هولاكو!
ومع الجنرال المريض بالكوليرا جاءت المس بيل وتسنّمت منصب المدير الفخري للآثار، وهذه، كانت سخيّة جداً في منح الأذونات للرحّالة والهواة والقناصل والجامعات، وفتحت باب الأرض للجميع. ومع الفرنسيين والإنجليز والألمان؛ دخل الأمريكان على الخط، ليعثروا على أكبر مكتبة لّلغة التي ستعرف لاحقاً باللغة السومرية، والتي سنتعرّف من خلالها على حضارة مفقودة، لا تشبه غيرها، ولم يسجل التأريخ مثلها، واسمها سومر.
المشكلة مع الملك غوديا حاكم لكش مضافاً إلى صبره وطول باله، هي إرباكه للآثاريين، ذلك لأنه حليق اللحية، وهذا يعني أن السومريين كانوا أمة غير مقدسة ذات شعب غير مقدس، واحتكم بعض المنقبين إلى العهد القديم وقتها، وبما أن حلق اللحية كان شيئاً ممقوتاً في الكتاب المقدس، فهذا يعني أن هؤلاء ليسوا ساميين وغير مذكورين في الحكايات الدينية، وهنا حكم الآثاري العثماني المعروف جوزيف حلبي، بعد أن فشل في العثور على رابط بين لغته العبرية والمسامير السومرية، أن اللغة السومرية ليست لغة والسومريون لا وجود لهم، وهذه التماثيل والكتابات هي ترنيمات ورموز خاصة برجال الدين الآشوريين. وتصاعدت المعارك الكلاميّة في الصحف، وتطورت إلى تهجمات شخصية بين حلبي الذي اتهم كل من يخالفه الرأي بمعاداة الساميّة، وبين الفرنسي الألماني يوليوس أوبرت، الذي آمن أن السومريين شعب حقيقي يتحدث لغة منطوقة، وساهم لاحقاً بتفكيك مسامير اللغة السومرية.
وقبل أن يحسم الجواب، ظلت هوية من سيعرفون لاحقاً بالسومريين مجهولة، وقبل أن توصل الرؤوس بالأجساد اختلطت النظريات وتصادمت في مطلع القرن العشرين، في جدالات ومعارك علمية وثقافية ودينية عن قضية أكاديمية سميّت بالـ«المعضلة السومرية»، فالجميع كان يدعي الوصل بسومر، وبتأثير من نظريات التفوق العرقي التي كانت رائجة في تلك الأيام، كانت أغراض الكثير من المنقبين هي إثبات عائدية السومريين إلى العرق الآري أو القوقازي الأبيض، الذي تعده دراسات ذلك الزمان متفوقاً على البشر وصاحب الدماغ العالية، وما زال الكثيرون اليوم يعتقدون أن السومريين قد نزحوا من أوربا إلى جنوب العراق ليشيدوا تلك الحضارة العظيمة التي لا يُعقل أن يبنيها هؤلاء الملحان الكلحان الذين يشغلون وادي الرافدين هذه الأيام!، حسب الزعم، وهذا ليس اعتقاداً شاذاً، إنه إحدى ركائز التنوير اليميني المتطرف في أوربا وشمال أمريكا، الذي يريد إحياء نظريات الامتياز العرقي بعد أن أصابها العلم وحقوق الإنسان في مقتل، ليزداد سمك تلك الفقاعات التي يغلف بها البشر أنفسهم، حيث الجميع يدعي أنه وصل قبلك إلى هذا العالم، وهذا يمنحه حق أن يضغط على القنبلة النووية قبل أن تضغط أنت، لينتهي العالم قبل أن تفكر الطبيعة بإنهائه.
يسمي بعض النشطاء المعاصرين اليوم تنويرهم هذا بالتنوير الحالك، ذلك لأنه يعد بنسخة دستوبية -غير فاضلة- من العالم تشبه المدن الكابوسية في أفلام هوليود المعنية بتصوّر نهاية العالم، تجعله محكوماً بالعرق الأبيض حصراً، ويصبح الجميع عبيداً وزبائن لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويعود فيه الجميع إلى نسخة من كوكب الأرض أكثر رجولية بعد أن ملئت غنجاً وأنوثة!، تعود الأرض إلى أصحابها أصحاب الشركات، سناب شات وتويتر ويوتيوب وفيسبوك، جمهوريات عتيدة الجميع فيها مستخدَمون لا مستخدِمون.
تقول عالمة الفن الرافديني القديم، والأستاذة في جامعة كولومبيا، العراقية زينب بحراني في كتابها «النساء في بابل» إن سكان سومر وآشور كانوا خليطاً متنوعاً، ليسوا قوقازيين ولا أفارقة، مفندة بذلك نظريات سومر السوداء، التي تزعم أن السومريين كانوا أفارقة، وسومر البيضاء التي ترى أنهم نزحوا من بلاد العم ماركوس.
الحاصل، مرّ السومريون -قبل أن يتم العثور على رؤوسهم- بلحظة تساؤلية جعلتهم عرضة للتأريخ، والتعرض للتأريخ قد يكون أقسى من التعرض لألسنة البراكين وارتجافات الزلازل، والتأريخ هنا لم يكن سوى أساطير ونظريات وأذواق وأمزجة وخيالات عقائدية وروحية وسياسية، حتى أن أحد المنقبين الأمريكان بعث بأحد تماثيل غوديا إلى جامعة فيلادلفيا مصحوبا برسالة من جملة واحدة تقول: «وجدت لكم تمثال داود النبي!».
غوديا، كان هوية متكسرة على هيأة تمثال مكسور، يجمع شظاياها الآخرون ويعيدون تشكيلها حسب أخيلتهم، وهو يشبه ما تحاول هوياتنا ممارسته، اخفاء الكسور والصدوع والحفاظ على الرأس في مكانه، لكن «الآخرين» لهم الكلمة الأخيرة!.
اللقى الأثرية في تلك الأيام كانت أشبه بالمسلسلات التاريخية التي ترّوج لسردية معينة تخص فئة معيّنة، في الرأس استنتاجات مسبّقة يراد تلبيسها بالدليل الأركيولوجي، مثل شاعر قصيدة عمودية ينسج قصيدة بقافية محدّدة؛ هو يعلم بالضرورة أن هذا البيت سينتهي بنوع من الكلمات ذات جرس موسيقي واحد، لا أمل في استعمال كلمات خارج القافية المعدة سلفاً، الموسيقى تقود المعنى، والأغنيات تجرّ العقل من أذنيه، مثلما تقود المشاعر عمليات التنقيب في التاريخ.
في أيام تظاهرت حياة السود مهمّة، شعر الكثير من المغترين بأدوارهم الريادية في الماضي بأن الاحتجاجات تستهدف تاريخهم، واستهداف التاريخ يعني استهداف الذات ووجودها، فلا يمكن أن يتحول قادة المجد الأمريكي -مثل جورج واشنطن الملقب بمحرر العبيد-إلى تجار عبيد متغطرسين بليلة وضحاها! ومن ذا الذي يجرأ على وصم القيم الجمهورية المستخلصة من عصارة الحضارة الأوربية الغربية بالعار، كانت الاحتجاجات تحرج السيرة الذاتية الوطنية وتلطخ صورة المؤسسة الأمريكية وتشككها بنفسها، الأمر الذي أطاح لاحقاً حتى بمقررات الدراسة في مدارس الأطفال وأعاد صياغتها نسبياً. فلا أحد يريد أن يحظى بتأريخ غير نبيل، وأن التخلي عن الامتياز التاريخي بالتفوق والسبق في الحريات وحقوق الإنسان هو شعور غير محبب لمن أعتاد أن يرفع راية الحضارة.
يقول بول كولنز، استاذ السومريات في جامعة أكسفورد، في كتابه السومريون حضارة مفقودة، إنَّ السومريين ليسوا أمة دمرتها الأمم المجاورة، لم تغضب عليهم الآلهة ولم يتعرضوا للمحو كما نظن، ما حدث للسومريين، وهم أحد أغرب وأندر الحضارات في التأريخ، هو أنهم فقدوا لغتهم، بسبب احتلالات أهل الآلهة فرضوا عليهم لغاتٍ أخرى، وهكذا، وخلال أقل من مئتي سنة، انمحقت اللغة السومرية إلى الأبد.
بينما يظهر رأس غوديا على ضفاف شط الغرّاف، تتضعضع إمارة ناصر باشا ويتبدد حلمه في أن يحوّل العراق إلى إمارة أو مملكة كما هي إمارات جيرانه في السعودية والخليج، ملك يظهر وآخر يخبو، لم تندثر إمارة السعدون المنتفجية تماماً، تحوّلت إلى شارع في بغداد، يحرسه حفيد الأسرة، الوطني الذي انتحر، عبد المحسن السعدون، الذي يوصف بأنه أول من دشّن الروح الوطنية العراقية.
في عالمنا العربي، وبعد أن تخلّى العالم عن التعامل مع رموز نصوصه الدينية وتعاليمه المقدسة على أنها مصادر للقيم النبيلة، ما زالت الميزانيات الكريمة تبذل من أجل تحضير أرواح الذوات التأريخية، وإعادة تشكيلها وفقاً لبروبغاندا الدولة المانحة، بينما، لا شيء في التأريخ يستحق الاقتداء به قيمياً، عدا المثل الأخلاقية التي تتناسب مع حياتنا المعاصرة، وهي مفردات قد لم تسمع عنها تلك الذوات المحبوسة في التأريخ، أشياء مثل الحياد العلمي مثلاً، أو الحرية الشخصية والأخلاق المتحضرة، التاريخ الذي ينبغي أن يكون بمثابة كابوس لا يناسب حياتنا الحديثة، يصر بعضنا على العيش فيه وتحمل الضوضاء القادمة منه، وأصوات الخيول والدخان الكثيف وصيحات الغزاة وويلات المضطهدين، ويصبح مثل الذكريات التي حتى لو نسيناها ستطفو يوماً ما على السطح دون استئذان، وعلى رأي نيتشه فأن الأفكار التي حطمناها سابقاً ستهاجمنا في أيام ضعفنا، والبحث عن رؤوس ملوك سومر يستلزم الافتراض أن الحقائق مخبوءة داخل رؤوس ملوك سومر، وليس في رؤوسنا.
وفق المزاج الاستشراقي أعلاه، يمكنني أن أمرّر نظريتي الخاصة حول السومريين!، مستنداً إلى دراسة نشرتها جامعة شيكاغو لخبير السومريات جون بوتيرو عنوانها «الطبخ في بلاد ما بين النهرين»، وتفيد بأن السومريين أحبوا السمك والبقوليات أكثر من اللحوم، كانوا يأكلون التمر والبصل والنعناع واللبن والعدس والثوم، وقد كانت حيواناتهم الداجنة، والغزلان والماعز والخرفان، عزيزة عليهم ولا يجرؤون على ذبحها، فضلاً عن طبخ جماجمها لساعات طوال لتحضير أكلة الباچة، وهذا كفيل بتعزيز القول، وبضرس قاطع: السومريون لا يأكلون الباچة!، وهم إلى أكل المسموطة والصبور أقرب، فقد كانوا أمة «سميچية» بامتياز.
أمام هذه النظرية عقبة كؤود، وهي أن نكرانها لا يزعل أحداً.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
«اعثر على الرؤوس مهما كان الثمن»، هذه رسالة قصيرة وصلت إلى البصرة من باريس في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، المرسل هو مدير متحف اللوڤر والمستلم هو القنصل الفرنسي السيد سارزيك. قبل ذلك بشهرين كان سارزيك قد أرسل ثلاثة تماثيل سوداء بلا رؤوس إلى المتحف، هرّبها بالقوارب بعد أن حبسها في التنانير الطينية. كان اكتشافاً فريداً لكنه بلا عنوانات ولا أسماء، لا أحد يعرف بعد هويّة الرجال الذين تمثلهم هذه الآثار، أنصاف جثامين صخرية محزوزة الرؤوس من الأكتاف ومطرّزة بكتابات طوطمية غامضة ذات حروف تشبه المسامير المبعثرة، هل هذه لغة؟ ولماذا كان هؤلاء الناس يكتبون كلماتهم بالمطرقة، لا يبدو أنهم آشوريون ولا أكديون ولا بابليون ولا مصريون. أمام سارزيك ثلاث مشكلات حتى يحل لغز الرؤوس هذا، الأولى هي أن السلطان عبد الحميد الثاني قد أصدر فرماناً يقيّد ملكية اللقى والكنوز الأثرية بالدولة العثمانية، بمعنى أن كل ما تستخرجه عمليات الحفر التي يجريها الأجانب بمساعدة أبناء العشائر على ضفاف دجلة والفرات، بحثاً عن الله والذهب وأنبياء التوراة والإنجيل!؛ ينبغي أن يبتعث مخفوراً إلى أسطنبول، لكنه وكما يحدث في كل مرّة، يطيب له أن يرسل للسلطان هدية أنيقة عمرها أربعة آلاف سنة ليغض النظر عنه وعن مستخرجاته، ولا من شاف ولا من درى.
المشكلة الثانية، هي جناب أمير الأمراء ناصر باشا السعدون، امبراطور الجنوب الذي يراقص في كفيّه دزينة برتقالات بيد واحدة: يريد أن يوسّع إمارته من جنوب ولاية بغداد وحتى الأحساء التي سيختطفها من آل سعود، ويريد أن ينقل عاصمته تدريجياً من البصرة إلى مدينة سيسميها الناصرية فيما بعد، ويريد أن يستوعب دهاء السلطان الذي أخذ منه السيادة على الجنوب مقابل منحه لقب «الباشا أمير الأمراء»، استبدل الأرض بالألقاب!، ويريد أن يسيطر على خوفه من جهاز البريد، فقد كان أمير الأمراء المنتفجي لا يصدّق التكنولوجيا، ويظن أن الأخبار التي تصله بواسطة التلغراف مجرد أكاذيب وخرافات، فلا يمكن للإنسان أن ينقل الأخبار بهذه السرعة. وكان على سارزيك أن يصبر على ناصر باشا قليلاً قبل أن يمنحه مأذونية كاملة للحفر وحماية مشروطة لكل مستخرجاته وتنقلاته.
المشكلة الثالثة هي التماثيل نفسها، كأنها تعرضت لعملية ذبح منظمة تحت التراب، هنالك قصص كثيرة يمكن تلفيقها حول هؤلاء الملوك، لكنه يبحث عن قصة صلدة يمكنها أن تصمد أمام مستشاري المتحف وهم يفكرون بكتابة كذبة مناسبة تغري الناس في زيارة المتحف والانبهار بالتماثيل الشرقية الغامضة القادمة تواً من بلاد الرافدين.
لعلّ أفضل ما يمكن تعلّمه من تمثال مكسور ومنزوع الرأس هو أن نبقى ساكنين بلا حركة مهما حدث، فلا شيء سيبقى على حاله، سيأتي من يعيد الرأس إلى مكانه ويرجع إلينا اسماءنا ذات يوم، وهذا ما حدث للملك غوديا، تقدست أسراره، الذي تبيّن أنه أحد الأشخاص الذين تجسدهم التماثيل، فقد عثر على رأسه بعد أعوام، بينما تأخر العثور على الرؤوس الأخرى، وكان على أقران الملك وبناته وكهنته وشعرائه الانتظار عشرين سنة حتى تدخل بريطانيا العراق وتحفر تحت العراقيين أكثر، ويخطب الجنرال مود في العراقيين قائلاً: جئنا لنعيد لكم أمجاد بغداد وتاريخها التليد قبل أن يخرّبها هولاكو!
ومع الجنرال المريض بالكوليرا جاءت المس بيل وتسنّمت منصب المدير الفخري للآثار، وهذه، كانت سخيّة جداً في منح الأذونات للرحّالة والهواة والقناصل والجامعات، وفتحت باب الأرض للجميع. ومع الفرنسيين والإنجليز والألمان؛ دخل الأمريكان على الخط، ليعثروا على أكبر مكتبة لّلغة التي ستعرف لاحقاً باللغة السومرية، والتي سنتعرّف من خلالها على حضارة مفقودة، لا تشبه غيرها، ولم يسجل التأريخ مثلها، واسمها سومر.
المشكلة مع الملك غوديا حاكم لكش مضافاً إلى صبره وطول باله، هي إرباكه للآثاريين، ذلك لأنه حليق اللحية، وهذا يعني أن السومريين كانوا أمة غير مقدسة ذات شعب غير مقدس، واحتكم بعض المنقبين إلى العهد القديم وقتها، وبما أن حلق اللحية كان شيئاً ممقوتاً في الكتاب المقدس، فهذا يعني أن هؤلاء ليسوا ساميين وغير مذكورين في الحكايات الدينية، وهنا حكم الآثاري العثماني المعروف جوزيف حلبي، بعد أن فشل في العثور على رابط بين لغته العبرية والمسامير السومرية، أن اللغة السومرية ليست لغة والسومريون لا وجود لهم، وهذه التماثيل والكتابات هي ترنيمات ورموز خاصة برجال الدين الآشوريين. وتصاعدت المعارك الكلاميّة في الصحف، وتطورت إلى تهجمات شخصية بين حلبي الذي اتهم كل من يخالفه الرأي بمعاداة الساميّة، وبين الفرنسي الألماني يوليوس أوبرت، الذي آمن أن السومريين شعب حقيقي يتحدث لغة منطوقة، وساهم لاحقاً بتفكيك مسامير اللغة السومرية.
وقبل أن يحسم الجواب، ظلت هوية من سيعرفون لاحقاً بالسومريين مجهولة، وقبل أن توصل الرؤوس بالأجساد اختلطت النظريات وتصادمت في مطلع القرن العشرين، في جدالات ومعارك علمية وثقافية ودينية عن قضية أكاديمية سميّت بالـ«المعضلة السومرية»، فالجميع كان يدعي الوصل بسومر، وبتأثير من نظريات التفوق العرقي التي كانت رائجة في تلك الأيام، كانت أغراض الكثير من المنقبين هي إثبات عائدية السومريين إلى العرق الآري أو القوقازي الأبيض، الذي تعده دراسات ذلك الزمان متفوقاً على البشر وصاحب الدماغ العالية، وما زال الكثيرون اليوم يعتقدون أن السومريين قد نزحوا من أوربا إلى جنوب العراق ليشيدوا تلك الحضارة العظيمة التي لا يُعقل أن يبنيها هؤلاء الملحان الكلحان الذين يشغلون وادي الرافدين هذه الأيام!، حسب الزعم، وهذا ليس اعتقاداً شاذاً، إنه إحدى ركائز التنوير اليميني المتطرف في أوربا وشمال أمريكا، الذي يريد إحياء نظريات الامتياز العرقي بعد أن أصابها العلم وحقوق الإنسان في مقتل، ليزداد سمك تلك الفقاعات التي يغلف بها البشر أنفسهم، حيث الجميع يدعي أنه وصل قبلك إلى هذا العالم، وهذا يمنحه حق أن يضغط على القنبلة النووية قبل أن تضغط أنت، لينتهي العالم قبل أن تفكر الطبيعة بإنهائه.
يسمي بعض النشطاء المعاصرين اليوم تنويرهم هذا بالتنوير الحالك، ذلك لأنه يعد بنسخة دستوبية -غير فاضلة- من العالم تشبه المدن الكابوسية في أفلام هوليود المعنية بتصوّر نهاية العالم، تجعله محكوماً بالعرق الأبيض حصراً، ويصبح الجميع عبيداً وزبائن لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويعود فيه الجميع إلى نسخة من كوكب الأرض أكثر رجولية بعد أن ملئت غنجاً وأنوثة!، تعود الأرض إلى أصحابها أصحاب الشركات، سناب شات وتويتر ويوتيوب وفيسبوك، جمهوريات عتيدة الجميع فيها مستخدَمون لا مستخدِمون.
تقول عالمة الفن الرافديني القديم، والأستاذة في جامعة كولومبيا، العراقية زينب بحراني في كتابها «النساء في بابل» إن سكان سومر وآشور كانوا خليطاً متنوعاً، ليسوا قوقازيين ولا أفارقة، مفندة بذلك نظريات سومر السوداء، التي تزعم أن السومريين كانوا أفارقة، وسومر البيضاء التي ترى أنهم نزحوا من بلاد العم ماركوس.
الحاصل، مرّ السومريون -قبل أن يتم العثور على رؤوسهم- بلحظة تساؤلية جعلتهم عرضة للتأريخ، والتعرض للتأريخ قد يكون أقسى من التعرض لألسنة البراكين وارتجافات الزلازل، والتأريخ هنا لم يكن سوى أساطير ونظريات وأذواق وأمزجة وخيالات عقائدية وروحية وسياسية، حتى أن أحد المنقبين الأمريكان بعث بأحد تماثيل غوديا إلى جامعة فيلادلفيا مصحوبا برسالة من جملة واحدة تقول: «وجدت لكم تمثال داود النبي!».
غوديا، كان هوية متكسرة على هيأة تمثال مكسور، يجمع شظاياها الآخرون ويعيدون تشكيلها حسب أخيلتهم، وهو يشبه ما تحاول هوياتنا ممارسته، اخفاء الكسور والصدوع والحفاظ على الرأس في مكانه، لكن «الآخرين» لهم الكلمة الأخيرة!.
اللقى الأثرية في تلك الأيام كانت أشبه بالمسلسلات التاريخية التي ترّوج لسردية معينة تخص فئة معيّنة، في الرأس استنتاجات مسبّقة يراد تلبيسها بالدليل الأركيولوجي، مثل شاعر قصيدة عمودية ينسج قصيدة بقافية محدّدة؛ هو يعلم بالضرورة أن هذا البيت سينتهي بنوع من الكلمات ذات جرس موسيقي واحد، لا أمل في استعمال كلمات خارج القافية المعدة سلفاً، الموسيقى تقود المعنى، والأغنيات تجرّ العقل من أذنيه، مثلما تقود المشاعر عمليات التنقيب في التاريخ.
في أيام تظاهرت حياة السود مهمّة، شعر الكثير من المغترين بأدوارهم الريادية في الماضي بأن الاحتجاجات تستهدف تاريخهم، واستهداف التاريخ يعني استهداف الذات ووجودها، فلا يمكن أن يتحول قادة المجد الأمريكي -مثل جورج واشنطن الملقب بمحرر العبيد-إلى تجار عبيد متغطرسين بليلة وضحاها! ومن ذا الذي يجرأ على وصم القيم الجمهورية المستخلصة من عصارة الحضارة الأوربية الغربية بالعار، كانت الاحتجاجات تحرج السيرة الذاتية الوطنية وتلطخ صورة المؤسسة الأمريكية وتشككها بنفسها، الأمر الذي أطاح لاحقاً حتى بمقررات الدراسة في مدارس الأطفال وأعاد صياغتها نسبياً. فلا أحد يريد أن يحظى بتأريخ غير نبيل، وأن التخلي عن الامتياز التاريخي بالتفوق والسبق في الحريات وحقوق الإنسان هو شعور غير محبب لمن أعتاد أن يرفع راية الحضارة.
يقول بول كولنز، استاذ السومريات في جامعة أكسفورد، في كتابه السومريون حضارة مفقودة، إنَّ السومريين ليسوا أمة دمرتها الأمم المجاورة، لم تغضب عليهم الآلهة ولم يتعرضوا للمحو كما نظن، ما حدث للسومريين، وهم أحد أغرب وأندر الحضارات في التأريخ، هو أنهم فقدوا لغتهم، بسبب احتلالات أهل الآلهة فرضوا عليهم لغاتٍ أخرى، وهكذا، وخلال أقل من مئتي سنة، انمحقت اللغة السومرية إلى الأبد.
بينما يظهر رأس غوديا على ضفاف شط الغرّاف، تتضعضع إمارة ناصر باشا ويتبدد حلمه في أن يحوّل العراق إلى إمارة أو مملكة كما هي إمارات جيرانه في السعودية والخليج، ملك يظهر وآخر يخبو، لم تندثر إمارة السعدون المنتفجية تماماً، تحوّلت إلى شارع في بغداد، يحرسه حفيد الأسرة، الوطني الذي انتحر، عبد المحسن السعدون، الذي يوصف بأنه أول من دشّن الروح الوطنية العراقية.
في عالمنا العربي، وبعد أن تخلّى العالم عن التعامل مع رموز نصوصه الدينية وتعاليمه المقدسة على أنها مصادر للقيم النبيلة، ما زالت الميزانيات الكريمة تبذل من أجل تحضير أرواح الذوات التأريخية، وإعادة تشكيلها وفقاً لبروبغاندا الدولة المانحة، بينما، لا شيء في التأريخ يستحق الاقتداء به قيمياً، عدا المثل الأخلاقية التي تتناسب مع حياتنا المعاصرة، وهي مفردات قد لم تسمع عنها تلك الذوات المحبوسة في التأريخ، أشياء مثل الحياد العلمي مثلاً، أو الحرية الشخصية والأخلاق المتحضرة، التاريخ الذي ينبغي أن يكون بمثابة كابوس لا يناسب حياتنا الحديثة، يصر بعضنا على العيش فيه وتحمل الضوضاء القادمة منه، وأصوات الخيول والدخان الكثيف وصيحات الغزاة وويلات المضطهدين، ويصبح مثل الذكريات التي حتى لو نسيناها ستطفو يوماً ما على السطح دون استئذان، وعلى رأي نيتشه فأن الأفكار التي حطمناها سابقاً ستهاجمنا في أيام ضعفنا، والبحث عن رؤوس ملوك سومر يستلزم الافتراض أن الحقائق مخبوءة داخل رؤوس ملوك سومر، وليس في رؤوسنا.
وفق المزاج الاستشراقي أعلاه، يمكنني أن أمرّر نظريتي الخاصة حول السومريين!، مستنداً إلى دراسة نشرتها جامعة شيكاغو لخبير السومريات جون بوتيرو عنوانها «الطبخ في بلاد ما بين النهرين»، وتفيد بأن السومريين أحبوا السمك والبقوليات أكثر من اللحوم، كانوا يأكلون التمر والبصل والنعناع واللبن والعدس والثوم، وقد كانت حيواناتهم الداجنة، والغزلان والماعز والخرفان، عزيزة عليهم ولا يجرؤون على ذبحها، فضلاً عن طبخ جماجمها لساعات طوال لتحضير أكلة الباچة، وهذا كفيل بتعزيز القول، وبضرس قاطع: السومريون لا يأكلون الباچة!، وهم إلى أكل المسموطة والصبور أقرب، فقد كانوا أمة «سميچية» بامتياز.
أمام هذه النظرية عقبة كؤود، وهي أن نكرانها لا يزعل أحداً.