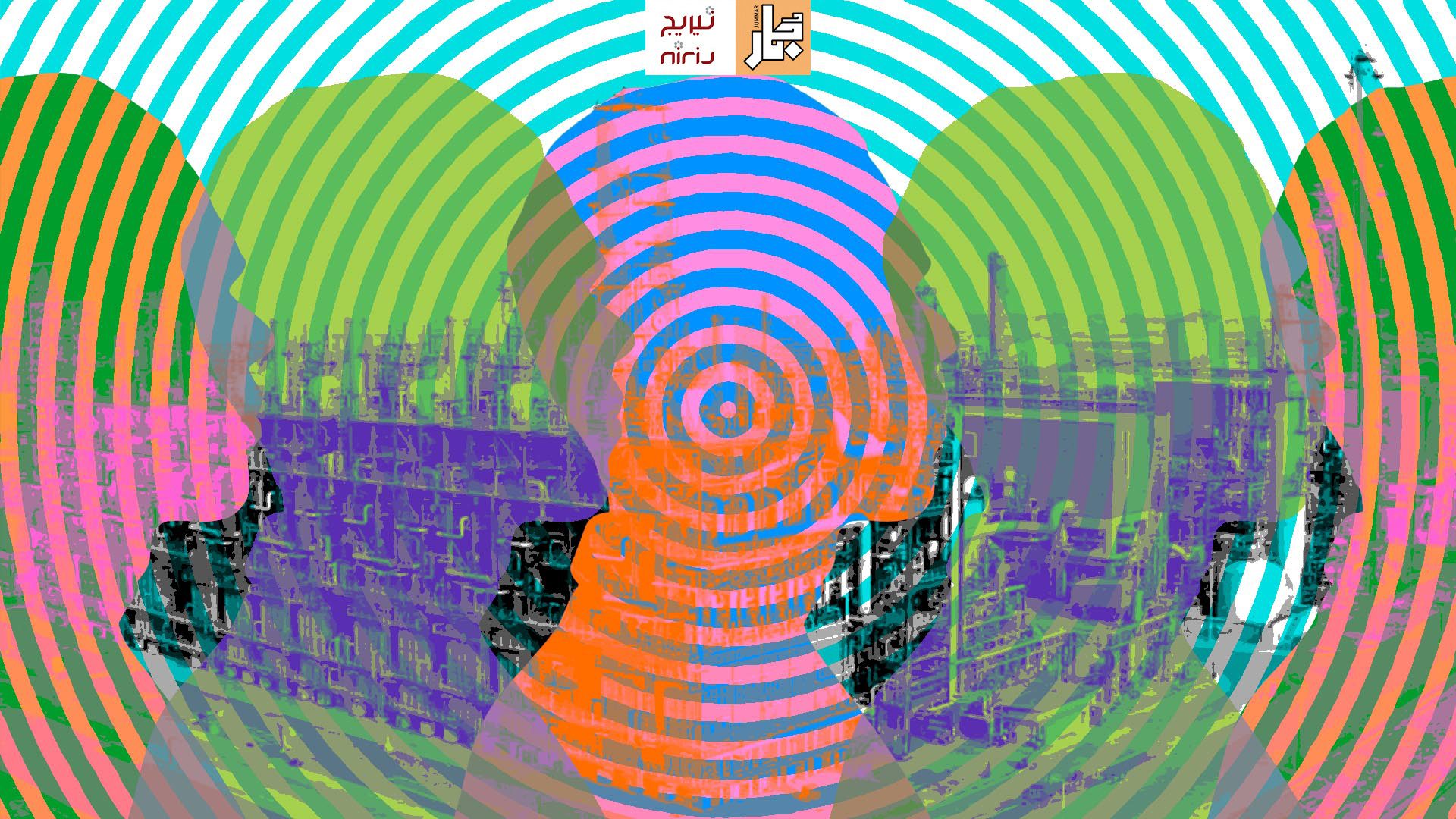رأينا وجه صدّام على القمر
12 نيسان 2023
كان الثامن والعشرون من نيسان يوماً غائماً عندما سافرت مع طاقم بي بي سي لساعات عبر الحدود من الأردن. عندما دخلنا بغداد، كانت رائحة الدخان تنبعث من البنايات المحترقة. لم تكن المدينة في حالة فوضى، وإنما في حالة صدمة.. وعلى مدى ستة أسابيع تجوّلنا معاً في بغداد والنجف وكربلاء والفلوجة وتحدّثنا مع الناس وجمعنا قصصهم...
بُعيْد سقوط بغداد في نيسان عام 2003، استدعاني رئيس تحرير إذاعة بي بي سي العربية إلى مكتبه في لندن. كنت قد انضممت إلى الإذاعة قبل ستة أشهر، وأراد أن يعرف إن كنت مستعدةً للذهاب في مهمّة صحفية إلى بغداد.
كانت “الحرب” قد انتهت. اختفى صدام حسين. وكنت لا أزال في حالة صدمة لأن زميلاً قديماً لي، طارق أيوب، كان قد قُتل في قصف أمريكي على مكتب قناة الجزيرة وسط بغداد. كان عليّ أن أقنع والديّ بأن الوضع في العراق آمن، وهذا لم يكن سهلاً.
كانت هذه أول مهمّة صحفية أجنبية لي.
أشعر أن كلمة “أجنبية” خاطئة. لم أكن قد ذهبت إلى بغداد من قبل، لكنني عرفت الكثير عن الثقافة العراقية لأنني نشأت في الكويت حيث كنّا نتلقى إرسال التلفزيون العراقي. نشأتُ على الدراما والكوميديا العراقية، وكنت أحُبّ نجومها كشذى سالم ومحمد حسين عبد الرحيم. كنت أفهم اللهجة العراقية. كان العراق رمزاً للقومية والكرامة العربية في وجه الإمبريالية الغربية. وعلى الرغم من أن قلة قليلة تقر بذلك اليوم، إلا أن صدام حسين كان بالنسبة لنا بطلاً.
الكثير من الفلسطينيين كانوا يأملون أن تكون حرب الخليج عام 1991 لحظة حاسمة في تاريخنا لأن صدام كان يطلق صواريخ سكود نحو إسرائيل. وكغيرها من الأسر الفلسطينية المغتربة في الكويت، كان على أسرتي أن تنتقل إلى الأردن بسبب الحرب وأن تتأقلم مع حياة جديدة. وصل الحماس لحرب صدام ضد الإمبريالية آنذاك إلى حد أنه خيّل للبعض أن وجه صدام كان مطبوعاً على القمر. ظنّ البعض أنه سيحرّر فلسطين. كنّا غافلين عن كل الأمور الأخرى التي كان ينبغي أن نعرفها عنه.
هذا الحماس بدأ يخبو تدريجياً، ومع حلول عام 2003 لم نعد نشجع صدام ولكن قلوبنا كانت تُدمى للعراق، وشعرنا وكأننا تلقينا ركلة قاسية لأن سقوطه أتى على يد الغرب.
كان الثامن والعشرون من نيسان يوماً غائماً عندما سافرت مع طاقم بي بي سي لساعات عبر الحدود من الأردن. عندما دخلنا بغداد، كانت رائحة الدخان تنبعث من البنايات المحترقة. كانت أعمال السلب والنهب للمؤسسات الحكومية قد بدأت قبل أسبوعين. ولكن “السلّابة” كانوا لا يزالون يذهبون إلى تلك البنايات، ويستولون على أي شيء تبقّى بداخلها. كانت الشوارع ممتلئة بأكياس القمامة لأن عاملي النظافة توقفوا عن العمل منذ سقوط المدينة. لم تكن إشارات المرور تعمل ولم يكن هناك رجال شرطة، ومع ذلك بدا وكأن المرور ينظم نفسه.
كان شعوراً غريباً. لم تكن المدينة في حالة فوضى، وإنما كانت في حالة صدمة.
تحت صخب اللصوص والبائعين – لم أر في حياتي كمّاً كبيراً من الكحول يباع في الشوارع كما رأيت في بغداد في تلك الفترة – كانت هناك طبقة مريبة من الصمت. كان الناس في حالة ذهول كمن تلقى صفعة على وجهه. هي تلك اللحظات التي تلي الصفعة عندما يقف المرء مشدوهاً محاولاً استيعاب ما حدث. كان العراق لا يزال مشدوهاً من الصفعة، وبقي على هذه الحال لأسابيع تلت.
عيّنتُ مساعداً (فكسر) اسمه محمد، وعلى مدى ستة أسابيع تجولنا معاً في بغداد والنجف وكربلاء والفلوجة وتحدّثنا مع الناس وجمعنا قصصهم. كان الأمر سهلاً للغاية لأن الناس أرادوا أن يتحدّثوا ويفرغوا ما بداخلهم. هناك من أراد لعن الدكتاتور والأمريكيين معاً. أحيانا كانوا يريدون فقط أن أسجّل سلامهم لأقرباء في الكويت أو الأردن أو الولايات المتحدة. كانت الأمور سهلة أيضاً لأنني كنت أعمل للإذاعة. كان الناس يقولون ما يشاؤون للميكروفون، ومن دون كاميرا لا توجد وسيلة للتعرّف عليهم.
في الأسبوعين الأولين كنت أرسل تقارير “سعيدة”، عن أول مباراة كرة قدم بعد انتهاء العملية العسكرية، وعن الشقيقين اللذين أنقذا بعضاً من أهم مقتنيات المتحف الوطني العراقي من اللصوص، والاحتفالات الدينية للشيعة في النجف وكربلاء.

ولكن مع مرور الوقت، أصبحت الأمور قاتمة.
في أحد الأيام، جاء رجال بثياب رثة ووقفوا عند الأسلاك الشائكة المحيطة بفندق فلسطين، والذي كان آنذاك المقرّ المؤقت للحكومة الانتقالية في العراق. كانوا قد أتوا من مدينة أربيل في إقليم كردستان بعد أن طردهم الكرد من بيوتهم. كان هؤلاء الرجال جزءاً من الجالية العربية التي قرر النظام السابق توطينها في أربيل كجزء من حملته لتعريب كردستان، والآن أراد الكرد الانتقام منهم. حاولت أن أسجّل مقابلة مع الرجال ولكنهم كانوا يصرخون في الميكروفون للتنفيس عن غضبهم ويأسهم. كان الصوت مشوّشاً للغاية فلم أتمكن من استخدام أصواتهم في تقريري الإذاعي.
الكثير من العراقيين الذين كانوا منفيّين إلى إيران عادوا أيضاً لاسترداد بيوتهم، والتي كانت تسكنها الآن أُسرٌ فقيرة. ذهبت إلى تلك البيوت واستمعت للرجال والنساء وهم يبكون لأن لا قدرة لديهم على الحيلولة دون طردهم. كانوا يتحدثون للميكروفون وكأنهم متيقنون بأنني سأساعدهم في إيصال أصواتهم. لم يكن بوسعي إلا أن أقول “إن شاء الله”.
في أحد الأيام، اتصل بي محمد وأخبرني أن الناس يحفرون قبراً جماعياً في سلمان باك جنوب العاصمة. وصلنا إلى هناك قبل أن تبدأ أعمال الحفر ووجدنا الكثير من الطواقم الإعلامية. لأول مرة فاق عدد الصحفيين المتواجدين عدد العراقيين، والذين تضايقوا من ذلك. حاولوا إخلاءنا من المكان وصاح أحدهم: “شنو سوتلنا الصحافة؟”، ولكن محمد تدخل وأقنعهم أنه من الضروري أن يشاهد العالم ما جرى. كانت هناك مواقع كثيرة لمقابر جماعية في العراق. كان الناس يعرفون عنها ولكنهم لم يجرؤوا على الاقتراب منها أيام النظام السابق.

نظرت إلى مجموعة من أمهات يبكين وينتظرن بصبر حتى تبدأ أعمال الحفر وشعرت يومها أنني أتطفّل عليهن. حكت إحداهن لي كيف قام جنود بجرّ ابنها أمام عينيها قبل عشرين عاماً، وكم أنها توسلّت لهم كي لا يقتادوه بعيداً. لم تكن تعرف إن كان ابنها مدفوناً هنا ولكنها أتت أملاً في العثور على رفاته ودفنه بشكل لائق.
“من أين أنتِ؟” سألني أحد الرجال الذين كانوا يهمّون بالحفر. أصبح وجهه قاتماً عندما أجبته بأنني فلسطينية. أشاح بوجهه وواصل الحفر، ولكنه استدار مرة أخرى فجأة وقال: “على الأقل شارون رح يعطيكم غزة!”.
كان ذلك في أيار 2003 وكانت هناك تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون، يضع خططاً لاستراتيجية رسمية لسحب القوات الإسرائيلية والمستوطنين من قطاع غزة. آثرت الصمت بدلاً من الردّ على رجل حزين يبحث عن جثة قريب له. ولكنني سمعت هذه العبارة مراتٍ عدة بعد ذلك، وفي كل مرة كنت ألتزم الصمت.
وهناك قصص الأطفال..
الكثير منهم كانوا ينامون عند الدبابات الأمريكية التي كانت متمركزة في ساحة الفردوس، وغالباً ما كانوا مخدّرين من استنشاق الصمغ. كان الناس يتداولون أخباراً بأن الأمريكيين قاموا بإخلاء مركزين للأيتام لسبب غير معروف. الشيء نفسه حدث في مشفى للأمراض العقلية في منطقة الشمّاعية. بين الحين والآخر، كنت أرى رجالاً يجولون في شوارع بغداد وقد بدا عليهم وكأنهم يعانون من تحدٍ عقلي. لم يتأخر العاملون في مراكز الأيتام والمشفى في العودة إلى دوامهم والسعي لإعادة كل من خرجوا إلى تلك المراكز. لم يعرفوا من سيدير تلك المراكز من الآن فصاعداً، أو متى سيستلمون رواتبهم، لكنهم عادوا من باب المسؤولية تجاه أولئك الأطفال والمرضى.
في أحد أيام الجمعة، قرّرنا أنا ومحمد أن نأخذ استراحة ونتجوّل في سوق الشورجة الشهير. أخذت معي مسجل الصوت احتياطاً.
“منو يريد صور عدي وقصي؟” صاح أحد البائعين. كانت لديه مجموعة صور من الحفلات التي كان يقيمها نجلا صدام حسين. لم تكن الصور فاضحة إلى حدّ كبير. في واحدة منها، يضع قصي ذراعه حول امرأة شقراء ترتدي فستاناً بصدر مفتوح. وفي صورة أخرى، يجلس عدي وحوله مجموعة نساء، كان يحمل رشاشاً ويطلق النار في الهواء، بينما تنحني النساء ويغطين آذانهن من الصوت. لم تبدُ النساء في أيٍّ من هذه الصور وكأنهن مستمتعات بوقتهن.
كنت أتفحص مجموعة من الأقراص المدمجة (السي دي) لأفلام وألبومات موسيقى البوب عندما عثرت على قرص وقد كتبت عليه عبارة “هجوم الكيماوي على الأكراد”.
كانت لدى البائع مجموعة من الفيديوهات المرعبة، والتي تم الاستيلاء على أغلبها من مكاتب المؤسسات الأمنية. يقولون إن صدام حسين كان يأمر بتوثيق كافة الإعدامات، إما كدليل على تنفيذها أو كوسيلة لردع المنشقين. بينما كان البائع يصف لي محتويات هذه الفيديوهات، أتى زبون وسأله إن كان لديه فيديو لحلبجة. دفع ثمن النسخة وانصرف.

أنشأت سلطة الائتلاف المؤقتة فيما بعد مقراً لها في المنطقة الخضراء وتسلمنا دعوة عبر البريد الإلكتروني لحضور مؤتمر صحفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من أيار. في ذلك الوقت، كانت بي بي سي قد فتحت مكتباً في فيلا جميلة مكونة من طابقين. كبار المراسلين من جيريمي بوين إلى جون سويني وستيفن ساكر وباربرا بليت وكارولاين هولي وغيرهم كانوا يأتون إلى بغداد بالتناوب. ومع أنهم تسلموا الدعوة نفسها، إلا أنهم قرروا عدم الذهاب للمؤتمر لأنه في يوم جمعة – أي عطلة رسمية-.
عندما وصلت إلى مكان المؤتمر وجدت صحفية أخرى فقط – جين عراف من سي إن إن. انتظر المسؤولون من سلطة الائتلاف المؤقتة بصبر في غرفة كبيرة مليئة بالكراسي البلاستيكية البيضاء، ثم قرروا أخيرا أن يبدؤوا المؤتمر معنا نحن الاثنتين. المؤتمر الذي أغفله كل الصحفيين كان للإعلان بأن بول بريمير، رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة، قد حلّ الجيش العراقي.
بمجرد أن خرجنا من المبنى، اتصلت بغرفة الأخبار في لندن وأذيع الخبر على الهواء مباشرة. وعلى مدى ساعتين، كان الخبر عنواناً رئيسياً في نشرة أنباء إذاعة بي بي سي العربية قبل أن تنتبه بقية أقسام بي بي سي إلى الأمر. ليس إنجازاً بالنسبة لي أن السبق الصحفي الوحيد الذي حصلت عليه كان لأن صحفيين آخرين لم يحضروا المؤتمر، ولكنني لا أنكر أنني شعرت بالكبرياء عندما نزل كبار مراسلي بي بي سي إلى مكتبنا بدفاترهم ليدوّنوا تفاصيل القصة منّي.
في ذلك الوقت، لم يكن الصحفيون المحليون يحلمون بأن تعيّنهم وسائل الإعلام الكبرى إلا كمساعدي طواقم أو سائقين. كانت لديهم كل المعرفة، ولكن لم يكونوا من الجنسية أو العرق الصحيح. كنت أشاهد الصحفيين الأجانب يدوّنون ملاحظات من مساعديهم أو المترجمين العراقيين: أغلبهم لم تكن لديهم المعرفة المطلوبة فحسب، وإنما الكفاءة والقدرة على تلخيص معلومات معقدة بشكل واضح، وهي أهم كفاءة مطلوبة في أي صحفي. قد يقول الخبراء في قطاع الصحافة إن الأمور هي هكذا ببساطة. في الوقت الذي أمضيته في العراق، شعرت أن العراقيين عوملوا وكأنهم ليسوا محل ثقة لسرد حكايتهم بأنفسهم. إلى أي جهة ينحازون؟ هل هم فعلا ضد حزب البعث؟ أم أنهم يتظاهرون بذلك لكي يحصلوا على عمل؟ في كثير من الجولات الميدانية، شاهدت صحفيين أجانب يتصرفون وكأنهم امتداد لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في تعاملهم مع العراقيين.
أسوأ مثال على ذلك كان في مؤتمر صحفي في وزارة الصحة العراقية للإعلان عن تعيين مسؤول عراقي رفيع المستوى. أحد الصحفيين فضح ذلك المسؤول بمعلومات تثبت أنه من حزب البعث، وشاهدت المسؤول وهو يزداد توتراً. انفض المؤتمر بسرعة وحاول مساعدوه إخراجه من المكان بهدوء، إلا أن صحفياً أمريكياً من وكالة الأسوشييتد بريس لحق به. ظلّ يعترض طريقه، دافعاً وجهه في أنف المسؤول وسأله بعربية ركيكة مرات عدة إن كان يدين حزب البعث. لوهلة بدا وكأن الصحفي سيمسك بالمسؤول لولا أن أحد المساعدين صرخ به ووضع حداً للمهزلة.
مع نهاية مهمتي في العراق والتي استمرت ستة أسابيع، أصبحت أكوام القمامة أكثر ارتفاعاً، وجفت الطبقات السفلى منها تحت أشعة الشمس. كنّا نسمع أصوات انفجارات بين الحين والآخر، وقيل لنا إن القوات الأمريكية كانت تُفجِّر مخازن الذخيرة العراقية.
ولكن هناك قصة أخرى كانت قد بدأت بالظهور.
الطريق الذي سلكناه إلى العراق من الأردن لم يعد آمناً. كانت هناك أنباء بأن مجموعات مسلحة تهجم على المواكب العسكرية وطواقم الصحفيين. الطريق الوحيد للخروج من العراق كان على متن طائرة عسكرية بريطانية إلى الكويت. كانت تلك المرة الأولى التي أعود فيها إلى الكويت منذ أن خرجنا من هناك عام 1991. البعض يقول إن غزو صدام للكويت ذلك العام كان الحدث الذي حسم مصير العراق.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
بُعيْد سقوط بغداد في نيسان عام 2003، استدعاني رئيس تحرير إذاعة بي بي سي العربية إلى مكتبه في لندن. كنت قد انضممت إلى الإذاعة قبل ستة أشهر، وأراد أن يعرف إن كنت مستعدةً للذهاب في مهمّة صحفية إلى بغداد.
كانت “الحرب” قد انتهت. اختفى صدام حسين. وكنت لا أزال في حالة صدمة لأن زميلاً قديماً لي، طارق أيوب، كان قد قُتل في قصف أمريكي على مكتب قناة الجزيرة وسط بغداد. كان عليّ أن أقنع والديّ بأن الوضع في العراق آمن، وهذا لم يكن سهلاً.
كانت هذه أول مهمّة صحفية أجنبية لي.
أشعر أن كلمة “أجنبية” خاطئة. لم أكن قد ذهبت إلى بغداد من قبل، لكنني عرفت الكثير عن الثقافة العراقية لأنني نشأت في الكويت حيث كنّا نتلقى إرسال التلفزيون العراقي. نشأتُ على الدراما والكوميديا العراقية، وكنت أحُبّ نجومها كشذى سالم ومحمد حسين عبد الرحيم. كنت أفهم اللهجة العراقية. كان العراق رمزاً للقومية والكرامة العربية في وجه الإمبريالية الغربية. وعلى الرغم من أن قلة قليلة تقر بذلك اليوم، إلا أن صدام حسين كان بالنسبة لنا بطلاً.
الكثير من الفلسطينيين كانوا يأملون أن تكون حرب الخليج عام 1991 لحظة حاسمة في تاريخنا لأن صدام كان يطلق صواريخ سكود نحو إسرائيل. وكغيرها من الأسر الفلسطينية المغتربة في الكويت، كان على أسرتي أن تنتقل إلى الأردن بسبب الحرب وأن تتأقلم مع حياة جديدة. وصل الحماس لحرب صدام ضد الإمبريالية آنذاك إلى حد أنه خيّل للبعض أن وجه صدام كان مطبوعاً على القمر. ظنّ البعض أنه سيحرّر فلسطين. كنّا غافلين عن كل الأمور الأخرى التي كان ينبغي أن نعرفها عنه.
هذا الحماس بدأ يخبو تدريجياً، ومع حلول عام 2003 لم نعد نشجع صدام ولكن قلوبنا كانت تُدمى للعراق، وشعرنا وكأننا تلقينا ركلة قاسية لأن سقوطه أتى على يد الغرب.
كان الثامن والعشرون من نيسان يوماً غائماً عندما سافرت مع طاقم بي بي سي لساعات عبر الحدود من الأردن. عندما دخلنا بغداد، كانت رائحة الدخان تنبعث من البنايات المحترقة. كانت أعمال السلب والنهب للمؤسسات الحكومية قد بدأت قبل أسبوعين. ولكن “السلّابة” كانوا لا يزالون يذهبون إلى تلك البنايات، ويستولون على أي شيء تبقّى بداخلها. كانت الشوارع ممتلئة بأكياس القمامة لأن عاملي النظافة توقفوا عن العمل منذ سقوط المدينة. لم تكن إشارات المرور تعمل ولم يكن هناك رجال شرطة، ومع ذلك بدا وكأن المرور ينظم نفسه.
كان شعوراً غريباً. لم تكن المدينة في حالة فوضى، وإنما كانت في حالة صدمة.
تحت صخب اللصوص والبائعين – لم أر في حياتي كمّاً كبيراً من الكحول يباع في الشوارع كما رأيت في بغداد في تلك الفترة – كانت هناك طبقة مريبة من الصمت. كان الناس في حالة ذهول كمن تلقى صفعة على وجهه. هي تلك اللحظات التي تلي الصفعة عندما يقف المرء مشدوهاً محاولاً استيعاب ما حدث. كان العراق لا يزال مشدوهاً من الصفعة، وبقي على هذه الحال لأسابيع تلت.
عيّنتُ مساعداً (فكسر) اسمه محمد، وعلى مدى ستة أسابيع تجولنا معاً في بغداد والنجف وكربلاء والفلوجة وتحدّثنا مع الناس وجمعنا قصصهم. كان الأمر سهلاً للغاية لأن الناس أرادوا أن يتحدّثوا ويفرغوا ما بداخلهم. هناك من أراد لعن الدكتاتور والأمريكيين معاً. أحيانا كانوا يريدون فقط أن أسجّل سلامهم لأقرباء في الكويت أو الأردن أو الولايات المتحدة. كانت الأمور سهلة أيضاً لأنني كنت أعمل للإذاعة. كان الناس يقولون ما يشاؤون للميكروفون، ومن دون كاميرا لا توجد وسيلة للتعرّف عليهم.
في الأسبوعين الأولين كنت أرسل تقارير “سعيدة”، عن أول مباراة كرة قدم بعد انتهاء العملية العسكرية، وعن الشقيقين اللذين أنقذا بعضاً من أهم مقتنيات المتحف الوطني العراقي من اللصوص، والاحتفالات الدينية للشيعة في النجف وكربلاء.

ولكن مع مرور الوقت، أصبحت الأمور قاتمة.
في أحد الأيام، جاء رجال بثياب رثة ووقفوا عند الأسلاك الشائكة المحيطة بفندق فلسطين، والذي كان آنذاك المقرّ المؤقت للحكومة الانتقالية في العراق. كانوا قد أتوا من مدينة أربيل في إقليم كردستان بعد أن طردهم الكرد من بيوتهم. كان هؤلاء الرجال جزءاً من الجالية العربية التي قرر النظام السابق توطينها في أربيل كجزء من حملته لتعريب كردستان، والآن أراد الكرد الانتقام منهم. حاولت أن أسجّل مقابلة مع الرجال ولكنهم كانوا يصرخون في الميكروفون للتنفيس عن غضبهم ويأسهم. كان الصوت مشوّشاً للغاية فلم أتمكن من استخدام أصواتهم في تقريري الإذاعي.
الكثير من العراقيين الذين كانوا منفيّين إلى إيران عادوا أيضاً لاسترداد بيوتهم، والتي كانت تسكنها الآن أُسرٌ فقيرة. ذهبت إلى تلك البيوت واستمعت للرجال والنساء وهم يبكون لأن لا قدرة لديهم على الحيلولة دون طردهم. كانوا يتحدثون للميكروفون وكأنهم متيقنون بأنني سأساعدهم في إيصال أصواتهم. لم يكن بوسعي إلا أن أقول “إن شاء الله”.
في أحد الأيام، اتصل بي محمد وأخبرني أن الناس يحفرون قبراً جماعياً في سلمان باك جنوب العاصمة. وصلنا إلى هناك قبل أن تبدأ أعمال الحفر ووجدنا الكثير من الطواقم الإعلامية. لأول مرة فاق عدد الصحفيين المتواجدين عدد العراقيين، والذين تضايقوا من ذلك. حاولوا إخلاءنا من المكان وصاح أحدهم: “شنو سوتلنا الصحافة؟”، ولكن محمد تدخل وأقنعهم أنه من الضروري أن يشاهد العالم ما جرى. كانت هناك مواقع كثيرة لمقابر جماعية في العراق. كان الناس يعرفون عنها ولكنهم لم يجرؤوا على الاقتراب منها أيام النظام السابق.

نظرت إلى مجموعة من أمهات يبكين وينتظرن بصبر حتى تبدأ أعمال الحفر وشعرت يومها أنني أتطفّل عليهن. حكت إحداهن لي كيف قام جنود بجرّ ابنها أمام عينيها قبل عشرين عاماً، وكم أنها توسلّت لهم كي لا يقتادوه بعيداً. لم تكن تعرف إن كان ابنها مدفوناً هنا ولكنها أتت أملاً في العثور على رفاته ودفنه بشكل لائق.
“من أين أنتِ؟” سألني أحد الرجال الذين كانوا يهمّون بالحفر. أصبح وجهه قاتماً عندما أجبته بأنني فلسطينية. أشاح بوجهه وواصل الحفر، ولكنه استدار مرة أخرى فجأة وقال: “على الأقل شارون رح يعطيكم غزة!”.
كان ذلك في أيار 2003 وكانت هناك تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون، يضع خططاً لاستراتيجية رسمية لسحب القوات الإسرائيلية والمستوطنين من قطاع غزة. آثرت الصمت بدلاً من الردّ على رجل حزين يبحث عن جثة قريب له. ولكنني سمعت هذه العبارة مراتٍ عدة بعد ذلك، وفي كل مرة كنت ألتزم الصمت.
وهناك قصص الأطفال..
الكثير منهم كانوا ينامون عند الدبابات الأمريكية التي كانت متمركزة في ساحة الفردوس، وغالباً ما كانوا مخدّرين من استنشاق الصمغ. كان الناس يتداولون أخباراً بأن الأمريكيين قاموا بإخلاء مركزين للأيتام لسبب غير معروف. الشيء نفسه حدث في مشفى للأمراض العقلية في منطقة الشمّاعية. بين الحين والآخر، كنت أرى رجالاً يجولون في شوارع بغداد وقد بدا عليهم وكأنهم يعانون من تحدٍ عقلي. لم يتأخر العاملون في مراكز الأيتام والمشفى في العودة إلى دوامهم والسعي لإعادة كل من خرجوا إلى تلك المراكز. لم يعرفوا من سيدير تلك المراكز من الآن فصاعداً، أو متى سيستلمون رواتبهم، لكنهم عادوا من باب المسؤولية تجاه أولئك الأطفال والمرضى.
في أحد أيام الجمعة، قرّرنا أنا ومحمد أن نأخذ استراحة ونتجوّل في سوق الشورجة الشهير. أخذت معي مسجل الصوت احتياطاً.
“منو يريد صور عدي وقصي؟” صاح أحد البائعين. كانت لديه مجموعة صور من الحفلات التي كان يقيمها نجلا صدام حسين. لم تكن الصور فاضحة إلى حدّ كبير. في واحدة منها، يضع قصي ذراعه حول امرأة شقراء ترتدي فستاناً بصدر مفتوح. وفي صورة أخرى، يجلس عدي وحوله مجموعة نساء، كان يحمل رشاشاً ويطلق النار في الهواء، بينما تنحني النساء ويغطين آذانهن من الصوت. لم تبدُ النساء في أيٍّ من هذه الصور وكأنهن مستمتعات بوقتهن.
كنت أتفحص مجموعة من الأقراص المدمجة (السي دي) لأفلام وألبومات موسيقى البوب عندما عثرت على قرص وقد كتبت عليه عبارة “هجوم الكيماوي على الأكراد”.
كانت لدى البائع مجموعة من الفيديوهات المرعبة، والتي تم الاستيلاء على أغلبها من مكاتب المؤسسات الأمنية. يقولون إن صدام حسين كان يأمر بتوثيق كافة الإعدامات، إما كدليل على تنفيذها أو كوسيلة لردع المنشقين. بينما كان البائع يصف لي محتويات هذه الفيديوهات، أتى زبون وسأله إن كان لديه فيديو لحلبجة. دفع ثمن النسخة وانصرف.

أنشأت سلطة الائتلاف المؤقتة فيما بعد مقراً لها في المنطقة الخضراء وتسلمنا دعوة عبر البريد الإلكتروني لحضور مؤتمر صحفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من أيار. في ذلك الوقت، كانت بي بي سي قد فتحت مكتباً في فيلا جميلة مكونة من طابقين. كبار المراسلين من جيريمي بوين إلى جون سويني وستيفن ساكر وباربرا بليت وكارولاين هولي وغيرهم كانوا يأتون إلى بغداد بالتناوب. ومع أنهم تسلموا الدعوة نفسها، إلا أنهم قرروا عدم الذهاب للمؤتمر لأنه في يوم جمعة – أي عطلة رسمية-.
عندما وصلت إلى مكان المؤتمر وجدت صحفية أخرى فقط – جين عراف من سي إن إن. انتظر المسؤولون من سلطة الائتلاف المؤقتة بصبر في غرفة كبيرة مليئة بالكراسي البلاستيكية البيضاء، ثم قرروا أخيرا أن يبدؤوا المؤتمر معنا نحن الاثنتين. المؤتمر الذي أغفله كل الصحفيين كان للإعلان بأن بول بريمير، رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة، قد حلّ الجيش العراقي.
بمجرد أن خرجنا من المبنى، اتصلت بغرفة الأخبار في لندن وأذيع الخبر على الهواء مباشرة. وعلى مدى ساعتين، كان الخبر عنواناً رئيسياً في نشرة أنباء إذاعة بي بي سي العربية قبل أن تنتبه بقية أقسام بي بي سي إلى الأمر. ليس إنجازاً بالنسبة لي أن السبق الصحفي الوحيد الذي حصلت عليه كان لأن صحفيين آخرين لم يحضروا المؤتمر، ولكنني لا أنكر أنني شعرت بالكبرياء عندما نزل كبار مراسلي بي بي سي إلى مكتبنا بدفاترهم ليدوّنوا تفاصيل القصة منّي.
في ذلك الوقت، لم يكن الصحفيون المحليون يحلمون بأن تعيّنهم وسائل الإعلام الكبرى إلا كمساعدي طواقم أو سائقين. كانت لديهم كل المعرفة، ولكن لم يكونوا من الجنسية أو العرق الصحيح. كنت أشاهد الصحفيين الأجانب يدوّنون ملاحظات من مساعديهم أو المترجمين العراقيين: أغلبهم لم تكن لديهم المعرفة المطلوبة فحسب، وإنما الكفاءة والقدرة على تلخيص معلومات معقدة بشكل واضح، وهي أهم كفاءة مطلوبة في أي صحفي. قد يقول الخبراء في قطاع الصحافة إن الأمور هي هكذا ببساطة. في الوقت الذي أمضيته في العراق، شعرت أن العراقيين عوملوا وكأنهم ليسوا محل ثقة لسرد حكايتهم بأنفسهم. إلى أي جهة ينحازون؟ هل هم فعلا ضد حزب البعث؟ أم أنهم يتظاهرون بذلك لكي يحصلوا على عمل؟ في كثير من الجولات الميدانية، شاهدت صحفيين أجانب يتصرفون وكأنهم امتداد لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في تعاملهم مع العراقيين.
أسوأ مثال على ذلك كان في مؤتمر صحفي في وزارة الصحة العراقية للإعلان عن تعيين مسؤول عراقي رفيع المستوى. أحد الصحفيين فضح ذلك المسؤول بمعلومات تثبت أنه من حزب البعث، وشاهدت المسؤول وهو يزداد توتراً. انفض المؤتمر بسرعة وحاول مساعدوه إخراجه من المكان بهدوء، إلا أن صحفياً أمريكياً من وكالة الأسوشييتد بريس لحق به. ظلّ يعترض طريقه، دافعاً وجهه في أنف المسؤول وسأله بعربية ركيكة مرات عدة إن كان يدين حزب البعث. لوهلة بدا وكأن الصحفي سيمسك بالمسؤول لولا أن أحد المساعدين صرخ به ووضع حداً للمهزلة.
مع نهاية مهمتي في العراق والتي استمرت ستة أسابيع، أصبحت أكوام القمامة أكثر ارتفاعاً، وجفت الطبقات السفلى منها تحت أشعة الشمس. كنّا نسمع أصوات انفجارات بين الحين والآخر، وقيل لنا إن القوات الأمريكية كانت تُفجِّر مخازن الذخيرة العراقية.
ولكن هناك قصة أخرى كانت قد بدأت بالظهور.
الطريق الذي سلكناه إلى العراق من الأردن لم يعد آمناً. كانت هناك أنباء بأن مجموعات مسلحة تهجم على المواكب العسكرية وطواقم الصحفيين. الطريق الوحيد للخروج من العراق كان على متن طائرة عسكرية بريطانية إلى الكويت. كانت تلك المرة الأولى التي أعود فيها إلى الكويت منذ أن خرجنا من هناك عام 1991. البعض يقول إن غزو صدام للكويت ذلك العام كان الحدث الذي حسم مصير العراق.