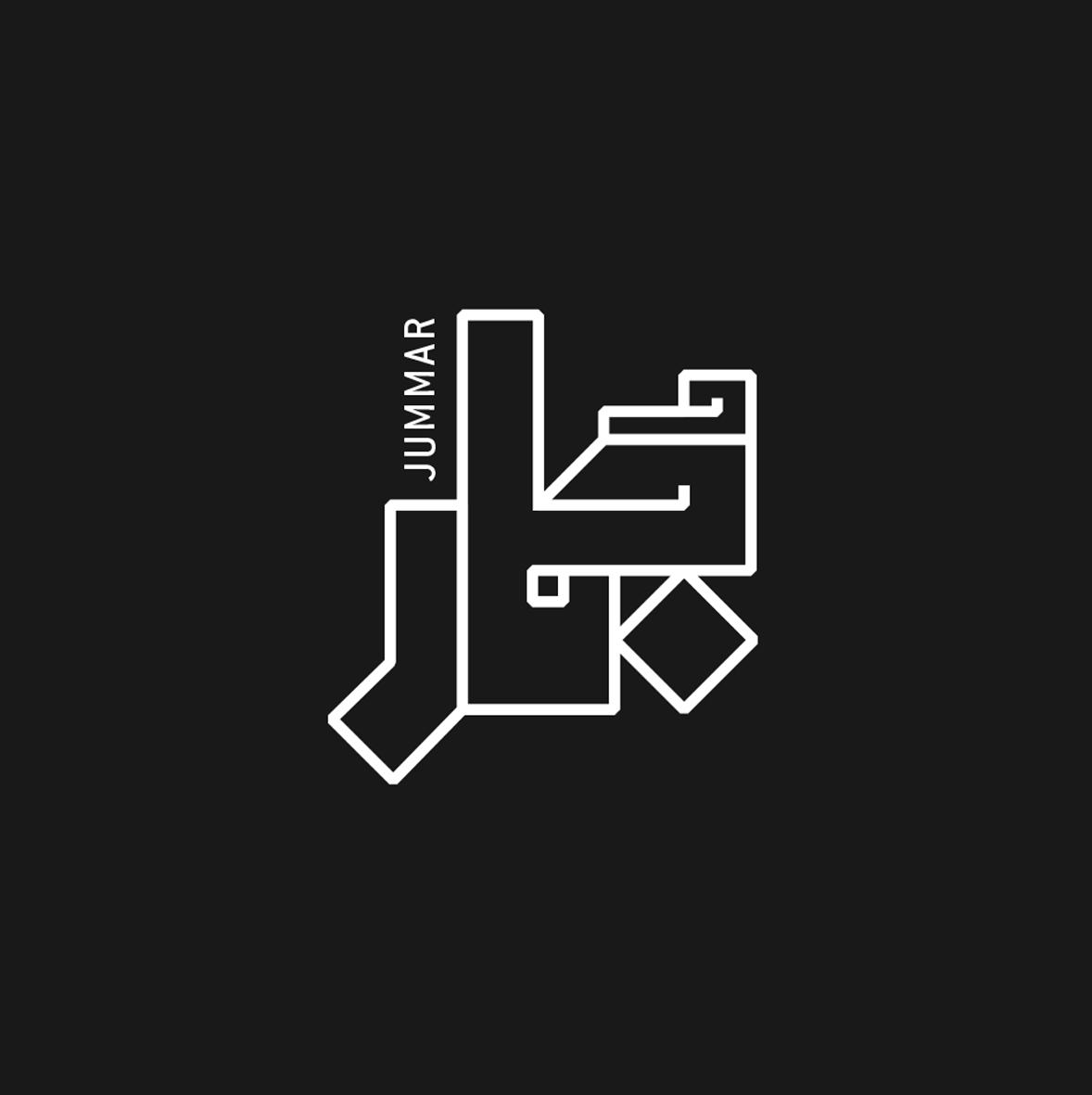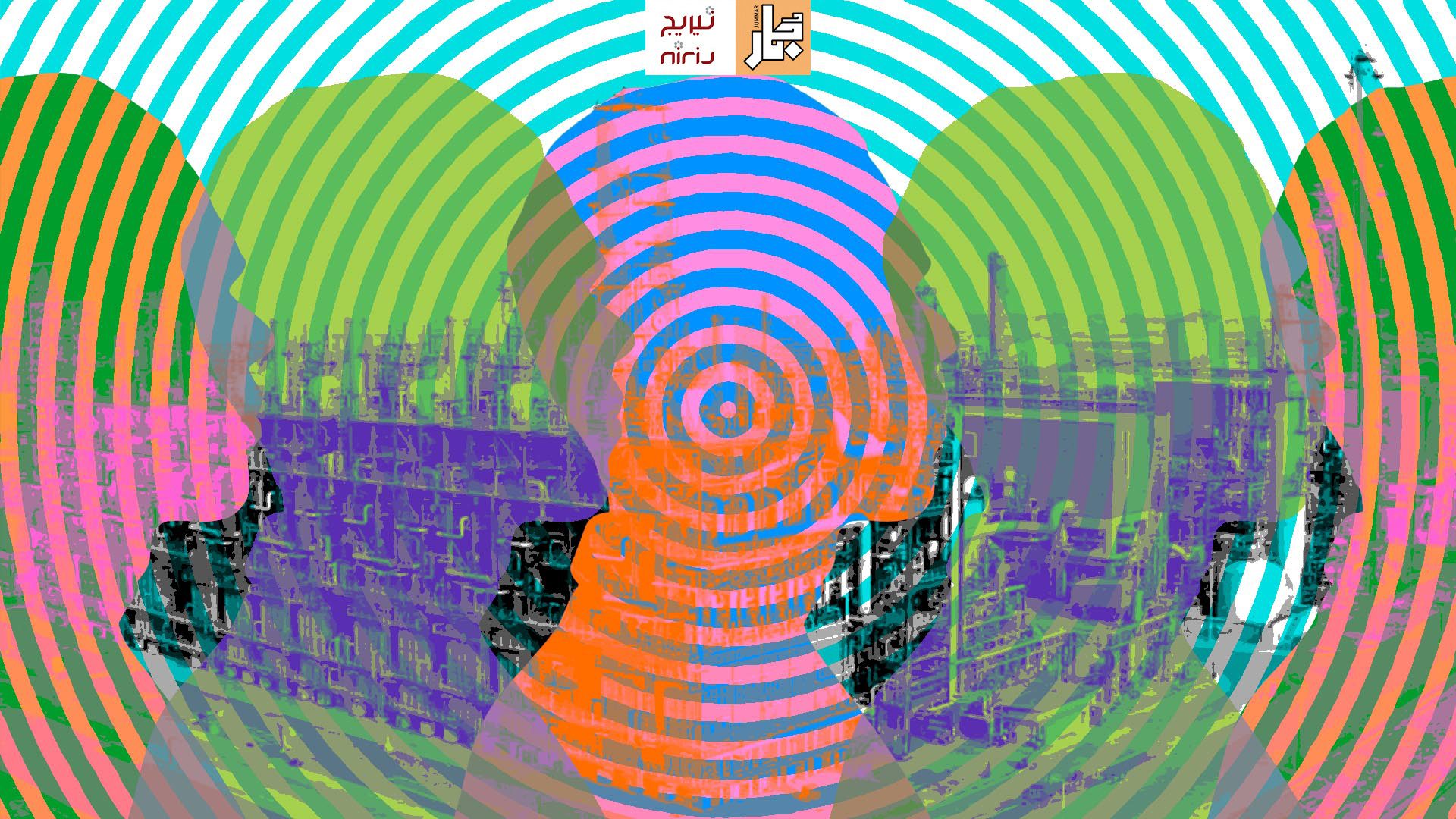قمع حريّات العيش والتعبير في العراق.. إن لم يكن بالعنف فبالقانون
20 كانون الأول 2022
حكم على شاب بالسجن ثلاث سنوات لأنه انتقد الحشد الشعبي. يُحاول نوابٌ تشريع قانون يجرم المثليين وداعميهم. اغتيل ناشطون عدّة في محافظات الجنوب. البرلمان يقرأ القراءة الأولى لقانون حرية التعبير والتجمع السلمي وقانون جرائم المعلوماتية.. حصيلة ثقيلة في الحد من حريات التعبير والعيش.. لكن لماذا يحصل هذا العنف ضد المجتمع، وكيف يستمر؟
خلال الربع الأخير من هذا العام، شهد العراق هجمات على فئات مختلفة، منها ما يتعلّق بحق الناس بحريّة التعبير أو العيش. وفي هذه الهجمات، اتبع إمّا طريق القانون أو طريق العنف، لقمع حق هذه الفئات بالتعبير أو نمط العيش.
حكم على شاب بالسجن ثلاث سنوات لأنه انتقد الحشد الشعبي. يُحاول نواب تشريع قانون يجرم المثليين وداعميهم. اغتيل ناشطون عدّة في محافظات الجنوب. البرلمان يقرأ القراءة الأولى لقانون حرية التعبير والتجمع السلمي وقانون جرائم المعلوماتية.. لم تكن هذه الأفعال هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة حتى. ذلك أنها تندرج ضمن سياق أوسع لا تمثل فيه هذه الأفعال سوى أحد التجليات. هذا السياق هو إقصاء المختلف مادياً ومعنوياً، سواء كانت “جريمته” مجرد انتقاد لمؤسسات الدولة أو التظاهر أو لا ينتمي لدين ومذهب السلطة وسياسييها، أو لا يؤمن بالمقاومة أو كان مثليا أو ملحدا الخ.. وهكذا.
هذا الإقصاء صار مُخيفاً، وصار صانع رقباء على الآخرين وأنفسهم. وأنا نفسي، كنت شاهداً على المثالين.
فعندما أكتبُ، سواء على السوشيال ميديا أو الصحف والمواقع، أتعرض لتحذيرات من جهتين، جهة الأصدقاء الحريصين على حياتي، فهم خائفون من عواقب ما أكتبه، ومن جهة بعض المسؤولين عن المنصات.
هذا الوضع يعكس لنا الخوف من الاختلاف، خوف السلطة من المختلف، وخوف المختلف من السلطة. فالسلطة تقمع، والمختلف يمارس إمّا المواربة والتقنع أو يهاجر خارج البلد أو يسكت، فيهتم بأمور لا علاقة لها بالوضع السياسي إطلاقاً.
هل هذه مبالغة؟
يعتقد كثيرون أن ما أقوله مُبالغ فيه، وأني أرى الحياة من منظار معتم، ذلك أنهم يؤمنون بأن حرية التعبير أكبر وأهم منجز لحكومات ما بعد 2003.
هل هذه حقيقة؟
في الواقع، لا. فعندما حكمت المحكمة بعقوبة قاسية بحق شاب ارتكب فعلاً لم يتجاوز به القانون، أثار البرلمان العراقي قضية تشريع قانوني حرية التعبير والجرائم المعلوماتية ذي المضامين التي لا تتوافق مع مبدأ المواطنة والدولة وحقوق الإنسان.
استخدمت المحكمة قانوناً أقرّته سلطة البعث لقمع معارضيها، بينما البرلمان كان يقرّ قانوناً ليس أفضل بكثير من قانون نظام شمولي مثل نظام صدام حسين.
والحال هذه، لا يهّم إذا ما أقرّ قانون أو استخدم قانون جديد، فالغرض يؤدي نفسه، وهو قمع المخالف.
لكن السلطة تحاول دائماً وضع هالة قانونية على مجموعات أو تعاقدات أو أفعال غير قانونية. مثال على ذلك، هو تحويل المليشيات من مستوى الخروج على الدولة إلى التحكم بالدولة، عبر التكييف القانوني لها من خلال اختلاق مؤسسة الحشد الشعبي التي أصبحت مقدسة.
نتاج هذا كله، فإننا أمام بلد تحكمه طغمة سياسية لا تؤمن بكل قوانين حقوق الإنسان العامة، ولا بالدستور، وما موافقة الدولة على ذلك سوى أنها شكليات تجنّبها عقوبات الجهات الدولية التي فرضت عليها تلك القوانين والمواثيق. لذلك، يتعارض مضمونا هذين القانونين ليس مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وافق عليها العراق فحسب، بل يتعارض مع بنود الدستور العراقي أيضاً.

هذا التعارض بين منطلقات الدولة وأفعال حكوماتها ليس جديداً، وليس من نوع واحد، فمثلاً هنالك استخفاف بالتعامل مع العنف الأسري وما تتعرض له النساء من بشاعة لمجرد كونهن نساءً، فأي فعل يخرج عن نطاق العادات والتقاليد يودي بالمرأة للقتل ولا توجد عقوبات رادعة تحفظ لمفهوم “المواطنة” كرامته.
تريد السلطة فرض إرادتها على المجتمع وضده في الآن نفسه، فقانونا حرية التعبير وجرائم المعلوماتية لم يخضعا لسياق طبيعي بأن يعرضا للنقاش المجتمعي، نقاش منظمات المجتمع المدني التي تعمل بصفة وسيط بين المجتمع والسلطة، كما أنهما -أي كلا القانونين- لم يتضمنا حقوق غير الجماعة الغالبة، وأعني بمصطلح “الحقوق” الحقوقَ الهووية المتضخمة، لا حقوق المواطنة التي لو جرى الاهتمام بها لأدى للاهتمام بغير الجماعة الغالبة.
مما يجعلنا نستنتج أن غياب حقوق الأقليات بشكل أساسيّ يتضامن عضوياً مع مسألة غياب النقاش المجتمعي الذي يسبق إقرار القانون في البرلمان، فدولتنا لا تعترف بالمجتمع المدني، ومن باب أولى أن لا تعترف بحقوق الأقلية، وأولى من هذا وذاك أن لا تعترف حتى بالحقوق “المواطنية” للجماعة الغالبة ذاتها!
أفق تفكير الإسلاميين
جاءت الدولة الجديدة على نمط المعارضة التي كانت تمارس، فهي معارضة غير وطنية، معارضة فئوية استنجدت بقوى خارجية محضتها كامل ولائها. معارضة فُرِضت عليها الديمقراطيةُ من قبل المجتمع الدولي، برغم عدم إيمانها ليس بالديمقراطية فحسب، بل لا يؤمنون بالدولة حتى، ولو كانوا يؤمنون بالدولة لما وافقوا على تحطيمها عن آخرها بحجة إعادة بنائها، ولما عارضوها بطريقة العمالة لدول أخرى أو بطريقة المداعاة بحقوق طائفية لا وطنية.
وبالتالي لا ديمقراطية بدون دولة، فإذا كانت الدولة في حدها الأدنى تركز على بند الواجبات، فإن الديمقراطية تركز على بند الحقوق، فالأولى تداعي بالوطنية والثانية بالمواطنة، الأولى تريد فرض السيادة والثانية تريد فرض الحقوق. والأولى شرط وجود الثانية، لا معنى للحديث عن ديمقراطية بدون دولة، وهذا هو مكمن الخطأ التاريخي بحق العراق! لدينا ديمقراطية مهجّنة بالسلطوية، إنها “سلطوية تنافسية” بحسب اصطلاح دراسات السياسة المقارنة، وبذلك تعيد لنا الديمقراطية إنتاج نقيضها، لأنها بلا أرضية خصبة، بلا شرط إمكان وجودها ونجاحها.
خلاصة القول، إن الخضوع للشكل لا يضمن لنا المضمون، لاسيما وأن الخاضع لا يؤمن بمضمون ذلك الشكل، فهو إسلامي لا وطنية لديه بحكم تجاوز الدين -في منظوره- للحدود الوضعية ذات المنشأ الاستعماري، وأن الدولة القطرية تخلق التجزئة بحق الأمة الإسلامية (مع أنه لا تعنيهم التجزئة بحق الأمة الوطنية الناتجة عن الوحدة الإسلامية!). هذا ينتج لنا شكلاً ديمقراطياً بمضمون إسلامي، شكل دولة بمضمون لا دولة، وليس غريباً أن تتحكم المليشيات بالدولة مع أن المليشيات أعدى أعداء الدولة، يمكن فهم ذلك بسهولة ضمن هذا السياق النظري.
أصبحت السيادة -التي هي أثمن جوهر بمفهوم الدولة- هي سيادة المليشيات. والحال هذه، فمن لا يحترم المليشيات بفعله سيقتل بالقناص، ومن لا يحترمها بقوله فقانونا حرية التعبير والجرائم المعلوماتية بالمرصاد.
استغلت السلطة ممثلة بطغمتها الإسلاموية مفاهيم الدولة والديمقراطية ضد الدولة والديمقراطية. غدا الشكل خادماً لمضمون أجنبي عنه، وهذا الأمر يندرج ضمن سياق التشويه الذي ابتدأه الإخوان المسلمون. حدث تزييف للمفاهيم من قبل من لا يؤمون بها، وهذا ما جعل المختلف في وضعية حرجة، فهو لا يستطيع نكران المفاهيم لكونها عزيزة عليه، ومن جهة إذا أنكر التأويل السلطوي الزائف سيتعرّض للإقصاء الذي هرب منه من خلال إيمانه بتلك المفاهيم أساساً!

الدولة في العراق هي دولة جماعات محدّدة لا المجتمع بكليته، ومن الطبيعي أن تقصى جماعات لصالح جماعات أخرى. كما أن التركيز على الجماعات -دولة المكونات- يجعل الفرد خارج الدائرة، وهذا يعني غياباً مضاعفاً لحقوق المواطن، فالاختلاف لا يتجلى على صعيد الجماعات في قوته، بل في الفرد، فالفرد مظنة الاختلاف قبل الجماعة، ولذلك لا قيمة لحياة متظاهر أو امرأة أو مثلي أو منتقد لمؤسسات الدولة ما دام هؤلاء يمثلون حالات لا تشكل “ترينداً” أو حدثاً متواتراً ضاغطاً.
لذلك من أعدّ مسودات قانوني حرية التعبير وجرائم المعلوماتية الأخيرين هي لجنة حقوق الإنسان في البرلمان! لجنة حقوق إنسان لا تؤمن بحقوق الإنسان، وهو انعكاس لسياسة الدولة العامة، عندما تعاقب المليشيات الخارجة عن القانون مواطنين مختلفين بحجة عدم امتثالهم للقانون.
الشعبوية وسياسة الهوية
تقع سياسات الهوية بالضد من سياسات المواطنة، بل هنالك تلازم عكسي، ما أن تحضر إحداهما تغيب الأخرى، بمعنى أن سياسة الهوية تقوم على حساب سياسة المواطنة. هذا لا يعني أن سياسة المواطنة تنفي الهويات بالمرّة، على العكس تماماً، لكن الهويات المتضخمة، أو “الهويات القاتلة” بحسب اصطلاحية أمين معلوف، هي هويات غير وطنية ولا مواطنية، هويات غير متواضعة، أو غير متأصلة على أساس فكرة الحقوق. فهنالك من يطالب بحرية التعبير عن وجوده المختلف كصاحب هوية، وهو يداعي بحقوقه الأساسية التي ينبغي أن لا تسلب منه بسبب هويته، فهل هذا نفسه الذي يطالب بحقوق زائدة عن اللازم لأجل أنه ذو هوية غالبة وذو أغلبية؟
شتان ما بين الحياة والموت.
تحترم المواطنة حقوق الجميع بلا تمييز، فما يجري على جماعة يجري على الأخريات على حد سواء، وأي تمييز سيعكس عدم الإيمان بالمواطنة، وهذا يأخذنا إلى أن الاعتراف بالمواطنة لجهة على حساب أخرى، ليس مجرد اعترافٍ نابعٍ من الإيمان الأعور بالمواطنة، بل هو نوع من الاستغلال السياسي في الجماعة الغالبة لأنها غالبة، مما يعني أن الجماعة الغالبة ذاتها غيرُ محترمةٍ في حقيقة الأمر، هي مجال لممارسة الشعبوية المعسولة بالكلام والمسمومة بالنوايا، شعبوية تهيّج المشاعر وتسلب العقول، ولا حياة بدون عقلٍ.
لذلك، الشعبوية انحراف للديمقراطية سعياً للقضاء عليها بنقيضها، لكون الديمقراطية نظام مؤسسات رصينة تحيّد عنفوان السلطة التي تبيع الوهم للمجتمع وتأخذ منه مصالح سياسييها.
تعطي السلطةُ للجماعة الغالبة هوياتٍ متضخّمةً، مقابل أن تغيَّب الحقوقُ التي تخلق مواطناً كريماً، لأن الهويات تضمن مصالح السياسيين ولا يضمنها العملُ الشاق من أجل الحقوق. حتى المواطن “الولائي” -ذلك الذي يوالي فصيلا مسلحا أو حزبا يوالي إيران- عندما يختلف جزئياً على سياسة قادته يمكن أن يتعرض لضرر في جسده وكرامته، بل وفي حياته برمتها. فهو غير مُقدّر، وكونه يدعم الجهة الحاكمة لا يضمن له حقوقه كإنسان، هنالك “حاكم جعفري” و”زيارة للأربعينية” وهذا يكفي، فليحدث ما يحدث، هذا هو منجز العراق الجديد! ومن يعترض فمكانه القبر، أو كرسي الإعاقة، أو السجن ثلاث سنوات وغرامة نتيجة تغريدة تعطي لذي الباطل حقه الذي يستحقه.
حماية المجتمع من السلطة
ما كان لهذا العنف ضد المجتمع أن يكون، ولا كان للشعبوية أن تنمو، لولا ضعف المجتمع المدني في العراق، أو حتّى يمكن المبالغة والقول بانعدامه.
المجتمع المدني هو المجتمع الذي لا تخترقه السلطةُ بنحو مباشر، وتربطه بالمجتمع علاقة وجودية. وهو بمعناه الأساسي والحقيقي وليس بتعريفه بـNGO. أن يُنضّم السكّان بمؤسساته النقابية وجمعياته ومنظماته.
فالمجتمع المدني المنظّم يُطالب بالحقوق تجاه تغوّل السلطة التي لا حدَّ لمطامعها لو بقيت في الميدان وحيدة كما يحدث في الأنظمة المستبدة والشمولية. فأين هو دور منظمات المجتمع المدني في العراق بخصوص الحقوق المسلوبة من الشعب بإصرار؟ يبدو أن المنظمات غير فاعلة فعلاً إيجابياً. الكثير من التقارير تؤكد وجود فساد بداخلها، ويبدو أنها أصبحت على خلقة وأخلاق السلطة الحاكمة نفسها، تكتفي بالشكليات وتترك الفاعلية الجوهرية.
تمارس المنظمات غير الحكومية في العراق (NGO) أموراً لا تناسب المقتضيات التاريخية التي تمر بها الدولة العراقية. وانسحب الأمر حتى للمنظمات الحكومية، وكأنها عدوى. بعض الأحزاب الجديدة التي لم تتمكن من السلطة بعد تمارس نشاطات من قبيل تعليم المهن وما شاكل، وتطعم النشاطات بكلام عابر عن القيم الديمقراطية، ويرجع الجميع لأهله مطمئن الضمير بأنه قدم إنجازاً يحسب في التاريخ يستطيع بواسطته كسب الناخبين إن كان حزباً أو كسب التمويل إن كان منظمة غير حكومية.
بالعادة لا تنتفض المنظمات غير الحكومية إلا بالحالات التي ينتفض فيها المجتمع، وهنا نواجه الانتقائية التي تؤدي لنفق التلون بلون الصراعات الاجتماعية المفرغة من عقلانية الحقوق ونقاشها الجاد مع السلطة كمواجهة مباشرة لا تسكت فورتها مع سكوت “التريند” الاجتماعي. كما أن هذه الانتقائية لا تقف عند هذا الحد، بل تصل إلى مستوى الاهتمام بحقوق أدبية أو فكرية دونا عن الحقوق العامة، وهذا يكرس الضد من الحقوق. لا نجد نشاطات مكثفة وجادة وذات خطاب مؤثر وحاد وعميق الدلالة بخصوص مظاهر استغلال السلطة للمفاهيم، وللأغلبية، وكيف أن التنوع الذي يخافه المجتمع يخدم المجتمع في حقيقته، بينما من يخافه بالفعل ويهدد وجوده هي السلطة ذاتها، وأن مفاهيم المجتمع السائدة هي مفاهيم السلطة في حقيقة الأمر.
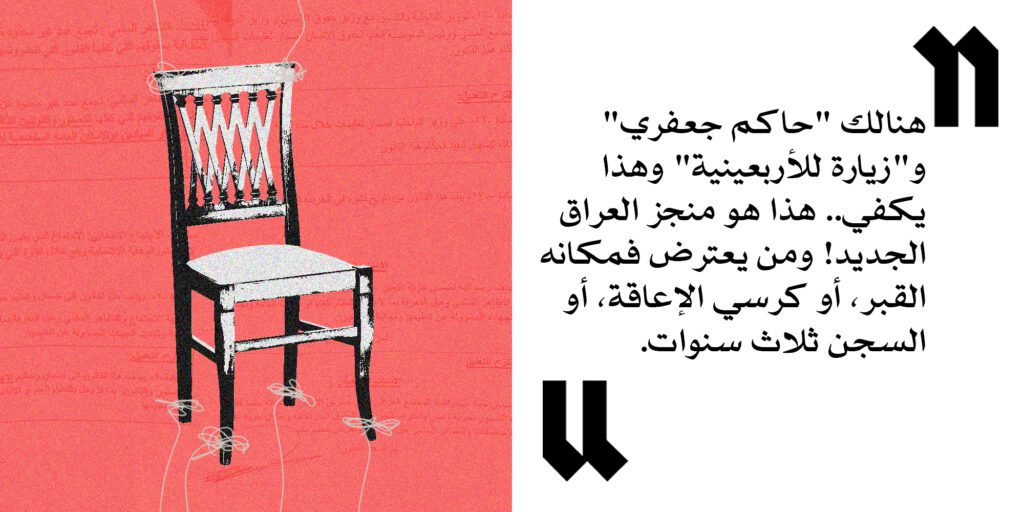
خطاب مؤسسات المجتمع المدني إذن مترهل، لا جدية فيه ولا عمق، فمن جهة ينبع ذلك من تهديد السلطة لهذه المنظمات إن فعلت ما يزاحم مصالحها، ومن جهة، وهو الأهم، سيما الأمر لا يقتصر على المنظمات التي تعمل داخل البلد، هو افتقاد تلك المنظمات لفاعلين ذوي تكوين فكري خاص يختلف عن إرادة مموليهم، فهم سطحيون لا يفهمون الأمور إلا من منظور السياسات الخارجية لدول تبعد آلاف الكيلومترات عن العراق.
الواجبات والحقوق، أية علاقة؟
يمكن تلخيص علاقة المجتمع بالدولة بأنها علاقة ثنائية، الحقوق والواجبات. تأتي هذه العلاقة متكافئة، عندما تكون الدولة هيئة اعتبارية لا شخصية، هيئة ليس لها أن تمتص الواجب المؤدى من قبل الشعب بدون أن تعكسه حقوقاً، بل كل ما يقدم لهذه الهيئة من واجب يرجع على المجتمع بحقوق. فسيادة القانون هي من أجل ضمان الحقوق لا غير، ما يطبق على المجتمع بالتساوي سيرجع عليه بالتساوي.
وهذا ما لا تفهمه الأنظمة السلطوية، بعثية كانت أو إسلاموية. فهي أنظمة تتسلّط على المجتمع، تأخذ ولا تعطي، لا تسمح بوجود مؤسسات منافسة تحيّد منها وتزاحمها.
في المحصّلة، فإن العلاقة بين الدولة والمجتمع في العراق غير متكافئة بالمرة، فهنالك خلل في الدولة من الأساس، دولة غير منجزة في حدها الأدنى، ولا تستطيع الديمقراطيةُ إيصالها لحدها الأعلى كما هو مفترض. فلا وجود لسيادة القانون حيث يطبق القانون على الجميع بالتساوي لصالح هيئة اعتبارية، بل هنالك تمييز بين المواطنين، هذا التمييز يجعل أناساً يخضعون للقانون وآخرين لا، هؤلاء الآخرون الذين لا يخضعون هم من يمثلون الدولة، وبالتالي هم اللادولة التي تقود الدولة، هم المضمون المخُالف لكل أعراف الدولة الحديثة، لكن مُتغطٍ بشكل الدولة. لذا أول شرط للسيادة وإثبات مصداقيتها هو تطبيق القانون على الحاكمين وحاضنتهم الشعبية قبل غيرهم.
ما تعطيه من واجبات لا يرجع عليك، بل يذهب لأولئك المتسيدين عليك ممّن لا يَخضَعون للقانونِ ويُخضِعون القانونَ نفسه. وهنا نصل للب الإشكال، إنهم لا يؤمنون بالقانون، وعدم الإيمان هذا لا يجعلهم يلتزمون به مرة ولا يلتزمون به مرة أخرى بحسب المصداق، بل الأنكى من ذلك أنهم باسم القانون يطبقون على الآخرين ما لا يرتضيه القانون نفسه، ويعطون لأنفسهم وللموافقين لهم ما لا يرتضيه القانون.
ازدواجية المعايير تقال لمن يعاقب على جرم ولا يعاقب على آخر، بينما مشكلتنا هي المعاقبة على حق أصيل ومكافأة الخروج على الحق، مثل مواجهة التظاهر بالقتل، مواجهة المعبِّر عن رأيه بالسجن، مقابل ليس التغافل عن إهانة السياسي للدولة ومؤسساتها وتهديدها فحسب، بل مكافأته، وبسط الأرضية المنعشة لذلك، مثل الاعتداء على القنوات الإعلامية، والاعتداء على السلم الأهلي وهو ما حدث بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في معركتهما للتمكن من السلطة في آب الماضي، حيث أعلنت الحكومة الحدادَ على قتلى الطرفين ثلاثة أيام، وكوفئ ذوو القتلى والجرحى بمليار دينار، وزارتِ المرجعيةُ الدينية الطرفين، القاتل والمقتول.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
خلال الربع الأخير من هذا العام، شهد العراق هجمات على فئات مختلفة، منها ما يتعلّق بحق الناس بحريّة التعبير أو العيش. وفي هذه الهجمات، اتبع إمّا طريق القانون أو طريق العنف، لقمع حق هذه الفئات بالتعبير أو نمط العيش.
حكم على شاب بالسجن ثلاث سنوات لأنه انتقد الحشد الشعبي. يُحاول نواب تشريع قانون يجرم المثليين وداعميهم. اغتيل ناشطون عدّة في محافظات الجنوب. البرلمان يقرأ القراءة الأولى لقانون حرية التعبير والتجمع السلمي وقانون جرائم المعلوماتية.. لم تكن هذه الأفعال هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة حتى. ذلك أنها تندرج ضمن سياق أوسع لا تمثل فيه هذه الأفعال سوى أحد التجليات. هذا السياق هو إقصاء المختلف مادياً ومعنوياً، سواء كانت “جريمته” مجرد انتقاد لمؤسسات الدولة أو التظاهر أو لا ينتمي لدين ومذهب السلطة وسياسييها، أو لا يؤمن بالمقاومة أو كان مثليا أو ملحدا الخ.. وهكذا.
هذا الإقصاء صار مُخيفاً، وصار صانع رقباء على الآخرين وأنفسهم. وأنا نفسي، كنت شاهداً على المثالين.
فعندما أكتبُ، سواء على السوشيال ميديا أو الصحف والمواقع، أتعرض لتحذيرات من جهتين، جهة الأصدقاء الحريصين على حياتي، فهم خائفون من عواقب ما أكتبه، ومن جهة بعض المسؤولين عن المنصات.
هذا الوضع يعكس لنا الخوف من الاختلاف، خوف السلطة من المختلف، وخوف المختلف من السلطة. فالسلطة تقمع، والمختلف يمارس إمّا المواربة والتقنع أو يهاجر خارج البلد أو يسكت، فيهتم بأمور لا علاقة لها بالوضع السياسي إطلاقاً.
هل هذه مبالغة؟
يعتقد كثيرون أن ما أقوله مُبالغ فيه، وأني أرى الحياة من منظار معتم، ذلك أنهم يؤمنون بأن حرية التعبير أكبر وأهم منجز لحكومات ما بعد 2003.
هل هذه حقيقة؟
في الواقع، لا. فعندما حكمت المحكمة بعقوبة قاسية بحق شاب ارتكب فعلاً لم يتجاوز به القانون، أثار البرلمان العراقي قضية تشريع قانوني حرية التعبير والجرائم المعلوماتية ذي المضامين التي لا تتوافق مع مبدأ المواطنة والدولة وحقوق الإنسان.
استخدمت المحكمة قانوناً أقرّته سلطة البعث لقمع معارضيها، بينما البرلمان كان يقرّ قانوناً ليس أفضل بكثير من قانون نظام شمولي مثل نظام صدام حسين.
والحال هذه، لا يهّم إذا ما أقرّ قانون أو استخدم قانون جديد، فالغرض يؤدي نفسه، وهو قمع المخالف.
لكن السلطة تحاول دائماً وضع هالة قانونية على مجموعات أو تعاقدات أو أفعال غير قانونية. مثال على ذلك، هو تحويل المليشيات من مستوى الخروج على الدولة إلى التحكم بالدولة، عبر التكييف القانوني لها من خلال اختلاق مؤسسة الحشد الشعبي التي أصبحت مقدسة.
نتاج هذا كله، فإننا أمام بلد تحكمه طغمة سياسية لا تؤمن بكل قوانين حقوق الإنسان العامة، ولا بالدستور، وما موافقة الدولة على ذلك سوى أنها شكليات تجنّبها عقوبات الجهات الدولية التي فرضت عليها تلك القوانين والمواثيق. لذلك، يتعارض مضمونا هذين القانونين ليس مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وافق عليها العراق فحسب، بل يتعارض مع بنود الدستور العراقي أيضاً.

هذا التعارض بين منطلقات الدولة وأفعال حكوماتها ليس جديداً، وليس من نوع واحد، فمثلاً هنالك استخفاف بالتعامل مع العنف الأسري وما تتعرض له النساء من بشاعة لمجرد كونهن نساءً، فأي فعل يخرج عن نطاق العادات والتقاليد يودي بالمرأة للقتل ولا توجد عقوبات رادعة تحفظ لمفهوم “المواطنة” كرامته.
تريد السلطة فرض إرادتها على المجتمع وضده في الآن نفسه، فقانونا حرية التعبير وجرائم المعلوماتية لم يخضعا لسياق طبيعي بأن يعرضا للنقاش المجتمعي، نقاش منظمات المجتمع المدني التي تعمل بصفة وسيط بين المجتمع والسلطة، كما أنهما -أي كلا القانونين- لم يتضمنا حقوق غير الجماعة الغالبة، وأعني بمصطلح “الحقوق” الحقوقَ الهووية المتضخمة، لا حقوق المواطنة التي لو جرى الاهتمام بها لأدى للاهتمام بغير الجماعة الغالبة.
مما يجعلنا نستنتج أن غياب حقوق الأقليات بشكل أساسيّ يتضامن عضوياً مع مسألة غياب النقاش المجتمعي الذي يسبق إقرار القانون في البرلمان، فدولتنا لا تعترف بالمجتمع المدني، ومن باب أولى أن لا تعترف بحقوق الأقلية، وأولى من هذا وذاك أن لا تعترف حتى بالحقوق “المواطنية” للجماعة الغالبة ذاتها!
أفق تفكير الإسلاميين
جاءت الدولة الجديدة على نمط المعارضة التي كانت تمارس، فهي معارضة غير وطنية، معارضة فئوية استنجدت بقوى خارجية محضتها كامل ولائها. معارضة فُرِضت عليها الديمقراطيةُ من قبل المجتمع الدولي، برغم عدم إيمانها ليس بالديمقراطية فحسب، بل لا يؤمنون بالدولة حتى، ولو كانوا يؤمنون بالدولة لما وافقوا على تحطيمها عن آخرها بحجة إعادة بنائها، ولما عارضوها بطريقة العمالة لدول أخرى أو بطريقة المداعاة بحقوق طائفية لا وطنية.
وبالتالي لا ديمقراطية بدون دولة، فإذا كانت الدولة في حدها الأدنى تركز على بند الواجبات، فإن الديمقراطية تركز على بند الحقوق، فالأولى تداعي بالوطنية والثانية بالمواطنة، الأولى تريد فرض السيادة والثانية تريد فرض الحقوق. والأولى شرط وجود الثانية، لا معنى للحديث عن ديمقراطية بدون دولة، وهذا هو مكمن الخطأ التاريخي بحق العراق! لدينا ديمقراطية مهجّنة بالسلطوية، إنها “سلطوية تنافسية” بحسب اصطلاح دراسات السياسة المقارنة، وبذلك تعيد لنا الديمقراطية إنتاج نقيضها، لأنها بلا أرضية خصبة، بلا شرط إمكان وجودها ونجاحها.
خلاصة القول، إن الخضوع للشكل لا يضمن لنا المضمون، لاسيما وأن الخاضع لا يؤمن بمضمون ذلك الشكل، فهو إسلامي لا وطنية لديه بحكم تجاوز الدين -في منظوره- للحدود الوضعية ذات المنشأ الاستعماري، وأن الدولة القطرية تخلق التجزئة بحق الأمة الإسلامية (مع أنه لا تعنيهم التجزئة بحق الأمة الوطنية الناتجة عن الوحدة الإسلامية!). هذا ينتج لنا شكلاً ديمقراطياً بمضمون إسلامي، شكل دولة بمضمون لا دولة، وليس غريباً أن تتحكم المليشيات بالدولة مع أن المليشيات أعدى أعداء الدولة، يمكن فهم ذلك بسهولة ضمن هذا السياق النظري.
أصبحت السيادة -التي هي أثمن جوهر بمفهوم الدولة- هي سيادة المليشيات. والحال هذه، فمن لا يحترم المليشيات بفعله سيقتل بالقناص، ومن لا يحترمها بقوله فقانونا حرية التعبير والجرائم المعلوماتية بالمرصاد.
استغلت السلطة ممثلة بطغمتها الإسلاموية مفاهيم الدولة والديمقراطية ضد الدولة والديمقراطية. غدا الشكل خادماً لمضمون أجنبي عنه، وهذا الأمر يندرج ضمن سياق التشويه الذي ابتدأه الإخوان المسلمون. حدث تزييف للمفاهيم من قبل من لا يؤمون بها، وهذا ما جعل المختلف في وضعية حرجة، فهو لا يستطيع نكران المفاهيم لكونها عزيزة عليه، ومن جهة إذا أنكر التأويل السلطوي الزائف سيتعرّض للإقصاء الذي هرب منه من خلال إيمانه بتلك المفاهيم أساساً!

الدولة في العراق هي دولة جماعات محدّدة لا المجتمع بكليته، ومن الطبيعي أن تقصى جماعات لصالح جماعات أخرى. كما أن التركيز على الجماعات -دولة المكونات- يجعل الفرد خارج الدائرة، وهذا يعني غياباً مضاعفاً لحقوق المواطن، فالاختلاف لا يتجلى على صعيد الجماعات في قوته، بل في الفرد، فالفرد مظنة الاختلاف قبل الجماعة، ولذلك لا قيمة لحياة متظاهر أو امرأة أو مثلي أو منتقد لمؤسسات الدولة ما دام هؤلاء يمثلون حالات لا تشكل “ترينداً” أو حدثاً متواتراً ضاغطاً.
لذلك من أعدّ مسودات قانوني حرية التعبير وجرائم المعلوماتية الأخيرين هي لجنة حقوق الإنسان في البرلمان! لجنة حقوق إنسان لا تؤمن بحقوق الإنسان، وهو انعكاس لسياسة الدولة العامة، عندما تعاقب المليشيات الخارجة عن القانون مواطنين مختلفين بحجة عدم امتثالهم للقانون.
الشعبوية وسياسة الهوية
تقع سياسات الهوية بالضد من سياسات المواطنة، بل هنالك تلازم عكسي، ما أن تحضر إحداهما تغيب الأخرى، بمعنى أن سياسة الهوية تقوم على حساب سياسة المواطنة. هذا لا يعني أن سياسة المواطنة تنفي الهويات بالمرّة، على العكس تماماً، لكن الهويات المتضخمة، أو “الهويات القاتلة” بحسب اصطلاحية أمين معلوف، هي هويات غير وطنية ولا مواطنية، هويات غير متواضعة، أو غير متأصلة على أساس فكرة الحقوق. فهنالك من يطالب بحرية التعبير عن وجوده المختلف كصاحب هوية، وهو يداعي بحقوقه الأساسية التي ينبغي أن لا تسلب منه بسبب هويته، فهل هذا نفسه الذي يطالب بحقوق زائدة عن اللازم لأجل أنه ذو هوية غالبة وذو أغلبية؟
شتان ما بين الحياة والموت.
تحترم المواطنة حقوق الجميع بلا تمييز، فما يجري على جماعة يجري على الأخريات على حد سواء، وأي تمييز سيعكس عدم الإيمان بالمواطنة، وهذا يأخذنا إلى أن الاعتراف بالمواطنة لجهة على حساب أخرى، ليس مجرد اعترافٍ نابعٍ من الإيمان الأعور بالمواطنة، بل هو نوع من الاستغلال السياسي في الجماعة الغالبة لأنها غالبة، مما يعني أن الجماعة الغالبة ذاتها غيرُ محترمةٍ في حقيقة الأمر، هي مجال لممارسة الشعبوية المعسولة بالكلام والمسمومة بالنوايا، شعبوية تهيّج المشاعر وتسلب العقول، ولا حياة بدون عقلٍ.
لذلك، الشعبوية انحراف للديمقراطية سعياً للقضاء عليها بنقيضها، لكون الديمقراطية نظام مؤسسات رصينة تحيّد عنفوان السلطة التي تبيع الوهم للمجتمع وتأخذ منه مصالح سياسييها.
تعطي السلطةُ للجماعة الغالبة هوياتٍ متضخّمةً، مقابل أن تغيَّب الحقوقُ التي تخلق مواطناً كريماً، لأن الهويات تضمن مصالح السياسيين ولا يضمنها العملُ الشاق من أجل الحقوق. حتى المواطن “الولائي” -ذلك الذي يوالي فصيلا مسلحا أو حزبا يوالي إيران- عندما يختلف جزئياً على سياسة قادته يمكن أن يتعرض لضرر في جسده وكرامته، بل وفي حياته برمتها. فهو غير مُقدّر، وكونه يدعم الجهة الحاكمة لا يضمن له حقوقه كإنسان، هنالك “حاكم جعفري” و”زيارة للأربعينية” وهذا يكفي، فليحدث ما يحدث، هذا هو منجز العراق الجديد! ومن يعترض فمكانه القبر، أو كرسي الإعاقة، أو السجن ثلاث سنوات وغرامة نتيجة تغريدة تعطي لذي الباطل حقه الذي يستحقه.
حماية المجتمع من السلطة
ما كان لهذا العنف ضد المجتمع أن يكون، ولا كان للشعبوية أن تنمو، لولا ضعف المجتمع المدني في العراق، أو حتّى يمكن المبالغة والقول بانعدامه.
المجتمع المدني هو المجتمع الذي لا تخترقه السلطةُ بنحو مباشر، وتربطه بالمجتمع علاقة وجودية. وهو بمعناه الأساسي والحقيقي وليس بتعريفه بـNGO. أن يُنضّم السكّان بمؤسساته النقابية وجمعياته ومنظماته.
فالمجتمع المدني المنظّم يُطالب بالحقوق تجاه تغوّل السلطة التي لا حدَّ لمطامعها لو بقيت في الميدان وحيدة كما يحدث في الأنظمة المستبدة والشمولية. فأين هو دور منظمات المجتمع المدني في العراق بخصوص الحقوق المسلوبة من الشعب بإصرار؟ يبدو أن المنظمات غير فاعلة فعلاً إيجابياً. الكثير من التقارير تؤكد وجود فساد بداخلها، ويبدو أنها أصبحت على خلقة وأخلاق السلطة الحاكمة نفسها، تكتفي بالشكليات وتترك الفاعلية الجوهرية.
تمارس المنظمات غير الحكومية في العراق (NGO) أموراً لا تناسب المقتضيات التاريخية التي تمر بها الدولة العراقية. وانسحب الأمر حتى للمنظمات الحكومية، وكأنها عدوى. بعض الأحزاب الجديدة التي لم تتمكن من السلطة بعد تمارس نشاطات من قبيل تعليم المهن وما شاكل، وتطعم النشاطات بكلام عابر عن القيم الديمقراطية، ويرجع الجميع لأهله مطمئن الضمير بأنه قدم إنجازاً يحسب في التاريخ يستطيع بواسطته كسب الناخبين إن كان حزباً أو كسب التمويل إن كان منظمة غير حكومية.
بالعادة لا تنتفض المنظمات غير الحكومية إلا بالحالات التي ينتفض فيها المجتمع، وهنا نواجه الانتقائية التي تؤدي لنفق التلون بلون الصراعات الاجتماعية المفرغة من عقلانية الحقوق ونقاشها الجاد مع السلطة كمواجهة مباشرة لا تسكت فورتها مع سكوت “التريند” الاجتماعي. كما أن هذه الانتقائية لا تقف عند هذا الحد، بل تصل إلى مستوى الاهتمام بحقوق أدبية أو فكرية دونا عن الحقوق العامة، وهذا يكرس الضد من الحقوق. لا نجد نشاطات مكثفة وجادة وذات خطاب مؤثر وحاد وعميق الدلالة بخصوص مظاهر استغلال السلطة للمفاهيم، وللأغلبية، وكيف أن التنوع الذي يخافه المجتمع يخدم المجتمع في حقيقته، بينما من يخافه بالفعل ويهدد وجوده هي السلطة ذاتها، وأن مفاهيم المجتمع السائدة هي مفاهيم السلطة في حقيقة الأمر.
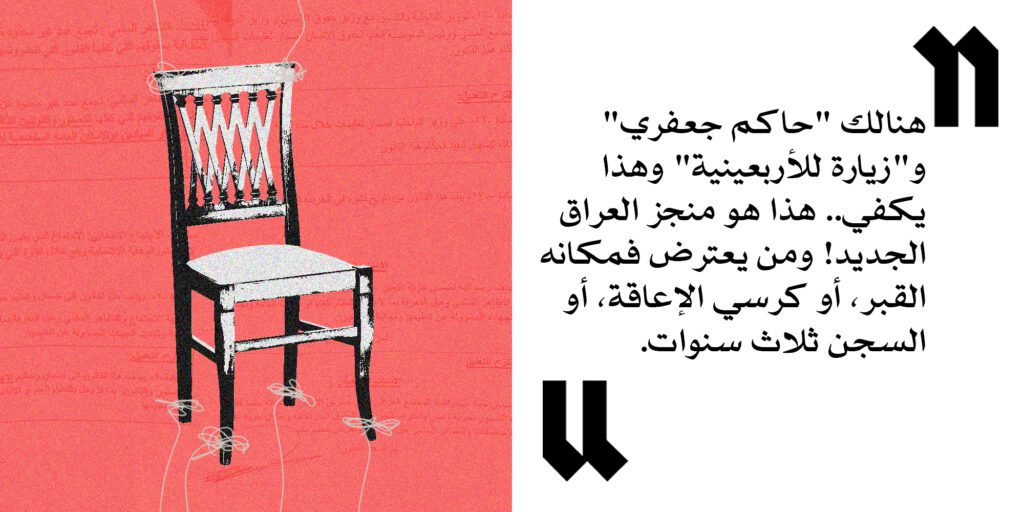
خطاب مؤسسات المجتمع المدني إذن مترهل، لا جدية فيه ولا عمق، فمن جهة ينبع ذلك من تهديد السلطة لهذه المنظمات إن فعلت ما يزاحم مصالحها، ومن جهة، وهو الأهم، سيما الأمر لا يقتصر على المنظمات التي تعمل داخل البلد، هو افتقاد تلك المنظمات لفاعلين ذوي تكوين فكري خاص يختلف عن إرادة مموليهم، فهم سطحيون لا يفهمون الأمور إلا من منظور السياسات الخارجية لدول تبعد آلاف الكيلومترات عن العراق.
الواجبات والحقوق، أية علاقة؟
يمكن تلخيص علاقة المجتمع بالدولة بأنها علاقة ثنائية، الحقوق والواجبات. تأتي هذه العلاقة متكافئة، عندما تكون الدولة هيئة اعتبارية لا شخصية، هيئة ليس لها أن تمتص الواجب المؤدى من قبل الشعب بدون أن تعكسه حقوقاً، بل كل ما يقدم لهذه الهيئة من واجب يرجع على المجتمع بحقوق. فسيادة القانون هي من أجل ضمان الحقوق لا غير، ما يطبق على المجتمع بالتساوي سيرجع عليه بالتساوي.
وهذا ما لا تفهمه الأنظمة السلطوية، بعثية كانت أو إسلاموية. فهي أنظمة تتسلّط على المجتمع، تأخذ ولا تعطي، لا تسمح بوجود مؤسسات منافسة تحيّد منها وتزاحمها.
في المحصّلة، فإن العلاقة بين الدولة والمجتمع في العراق غير متكافئة بالمرة، فهنالك خلل في الدولة من الأساس، دولة غير منجزة في حدها الأدنى، ولا تستطيع الديمقراطيةُ إيصالها لحدها الأعلى كما هو مفترض. فلا وجود لسيادة القانون حيث يطبق القانون على الجميع بالتساوي لصالح هيئة اعتبارية، بل هنالك تمييز بين المواطنين، هذا التمييز يجعل أناساً يخضعون للقانون وآخرين لا، هؤلاء الآخرون الذين لا يخضعون هم من يمثلون الدولة، وبالتالي هم اللادولة التي تقود الدولة، هم المضمون المخُالف لكل أعراف الدولة الحديثة، لكن مُتغطٍ بشكل الدولة. لذا أول شرط للسيادة وإثبات مصداقيتها هو تطبيق القانون على الحاكمين وحاضنتهم الشعبية قبل غيرهم.
ما تعطيه من واجبات لا يرجع عليك، بل يذهب لأولئك المتسيدين عليك ممّن لا يَخضَعون للقانونِ ويُخضِعون القانونَ نفسه. وهنا نصل للب الإشكال، إنهم لا يؤمنون بالقانون، وعدم الإيمان هذا لا يجعلهم يلتزمون به مرة ولا يلتزمون به مرة أخرى بحسب المصداق، بل الأنكى من ذلك أنهم باسم القانون يطبقون على الآخرين ما لا يرتضيه القانون نفسه، ويعطون لأنفسهم وللموافقين لهم ما لا يرتضيه القانون.
ازدواجية المعايير تقال لمن يعاقب على جرم ولا يعاقب على آخر، بينما مشكلتنا هي المعاقبة على حق أصيل ومكافأة الخروج على الحق، مثل مواجهة التظاهر بالقتل، مواجهة المعبِّر عن رأيه بالسجن، مقابل ليس التغافل عن إهانة السياسي للدولة ومؤسساتها وتهديدها فحسب، بل مكافأته، وبسط الأرضية المنعشة لذلك، مثل الاعتداء على القنوات الإعلامية، والاعتداء على السلم الأهلي وهو ما حدث بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في معركتهما للتمكن من السلطة في آب الماضي، حيث أعلنت الحكومة الحدادَ على قتلى الطرفين ثلاثة أيام، وكوفئ ذوو القتلى والجرحى بمليار دينار، وزارتِ المرجعيةُ الدينية الطرفين، القاتل والمقتول.