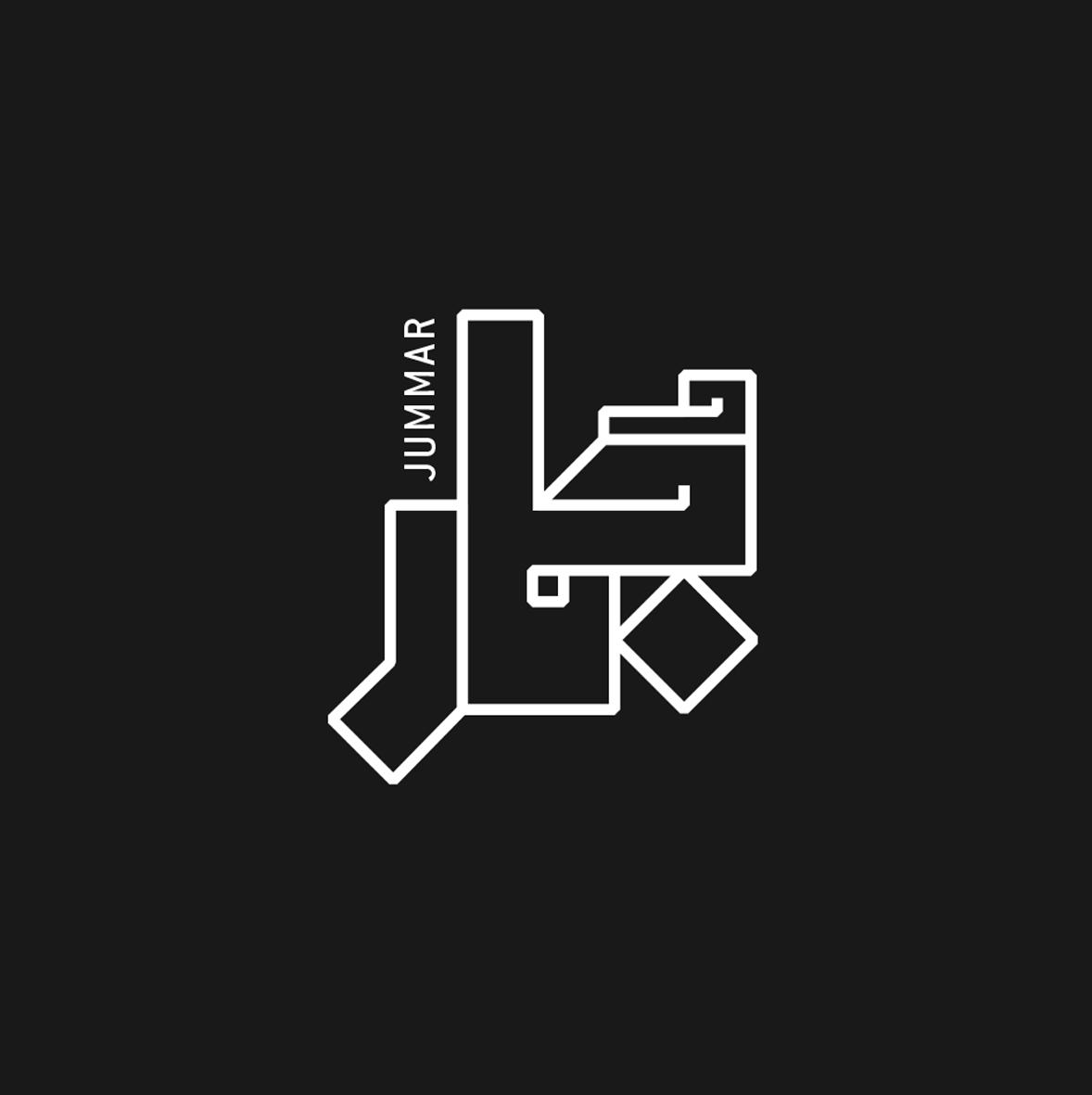أربعة كتاب يستعيدون لحظة 2003: وَصَلَنا الدخان والنار!
09 نيسان 2023
شبّه كاتبٌ ومترجمٌ ما حصل عام 2003 بـ"لحظة سقوط بغداد على يد المغول"، فيما شعر روائيّ بأن دخان 11 أيلول قد وصل إلى بغداد، ولَحَظ كاتبٌ شابٌ كيف تحوّلت مؤسسات البعث القومية إلى مؤسسات إسلامية، فيما تنتظر والدة شاعر استعادة البلاد لتفي بنذرٍ قطعته لحظة الغزو.. أربعة كتاب يتحدثون عن اللحظات والأيام الأولى لغزو العراق..
كيف يشعر المرء أمام حدث ضخم مثل سقوط نظام ديكتاتوري أوغل في وحشيته على مدار عقود، لكن كلفة رحيله كانت غزو البلاد، واستخدام العنف بإفراط، وتدمير المؤسسات؟
سأل “جمار” أربعة كتاب من أجيال مختلفة عن شعورهم في تلك اللحظة، ذكرياتهم معها، مشاعرهم المختلطة التي أحسُّوا بها، ومكان تواجدهم عندما أُسقِط تمثال صدّام في ساحة الفردوس بحبلٍ متينٍ لدبابةٍ أمريكية؟
شبّه كاتب ومترجم ما حصل عام 2003 بلحظة سقوط بغداد على يد المغول، فيما شعر روائي بأن الدخان الذي تطاير بعد تفجير برجي التجارة عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، قد امتدّ إلى بغداد بعد عامين.
ولَحَظ أحد الكتاب الشباب كيف تحوّلت مؤسسات البعث القومية إلى مؤسسات إسلامية بعد أيام من إسقاط نظام البعث، فيما تنتظر والدة شاعر استعادة البلاد -مرّة أخرى- لتفي بنذر قطعته لحظة الغزو..

حوالي الساعة التاسعة مساء يوم التاسع من نيسان عام 2003 اتصل بي أحد الإعلاميين البولنديين من القناة التلفزيونية رقم واحد. قال لي: أستاذ هاتف سنحتاجك لأمر مهم ونرجو ألاّ تمانع في مرافقتنا اعتباراً من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. سألته: ما المناسبة؟ أجابني: نتوقّع دخول القوات الأميركية إلى الأراضي العراقية.
على الرغم من تشاؤمي وقلقي الشديدين، قلت في نفسي، من الأفضل أن أكون، فأنا معارض وطني مستقل لسلطة ظالمة متهورة متمثلة في شخص واحد فقط، هذا أولاً، ومناهض لأي تدخل خارجي ثانياً. حظر معي أستاذ وصديق هو المرحوم المؤرخ والباحث البروفسور كشيشتوف ميخاوك -كان رئيساً لقسم الدراسات الأميركية في وارسو- وكنا متشابهين في موقفنا من التدخل الخارجي.
لم أخف فرحتي حينئذ من إمكانية تخلص العراقيين من النظام الشمولي، لكنني لم أخف قلقي الشديد من عواقب استخدام القوة العسكرية. ولعل من بين تلك المؤشرات على تشاؤمي كان استخدام الأسلحة المحرمة وتدمير البنية التحتية للبلد وقتل وتشريد أعداد هائلة من العراقيين الأبرياء، ونهب المتاحف والمؤسسات الحكومية والبنوك، وحل الجيش وأجهزة الدولة الأخرى، ونشر الخراب والفوضى. ولم يكن مشهد الدبابتين الأمريكيتين اللتين صوبتا فوهتيهما من على الجسر نحو فندق الرشيد وعلامة القراصنة التي رفعت على سطح إحداهما إلا نذير شؤم بالنسبة إليّ.
ما زال المنظر مهولاً في حياتي رغم رغبتي في أن يتخلص العراقيون من العسف والاضطهاد. لم أثق في يوم من الأيام في أي قوة خارجية مهما كانت طبيعتها ونواياها.
كنت ضيفاً على وسائل الإعلام البولندية لفترة طويلة، وأصبح من الواضح أن انتقادي في نمو مطرد، مشككاً في صدق نوايا المحتل ووجود خطة لديه لإحلال الاستقرار والإعمار في العراق تكفيراً عما اقترفه من دمار وإذلال للعراقيين.
ما جرى في العراق لم يكن بريئاً إطلاقاً، بل خطط له. في الذكرى الأولى لاحتلال العراق، كتبت مقالة بعنوان: “بغداد بين احتلالين”. وكنت أقصد الغزو المغولي لبغداد سنة 1258 م فسقوطها، والغزو الأميركي واحتلاله للعراق سنة 2003 وسقوط بغداد للمرة الثانية. العراقيون لا يستحقون نظاماً جائراً كالذي مثله صدام حسين -رغم وجود نظام ودولة آنذاك-، ولا نظاماً فاسداً جاهلاً فتت الدولة وسمعتها، وضعه المحتلون بغرض الحط من روح وعقل وحاضر ومستقبل بلد ذي ثقل حضاري على صعيد المنطقة والعالم.
لا يمكن هزيمة العراقيين.

سؤال لحظة عام 2003 مربك جداً، فقد كانت مشاعري يومها شتّى، وكثيرة التناقض، تراوحت ما بين الحزن الشديد، إلى حد البكاء، والشعور بعار لم أتصور يوماً بأنني سأعيش مثله!
هل كان يوماً حقيقياً أم مجرد كابوس انتابني في لحظة ضعف أو مرض؟ أنا أعرف الآن بأنه حقيقة قاسية جداً، ولكنني يومها كنت أتمنى لو استيقظت فجأة ورأيت الكابوس قد انتهى.
أحالني ذلك اليوم إلى ذكرى يوم سبقه، بسنتين تقريباً، استيقظت فيه على أصوات ولديّ وهما يتكلمان بانفعال وينظران إلى التلفاز، تساءلت عما بهما، فقالا إن أمريكا قد تعرضت إلى هجوم!
التفتّ إلى التلفاز، فرأيت الدخان الأسود يتصاعد من البرج المضروب فشعرت بخوف غامض امتلك نفسي. في يوم الاحتلال، عرفت بأن الدخان الأسود قد وصلنا كما خشيت، حين سمعت بأن الدبابات الأمريكية قد دخلت بغداد.
أنا أدرك تناقض مشاعر العراقيين…

لم أر والدي بهذا الكم الهائل من العاطفة من قبل، وصل إلينا في حصوة المسيب في بابل، واحتضننا باكياً بطريقة هستيرية، كان الأمر يحمل تناقضاً غريباً بالنسبة لي، كيف يبكي وهو كان يحتفل بأنباء الحرب قبل أن تندلع، وهو كان يعد الأيام والساعات لإسقاط صدام، سمعت منه في تلك الظهيرة كلمة احتلال للمرة الأولى.
في الطريق، قطع رتل أمريكي الشارع ليفجر كدس عتاد، صوت الانفجار كان أعلى من أي صوت آخر سمعته في حياتي، لكن صخب الصورة، صورة الدبابة الامريكية تقطع الشارع وتأمر العراقيين بالسير والتوقف كان أعلى.
دخلنا البيت وكان إمام جامع الإسراء والمعراج يدعو العائلات لإرسال أولادهم إلى المدرسة رغم عدم وجود دولة، قال وهو يبكي: “لن يدمروا بلدنا ما زلنا نتعلم، أول شيء سنقاومهم به هو العلم”.. حينها سألت أمي إن كان الأمر قد انتهى تماماً، وان البلاد الآن اصبحت محتلة، فأجابت بنعم. حينها، ساومت أمي الإمام الحسين على قدر الهريسة: إن لم تعد العراق لنا مرّة أخرى لن أطبخ لك مجدداً. ولم تطبخ أمي الهريسة حتى اللحظة بعد عشرين عاماً على تلك المساومة.

كان يوماً ربيعياً بامتياز، ذهبنا صباحاً إلى مدرستنا لنجد أن بعضاً من مدرسينا قد استقر به المقام على سطح المدرسة وآخر يقف خلف ساتر طيني. مُدرِّس مادة التاريخ وهو يرتدي زيه الزيتوني وجهنا للعودة من حيث اتينا فنحن في حالة حرب بعد أن بدأت امريكا بقصف بغداد. هكذا سمعنا بخبر الحرب.
بعد أسابيع، أعلن عن عودة الدوام الرسمي، وما أن دخلنا المدرسة حتى وجدنا مديرها وهو يحمل فرشةً وطلاء يقترب لونه من البرتقالي ليمحو صورة كبيرة لصدام حسين كانت تطالعنا من جدار كبير في واجهة المدرسة. وبقي هذا المدير وهو بدرجة حزبية “مرموقة” في منصبه لوقت طويل.
الصورة الثانية كانت لمقر الفرقة الحزبية في المنطقة والتي كانت تقع على طريقنا اليومي الى المدرسة، فقد تحوّلت وبوقت قياسي الى مركز “اسلامي” خيري. تورّط القائمون عليه لاحقاً بإشاعة الخطاب المتطرف.
يوم سقوط/انهيار نظام حسين كان عمر الدولة العراقية قد أنهى الثمانية عقود، وبعد كل هذا التاريخ المزدحم سياسياً وثقافياً واجتماعياً، يجد العراقي نفسه أمام لحظة معبأة بتناقض كبير غير منطقي، فهو يرفض الاحتلال بدباباته وهي تفتح الباب أمام مزيد من الخراب، وبين نظام دكتاتوري رهيب يحسب الانفاس على مواطنيه ويتفحصها خشيةً.
الطريقة التي انتهى بها الدكتاتور ونظامه طريقة تثير الشؤم، فهي تعكس عجزاً للداخل العراقي في إحداث التغيير، أو قد تدفع بهذا الاتجاه، وخاطئ من يتبنى أو يقف مع رؤية الخارج مهما كانت وردية ومهما كان ذلك الخارج.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً


جمهورية بيت طعيس..
الثراء القذر أو كيف تحكُم بالنيابة عن الآخرين
19 أبريل 2024
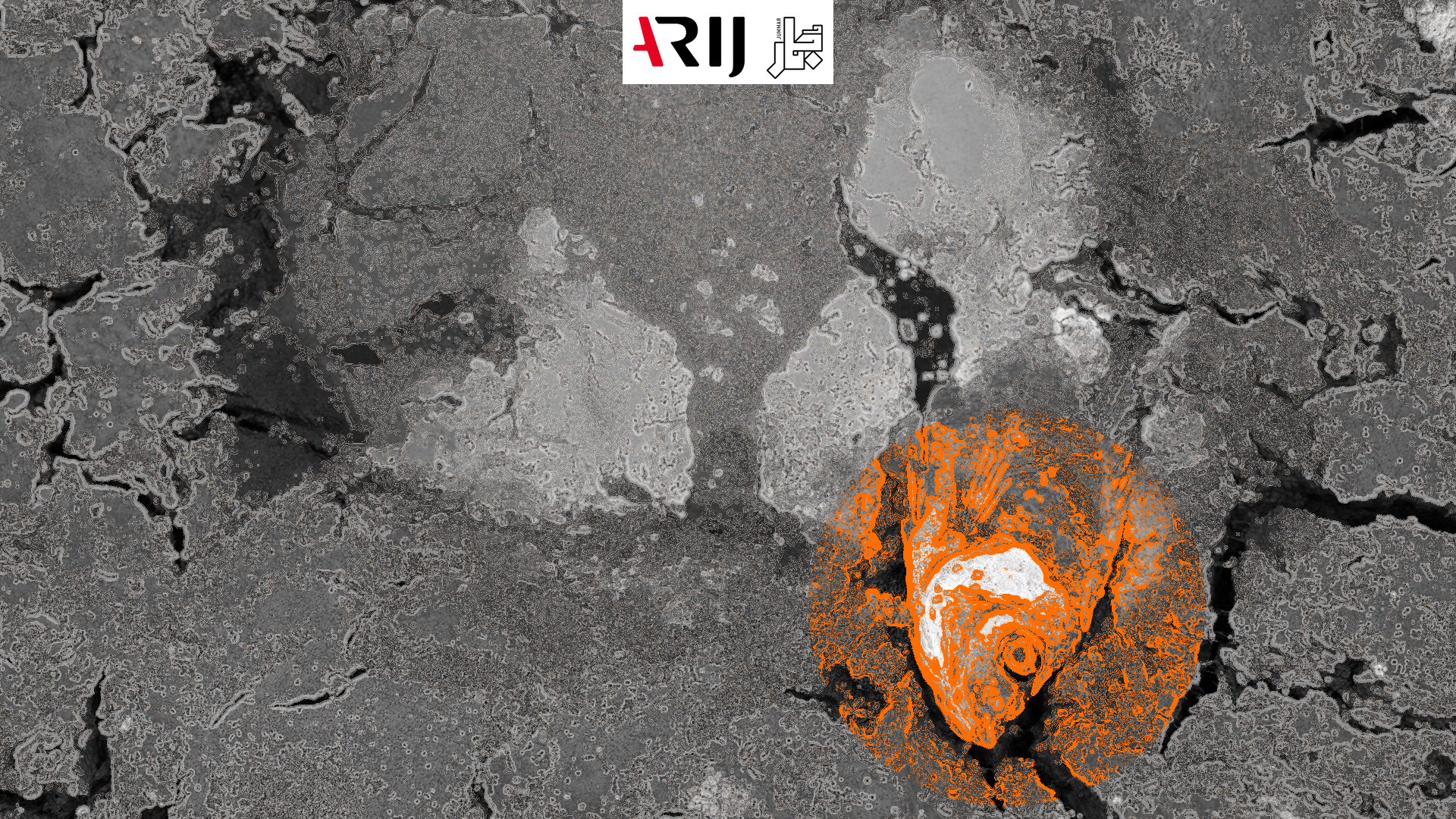
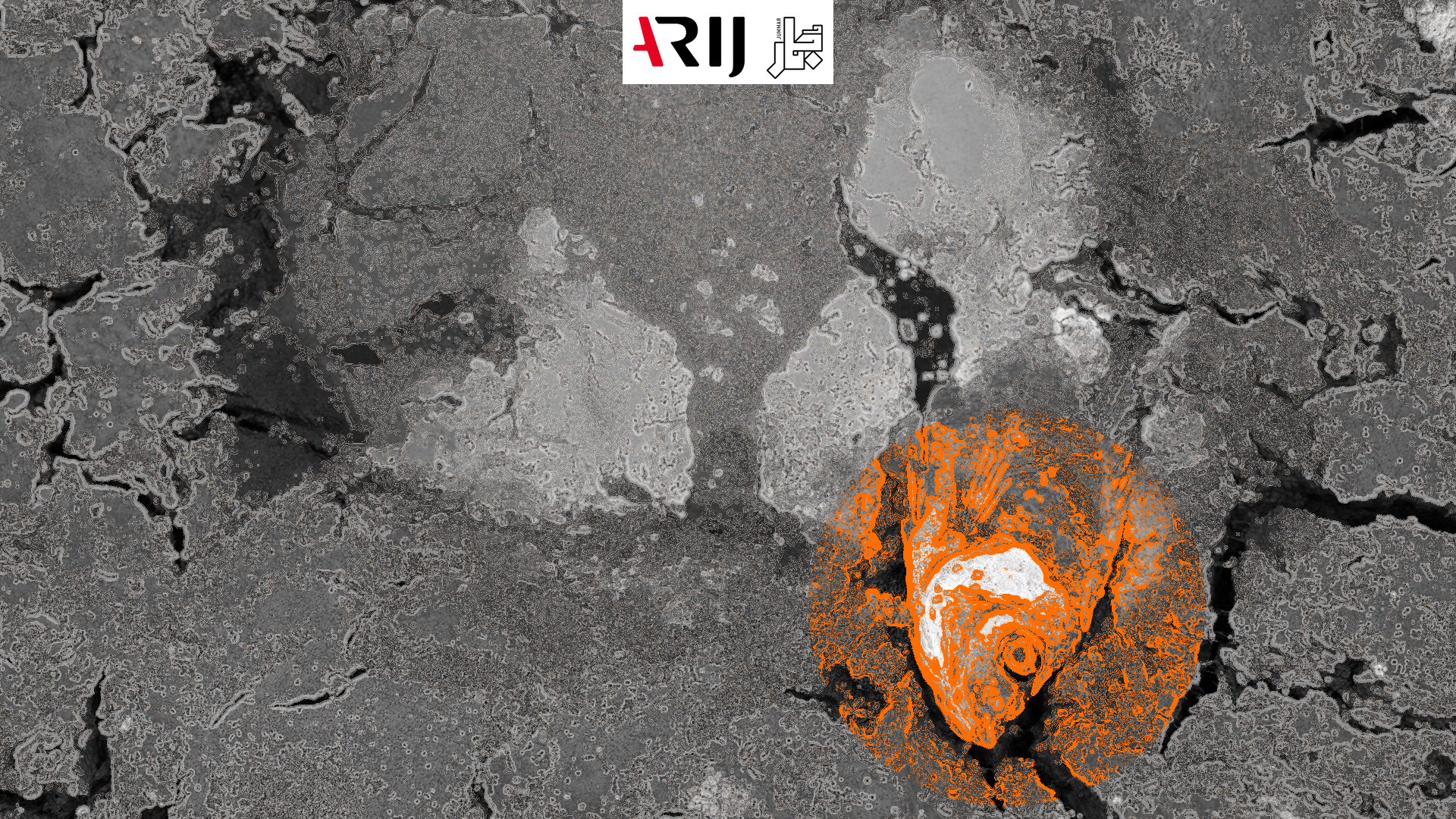
الجفاف والعطش.. جردة مطولة بالأنهار والسياسات المائية في العراق
18 أبريل 2024


"مَنْ يُريد وظيفةً يتركها مَنْ يعمل بها؟".. عن الممرضات والممرضين في العراق
16 أبريل 2024


صناعة الكَيمر من كلكامش إلى زهرة وأم أحمد
10 أبريل 2024
كيف يشعر المرء أمام حدث ضخم مثل سقوط نظام ديكتاتوري أوغل في وحشيته على مدار عقود، لكن كلفة رحيله كانت غزو البلاد، واستخدام العنف بإفراط، وتدمير المؤسسات؟
سأل “جمار” أربعة كتاب من أجيال مختلفة عن شعورهم في تلك اللحظة، ذكرياتهم معها، مشاعرهم المختلطة التي أحسُّوا بها، ومكان تواجدهم عندما أُسقِط تمثال صدّام في ساحة الفردوس بحبلٍ متينٍ لدبابةٍ أمريكية؟
شبّه كاتب ومترجم ما حصل عام 2003 بلحظة سقوط بغداد على يد المغول، فيما شعر روائي بأن الدخان الذي تطاير بعد تفجير برجي التجارة عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، قد امتدّ إلى بغداد بعد عامين.
ولَحَظ أحد الكتاب الشباب كيف تحوّلت مؤسسات البعث القومية إلى مؤسسات إسلامية بعد أيام من إسقاط نظام البعث، فيما تنتظر والدة شاعر استعادة البلاد -مرّة أخرى- لتفي بنذر قطعته لحظة الغزو..

حوالي الساعة التاسعة مساء يوم التاسع من نيسان عام 2003 اتصل بي أحد الإعلاميين البولنديين من القناة التلفزيونية رقم واحد. قال لي: أستاذ هاتف سنحتاجك لأمر مهم ونرجو ألاّ تمانع في مرافقتنا اعتباراً من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. سألته: ما المناسبة؟ أجابني: نتوقّع دخول القوات الأميركية إلى الأراضي العراقية.
على الرغم من تشاؤمي وقلقي الشديدين، قلت في نفسي، من الأفضل أن أكون، فأنا معارض وطني مستقل لسلطة ظالمة متهورة متمثلة في شخص واحد فقط، هذا أولاً، ومناهض لأي تدخل خارجي ثانياً. حظر معي أستاذ وصديق هو المرحوم المؤرخ والباحث البروفسور كشيشتوف ميخاوك -كان رئيساً لقسم الدراسات الأميركية في وارسو- وكنا متشابهين في موقفنا من التدخل الخارجي.
لم أخف فرحتي حينئذ من إمكانية تخلص العراقيين من النظام الشمولي، لكنني لم أخف قلقي الشديد من عواقب استخدام القوة العسكرية. ولعل من بين تلك المؤشرات على تشاؤمي كان استخدام الأسلحة المحرمة وتدمير البنية التحتية للبلد وقتل وتشريد أعداد هائلة من العراقيين الأبرياء، ونهب المتاحف والمؤسسات الحكومية والبنوك، وحل الجيش وأجهزة الدولة الأخرى، ونشر الخراب والفوضى. ولم يكن مشهد الدبابتين الأمريكيتين اللتين صوبتا فوهتيهما من على الجسر نحو فندق الرشيد وعلامة القراصنة التي رفعت على سطح إحداهما إلا نذير شؤم بالنسبة إليّ.
ما زال المنظر مهولاً في حياتي رغم رغبتي في أن يتخلص العراقيون من العسف والاضطهاد. لم أثق في يوم من الأيام في أي قوة خارجية مهما كانت طبيعتها ونواياها.
كنت ضيفاً على وسائل الإعلام البولندية لفترة طويلة، وأصبح من الواضح أن انتقادي في نمو مطرد، مشككاً في صدق نوايا المحتل ووجود خطة لديه لإحلال الاستقرار والإعمار في العراق تكفيراً عما اقترفه من دمار وإذلال للعراقيين.
ما جرى في العراق لم يكن بريئاً إطلاقاً، بل خطط له. في الذكرى الأولى لاحتلال العراق، كتبت مقالة بعنوان: “بغداد بين احتلالين”. وكنت أقصد الغزو المغولي لبغداد سنة 1258 م فسقوطها، والغزو الأميركي واحتلاله للعراق سنة 2003 وسقوط بغداد للمرة الثانية. العراقيون لا يستحقون نظاماً جائراً كالذي مثله صدام حسين -رغم وجود نظام ودولة آنذاك-، ولا نظاماً فاسداً جاهلاً فتت الدولة وسمعتها، وضعه المحتلون بغرض الحط من روح وعقل وحاضر ومستقبل بلد ذي ثقل حضاري على صعيد المنطقة والعالم.
لا يمكن هزيمة العراقيين.


سؤال لحظة عام 2003 مربك جداً، فقد كانت مشاعري يومها شتّى، وكثيرة التناقض، تراوحت ما بين الحزن الشديد، إلى حد البكاء، والشعور بعار لم أتصور يوماً بأنني سأعيش مثله!
هل كان يوماً حقيقياً أم مجرد كابوس انتابني في لحظة ضعف أو مرض؟ أنا أعرف الآن بأنه حقيقة قاسية جداً، ولكنني يومها كنت أتمنى لو استيقظت فجأة ورأيت الكابوس قد انتهى.
أحالني ذلك اليوم إلى ذكرى يوم سبقه، بسنتين تقريباً، استيقظت فيه على أصوات ولديّ وهما يتكلمان بانفعال وينظران إلى التلفاز، تساءلت عما بهما، فقالا إن أمريكا قد تعرضت إلى هجوم!
التفتّ إلى التلفاز، فرأيت الدخان الأسود يتصاعد من البرج المضروب فشعرت بخوف غامض امتلك نفسي. في يوم الاحتلال، عرفت بأن الدخان الأسود قد وصلنا كما خشيت، حين سمعت بأن الدبابات الأمريكية قد دخلت بغداد.
أنا أدرك تناقض مشاعر العراقيين…


لم أر والدي بهذا الكم الهائل من العاطفة من قبل، وصل إلينا في حصوة المسيب في بابل، واحتضننا باكياً بطريقة هستيرية، كان الأمر يحمل تناقضاً غريباً بالنسبة لي، كيف يبكي وهو كان يحتفل بأنباء الحرب قبل أن تندلع، وهو كان يعد الأيام والساعات لإسقاط صدام، سمعت منه في تلك الظهيرة كلمة احتلال للمرة الأولى.
في الطريق، قطع رتل أمريكي الشارع ليفجر كدس عتاد، صوت الانفجار كان أعلى من أي صوت آخر سمعته في حياتي، لكن صخب الصورة، صورة الدبابة الامريكية تقطع الشارع وتأمر العراقيين بالسير والتوقف كان أعلى.
دخلنا البيت وكان إمام جامع الإسراء والمعراج يدعو العائلات لإرسال أولادهم إلى المدرسة رغم عدم وجود دولة، قال وهو يبكي: “لن يدمروا بلدنا ما زلنا نتعلم، أول شيء سنقاومهم به هو العلم”.. حينها سألت أمي إن كان الأمر قد انتهى تماماً، وان البلاد الآن اصبحت محتلة، فأجابت بنعم. حينها، ساومت أمي الإمام الحسين على قدر الهريسة: إن لم تعد العراق لنا مرّة أخرى لن أطبخ لك مجدداً. ولم تطبخ أمي الهريسة حتى اللحظة بعد عشرين عاماً على تلك المساومة.



كان يوماً ربيعياً بامتياز، ذهبنا صباحاً إلى مدرستنا لنجد أن بعضاً من مدرسينا قد استقر به المقام على سطح المدرسة وآخر يقف خلف ساتر طيني. مُدرِّس مادة التاريخ وهو يرتدي زيه الزيتوني وجهنا للعودة من حيث اتينا فنحن في حالة حرب بعد أن بدأت امريكا بقصف بغداد. هكذا سمعنا بخبر الحرب.
بعد أسابيع، أعلن عن عودة الدوام الرسمي، وما أن دخلنا المدرسة حتى وجدنا مديرها وهو يحمل فرشةً وطلاء يقترب لونه من البرتقالي ليمحو صورة كبيرة لصدام حسين كانت تطالعنا من جدار كبير في واجهة المدرسة. وبقي هذا المدير وهو بدرجة حزبية “مرموقة” في منصبه لوقت طويل.
الصورة الثانية كانت لمقر الفرقة الحزبية في المنطقة والتي كانت تقع على طريقنا اليومي الى المدرسة، فقد تحوّلت وبوقت قياسي الى مركز “اسلامي” خيري. تورّط القائمون عليه لاحقاً بإشاعة الخطاب المتطرف.
يوم سقوط/انهيار نظام حسين كان عمر الدولة العراقية قد أنهى الثمانية عقود، وبعد كل هذا التاريخ المزدحم سياسياً وثقافياً واجتماعياً، يجد العراقي نفسه أمام لحظة معبأة بتناقض كبير غير منطقي، فهو يرفض الاحتلال بدباباته وهي تفتح الباب أمام مزيد من الخراب، وبين نظام دكتاتوري رهيب يحسب الانفاس على مواطنيه ويتفحصها خشيةً.
الطريقة التي انتهى بها الدكتاتور ونظامه طريقة تثير الشؤم، فهي تعكس عجزاً للداخل العراقي في إحداث التغيير، أو قد تدفع بهذا الاتجاه، وخاطئ من يتبنى أو يقف مع رؤية الخارج مهما كانت وردية ومهما كان ذلك الخارج.