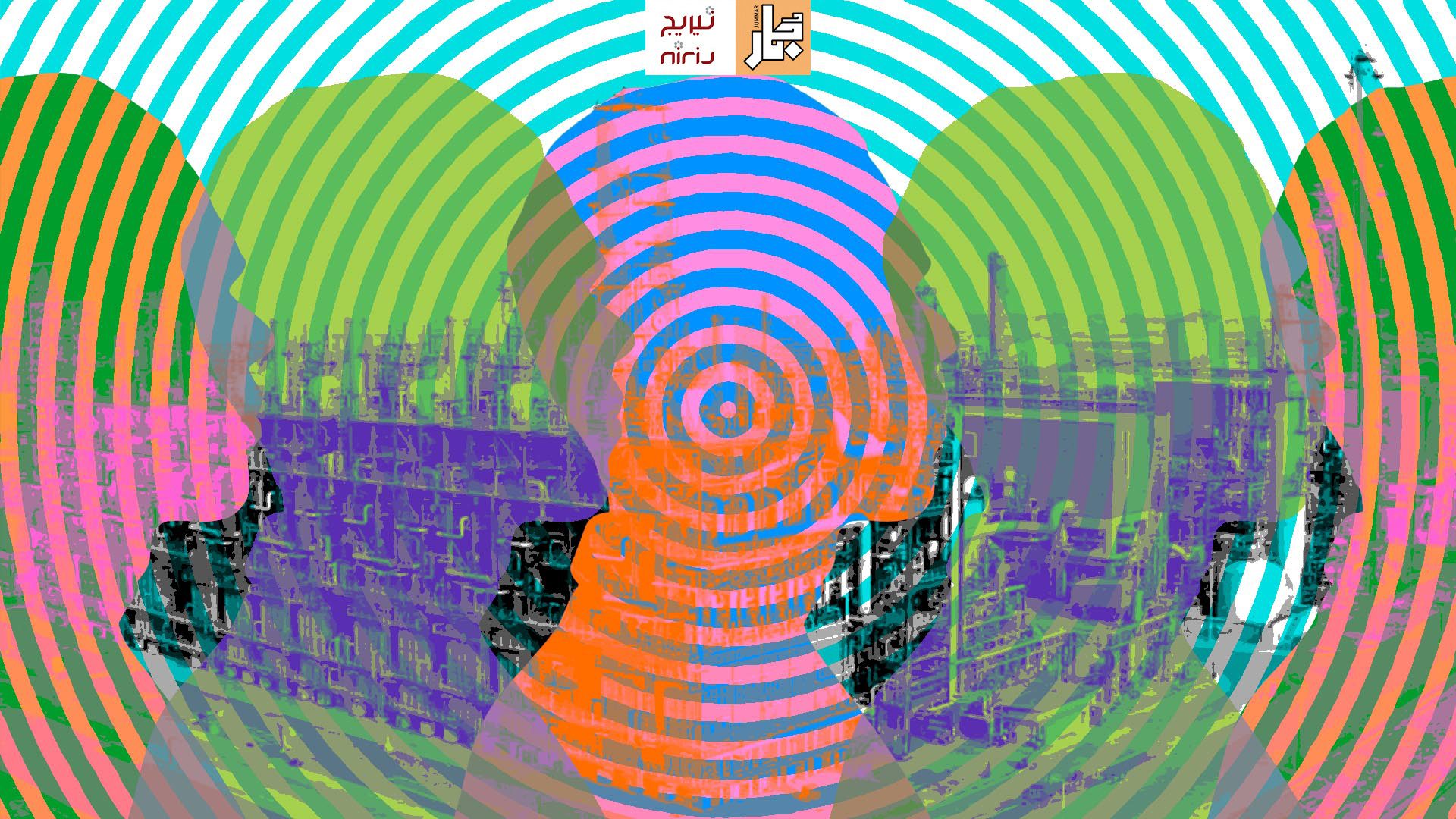ما بعد عام 2003: احتجاج متواصل وفشل الدولة
22 آذار 2023
لم تعقب عملية تدمير الدولة العراقيّة، بدءاً بالعقوبات المفروضة على النظام عام ١٩٩٠ وانتهاءً بغزو العراق عام ٢٠٠٣، عمليّة بناء دولة متماسكة، وما سُمّي بالعراق الجديد هو عبارة عن أجزاء ملصقة ببعضها من مخلّفات النظام السابق. عن الاحتجاج المتواصل وفشل الدولة العراقية..
شهد العراق في تشرين الأوّل ٢٠١٩ ما قد يُعدّ الاحتجاج الشعبي الأكبر في تاريخه الحديث. أثار حدثان جانبيان، إلى حدٍ ما، -هما حادثة قمع لاحتجاج خريجي جامعات وتجريد جنرال ذي شعبيّة من رتبته- استياءً طويل المدى من النظام السياسي الذي كان يولّد -بصورة دوريّة- الاحتجاجات الجماهيرية، ولو أنّها لم تقترب من حجم احتجاجات ٢٠١٩.
خرج عشرات آلاف العراقيّات والعراقيّين إلى الشارع في العاصمة وفي مختلف محافظات الجنوب. احتل المتظاهرون الساحات العامّة لمدّة ستّة أشهر، وفي بعض الأحيان استمرّ الأمر لمدّة أطول. احتُفي في العراق وخارجه بما عُرف لاحقاً بـ”احتجاجات تشرين”، نظراً لتماسكها والتزامها بالأساليب السلميّة واعتمادها الوطنيّة المدنيّة ورفضها للنظام السياسي والسياسات العرقيّة الطائفيّة. كما نُعيت الاحتجاجات، ليس فقط لفشلها في تبديل أسس النظام السياسي، إنما كذلك حزناً على فقدان أرواح ٦٠٠ إلى٨٠٠ عراقية وعراقي، عندما شنّت الحكومة حملة قمع ضدهم وتحديداً ما بين تشرين الأوّل ٢٠١٩ وكانون الثاني ٢٠٢٠.
شاعت ثقافة الاحتجاج في العراق منذ عام ٢٠١٩، وخاصّةً في بغداد وفي بقية المحافظات ذات الأغلبيّة الشيعيّة، والتي كانت بؤرة احتجاجات تشرين. تُنظّم التظاهرات بصورة منتظمة لأسباب عدة؛ تسعى بعضها للإبقاء على روح عام ٢٠١٩ فيما يُنظّم غيرها للمطالبة بوظائف حكوميّة. بعضها يكون رداً على قضايا سياسيّة أو اقتصاديّة معيّنة، مثل انخفاض قيمة الدينار أو العنف الجندري أو اعتقال النشطاء السياسيين أو حرق القرآن في السويد، على سبيل المثال لا الحصر. بينما تُنظَّم احتجاجات أخرى بصفتها استعراض قوى تنظّمه أطراف من النخبة السياسيّة. وقد شاعت هذه الأخيرة منذ عام ٢٠١٩، وذلك مع اعتماد الطبقة السياسيّة ثقافة الاحتجاج كاستراتيجيّة للحفاظ على النظام، وللحدّ من وقع نشاط الاحتجاجات الشعبية، وبصفتها تكتيكاً للتنافس في ما بين النخب.
يعكس حجم احتجاجات ٢٠١٩ الفشل في بناء دولة -تكون ناجعة وتمثيليّة- من حطام عام ٢٠٠٣، لكنه يعكس أيضاً قدرة النظام السياسي على الصمود أمام التحديات والأزمات وأمام ما بدا في حينه زخماً شعبياً لا يمكن إيقافه.
احتجاجات تشرين
أصبحت الاحتجاجات الشعبيّة في العراق منذ عام ٢٠١١، وبالأخصّ منذ عام ٢٠١٥، حدثاً شبه سنويّ، وأسبابها باتت معروفة لمن يتابعها؛ مدفوعة بالغضب من النهب الذي تقوم به الطبقات السياسيّة وتابعوها، والغضب من الحرمان من الحقوق السياسيّة، والغضب من انحناء الدولة العراقيّة للمصالح الأجنبيّة، والغضب من فشل الخدمات الحكوميّة ومؤسسات الدولة، والغضب من كون الشعب يعاني من فقرٍ يبدو بأنه لا مفرّ منه في دولة غنيّة على الورق فقط.
بدءاً من عام ٢٠١٥ أصبحت المظالم هذه هي الأساس المحوري للاحتجاج، فاستبدل بذلك التحشيد القائم على أساس الهويّة أو المظلوميات الطائفيّة.١ باستثناء عام ٢٠١١، غالباً ما كانت الاحتجاجات قبل عام ٢٠١٥ متمحورة حول سياسات الهويّة، كما كان حال التحشيد الجماهيري في المحافظات ذات الأغلبيّة السنّية في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.
اندلعت أهمّ الاحتجاجات منذ عام ٢٠١٥ في الأجزاء ذات الأغلبيّة الشيعيّة في العراق. وقد عاشت أجزاء أخرى من العراق دورات احتجاج مختلفة. تمحورت الاحتجاجات في كردستان العراق حول فشل حكومة إقليم كردستان وقوبلت الاحتجاجات هناك بقمع شديد من قوّات أمن الإقليم.٢ ونظّمت احتجاجات متفرّقة في المناطق السنّيّة، بما في ذلك بضع تظاهرات رمزيّة متضامنةً مع تشرين ٢٠١٩.٣ لكنها انتهت بمزيج من التخويف والإرهاق، وكذلك بنظرة البعض إلى احتجاجات تشرين بصفتها مسألة شيعيّة، بحيث تم حصر احتجاجات ٢٠١٩ في مناطق الأغلبيّة الشيعيّة في العراق، ما منع الطبقات السياسية الشيعيّة -وهي الجهة الفاعلة المهيمنة في السياسة العراقيّة- من اللعب على الورقة الطائفيّة لتدعيم نظامها السياسيّ؛ وهو تكتيك تستخدمه الأنظمة في جميع أنحاء المنطقة عند مواجهتها للاحتجاجات القابلة لتصنيف الآخر على أساس طائفي، كما استُخدم في العراق في احتجاجات عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، وكذلك في ردود الأنظمة على انتفاضات عام ٢٠١١ في سوريا والبحرين والسعوديّة.
وكونها قد كانت نتاجا تراكميا للنشاط الاحتجاجي منذ عام ٢٠١٥ (أو حتّى منذ عام ٢٠١١)، فإن ما ظهر عام ٢٠١٩ من احتجاجات كان غير مسبوق، حجماً ومدىً. وبالإضافة إلى حجمها واستمراريّتها، تجاوزت احتجاجات تشرين الخطوط الأيديولوجيّة وتعدّت حدود الطبقة والجيل والمهنة والجندر. وعلى الرغم من كون معظم المحتجّين شباناً شيعة من الطبقة العاملة، ما يعكس ديموغرافيّة المناطق المشارِكة، لم يمنع ذلك المجموعات النسائيّة والنشطاء من الطلّاب والطالبات وغير الشيعة وفئات جيليّة متنوّعة من التظاهر إلى جانبهم. من هنا فقد صادف أن كانت الاحتجاجات ذات غالبيّة شيعيّة، لكنّها لم تكن احتجاجات ذات طابع طائفي شيعي. وبالفعل، جسّدت الاحتجاجات رفضاً صريحاً للنظام ككلّ وتحديداً للسياسات الإثنوـطائفيّة والتدخّل الأجنبي. وكانت النتيجة تجسيداً متميزاً، وجميلاً أحياناً، للمبادئ التي رفعتها الاحتجاجات السابقة والتي صُقلت في تشرين.


كما حقّقت احتجاجات ٢٠١٩ بعض الانتصارات، إذ أُجبرت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة وصيِغ مشروع قانون انتخابي جديد. وساعد القانون، وتحديداً في توسيعه للدوائر الانتخابيّة، على تقليص الحصص الانتخابية لكثير من الجهات السياسيّة الفاعلة، وخاصةً الجناح المحسوب على إيران في الطبقة السياسيّة الشيعيّة. كما وفّر القانون الجديد بعض الفرص المتواضعة في انتخابات تشرين الأوّل ٢٠٢١ لمن ترشّح لأوّل مرّة فيها، بما في ذلك بعض المرشّحين والمرشّحات الوافدين من حراك تشرين نفسه.
الاحتجاجات ما بعد تشرين – ما بين الاستذكار وتبني الطبقة السياسية لثقافة الاحتجاج
من النجاحات الأخرى لتشرين كان خلق ثقافة احتجاج جديدة. لكنّ اتساع رقعة الاحتجاجات قلّصت من تأثيرها، فزرعت الشكوك في الرأي العام حول أيٍّ من التظاهرات تكون صادقة وحقيقية وأيّها تكون من تخطيط النخبة السياسيّة لتصبّ في مصلحتها أو لاستعراض قوّتها. على سبيل المثال، اندلعت احتجاجات في الناصريّة جنوبي العراق ضدّ سجن ناشط وانتهت بحالتي موت. في أعقابها انتشرت الاتهامات بسرعة عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام العراقيّة بأنّ الاحتجاجات كانت تمثيليّة لكسب مصالح شخصيّة. وزُعِم تحديداً بأنّ الناس غير المرتبطين باحتجاجات تشرين، هم من نزلوا إلى الشوارع متظاهرين بأنّهم مجموعات تشرينيّة كانت قد تأذّت عام ٢٠١٩، وذلك من أجل المطالبة بالتعويضات. وزعم آخرون بأنّ الفصائل السياسيّة كانت قد دفعت أموالاً لمحرّضين لتصعيد حالة الشغب أثناء المظاهرات.
وما يزيد تعقيد الرأي العام العراقي بخصوص النشاط الاحتجاجي هو ادّعاء الكثيرين الآن بأنّهم يتحدّثون باسم تشرين. ويزداد تركيب المشكلة مع تبني الطبقات السياسية ثقافة الاحتجاج بين الحين والآخر. فتحشد عناصر من النخبة السياسية الداعمين أو تستأجر بكلّ بساطة مجاميع لضعضعة مكانة خصومها ولاستعراض قوّتها. وقد وظّفت الفصائل السياسيّة هذه الممارسة منذ عام ٢٠١٩، في حين كان “خيار الشارع” قبل ذلك تكتيكاً صدرياً بالدرجة الأولى نظراً للقاعدة الشعبية المنتظمة لتياره.
على سبيل المثال، ومنذ عام ٢٠١٩، تكررّ تنظيم الجهات السياسيّة الفاعلة الحليفة لإيران تظاهرات خاصّة بها. وقد فعلت ذلك في عام ٢٠٢٠ في أعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي». وعندما تظاهروا مرّة أخرى عام ٢٠٢١ لتحدّي نتائج الانتخابات التي لم تصبّ في مصلحتهم، استخدم المحتجّون خطاباً مشابهاً لخطاب تشرين: استعادة الحقوق المسلوبة وتكريم المتظاهرين المستشهَدين وشجب النظام السياسي. وبصورة مشابهة استُعرضت رموز تشرينيّة في صيف ٢٠٢٢ في الاحتجاجات الصدريّة ضدّ منافسيهم في الطبقة السياسية الشيعية، فيما تخاصمت الجهتان على عمليّة تشكيل الحكومة. ورُفعت صور صفاء السّراي، وهو ناشط شاب تحوّلت صورته إلى أيقونة تشرينيّة بعدما قتلته القوّات الأمنيّة في تشرين الأوّل ٢٠١٩.

لقد أثبت عدم الوضوح في التمييّز ما بين الاحتجاجات الشعبيّة والاحتجاجات التي تسيّرها النخب نجاعته بالنسبة للجهات السياسية الفاعلة، التي تطمح إلى اختراق الحركات الاحتجاجيّة وزرع الشكوك بخصوص مصداقيّتها. وقد لوحظ استخدام هذا التكتيك منذ بدايات احتجاج تشرين. ووفق تعبير أحد النشطاء، سرعان ما اتسمت احتجاجات تشرين بثلاثة أنواع من المحتجّين والمحتجّات: فكان في نظره المحتجّون التشرينيّون “الحقيقيّون”، أي من لم يُدفع لهم مقابل الاحتجاج وليست لديهم دوافع خفيّة، وهناك الواجهات السياسيّة التي أسستها الأحزاب الحاكمة والتي زُرعت في مواقع الاحتجاجات لمراقبة مجرى الأحداث وتشويشه، وهناك المنتفعون – أي المتظاهرين الذين عرضوا خدماتهم للمُزايد الأكبر. يقلّص هذا التزايد لأنواع المتظاهرين من نجاعة الاحتجاج بصفته وسيلة لإحداث تغيير جدّي.
لقد أصبح محتجّو ومحتجّات تشرين من منطلقات عدة، ضحايا شهرتهم الخاصّة. وكثيراً ما كانت الأهمّيّة الرمزيّة الهائلة التي تولّدت عام ٢٠١٩ ذات نتيجة عكسيّة، وذلك مع تحوّل النشاط الاحتجاجي أحياناً إلى إحياء ذكرى تشرين على حساب تطوير العمل السياسي –وهي ميزة توضّحت بصورة خاصّة في مناسبة ذكرى تشرين وفي ترسيخ كثير من الخطاب المعارِض في أحداث تشرين الأوّل ٢٠١٩. إنّ استذكار أحداث مثل احتجاجات تشرين شيء طبيعي، خاصةً مع سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء. لكن في الوقت نفسه، فإنّ التركيز المفرط على إحياء ذكرى أمر ما قد يترتّب على تجميد حراك ضمن لحظة مقدسة، فتمنع تقدّم الزخم.
بكلمات أخرى، هل يشكّل تخليد ذكرى حدث في حدّ ذاته تحدّياً للنظام؟ سيبقى احياء ذكرى الأحداث فعلاً ذا أهمّيّة رمزيّة وعاطفيّة، لكن يفتقر إلى الإمكانات السياسيّة ما لم يُلهم مزيداً من النشاط، مثل مجموعة احتجاجات جديدة أو أشكال جديدة من التنظيم وما إلى ذلك.
إن التاريخ العراقي حافل بالأحداث المفصلية والمؤلمة وذات الأهمية العاطفية. واستذكار تشرين بحد ذاته يضمن ضم الاحتجاجات إلى لائحة المآسي التي بالكاد تُذكر، إلى جانب مذبحة العامرية وانتفاضة عام ١٩٩١ ومعارك الفلوجة والمجازر التي اكتسحت بغداد عام ٢٠٠٦، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
المطعم التركي
يستدعي التركيز المفرط على تخليد الذكرى كذلك نقاشاً بخصوص من يملك ذكرى حدث ما ويشجّع على اعتماد رموزه للمصلحة السياسيّة. وينتصب في ساحة التحرير، حيث تركّزت أحداث تشرين، أحد مباني بغداد الشاهقة القليلة، وهو مبنى ذو ١٤ طابقا، معروف لدى أهل بغداد بالمطعم التركي (لأنّه احتوى مرّة مطعماً تركيّاً). وفي بداية احتجاجات تشرين في تشرين الأوّل ٢٠١٩ استخدمت الرقابة الحكوميّة والقنّاصة (غالباً من المجموعات شبه العسكريّة التابعة للدولة) المطعم التركي لقمع المحتجّين. وعُلّق نشاط الاحتجاج في منتصف تشرين الأوّل بسبب زيارة الأربعين. وعندما استُؤنفت الاحتجاجات في أواخر تشرين الأوّل، سارعت الجماهير المحتجّة إلى احتلال المطعم التركي لمنع الحكومة من استخدام المبنى بشكل استراتيجي ضد المحتجين. وبهذا حوّل المحتجّون والمحتجّات المطعم التركي إلى أيقونة ترمز إلى احتجاجات تشرين. واكتسته لافتات الاحتجاج والأعمال الفنّيّة المعبّرة عن مبادئ الحركة الاحتجاجيّة، فحوّلته إلى أكبر لوحات الإعلان المرئيّة للتعبير عن روح الاحتجاج.
المطعم التركي أثناء احتجاجات تشرين، وصورة لحمّالة مفاتيح على شكل المطعم التركي، تصوير كاتب المقال.




مازالت بعض الأعمال الفنية التي قام بها المحتجون والمحتجّات تكسو المبنى إلى اليوم، لكنّه عاد إلى حدّ بعيد ليكون جزءاً عادياً من أفق بغداد الباهت. ويمتلئ المبنى حالياً بقوّات الأمن الحكوميّة وعناصر صدريّة، لمنعه من العودة إلى موقع للاحتجاج في المستقبل. كما أنّه أصبح جزءاً من المشهد الرمزي العمراني البغدادي المتنازع عليه. وسعت النخب السياسيّة إلى توظيف الأهمية الرمزيّة التي اكتسبها المبنى عام ٢٠١٩ في تخاصمها مع بعضها البعض ولتأكيد سلطتها الخاصّة. مثلًا، في تشرين الثاني ٢٠٢٠، وبعد فترة قصيرة من التخلّص من الجماهير المحتجة في ساحة التحرير، حشّد مقتدى الصدر أتباعه للتأكيد على السيادة الصدريّة في ساحات الاحتجاج، والتي كانت محسوبة على حراك تشرين في السابق. والحال، وبالتوافق مع الشعارات السابقة التي خلقتها اعتصامات تشرين، غطى الصدريّون المطعم التركي بشعارات تعرض أيقونات خاصّة بالحركة وزعيمها. عبر المساعدة في طرد المحتجّات والمحتجّين وعبر الاستحواذ على المطعم التركي بهذه الطريقة، لمّح الصدريون إلى قوّة الشارع التي يتمتّعون بها وحاولوا ادّعاء ملكيّة التحشيد الجماهيري.



وفي مثال آخر على تبني جهات فاعلة سياسية أساليب احتجاجات تشرين، بما في ذلك خصوم حراك تشرين، استخدمت «قوّات الحشد الشعبي» المطعم التركي لإحياء ذكرى مرور عام على اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في كانون الثاني ٢٠٢١. فتغطّت طوابق المبنى الـ١٤، على نفس منوال احتجاج تشرين، لكنها كانت هذه المرة بصور المهندس وسليماني وشخصيّات أخرى مغتالة إلى جانب عدد من الأعلام العراقيّة.
وسعى مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي السابق، هو الآخر إلى توظيف القيمة الرمزية للمطعم التركي ولحراك تشرين نفسه. في منتصف عام ٢٠٢١، زُيّنت الواجهة دائمة التغيّر بلائحة إعلان تعلن عن التغيير المقبل للمبنى وتحويله إلى «متحف تشرين»، وذلك “بدعم ورعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”. كانت تلك رسالة تضامن وتعاطف مع حراك تشرين، في محاولة لحكومة الكاظمي لإضفاء شرعيّة على نفسها اعتماداً على الفكرة، التي باتت فاقدة لمصداقيّتها الآن، بأنها -أي حكومة الكاظمي- هي ذاتها نتاج احتجاجات عام ٢٠١٩. لكنّ الإعلان عن «متحف تشرين» لاقى معارضة ضمن نشطاء الاحتجاج وأتباعهم. واحتجّ «البيت الوطني» وهو أحد المنظّمات المنسوبة إلى حراك تشرين، بأنّ “مطالب الانتفاضة السياسية ومطالب الشعب لم تتحقّق وأنّه من المبكّر جداً الحديث عن تأسيس متحف لتخليد ذكرى حراك تشرين وذلك لأنّ حراك تشرين لم ينتهِ”.٤



ولم يرَ المتحف النور وأزيل الشعار في نهاية المطاف. وكان السبب الرسمي المعلن بخصوص الاستغناء عن المشروع، بكون المبنى حالياً محور إجراءات قانونيّة جارية بين أمانة بغداد ومستثمري القطاع الخاصّ وأنّه لا يمكن إنجاز أيّ شيء قبل حسم المسألة.٥ ويوضح تبنيه والمعارضة الناتجة عن ذلك التعقيدات المتأصّلة في سياسات الاستذكار.
حالة من الاحتجاج المتواصل
ومع كلّ ما كان مثيراً للإعجاب والتقدير في ما يخصّ احتجاجات عام ٢٠١٩، كانت ثمّة نزعة عند الداعمين لإضفاء الرومانسيّة والمثاليّة على الاحتجاجات. لكنّ الحقيقة هي أنّ احتجاجات ٢٠١٩ فشلت في تغيير أسس النظام السياسي العراقي. وبالفعل، فإنّ هذه الأسس هي ما سمح للنظام بالصمود في وجه عاصفة ٢٠١٩. يكمن فهم تراجع حراك تشرين إذاً في فهم طبيعة الدولة العراقيّة.
لم تلحق تدمير الدولة العراقيّة، بدءاً بالعقوبات المفروضة على النظام عام ١٩٩٠ وانتهاءً بغزو العراق عام ٢٠٠٣، عمليّة بناء دولة متماسكة. بل ما سُمّي بالعراق الجديد هو عبارة عن أجزاء ملصقة ببعضها من مخلّفات النظام السابق. زرعت نخبة سياسيّة جديدة ومختلف المقاولين السياسيين ومجموعات النهب الاقتصادي، بالإضافة إلى المصالح الأجنبيّة في حطام بنى دولة البعث. وما ظهر على السطح كان كياناً هجيناً مليئاً بالتناقضات وتحكمه أوليغارشيّة من الجهات الفاعلة الرسميّة وغير الرسميّة والتي تشكّل الدولة كلّها معاً. ويواري وجه الدولة الڤيبرية -الوزارات ومؤسسات الدولة وما إلى ذلك- حقيقة الاختراق السياسي واستيلاء سماسرة السلطة الكبار على مؤسسات الدولة العراقيّة. وعلاقات القوّة والمصالح المتضمّنة التي تدعّم النظام تجعل الأخير غير قادر على إصلاح نفسه. وكان أن اصطدمت احتجاجات ٢٠١٩ بهذا الواقع نفسه، فقد خضعت أدوات إصلاح النظام المزعومة -أي جهاز القضاء ومؤسساته وبيروقراطيته وما الى ذلك- كلّها إلى هذا المنطق نفسه، وإلى علاقات القوّة التي استهدفها المحتجّون والمحتجّات نفسها.
ما تبين من أحداث ٢٠١٩ هو أنه في وجه التحشيد الجماهيري تتحول نقاط ضعف النظام السياسي إلى مصدر قوّة له. يعني اقتصاد الدولة الريعي باعتماده على النفط، اعتماد كتلة كبيرة من العراقيّين على النظام ولذلك تنزع إلى تحمّله وتقبّله. ويسلّط توزّع السلطة على شبكات زبائنية متنوّعة تلك التبعيّة وتجعل التغيير الثوري حتّى أكثر صعوبة، إذ لا يوجد حزب أساسيّ للإطاحة به ولا ملك لخلعه عن عرشه ولا تمثال للقائد العزيز لإسقاطه. وعلاوةً على ذلك فإنّ التواطؤ النخبوي الذي يدعّم توزّع السلطة، يعمل أيضاً، بطبيعة الحال، في خدمة النظام. فلا توجد معارضة برلمانيّة رسميّة تفوق رغبة الطبقات السياسيّة في صيانة الإمبراطوريّات التي بنتها بمصادر الدولة وعبر مؤسسات الدولة -الحاجة إلى حفظ الذات- قوّة نزاعاتها الداخليّة المستمرّة.
ويتعدى الأمر الشبكات النخبويّة، إذ حوّلت عيوب النظام الانتخابي العراقي صندوق الاقتراع إلى أداة غير مجدية في سبيل التغيير الشامل.٦ يعمل ضعف المؤسسات العراقيّة وسيادة العراق المحطّمة وضعف سيادة القانون كذلك لمصلحة النظام، بحيث تسهّل هذه الأمور استخدام العنف الخارج عن القانون والدعم الخارجي. وبالفعل يُعتقد أنّ عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، قد ساعدت في إخماد انتفاضة ٢٠١٩. وهكذا وعبر غيرها من الطرق يخلق النظام العراقي القوّة من خلال الضعف عند مواجهته لتفجّر الغضب والاحتجاج الشعبي.
وكما توقّع الكثيرون في ٢٠١٩، كان من المرجح صمود النظام وعودة الاحتجاج. وأصبح الاحتجاج اليوم معلماً ثابتاً في المشهد السياسي، لكنّه لم يَعُدْ أحاديّ الاتجاه. فالاحتجاجات تُنظَّم من قبل النخب السياسية ومعارضيها، وتُنظّم ضدّ النظام وضدّ الحكومة الحاليّة ومن أجل الحصول على الوظائف الحكوميّة. ويبقى السؤال المطروح عن طول مدّة بقاء الأمور على هذه الحال مفتوحاً. لقد أصبح التصريح بعدم استدامة السياقات غير العادلة أمراً شائعاً، لكنّ نظام ما بعد ٢٠٠٣ أثبت صموده مراراً وتكراراً. لا يمكننا افتراض اقتراب حدوث تغيير جذري قبل استنفاد مصادر صمود النظام أو أقلّه إضعافها. لقد عانت فينزويلا ولبنان أسوأ بكثير بدون الاستسلام لتغيير النظام، ومازال الطريق طويلاً أمام العراق قبل الوصول إلى حالة شبيهة لأيّ من الدولتين. تديم موارد العراق الضخمة والدعم الدولي الذي يتمتع به أسس الاقتصاد السياسي العراقي، حتّى وِإن أُنجز إجراء تغييرات عرضيّة أو تحسينات معيّنة في مجالات معيّنة، كما حصل في مجال الأمن العراقي والعلاقات الدوليّة في العقد الماضي.
يشكّل احتمال الاحتجاجات المتواصلة، سواء كانت مدفوعة من النخبة أم الشعبيّة، إلى جانب إخفاقات الدولة المستمرّة إدانة أكيدة لمشروع بناء الدولة ما بعد ٢٠٠٣. يذكر ذلك بملخص لوزير الاقتصاد السابق علي علّاوي للدولة العراقيّة في رسالة استقالته المطوّلة عام ٢٠٢٢. يصف فيها دولة موجودة شكلاً لكن لا فحوى لها. دولة قادرة على إعادة خلق نفسها على الرغم من تناقضاتها الكثيرة. والمفارقة هي أن هذه التناقضات ذاتها، والتي تدعّم تهجين وانعدام شفافيّة وخلل النظام، تمنحه مصادر صمودَه:
“كل دعوات الإصلاح جرت إعاقتها بسبب الإطار السياسي لهذا البلد (..) ولقد سمح بالاستيلاء على الدولة من قبل مجموعات المصالح الضيقة (..) وعلى عكس البشر، لا تموت الدول بشكل نهائي، ويمكن أن تبقى دولة (الزومبي) لسنوات بل حتّى لعقود قبل أن يتم دفنهم، أعتقد أن الدولة العراقية التي ولدت بعد غزو ٢٠٠٣ تظهر عليها علامات مرض عضال. وصحيح أن آلية الحكومة مستمرة، وتبقى مظاهر سلطة الدولة قائمة، لكن لا يوجد جوهر للشكل”.
ترجم “جمار” المادة من الإنجليزية إلى العربية، وتنشر بالشراكة مع مجلة “ميريب“
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
شهد العراق في تشرين الأوّل ٢٠١٩ ما قد يُعدّ الاحتجاج الشعبي الأكبر في تاريخه الحديث. أثار حدثان جانبيان، إلى حدٍ ما، -هما حادثة قمع لاحتجاج خريجي جامعات وتجريد جنرال ذي شعبيّة من رتبته- استياءً طويل المدى من النظام السياسي الذي كان يولّد -بصورة دوريّة- الاحتجاجات الجماهيرية، ولو أنّها لم تقترب من حجم احتجاجات ٢٠١٩.
خرج عشرات آلاف العراقيّات والعراقيّين إلى الشارع في العاصمة وفي مختلف محافظات الجنوب. احتل المتظاهرون الساحات العامّة لمدّة ستّة أشهر، وفي بعض الأحيان استمرّ الأمر لمدّة أطول. احتُفي في العراق وخارجه بما عُرف لاحقاً بـ”احتجاجات تشرين”، نظراً لتماسكها والتزامها بالأساليب السلميّة واعتمادها الوطنيّة المدنيّة ورفضها للنظام السياسي والسياسات العرقيّة الطائفيّة. كما نُعيت الاحتجاجات، ليس فقط لفشلها في تبديل أسس النظام السياسي، إنما كذلك حزناً على فقدان أرواح ٦٠٠ إلى٨٠٠ عراقية وعراقي، عندما شنّت الحكومة حملة قمع ضدهم وتحديداً ما بين تشرين الأوّل ٢٠١٩ وكانون الثاني ٢٠٢٠.
شاعت ثقافة الاحتجاج في العراق منذ عام ٢٠١٩، وخاصّةً في بغداد وفي بقية المحافظات ذات الأغلبيّة الشيعيّة، والتي كانت بؤرة احتجاجات تشرين. تُنظّم التظاهرات بصورة منتظمة لأسباب عدة؛ تسعى بعضها للإبقاء على روح عام ٢٠١٩ فيما يُنظّم غيرها للمطالبة بوظائف حكوميّة. بعضها يكون رداً على قضايا سياسيّة أو اقتصاديّة معيّنة، مثل انخفاض قيمة الدينار أو العنف الجندري أو اعتقال النشطاء السياسيين أو حرق القرآن في السويد، على سبيل المثال لا الحصر. بينما تُنظَّم احتجاجات أخرى بصفتها استعراض قوى تنظّمه أطراف من النخبة السياسيّة. وقد شاعت هذه الأخيرة منذ عام ٢٠١٩، وذلك مع اعتماد الطبقة السياسيّة ثقافة الاحتجاج كاستراتيجيّة للحفاظ على النظام، وللحدّ من وقع نشاط الاحتجاجات الشعبية، وبصفتها تكتيكاً للتنافس في ما بين النخب.
يعكس حجم احتجاجات ٢٠١٩ الفشل في بناء دولة -تكون ناجعة وتمثيليّة- من حطام عام ٢٠٠٣، لكنه يعكس أيضاً قدرة النظام السياسي على الصمود أمام التحديات والأزمات وأمام ما بدا في حينه زخماً شعبياً لا يمكن إيقافه.
احتجاجات تشرين
أصبحت الاحتجاجات الشعبيّة في العراق منذ عام ٢٠١١، وبالأخصّ منذ عام ٢٠١٥، حدثاً شبه سنويّ، وأسبابها باتت معروفة لمن يتابعها؛ مدفوعة بالغضب من النهب الذي تقوم به الطبقات السياسيّة وتابعوها، والغضب من الحرمان من الحقوق السياسيّة، والغضب من انحناء الدولة العراقيّة للمصالح الأجنبيّة، والغضب من فشل الخدمات الحكوميّة ومؤسسات الدولة، والغضب من كون الشعب يعاني من فقرٍ يبدو بأنه لا مفرّ منه في دولة غنيّة على الورق فقط.
بدءاً من عام ٢٠١٥ أصبحت المظالم هذه هي الأساس المحوري للاحتجاج، فاستبدل بذلك التحشيد القائم على أساس الهويّة أو المظلوميات الطائفيّة.١ باستثناء عام ٢٠١١، غالباً ما كانت الاحتجاجات قبل عام ٢٠١٥ متمحورة حول سياسات الهويّة، كما كان حال التحشيد الجماهيري في المحافظات ذات الأغلبيّة السنّية في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.
اندلعت أهمّ الاحتجاجات منذ عام ٢٠١٥ في الأجزاء ذات الأغلبيّة الشيعيّة في العراق. وقد عاشت أجزاء أخرى من العراق دورات احتجاج مختلفة. تمحورت الاحتجاجات في كردستان العراق حول فشل حكومة إقليم كردستان وقوبلت الاحتجاجات هناك بقمع شديد من قوّات أمن الإقليم.٢ ونظّمت احتجاجات متفرّقة في المناطق السنّيّة، بما في ذلك بضع تظاهرات رمزيّة متضامنةً مع تشرين ٢٠١٩.٣ لكنها انتهت بمزيج من التخويف والإرهاق، وكذلك بنظرة البعض إلى احتجاجات تشرين بصفتها مسألة شيعيّة، بحيث تم حصر احتجاجات ٢٠١٩ في مناطق الأغلبيّة الشيعيّة في العراق، ما منع الطبقات السياسية الشيعيّة -وهي الجهة الفاعلة المهيمنة في السياسة العراقيّة- من اللعب على الورقة الطائفيّة لتدعيم نظامها السياسيّ؛ وهو تكتيك تستخدمه الأنظمة في جميع أنحاء المنطقة عند مواجهتها للاحتجاجات القابلة لتصنيف الآخر على أساس طائفي، كما استُخدم في العراق في احتجاجات عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، وكذلك في ردود الأنظمة على انتفاضات عام ٢٠١١ في سوريا والبحرين والسعوديّة.
وكونها قد كانت نتاجا تراكميا للنشاط الاحتجاجي منذ عام ٢٠١٥ (أو حتّى منذ عام ٢٠١١)، فإن ما ظهر عام ٢٠١٩ من احتجاجات كان غير مسبوق، حجماً ومدىً. وبالإضافة إلى حجمها واستمراريّتها، تجاوزت احتجاجات تشرين الخطوط الأيديولوجيّة وتعدّت حدود الطبقة والجيل والمهنة والجندر. وعلى الرغم من كون معظم المحتجّين شباناً شيعة من الطبقة العاملة، ما يعكس ديموغرافيّة المناطق المشارِكة، لم يمنع ذلك المجموعات النسائيّة والنشطاء من الطلّاب والطالبات وغير الشيعة وفئات جيليّة متنوّعة من التظاهر إلى جانبهم. من هنا فقد صادف أن كانت الاحتجاجات ذات غالبيّة شيعيّة، لكنّها لم تكن احتجاجات ذات طابع طائفي شيعي. وبالفعل، جسّدت الاحتجاجات رفضاً صريحاً للنظام ككلّ وتحديداً للسياسات الإثنوـطائفيّة والتدخّل الأجنبي. وكانت النتيجة تجسيداً متميزاً، وجميلاً أحياناً، للمبادئ التي رفعتها الاحتجاجات السابقة والتي صُقلت في تشرين.



كما حقّقت احتجاجات ٢٠١٩ بعض الانتصارات، إذ أُجبرت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة وصيِغ مشروع قانون انتخابي جديد. وساعد القانون، وتحديداً في توسيعه للدوائر الانتخابيّة، على تقليص الحصص الانتخابية لكثير من الجهات السياسيّة الفاعلة، وخاصةً الجناح المحسوب على إيران في الطبقة السياسيّة الشيعيّة. كما وفّر القانون الجديد بعض الفرص المتواضعة في انتخابات تشرين الأوّل ٢٠٢١ لمن ترشّح لأوّل مرّة فيها، بما في ذلك بعض المرشّحين والمرشّحات الوافدين من حراك تشرين نفسه.
الاحتجاجات ما بعد تشرين – ما بين الاستذكار وتبني الطبقة السياسية لثقافة الاحتجاج
من النجاحات الأخرى لتشرين كان خلق ثقافة احتجاج جديدة. لكنّ اتساع رقعة الاحتجاجات قلّصت من تأثيرها، فزرعت الشكوك في الرأي العام حول أيٍّ من التظاهرات تكون صادقة وحقيقية وأيّها تكون من تخطيط النخبة السياسيّة لتصبّ في مصلحتها أو لاستعراض قوّتها. على سبيل المثال، اندلعت احتجاجات في الناصريّة جنوبي العراق ضدّ سجن ناشط وانتهت بحالتي موت. في أعقابها انتشرت الاتهامات بسرعة عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام العراقيّة بأنّ الاحتجاجات كانت تمثيليّة لكسب مصالح شخصيّة. وزُعِم تحديداً بأنّ الناس غير المرتبطين باحتجاجات تشرين، هم من نزلوا إلى الشوارع متظاهرين بأنّهم مجموعات تشرينيّة كانت قد تأذّت عام ٢٠١٩، وذلك من أجل المطالبة بالتعويضات. وزعم آخرون بأنّ الفصائل السياسيّة كانت قد دفعت أموالاً لمحرّضين لتصعيد حالة الشغب أثناء المظاهرات.
وما يزيد تعقيد الرأي العام العراقي بخصوص النشاط الاحتجاجي هو ادّعاء الكثيرين الآن بأنّهم يتحدّثون باسم تشرين. ويزداد تركيب المشكلة مع تبني الطبقات السياسية ثقافة الاحتجاج بين الحين والآخر. فتحشد عناصر من النخبة السياسية الداعمين أو تستأجر بكلّ بساطة مجاميع لضعضعة مكانة خصومها ولاستعراض قوّتها. وقد وظّفت الفصائل السياسيّة هذه الممارسة منذ عام ٢٠١٩، في حين كان “خيار الشارع” قبل ذلك تكتيكاً صدرياً بالدرجة الأولى نظراً للقاعدة الشعبية المنتظمة لتياره.
على سبيل المثال، ومنذ عام ٢٠١٩، تكررّ تنظيم الجهات السياسيّة الفاعلة الحليفة لإيران تظاهرات خاصّة بها. وقد فعلت ذلك في عام ٢٠٢٠ في أعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي». وعندما تظاهروا مرّة أخرى عام ٢٠٢١ لتحدّي نتائج الانتخابات التي لم تصبّ في مصلحتهم، استخدم المحتجّون خطاباً مشابهاً لخطاب تشرين: استعادة الحقوق المسلوبة وتكريم المتظاهرين المستشهَدين وشجب النظام السياسي. وبصورة مشابهة استُعرضت رموز تشرينيّة في صيف ٢٠٢٢ في الاحتجاجات الصدريّة ضدّ منافسيهم في الطبقة السياسية الشيعية، فيما تخاصمت الجهتان على عمليّة تشكيل الحكومة. ورُفعت صور صفاء السّراي، وهو ناشط شاب تحوّلت صورته إلى أيقونة تشرينيّة بعدما قتلته القوّات الأمنيّة في تشرين الأوّل ٢٠١٩.


لقد أثبت عدم الوضوح في التمييّز ما بين الاحتجاجات الشعبيّة والاحتجاجات التي تسيّرها النخب نجاعته بالنسبة للجهات السياسية الفاعلة، التي تطمح إلى اختراق الحركات الاحتجاجيّة وزرع الشكوك بخصوص مصداقيّتها. وقد لوحظ استخدام هذا التكتيك منذ بدايات احتجاج تشرين. ووفق تعبير أحد النشطاء، سرعان ما اتسمت احتجاجات تشرين بثلاثة أنواع من المحتجّين والمحتجّات: فكان في نظره المحتجّون التشرينيّون “الحقيقيّون”، أي من لم يُدفع لهم مقابل الاحتجاج وليست لديهم دوافع خفيّة، وهناك الواجهات السياسيّة التي أسستها الأحزاب الحاكمة والتي زُرعت في مواقع الاحتجاجات لمراقبة مجرى الأحداث وتشويشه، وهناك المنتفعون – أي المتظاهرين الذين عرضوا خدماتهم للمُزايد الأكبر. يقلّص هذا التزايد لأنواع المتظاهرين من نجاعة الاحتجاج بصفته وسيلة لإحداث تغيير جدّي.
لقد أصبح محتجّو ومحتجّات تشرين من منطلقات عدة، ضحايا شهرتهم الخاصّة. وكثيراً ما كانت الأهمّيّة الرمزيّة الهائلة التي تولّدت عام ٢٠١٩ ذات نتيجة عكسيّة، وذلك مع تحوّل النشاط الاحتجاجي أحياناً إلى إحياء ذكرى تشرين على حساب تطوير العمل السياسي –وهي ميزة توضّحت بصورة خاصّة في مناسبة ذكرى تشرين وفي ترسيخ كثير من الخطاب المعارِض في أحداث تشرين الأوّل ٢٠١٩. إنّ استذكار أحداث مثل احتجاجات تشرين شيء طبيعي، خاصةً مع سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء. لكن في الوقت نفسه، فإنّ التركيز المفرط على إحياء ذكرى أمر ما قد يترتّب على تجميد حراك ضمن لحظة مقدسة، فتمنع تقدّم الزخم.
بكلمات أخرى، هل يشكّل تخليد ذكرى حدث في حدّ ذاته تحدّياً للنظام؟ سيبقى احياء ذكرى الأحداث فعلاً ذا أهمّيّة رمزيّة وعاطفيّة، لكن يفتقر إلى الإمكانات السياسيّة ما لم يُلهم مزيداً من النشاط، مثل مجموعة احتجاجات جديدة أو أشكال جديدة من التنظيم وما إلى ذلك.
إن التاريخ العراقي حافل بالأحداث المفصلية والمؤلمة وذات الأهمية العاطفية. واستذكار تشرين بحد ذاته يضمن ضم الاحتجاجات إلى لائحة المآسي التي بالكاد تُذكر، إلى جانب مذبحة العامرية وانتفاضة عام ١٩٩١ ومعارك الفلوجة والمجازر التي اكتسحت بغداد عام ٢٠٠٦، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
المطعم التركي
يستدعي التركيز المفرط على تخليد الذكرى كذلك نقاشاً بخصوص من يملك ذكرى حدث ما ويشجّع على اعتماد رموزه للمصلحة السياسيّة. وينتصب في ساحة التحرير، حيث تركّزت أحداث تشرين، أحد مباني بغداد الشاهقة القليلة، وهو مبنى ذو ١٤ طابقا، معروف لدى أهل بغداد بالمطعم التركي (لأنّه احتوى مرّة مطعماً تركيّاً). وفي بداية احتجاجات تشرين في تشرين الأوّل ٢٠١٩ استخدمت الرقابة الحكوميّة والقنّاصة (غالباً من المجموعات شبه العسكريّة التابعة للدولة) المطعم التركي لقمع المحتجّين. وعُلّق نشاط الاحتجاج في منتصف تشرين الأوّل بسبب زيارة الأربعين. وعندما استُؤنفت الاحتجاجات في أواخر تشرين الأوّل، سارعت الجماهير المحتجّة إلى احتلال المطعم التركي لمنع الحكومة من استخدام المبنى بشكل استراتيجي ضد المحتجين. وبهذا حوّل المحتجّون والمحتجّات المطعم التركي إلى أيقونة ترمز إلى احتجاجات تشرين. واكتسته لافتات الاحتجاج والأعمال الفنّيّة المعبّرة عن مبادئ الحركة الاحتجاجيّة، فحوّلته إلى أكبر لوحات الإعلان المرئيّة للتعبير عن روح الاحتجاج.
المطعم التركي أثناء احتجاجات تشرين، وصورة لحمّالة مفاتيح على شكل المطعم التركي، تصوير كاتب المقال.






مازالت بعض الأعمال الفنية التي قام بها المحتجون والمحتجّات تكسو المبنى إلى اليوم، لكنّه عاد إلى حدّ بعيد ليكون جزءاً عادياً من أفق بغداد الباهت. ويمتلئ المبنى حالياً بقوّات الأمن الحكوميّة وعناصر صدريّة، لمنعه من العودة إلى موقع للاحتجاج في المستقبل. كما أنّه أصبح جزءاً من المشهد الرمزي العمراني البغدادي المتنازع عليه. وسعت النخب السياسيّة إلى توظيف الأهمية الرمزيّة التي اكتسبها المبنى عام ٢٠١٩ في تخاصمها مع بعضها البعض ولتأكيد سلطتها الخاصّة. مثلًا، في تشرين الثاني ٢٠٢٠، وبعد فترة قصيرة من التخلّص من الجماهير المحتجة في ساحة التحرير، حشّد مقتدى الصدر أتباعه للتأكيد على السيادة الصدريّة في ساحات الاحتجاج، والتي كانت محسوبة على حراك تشرين في السابق. والحال، وبالتوافق مع الشعارات السابقة التي خلقتها اعتصامات تشرين، غطى الصدريّون المطعم التركي بشعارات تعرض أيقونات خاصّة بالحركة وزعيمها. عبر المساعدة في طرد المحتجّات والمحتجّين وعبر الاستحواذ على المطعم التركي بهذه الطريقة، لمّح الصدريون إلى قوّة الشارع التي يتمتّعون بها وحاولوا ادّعاء ملكيّة التحشيد الجماهيري.



وفي مثال آخر على تبني جهات فاعلة سياسية أساليب احتجاجات تشرين، بما في ذلك خصوم حراك تشرين، استخدمت «قوّات الحشد الشعبي» المطعم التركي لإحياء ذكرى مرور عام على اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في كانون الثاني ٢٠٢١. فتغطّت طوابق المبنى الـ١٤، على نفس منوال احتجاج تشرين، لكنها كانت هذه المرة بصور المهندس وسليماني وشخصيّات أخرى مغتالة إلى جانب عدد من الأعلام العراقيّة.
وسعى مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي السابق، هو الآخر إلى توظيف القيمة الرمزية للمطعم التركي ولحراك تشرين نفسه. في منتصف عام ٢٠٢١، زُيّنت الواجهة دائمة التغيّر بلائحة إعلان تعلن عن التغيير المقبل للمبنى وتحويله إلى «متحف تشرين»، وذلك “بدعم ورعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”. كانت تلك رسالة تضامن وتعاطف مع حراك تشرين، في محاولة لحكومة الكاظمي لإضفاء شرعيّة على نفسها اعتماداً على الفكرة، التي باتت فاقدة لمصداقيّتها الآن، بأنها -أي حكومة الكاظمي- هي ذاتها نتاج احتجاجات عام ٢٠١٩. لكنّ الإعلان عن «متحف تشرين» لاقى معارضة ضمن نشطاء الاحتجاج وأتباعهم. واحتجّ «البيت الوطني» وهو أحد المنظّمات المنسوبة إلى حراك تشرين، بأنّ “مطالب الانتفاضة السياسية ومطالب الشعب لم تتحقّق وأنّه من المبكّر جداً الحديث عن تأسيس متحف لتخليد ذكرى حراك تشرين وذلك لأنّ حراك تشرين لم ينتهِ”.٤



ولم يرَ المتحف النور وأزيل الشعار في نهاية المطاف. وكان السبب الرسمي المعلن بخصوص الاستغناء عن المشروع، بكون المبنى حالياً محور إجراءات قانونيّة جارية بين أمانة بغداد ومستثمري القطاع الخاصّ وأنّه لا يمكن إنجاز أيّ شيء قبل حسم المسألة.٥ ويوضح تبنيه والمعارضة الناتجة عن ذلك التعقيدات المتأصّلة في سياسات الاستذكار.
حالة من الاحتجاج المتواصل
ومع كلّ ما كان مثيراً للإعجاب والتقدير في ما يخصّ احتجاجات عام ٢٠١٩، كانت ثمّة نزعة عند الداعمين لإضفاء الرومانسيّة والمثاليّة على الاحتجاجات. لكنّ الحقيقة هي أنّ احتجاجات ٢٠١٩ فشلت في تغيير أسس النظام السياسي العراقي. وبالفعل، فإنّ هذه الأسس هي ما سمح للنظام بالصمود في وجه عاصفة ٢٠١٩. يكمن فهم تراجع حراك تشرين إذاً في فهم طبيعة الدولة العراقيّة.
لم تلحق تدمير الدولة العراقيّة، بدءاً بالعقوبات المفروضة على النظام عام ١٩٩٠ وانتهاءً بغزو العراق عام ٢٠٠٣، عمليّة بناء دولة متماسكة. بل ما سُمّي بالعراق الجديد هو عبارة عن أجزاء ملصقة ببعضها من مخلّفات النظام السابق. زرعت نخبة سياسيّة جديدة ومختلف المقاولين السياسيين ومجموعات النهب الاقتصادي، بالإضافة إلى المصالح الأجنبيّة في حطام بنى دولة البعث. وما ظهر على السطح كان كياناً هجيناً مليئاً بالتناقضات وتحكمه أوليغارشيّة من الجهات الفاعلة الرسميّة وغير الرسميّة والتي تشكّل الدولة كلّها معاً. ويواري وجه الدولة الڤيبرية -الوزارات ومؤسسات الدولة وما إلى ذلك- حقيقة الاختراق السياسي واستيلاء سماسرة السلطة الكبار على مؤسسات الدولة العراقيّة. وعلاقات القوّة والمصالح المتضمّنة التي تدعّم النظام تجعل الأخير غير قادر على إصلاح نفسه. وكان أن اصطدمت احتجاجات ٢٠١٩ بهذا الواقع نفسه، فقد خضعت أدوات إصلاح النظام المزعومة -أي جهاز القضاء ومؤسساته وبيروقراطيته وما الى ذلك- كلّها إلى هذا المنطق نفسه، وإلى علاقات القوّة التي استهدفها المحتجّون والمحتجّات نفسها.
ما تبين من أحداث ٢٠١٩ هو أنه في وجه التحشيد الجماهيري تتحول نقاط ضعف النظام السياسي إلى مصدر قوّة له. يعني اقتصاد الدولة الريعي باعتماده على النفط، اعتماد كتلة كبيرة من العراقيّين على النظام ولذلك تنزع إلى تحمّله وتقبّله. ويسلّط توزّع السلطة على شبكات زبائنية متنوّعة تلك التبعيّة وتجعل التغيير الثوري حتّى أكثر صعوبة، إذ لا يوجد حزب أساسيّ للإطاحة به ولا ملك لخلعه عن عرشه ولا تمثال للقائد العزيز لإسقاطه. وعلاوةً على ذلك فإنّ التواطؤ النخبوي الذي يدعّم توزّع السلطة، يعمل أيضاً، بطبيعة الحال، في خدمة النظام. فلا توجد معارضة برلمانيّة رسميّة تفوق رغبة الطبقات السياسيّة في صيانة الإمبراطوريّات التي بنتها بمصادر الدولة وعبر مؤسسات الدولة -الحاجة إلى حفظ الذات- قوّة نزاعاتها الداخليّة المستمرّة.
ويتعدى الأمر الشبكات النخبويّة، إذ حوّلت عيوب النظام الانتخابي العراقي صندوق الاقتراع إلى أداة غير مجدية في سبيل التغيير الشامل.٦ يعمل ضعف المؤسسات العراقيّة وسيادة العراق المحطّمة وضعف سيادة القانون كذلك لمصلحة النظام، بحيث تسهّل هذه الأمور استخدام العنف الخارج عن القانون والدعم الخارجي. وبالفعل يُعتقد أنّ عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، قد ساعدت في إخماد انتفاضة ٢٠١٩. وهكذا وعبر غيرها من الطرق يخلق النظام العراقي القوّة من خلال الضعف عند مواجهته لتفجّر الغضب والاحتجاج الشعبي.
وكما توقّع الكثيرون في ٢٠١٩، كان من المرجح صمود النظام وعودة الاحتجاج. وأصبح الاحتجاج اليوم معلماً ثابتاً في المشهد السياسي، لكنّه لم يَعُدْ أحاديّ الاتجاه. فالاحتجاجات تُنظَّم من قبل النخب السياسية ومعارضيها، وتُنظّم ضدّ النظام وضدّ الحكومة الحاليّة ومن أجل الحصول على الوظائف الحكوميّة. ويبقى السؤال المطروح عن طول مدّة بقاء الأمور على هذه الحال مفتوحاً. لقد أصبح التصريح بعدم استدامة السياقات غير العادلة أمراً شائعاً، لكنّ نظام ما بعد ٢٠٠٣ أثبت صموده مراراً وتكراراً. لا يمكننا افتراض اقتراب حدوث تغيير جذري قبل استنفاد مصادر صمود النظام أو أقلّه إضعافها. لقد عانت فينزويلا ولبنان أسوأ بكثير بدون الاستسلام لتغيير النظام، ومازال الطريق طويلاً أمام العراق قبل الوصول إلى حالة شبيهة لأيّ من الدولتين. تديم موارد العراق الضخمة والدعم الدولي الذي يتمتع به أسس الاقتصاد السياسي العراقي، حتّى وِإن أُنجز إجراء تغييرات عرضيّة أو تحسينات معيّنة في مجالات معيّنة، كما حصل في مجال الأمن العراقي والعلاقات الدوليّة في العقد الماضي.
يشكّل احتمال الاحتجاجات المتواصلة، سواء كانت مدفوعة من النخبة أم الشعبيّة، إلى جانب إخفاقات الدولة المستمرّة إدانة أكيدة لمشروع بناء الدولة ما بعد ٢٠٠٣. يذكر ذلك بملخص لوزير الاقتصاد السابق علي علّاوي للدولة العراقيّة في رسالة استقالته المطوّلة عام ٢٠٢٢. يصف فيها دولة موجودة شكلاً لكن لا فحوى لها. دولة قادرة على إعادة خلق نفسها على الرغم من تناقضاتها الكثيرة. والمفارقة هي أن هذه التناقضات ذاتها، والتي تدعّم تهجين وانعدام شفافيّة وخلل النظام، تمنحه مصادر صمودَه:
“كل دعوات الإصلاح جرت إعاقتها بسبب الإطار السياسي لهذا البلد (..) ولقد سمح بالاستيلاء على الدولة من قبل مجموعات المصالح الضيقة (..) وعلى عكس البشر، لا تموت الدول بشكل نهائي، ويمكن أن تبقى دولة (الزومبي) لسنوات بل حتّى لعقود قبل أن يتم دفنهم، أعتقد أن الدولة العراقية التي ولدت بعد غزو ٢٠٠٣ تظهر عليها علامات مرض عضال. وصحيح أن آلية الحكومة مستمرة، وتبقى مظاهر سلطة الدولة قائمة، لكن لا يوجد جوهر للشكل”.
ترجم “جمار” المادة من الإنجليزية إلى العربية، وتنشر بالشراكة مع مجلة “ميريب“