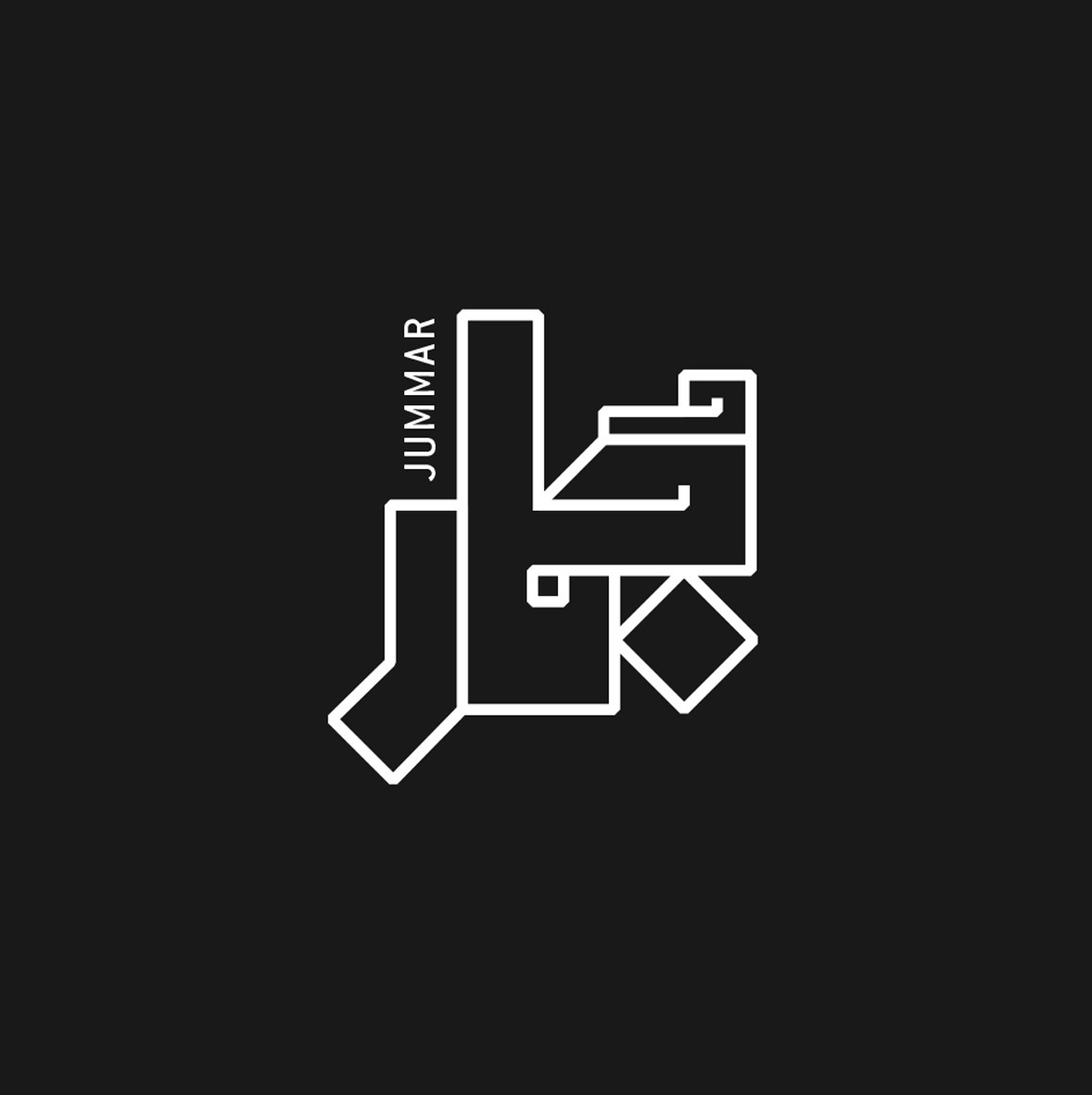السلطة حينما واجهت شباب تشرين: إباحة القتل لإدامة النظام
01 تشرين الأول 2022
ما حدث في تشرين الأول 2019 من عمليات قتل ضد المتظاهرين لم تكن فرديّة، وإنما مؤسساتية ومتغلغلة كاستراتيجية للتعامل مع الاحتجاجات التي تهدّد النظام السياسي في العراق..
بمضي ثلاثة أعوام على انتفاضة تشرين ومع الركود السياسي الذي يحيق بالعراق، تبدو الأحداث كأنما باتت على هامش ذاكرة وأولويات السلطة. فالعنف يمارس ذاته، والقتل ضد الناشطين والمتظاهرين ما يزال مستمراً، وما زال الآلاف من المصابين يتخبطون بين المشافي بحثاً عن علاج. علاوة على ذلك، لم يُحاسب القتلة وحتى أن العدد النهائي للضحايا والقتلى ما يزال غير واضح.
يسترجع المقال التسلسل الزمني للأحداث الأمنية التي رافقت تظاهرات تشرين الأول، لتبيان كيف أن عمليات القتل التي جرت ضد المتظاهرين لم تكن فرديّة، وإنما مؤسساتية ومتغلغلة كاستراتيجية للتعامل مع الاحتجاجات التي تهدّد النظام السياسي في العراق.
كيف بدأ كل شيء؟ مدافع الماء التي أحرقت العراق
في العراق، الدولة ذات الاقتصاد الريعي، والتي تعيش فيه الطبقة السياسية صراعاً محتدماً يتمحور حول كيفية الضغط باتجاه ضمان حصص القوى المتنافرة داخل المؤسسات الحكومية، بالطريقة التي تمنح هذه القوى فرصة سرقة المال العام وديمومة وجودها السياسي، من الترف أن نتوقع إدراك السلطة لتداعيات أخطائها، فهي لا تنظر الى الأخطاء ضمن هذا التوصيف، وهي تدافع عنها دوماً، ولاسيما في جانب الأمن والمؤسسة العسكرية، ولطالما عاش البلد أعواماً من العنف الرهيب كان يمكن تدارك أضرارها لو اعترف النظام أنه مخطأ ويحتاج الى تصويب أخطائه ومعالجتها. بدأ الأمر في هذا السياق، وتم قمع الكلمة التي كانت تقال بلسان الرجاء، لتتحول الى صراخ يطالب بزوال النظام.
جاء ذلك في احتجاجات لم يشهد لها العراق مثيلاً منذ إعلان دولته الوطنية عام 1921. نعم، الكلمة المقموعة هي البداية لكل شيء حدث، الدماء التي سالت والبنادق والهراوات وأقبية الاعتقال والإخفاء التي استعملت، والتغييرات التي حدثت بكل ما فيها من تناقضات وخطوات للأمام أو الخلف، كلها جاءت بسبب تعمّد النظام “الخطأ” والدفاع عنه وتمجيده احياناً.

القصّة بدأت في نهار يوم 25 أيلول 2019، وفي بغداد، وداخل المنطقة الخضراء حيث المقار الحكومية والتشريعية وغرف صناعة القرار، تم إنهاء اعتصام أقامه عدد من حملة شهادات (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) دام ما يقارب المئة يوم أمام مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي[1]، كان هؤلاء المعتصمون يطالبون بتوظيفهم في دوائر الدولة وتخليصهم من حياة البطالة المذلة، وهنا آمنت السلطة بضرورة قمع الكلمة رغم أن أسلوب فض الاعتصام أقل عنفاً مما سيليه من عمليات قمع واستهداف للاحتجاجات والاعتصامات. حينها، كان عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق منتشياً بمنجزاته التي ذكرها مراراً، ومنها فتح المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً أمام المواطنين، وعقده سلسلة اتفاقات مع الصين التي كان عائداً منها إبان فض الاعتصام بفارق ساعات قلائل فقط.
انتشرت صور قليلة لفض اعتصام الخريجين كالنار في الهشيم، وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في الغالب، ولامست جرحاً انسانياً في المتلقي العراقي، حيث كانت بعض المعتصمات ممن طالبن بالتوظيف مع زملائهن قد تعرضن للإذلال بمدافع الماء، مما رسمهن في المخيال العراقي كطيور مبللة لا تقوى على الهروب. كانت هذه اللحظة رسالة بصرية ذهبت عميقاً في غضب شريحة الشباب وأعادت شحنه تمهيداً للانفجار الكبير بعد أيام قليلة من ذلك النهار العادي.
ممهّدات تشرين والتهيئة الذهنية لقمعها
لم تخل ممهدات احتجاجات تشرين الأوّل عام 2019 من نبوءات وتهديدات بين أطراف السلطة، رغم أن جميع صنّاع القرار تفاجأوا لاحقاً من حجم ما توقعوه أو هددوا به ضمن صراعاتهم المستمرة منذ تأسيس النظام السياسي الجديد عام 2003.
في البداية، كان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قد منح رئيس الوزراء المكلف حينها عادل عبد المهدي مهلة بدأت في 2 تشرين الأول 2018، وهي المهلة التي انتهت مع انطلاق احتجاجات تشرين الأول 2019 دون ترابط بين الأمرين بحسب مصادر من داخل الصدريين([2])، ومن جانب آخر، توقع قيس الخزعلي أمين عام عصائب أهل الحق، وهو فصيل مسلح وجزء من العملية السياسية والحشد الشعبي، أن تخرج تظاهرات تطيح بحكومة عبد المهدي في الشهر العاشر لأسباب وصفها بأنها تتعلق بموقف العراق من صفقة القرن، وكان تصريحه هذا في يوم 26 آب 2019([3])، أي قبل انطلاق احتجاجات تشرين الأول بشهر تقريباً.
غير أن ممهدات الاحتجاجات كانت أكثر من ذلك، إذ جاءت إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي يوم 27 أيلول 2019 الى إمرة وزارة الدفاع، بعد أن كان قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، المؤسسة القتالية المعنية بمواجهة الإرهاب ولها دور كبير في هزيمة “داعش”، لتزيد الطين بلة، حيث اكتسب الساعدي نجومية شعبية بين العراقيين إبان معارك تحرير المحافظات الشمالية والغربية من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بين أعوام 2014 و2017، مما جعل الشباب المتحفز للتظاهر أكثر حنقاً وهو يرى السلطة تقصي قائداً عسكرياً لطالما داعب مظهره واسلوبه خيال الناس وامنيات بعضهم في حدوث انقلاب عسكري بقيادته ينهي العملية السياسية المليئة بالفاسدين.
يشبه الساعدي، من جوانب ظاهرية، عبد الكريم قاسم الذي قاد انقلاب 1958 في العراق على الملكية الهاشمية، والذي ما زال أحفاد النازحين الى العاصمة بغداد يحبونه لأنه كان منصفاً وعادلاً وفقيراً ينتمي لطبقتهم الاجتماعية، بحسبهم. الساعدي، والحال هذه، في عيون هؤلاء ينحدر ايضاً من أسرة فقيرة ويوحي مظهره البسيط وغير المتكلف بالنزاهة التي يحلم بها العراقيون، حيث يؤمن جزء كبير من العراقيين أن الطريق نحو تغيير سلمي في واقع إدارة الحكم بات مغلقاً في ظل تغوّل الأحزاب التي تعيد انتاج نفسها دائماً وفق انتخابات تصمم هي قانونها والمفوضية المشرفة عليها بما يتوافق مع مصلحتها دون إمكانية فسح المجال أمام أي قوى جديدة، لذلك تجد الفقراء ومن يشعرون بالخوف في ظل الانفلات الأمني المستحكم، يتمنون حدوث انقلاب عسكري بقيادة عبد الوهاب الساعدي أو من يشبهونه في بلد له تاريخ انقلابي عريق، حيث شهد العراق انقلابات في أعوام 1936، و1941، و1958، و1963، و1968[4]، وهذه جميعها انقلابات ناجحة، وهناك عدد كبير أيضاً من محاولات الانقلاب الفاشلة[5].
كل ما سبق كانت أحداثاً تحفز التظاهرات الواسعة التي ستندلع يوم 1 تشرين الأول 2019، والتي ستترك أثراً كبيراً في حياة العراقيين ونظرة العالم لهم ولدولتهم التي أسست على ركام الانظمة الدكتاتورية ومرّت عليها دبابة الابرامز الأمريكية مطلع الألفية الجديدة.
موجة تشرين الأولى وطبيعة التعامل الأمني معها
بعد الساعة العاشر صباحاً من يوم 1 تشرين الأول 2019 بدأت أعداد من المتظاهرين بالتجمهر في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وقبيل منتصف النهار كان العدد قد زاد وانقطعت حركة السيارات في محيط المنطقة، حيث بادرت السلطات الى اغلاق جسر الجمهورية الواصل بين الساحة والمدخل الشمالي للمنطقة الخضراء، ومع استمرار التحشد وقع إطلاق نار من جهة الجسر باتجاه المتظاهرين بشكل عشوائي، وخلال الساعات اللاحقة التي شهدت سقوط اوائل الضحايا اتضحت استراتيجية السلطات بدفع المتظاهرين باتجاه عكسي نحو المناطق التي اتوا منها، حيث بدأ المتظاهرون بالتراجع تحت الضغط من ساحة الطيران الى منطقة شارع فلسطين وصولاً الى منطقة البلديات في خط عمودي حالت القوات الأمنية دون انتشار المتظاهرين في الشوارع الافقية المتعامدة عليه.
الاتجاه الذي تم دفع الجزء الأكبر من المتظاهرين نحوه في ذلك النهار يحدد خلفيتهم الاجتماعية والمذهبية، حيث أن هذا الجزء الشمالي الشرقي من بغداد يسكنه في غالبيته العظمى شيعة من الطبقة المسحوقة والوسطى وتعود أصول غالبيتهم الى جنوب العراق قبل ان ينزحوا في ثلاثينيات القرن الماضي وما بعدها الى العاصمة.

خلال 6 عقود خضعت مناطق بغداد التي يسكنها النازحون من الجنوب إلى هندسة أمنية اتقنتها الأنظمة المتعاقبة، وقد نجحت الحكومات في تعطيل قوة الحشود في هذه المناطق مراراً. ففي عام 1963 تم إبطال زحف جماهير غفيرة كانت في طريقها لإنقاذ نظام عبد الكريم قاسم من الانقلاب الذي قاده البعثيون. وبعد ذلك، سيطر نظام البعث على هذه المناطق عبر زرع مقترباتها بمؤسساته القمعية الرهيبة من الشرق والغرب، وبعد احتلال العراق عام 2003، نجح الجيش الأمريكي والحكومات العراقية في تطويق هذه المربعات السكنية المتجاورة على مراحل، وخاصّة في أعوام 2004، و2005 و2008 وذلك إبان المواجهات مع التيار الصدري[6].
ما حدث في تشرين الأول 2019، كان عشوائياً في مرحلته الأولى، وامام اندفاع غير منظم للمتظاهرين فقد بات عنف القوات الأمنية قاتلاً ومفتقداً لأي حسابات منطقية يعتمدها القادة الأمنيون عادة، ونتيجة لذلك فقد سقط عدد كبير من القتلى برصاص كثيف تم اطلاقه دون مبرر أمني.

ورغم أن تقارير دولية اشارت في أعوام سابقة الى وجود 9 ملايين قطعة سلاح خارج إطار الدولة بالعراق[7]، إلا ان الليالي العنيفة والساخنة لم تشهد ردة فعل عنيفة من أهالي الضحايا ورفاقهم المتظاهرين، وهو ما شكّل ظاهرة متميزة في بلد منفلت أمنياً منذ 17 عاماً، ويستعمل فيه السلاح لأصغر الأسباب وأكبرها. لكن مرد عدم استخدام السلاح يعود لسببين رئيسيين، أوّلهما هو أن لجوء المتظاهرين إلى السلاح يعني خسارتهم “السلميّة” التي شكّلت حراكهم وبالتالي خسارتهم لتعاطف المجتمع معهم، وثانياً هو خوف من اندلاع اقتتال شيعي – شيعي متوقع، لم تدخر قوى السلطة وجماهيرها وسعاً في الترهيب من مآله، مما جعل الأهالي والعشائر والقوى الاجتماعية الغاضبة تعض على النواجذ خشية من حرب الأخ مع أخيه والتي لا يمكن إيقافها في حال نشوبها بوقت قصير أو تضحيات قليلة.
وقد تكرر العنف من السلطة أكثر من مرة خلال الايام السبعة الاولى للاحتجاجات قبل توقفها في اليوم الثامن بشكل مؤقت ريثما تنقضي زيارة اربعين الامام الحسين في كربلاء، وقد خرجت تظاهرات في ميسان وواسط باليوم الاول وتم منع تظاهرات البصرة بالقوة.
شهد اليومان اللاحقان سقوط 18 متظاهراً، وقامت السلطات بفرض حظر التجوال وقطع خدمة الانترنت عن العراق بالكامل عدا اقليم كردستان، وعاشت المناطق الشعبية في الرصافة شمال بغداد ليالي ساخنة بفعل قطع الطرقات من قبل المحتجين وتحول مجالس عزاء ضحايا التظاهرات الى بؤر تحشيد تدعم الاخذ بالثأر من السلطة بوصفها المسؤولة عن مقتل ابناء هذه المناطق التي يغلب عليها الطابع العشائري، الأمر الذي لم يتفاقم بسبب تداخل جماهير قوى السلطة مع بقية الممتعضين منها.
ولأن عبد الوهاب الساعدي ونجوميته كانا سبباً في الغضب الاساس الذي انطلقت منه الاحتجاجات، فقد رُفعت صوره ومطالبته بقيادة انقلاب عسكري للسيطرة على مفاصل الدولة في اغلب الساحات، الامر الذي دفع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الى الخروج بمؤتمر صحفي للحديث عن مؤامرة انقلابية تم اسقاطها، وهو الخطاب الذي زاد من استفزاز الجموع بشكل كبير وتسبب باستياء عام يوم 8 تشرين الأول 2019. منذ ذلك الحين بدأت جموع المتظاهرين بنصب خيام في ساحة التحرير، وهو الامر الذي سيستمر لأكثر من عام لاحقاً، معلنة بداية اعتصام طويل في قلب بغداد وصداع في رأس العملية السياسية.
فرضية القنّاص في الاسبوع الأول من احتجاجات تشرين
في اليوم الرابع من الاحتجاجات، قام ناشطون وبالتنسيق مع إعلاميين عراقيين يعيشون خارج العراق بتوثيق مشاهد مصورة لإصابات طالت المتظاهرين تم وصفها بأنها “حالات قنص”، وقد نقل مكتب وكالة رويترز ببغداد خبراً عن مصادر خاصة بها من داخل القوات الامنية العراقية اتهمت فيه فصيلاً من الحشد الشعبي – تحديدا سرايا الخراساني بحسب عدد من المدونين – بأنه يقف وراء قنص المتظاهرين.
فيما شهد اليوم الخامس من الاحتجاجات قيام قوة مسلحة (تم اعتقال افراد منها لاحقاً واتضح انتماؤهم الى مديرية أمن الحشد الشعبي) بالاعتداء على مقرات قنوات فضائية وشركة للبث الفضائي تقدم خدمات لقنوات عربية على خلفية نقلها للتظاهرات.
لاحقا، وبعد انتهاء الموجة الاولى من الاحتجاجات ليلة يوم 7 تشرين الأول 2019، شكلّت السلطة بضغط من مرجعية النجف ومنظمة العفو الدولية وعدد من البعثات الدبلوماسية لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب العنف ضد المتظاهرين، وترأس اللجنة وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، وكان أبرز ما جاءت به اللجنة سقوط 149 قتيلاً في صفوف المتظاهرين و4207 جريحاً، إضافة إلى ثمانية قتلى من قوات الأمن في عموم العراق.
وتضمن تقرير نتائج التحقيق إحصائية صحية لدائرة الطب العدلي تبين أن 70% من الإصابات لقتلى المظاهرات في منطقتي الرأس والصدر، وهو ما عزّز لجوء السلطات الأمنية إلى استخدام قنّاصين في البنايات المحيطة بمنطقة التظاهرات، غير ان التحقيق لم يتهم الحشد الشعبي واوصَ بإحالة قادة امنيين وعسكريين بما فيهم مسؤول حماية شخصية في رئاسة الجمهورية الى التحقيق بعد اعفائهم، وهو ما جعل السياسيين والمدونين المنحازين للاحتجاجات يشككون بقيمة التحقيق.

لكن التحقيقات والأحداث تُثبت، بما لا يقبل الشكّ، أن القوات الأمنية -رسميّة كانت أم لا- كانت تهدف إلى قتل المتظاهرين. فاغلفة الرصاص المكتشفة فوق أسطح أحد البنايات والتي تم توثيقها في تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في اسباب العنف وهي من نوعية 5.8 × 42 ملم، وبحسب خبراء، يمكنها ان تستعمل لأسلحة القنص وللأسلحة العادية، وعلاوة على ذلك، فإن إطلاق الرصاص الحي بكثافة وبشكل عشوائي على جموع يصيب عدداً كبيراً بإصابات قاتلة.
وقد اثبتت الأيام القصدية في استهداف رؤوس المتظاهرين عبر قنابل الغاز المسيل للدموع، مما يعزز القصدية في استهداف المتظاهرين قنصا في الأيام الأولى لتظاهرات تشرين الأول، حيث أن الغطاء الحكومي للقوى القامعة وفّر مساحة نجاة للقتلة من خارج القوات الأمنية وهو ما يجعل الغطاء مناسبا للقوات نفسها أكثر إقناعاً، وقد ظهرت تبريرات حكومية لاحقة لا بد من ذكرها رغم هزالتها وشناعتها، ومنها انتشار تعاطي عقاقير الهلوسة بين المنتسبين الأمنيين من جهة وكذلك عدم تدرّب هذه القوات على مكافحة الشغب بطريقة صحيحة من جهة أخرى، بالإضافة الى ربط عنف المنتسب الأمني الحكومي بعودته القريبة من ساحات المعارك ضد الإرهابيين.
ولا يُمكن فهم هذه التبريرات، إلا على أنها محاولة من الجهات الرسمية لحرف الأنظار عن قرار استخدام الرصاص والقتل من منهجية معتمدة في التعامل مع التظاهرات، إلى تحويلها لأحداث فرديّة يتحمل مسؤوليتها أفراد داخل المؤسسة الأمنية.
وفي الواقع، فإن هذه التبريرات تحوّلت، في وقت لاحق، إلى منهجية لدى المؤسسة الأمنية، إذ أنها لم تحاكم ضباطاً ورتباً كبيرة منحت أوامر مباشرة باستخدام الرصاص الحي، وقامت، بدلاً من ذلك، بمحاكمة عناصر أمنية نفذّت أوامر قادتها[8].
انتقال الشرارة الى المحافظات الجنوبية
بالإضافة الى بغداد، شهدت محافظات ذي قار والبصرة وميسان وواسط والديوانية والنجف وكربلاء وبابل والمثنى احتجاجات مماثلة في الايام السبعة الاولى، غير ان طبيعة الاحتجاجات في ذي قار اتخذت بعداً أكثر عنفاً، مع استمرار احراق مقرات الاحزاب الاسلامية الشيعية (ما عدا مقرات التيار الصدري) بالإضافة الى الحزب الشيوعي، وهذه الظاهرة كانت تكراراً لما شهدته تظاهرات البصرة عام 2018 على خلفية ارتفاع ملوحة المياه وفشل الحكومة المحليّة في توفير الخدمات، غير ان مسلسل الحرائق سيستمر ويطال قنصليات إيرانية وبيوتا للمسؤولين[9] وهو ما سيخلق تبعات خطيرة وموجات عنف ارتدادية لاحقاً.
من جهة ثانية، تبلورت صفة ساحات احتجاج جديدة في المحافظات على غرار ساحة التحرير، وكانت أبرزها ساحة الحبوبي في ذي قار، وساحة ثورة العشرين في النجف، وساحة البحرية في البصرة، وبات لكل محافظة ساحة احتجاجها الخاصة والتي شهدت لاحقاً نصب خيام للاعتصام في كل واحدة منهن ما عدا بعض الاستثناءات.
وقد تحولت الساحات المتناسلة من ساحة التحرير الأم الى ملاذات للمتظاهرين الخائفين على حياتهم، خصوصاً بعد حالات الاعتقال والاختطاف التي رافقت عودة بعضهم إلى بيوتهم، بالإضافة الى رغبة عدد كبير من شباب التظاهرات بالتحرر من الضغوط الأسرية التي تطالبهم بالتوقف عن الاحتجاج، وصولاً إلى مرحلة بات البقاء في الساحات والخيم يمثل انقطاعاً لبعض المتظاهرين عن المجتمع الذي باتوا يرونه مدجناً حسب وجهات نظرهم الغاضبة والحانقة.
الموجة الثانية من الاحتجاجات
بعد البداية الارتجالية للتظاهرات على مستوى المحتجين وعلى مستوى ردة فعل السلطة، جاء وقت التنظيم، واستعد الطرفان للجولة الثانية بطريقة أكثر حنكة.
قامت السلطة، بتطويق ساحات الاحتجاج وعلى رأسها ساحة التحرير عبر قطع الشوارع المؤدية لها ونشر القوات الامنية في مداخلها، وكانت الصفوف الاولى للقوات الامنية بمواجهة المحتجين ليلة 24 تشرين الأول 2019 لا تحمل اسلحة قاتلة، إلا ان ذلك لم ينه الكارثة ابداً.
من جانبهم، عبّأ المتظاهرون أنفسهم جيداً، ثم قاموا بالاستقرار في ساحة التحرير في بناية متروكة مشرفة على نهر دجلة وجسر الجمهورية تسمى شعبياً بالمطعم التركي، حيث اسموها المتظاهرون “جبل أحد”[10]، مكسبيها صفة برج المراقبة ومشاغلة قوات مكافحة الشغب، وستكون هذه البناية مصدراً للكثير من الحكايات على مدى أشهر لاحقة، وقد انطوت رمزية المطعم التركي على ثنائية بليغة جداً، اذ ان البناية نفسها كانت مقراً للقوات الحكومية القامعة للتظاهرات السابقة في ساحة التحرير على مدى عقد كامل، حتى ان بعض السياسيين الشامتين بالمتظاهرين اعتلوا تلك البناية في تظاهرات عام 2011[11]، وهكذا مثّلت السيطرة عليها رد اعتبار للمتظاهرين من قامعيهم، كما ان البناية تمثل بالنسبة للعراقيين دلالة واضحة على فشل النظام وعجزه، خصوصاً وانها بقيت مهجورة لنحو 17 عاماً في قلب بغداد بحجة أنها قصفت من قبل القوات الامريكية بقنابل تحتوي اليورانيوم المنضب في عام 2003.
شهد يوم 25 تشرين الأول 2019 الكثير من الحراك باتجاه المباني الحكومية في عموم محافظات الجنوب، وتم حرق الكثير من المقار السياسية، ومحاصرة بنايات الحكم المحلي رغم فرض حظر التجوال، ولم تكن هذه التحركات بدون تضحيات مؤلمة بلغت 40 قتيلاً وإصابة أكثر من 1700 آخرين بجروح في اليوم الاول فقط[12].
العصيان المدني
في هذه الايام، ظهرت فكرة الاضراب العام ودعوة الطلبة والموظفين إلى تعطيل الحياة العامة وتفعيل العصيان المدني، ثم ظهرت مجاميع – في الجنوب غالباً – تسمى (افواج مكافحة الدوام)، وكان جمهور التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، عنصراً اساسياً في هذه الجماعات، وفي يوم 27 تشرين الأول 2019 توِّجت هذه الجهود بخروج تظاهرات طلبة المدارس والكليات بملابسهم البيضاء لتكون لحظة فاصلة في تاريخ الاحتجاجات بالعراق، حيث غابت مشاركة الطلبة بالشأن السياسي العام منذ ستينيات القرن الماضي، وباتت صورة افواج الطلبة داخل النفق المؤدي الى ساحة التحرير بداية كل أسبوع مظهراً اساسياً في الاحتجاجات وزخماً قوياً داعماً لها.
ومع نصب الخيام برزت ظاهرتان كانتا عنصراً اساسياً في ادامة الاحتجاجات، الاولى هي ظاهرة المفارز الطبية لكوادر من المسعفين والمسعفات والذين قاموا بمعالجة غالبية حالات اصابة المتظاهرين قبل نقلهم الى المستشفيات، والثانية هي ظاهرة المواكب الحسينية التي انتشرت في ساحات الاحتجاج لتقديم المساعدات كالغذاء والماء وعدد كبير من الخدمات، وقد ساهم في الكثير من تلك الجوانب نقابات مهنية ومنظمات انسانية، غير ان السلطات الرسميّة تحدّثت عن “خطوط تمويل” بمبالغ كبيرة قد اتصلت بساحات التظاهر ومصدرها كان من خارج العراق في الغالب -في اشارة الى دعم خارجي لتقويض النظام، وهذا الامر اكده متظاهرون لكنهم قللوا من حجم المال السياسي المنفق قياساً إلى التبرعات الخيرية الوطنية، كما انهم أدانوا شكلاً من اشكال التبرعات جاءت من الخارج وتم طرد من أوصلها أحياناً وبُرّر رفضها بهزالة مواقف من يقف وراءها أو شذوذه الفكري والسياسي[13].
مطلع شهر تشرين الثاني ٢٠١٩، شهد بداية قطع الطرق باتجاه حقول النفط في جنوب العراق، وتحديداً في البصرة وميسان وذي قار، وقد بادرت السلطة إلى فتح الاعتصامات الخانقة لصناعة النفط بالقوة بغية وصول الموظفين الى الحقول وضمان استمرار تدفق المورد الاساس للعراق مالياً، لكن هذا الامر لم ينجح وبقيت الامور تتصاعد بين الحين والآخر، ثم تطورت الى محاصرة موانئ البصرة ومحاولة قطع الطريق السريع الرابط بين محافظات الجنوب وبغداد وهو الأمر الذي سيتكرر ولأكثر من عام، تزامن ذلك مع انخفاض حاد بأسعار النفط وأزمة اقتصادية شديدة.
وأظهرت الحركات الاحتجاجية التي حاصرت حقول النفط والموانئ وقطعت الطرق السريعة تطوراً في عقلية المعارض للنظام الريعي والمنتفعين منه، حيث باتت حقول النفط رمزية إضافة لسبب أساس من أسباب فشل النظام الذي وجد قدرته على البقاء في استنزافها وتقاسم مواردها، برغم ان عدداً كبيراً من المحتجين كانوا يريدون ضمان فرص توظيف في تلك الحقول قبل وبعد احتجاجات تشرين الأول.
الاغتيال والاختطاف أو الاعتقال المزامن للاحتجاجات
شهدت الموجة الاولى والثانية التي استمرت طويلاً من احتجاجات تشرين الأوّل عدداً كبيراً من حالات التغييب التي كان اغلبها اعتقالاً لم تتضح فيه الجوانب القضائية المعهودة، فيما حدثت عمليات اختطاف أقل تم إطلاق سراح بعض المختطفين فيها وبقي عدد منهن في حالة تغييب لم تنجح السلطة في ايجاد حل لها حتى بعد تغيير الحكومة، وقبيل انتهاء الشهر العاشر من التظاهرات كانت الحصيلة 158 معتقلاً، أطلق سراح 123 منهم وبقي 35 معتقلاً في حينها[14].
اما على مستوى الاغتيالات التي بدأت في البصرة بعد يوم واحد من اندلاع الاحتجاجات وراح ضحيتها ناشط وزوجته تمت تصفيتهما داخل البيت[15]، فلم تتوقف رغم التباعد الزمني لحالات الاغتيال، واستهدفت ناشطين وناشطات في عموم بغداد والمحافظات الجنوبية، وتنوعت طرق الاغتيال بين استعمال القتلة لدراجات نارية تطارد الضحية او اقتحام بيوتهم وإطلاق النار المباشر عليهم، في حين كان استعمال القنابل أقل ولم تتجاوز حالات القتل بهذه الطريقة الحالتين في مجمل الاستهدافات.
وقد باتت الصناعة الإعلامية المناوئة للتظاهرات غطاء لعمليات الاغتيال والاختطاف والاعتقال وشرعنة لها، مما يؤكد تصميم السلطة على اتباع هذا النهج واستبعاد كونه تخبطاً في القرارات، كما ان نشاط بعض الفصائل المسلحة في استهداف أسماء محددة من قيادات الاحتجاج ضمن تبريرات سياسية يكمل الصورة، اذ ان الحكومة والطبقة السياسية الصانعة لها منحت تلك الجماعات المسلحة فرصة الدفاع عن النظام باعتقادهم أنه نظام شيعي مدعوم من إيران ومستهدف من السنة وحلفائهم الخارجيين، وعلى ضوء ذلك فقد تم اعتبار مواجهة النشطاء الشيعة واغتيالهم امتداد للحرب على الإرهاب.
قنابل الغاز القاتلة
في الموجة الثانية للاحتجاجات، بعد 25 تشرين الأول 2019، استبدلت السلطة القناص ليحضر بدلاً منها قتل المحتجين عبر اطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه رؤوسهم مباشرة من قبل قوات مكافحة الشغب والقوات الامنية ايضاً، وفي يوم 28 تشرين الأول 2019 سقط صفاء السراي احد قدماء المحتجين الشباب في ساحة التحرير والذي سيصبح لاحقاً ايقونة للاحتجاجات بالطرقة هذه، حيث تم خرق رأسه بقنبلة غاز ادت الى وفاته قرب جسر الجمهورية، وعلى مدى عام لاحق من الاحتجاج سيتكرر القتل بهذه الطريقة كثيراً رغم حديث السلطة المتكرر عن عدم اعطائها موافقة بإطلاق النار او تصويب اسلحة تفريق الجموع الى رؤوس المتظاهرين.
معركة الجسور
اختار جزء من المتظاهرين، غالبيتهم من جمهور التيار الصدري الاتجاه شرقاً من ساحة التحرير لتعطيل جسري السنك والشهداء، ونجحوا في السيطرة على مرآب مطل على نهر دجلة وجسر السنك ليكون مماثلاً للمطعم التركي (جبل احد) في ساحة التحرير، لكن اعداد المتظاهرين بدأت بالتناقص كلما ابتعدوا عن موقعهم الاساس في قلب بغداد، ورغم كتابة شعارات تدعو لإغلاق المقرات الحكومية في عموم مناطق الرصافة ابان حظر التجوال، الا ان الحياة كانت تعود الى طبيعتها كلما تم رفعه، ولم تبلغ نسبة الموظفين المضربين عن الدوام نسبة كبيرة في بغداد قياساً الى محافظات الجنوب، ورغم شيوع ظاهرة التنمر على الموظفين الحكوميين غير المنقطعين عن دوائرهم في مواقع التواصل، إلا ان هذه الظاهرة لم تتسرب الى الشارع المحتقن وهو ما يعزز مفهوم انضباط التظاهرات في عدد من جوانبها.
حتى ذلك الحين، كان عدد ضحايا القمع قد بلغ 319 شخصاً على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات. ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أصيب 15000 آخرين بجروح[16].
المجازر
قبل ان ينتهي تشرين الثاني ٢٠١٩، وهو الشهر الثاني للاحتجاجات، وقبل يوم واحد من قبول البرلمان استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، شهدت النجف موجة عنف بالقرب من مرقد محمد باقر الحكيم بعد محاولات من محتجين لاقتحامه وحرق بوابته الرئيسة.
وفي توقيت مقارب، شهدت الناصرية مجزرة راح ضحيتها العشرات من المحتجين قرب جسر الزيتون، وجاءت المجزرة بعد وفود قوات من الرد السريع (أحد الاذرع الامنية الحكومية) لحقها تنسيب الفريق الركن جميل الشمري مشرفاً امنياً على ذي قار، غير ان اوامر بإطلاق النار المباشر فضحت آلية السلطة لضبط الوضع في المحافظة الجنوبية وتسببت بانعدام الثقة تماماً بين القوى الفاعلة فيها من جهة والسلطة في بغداد من جهة اخرى.



وفي يوم 5 كانون الثاني 2019، خرجت تظاهرات تطالب بتنفيذ مطالب مرجعية النجف والتي نصّت ضمناً على ضرورة تنقية المتظاهرين صفوفهم من مفتعلي الشغب والمندسين، وكانت هذه التظاهرات عبارة عن أول احتجاج جماعي لجمهور الحشد الشعبي منذ تأسيسه، وقد قرر المحتجون الذين يوصفون بـ (الولائيين)[17] الذهاب باتجاه ساحة التحرير التي دخلوها دون مصادمات، غير ان مصادر اتفقت على ان عدد من هؤلاء المحتجين تم اختطافهم، واشيع ان من قام بذلك هم جماعات تابعة للتيار الصدري، حيث كان جمهور الصدريين قد ادعى حماية التظاهرات بواسطة مجموعة من اتباعه اطلق عليهم “القبعات الزرقاء”. في اليوم التالي، حدثت مواجهة عنيفة في مرآب السنك بين متظاهري الحشد الشعبي وبين محتجين غالبيتهم من الصدريين، وقررت هيئة الحشد الشعبي التدخل مستعملة اطلاق النار الحي مما تسبب بسقوط ضحايا في محيط المرآب وساحة الخلاني وعلى مقربة من ساحة التحرير[18].
وقد استمرت المجازر حتى شهر شباط من عام 2020، حيث شهدت ساحة الصدرين في النجف موجة عنف جديدة راح ضحيتها أكثر من عشرين ضحية سقطوا نتيجة التصعيد بين جمهور التيار الصدري والمدنيين من المحتجين الرافضين لوجود الصدريين في الاحتجاجات كونهم أحد اقطاب السلطة[19].
الصراع بين الوجود الأمريكي وحلفاء إيران
سبقت الاحتجاجات عدد من الخروقات الجوية وعمليات القصف الممنهجة طالت عدداً من مواقع الحشد الشعبي في العراق، بحسب التصريحات الامريكية المعلنة فان اسرائيل كانت وراء هذه العمليات بحجة وجود صواريخ بالستية ايرانية بحوزة عدد من الفصائل بالعراق يمكنها ان تطال تل ابيب[20]، وعلى ضوء هذه الاستهدافات انتهت هدنة غير معلنة بين الوجود الامريكي في العراق منذ 2014 وبين الفصائل الشيعية المسلحة المتحالفة مع ايران، وكان قصف احدى القواعد ومقتل متعاقد امريكي من اصول عراقية سبباً في هجمات امريكية ضد مقار للحشد الشعبي بالتزامن مع الاحتجاجات.
كانت الفترة ما بين 29 كانون الأول 2019 حيث قصفت الطائرات الامريكية مقراً للحشد الشعبي وقتلت 25 مقاتلاً على الحدود العراقية السورية وبين 3 كانون الثاني 2020 حينما قامت طائرة مسيرة امريكية باغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في مطار بغداد الدولي من أشد الفترات ضغطاً على الاحتجاجات، حيث انقسم المتظاهرون الى فريقين. لم يخفِ الفريق الاول سعادته بمقتل قائد فيلق القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بحجة انهما داعمان لحكومة عبد المهدي ولهما يد في قمع الاحتجاجات، والثاني لا يريد ان يقف في صف قوات غازية تنتهك السيادة العراقية. ورغم محاولة الجمع بين الموقفين في بيانات موحدة، إلا ان الانقسام بدأ يزداد يوما بعد آخر، ومع انسحاب جمهور التيار الصدري من الاحتجاجات وظهور بوادر انتشار فايروس “كورونا” في العالم والعراق ضمناً، ثم احتجاب المرجعية عن اقامة صلاة الجمعة التي منحت المتظاهرين دفعاً معنوياً كبيراً، وكذلك استقالة عبد المهدي التي فتحت باب المزايدات على من يخلفه مما اضعف الساحة وسمح لجماهير كتل سياسية باختراقها لإدعاء تمثيلهم للمتظاهرين وترشيح من يريدونه للموقع الابرز، كل هذه الاسباب ادت في المحصلة النهائية الى فتور التظاهرات وتقلص اعداد المحتجين في بغداد، رغم استمرار العنف ضدهم في عدد من المحافظات منها ذي قار والبصرة التي شهدت تغييباً لعدد من الناشطين واغتيال عدد آخر.
الخلاصة لا تكفي!
بدأ مشهد تظاهرات تشرين وانتهى، ولم تفرز تلك الاحداث الكبيرة قيادة متفق عليها بين مجموع التنسيقيات، وقد ترك ذلك التشظي واللا مركزية فراغاً كبيراً في آلية تحويل الاحتجاجات إلى قوّة سياسية، أو أن ينبثق عنها مؤسسات تضغط على السلطة لإجراء تغيير هيكلي في طريقة التعامل القوات الأمنية مع الاحتجاجات، فضلاً عن محاسبة القيادات التي منحت أوامر بالقتل المباشر للمتظاهرين.
والحال، فإن الحقوقيين المحتجين او المتعاطفين مع احتجاجات تشرين الأوّل عام ٢٠١٩ لم ينتظموا في جبهة واحدة لإدانة السلطة والقمع والعنف داخلياً أو خارجياً، وشهدنا اجتهادات لا تعدو كونها شجاعة فردية – في الغالب – فرضتها ظروف المواجهة من اجل إطلاق سراح معتقلين أو توثيق جرائم القتل أو الاختطاف.
ميدانياً، لم يملك المحتجون ما يضمن سلامتهم من القمع الشديد، وكانت بعض الإجراءات البسيطة – مثل درع التحرير وهو تجمع شبابي لصد قنابل الغاز المسيل – دليلاً على ان عنف السلطة أكبر من أن يتم صده أو تقليل ضرره.
من جانب السلطة، فقد نجحت بجميع قواها المتصارعة في الاتفاق على تثبيط الاحتجاجات وتوهينها، وعملت السلطة بكل أذرعها إعلامياً وامنياً وسياسياً على التقليل من زخم الاحتجاجات واندفاعها، وجاءت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتعمل عبر قوى ناعمة تلتقي مع قيادات احتجاجية مؤثرة في مشتركات من اجل فض التظاهرات ورفع الاعتصامات وهو ما جرى لاحقاً.
لقد مثلت الأساليب التي تعاملت بها الحكومة العراقية مع احتجاجات تشرين نموذجاً قريباً من القمع الذي شهدته الاحتجاجات الإيرانية 2009 او احتجاجات الربيع العربي التي انطلقت في ٢٠١١، ولكنها تميزت بعدم تحميل المسؤولية لقوى الدولة الرسمية والحاضرة في الميادين بشكل واضح وصريح ومباشر، وتعدى الأمر تلك القوى الى ادانة قوى غامضة تم وصفها بالطرف الثالث.
النص جزء من كتاب “رائحة الفلفل – تحليل وتأريخ وسير لانتفاضات العراق” الصادر عن دار الرافدين
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً


جمهورية بيت طعيس..
الثراء القذر أو كيف تحكُم بالنيابة عن الآخرين
19 أبريل 2024
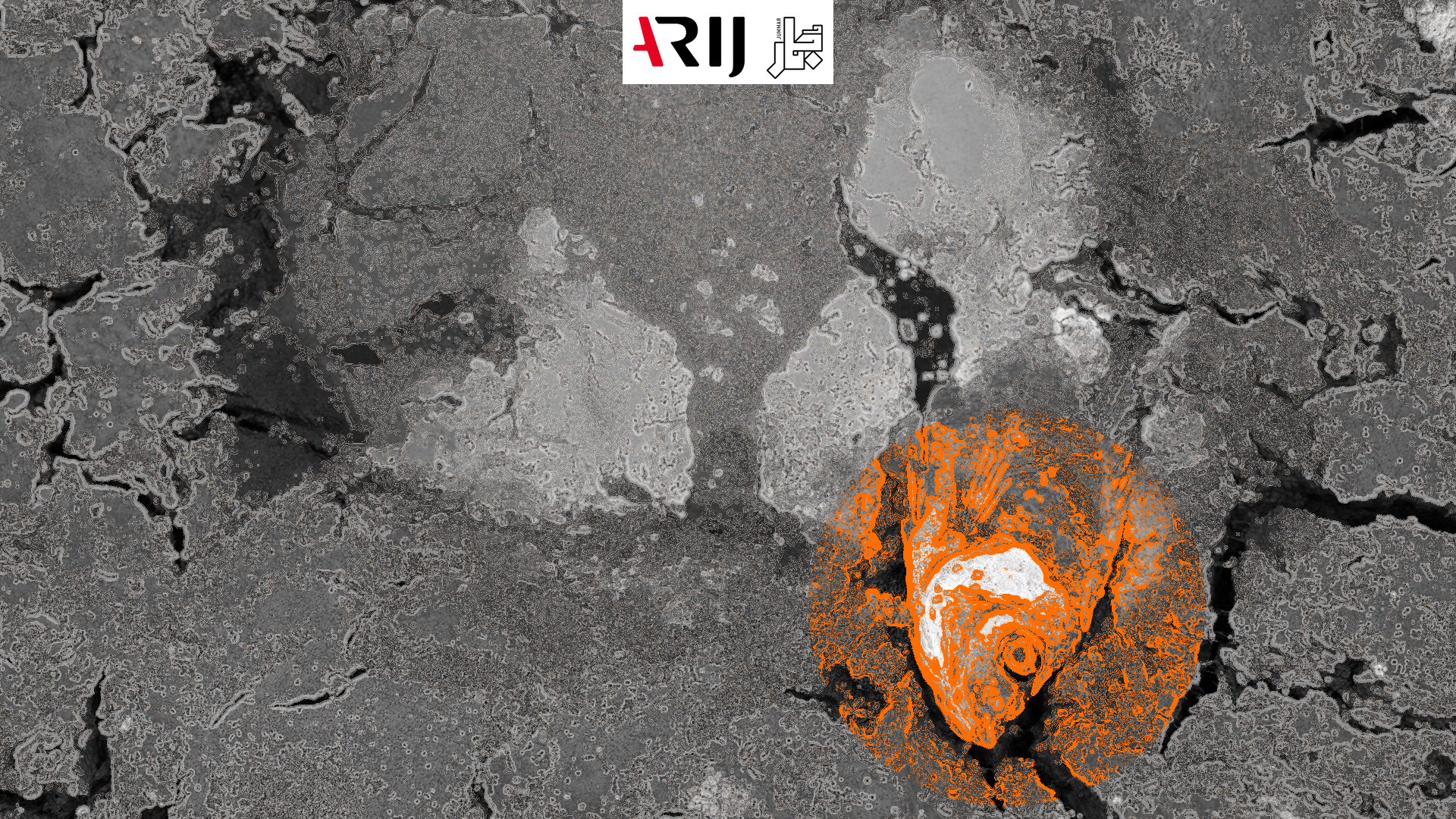
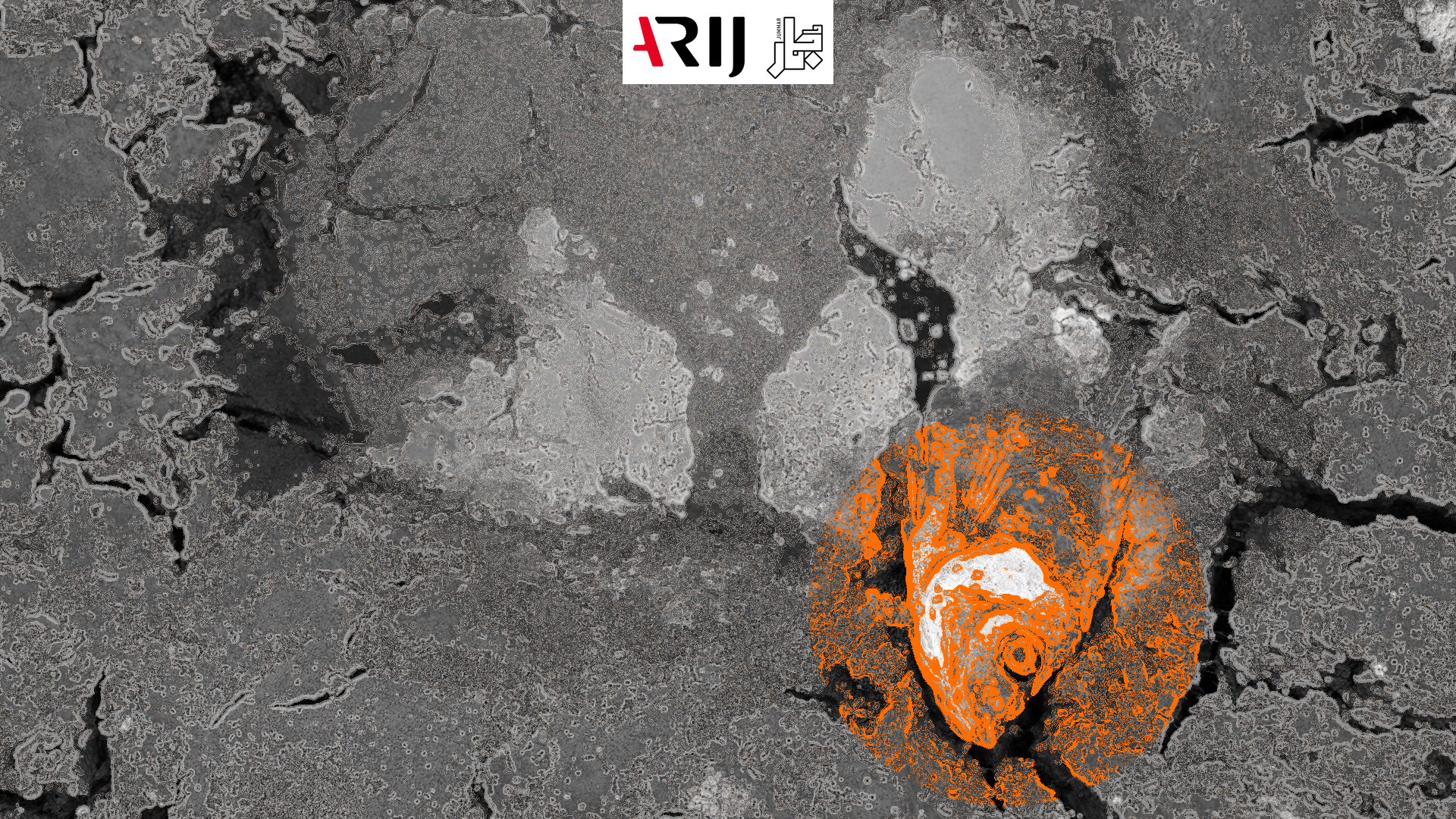
الجفاف والعطش.. جردة مطولة بالأنهار والسياسات المائية في العراق
18 أبريل 2024


"مَنْ يُريد وظيفةً يتركها مَنْ يعمل بها؟".. عن الممرضات والممرضين في العراق
16 أبريل 2024


صناعة الكَيمر من كلكامش إلى زهرة وأم أحمد
10 أبريل 2024
بمضي ثلاثة أعوام على انتفاضة تشرين ومع الركود السياسي الذي يحيق بالعراق، تبدو الأحداث كأنما باتت على هامش ذاكرة وأولويات السلطة. فالعنف يمارس ذاته، والقتل ضد الناشطين والمتظاهرين ما يزال مستمراً، وما زال الآلاف من المصابين يتخبطون بين المشافي بحثاً عن علاج. علاوة على ذلك، لم يُحاسب القتلة وحتى أن العدد النهائي للضحايا والقتلى ما يزال غير واضح.
يسترجع المقال التسلسل الزمني للأحداث الأمنية التي رافقت تظاهرات تشرين الأول، لتبيان كيف أن عمليات القتل التي جرت ضد المتظاهرين لم تكن فرديّة، وإنما مؤسساتية ومتغلغلة كاستراتيجية للتعامل مع الاحتجاجات التي تهدّد النظام السياسي في العراق.
كيف بدأ كل شيء؟ مدافع الماء التي أحرقت العراق
في العراق، الدولة ذات الاقتصاد الريعي، والتي تعيش فيه الطبقة السياسية صراعاً محتدماً يتمحور حول كيفية الضغط باتجاه ضمان حصص القوى المتنافرة داخل المؤسسات الحكومية، بالطريقة التي تمنح هذه القوى فرصة سرقة المال العام وديمومة وجودها السياسي، من الترف أن نتوقع إدراك السلطة لتداعيات أخطائها، فهي لا تنظر الى الأخطاء ضمن هذا التوصيف، وهي تدافع عنها دوماً، ولاسيما في جانب الأمن والمؤسسة العسكرية، ولطالما عاش البلد أعواماً من العنف الرهيب كان يمكن تدارك أضرارها لو اعترف النظام أنه مخطأ ويحتاج الى تصويب أخطائه ومعالجتها. بدأ الأمر في هذا السياق، وتم قمع الكلمة التي كانت تقال بلسان الرجاء، لتتحول الى صراخ يطالب بزوال النظام.
جاء ذلك في احتجاجات لم يشهد لها العراق مثيلاً منذ إعلان دولته الوطنية عام 1921. نعم، الكلمة المقموعة هي البداية لكل شيء حدث، الدماء التي سالت والبنادق والهراوات وأقبية الاعتقال والإخفاء التي استعملت، والتغييرات التي حدثت بكل ما فيها من تناقضات وخطوات للأمام أو الخلف، كلها جاءت بسبب تعمّد النظام “الخطأ” والدفاع عنه وتمجيده احياناً.

القصّة بدأت في نهار يوم 25 أيلول 2019، وفي بغداد، وداخل المنطقة الخضراء حيث المقار الحكومية والتشريعية وغرف صناعة القرار، تم إنهاء اعتصام أقامه عدد من حملة شهادات (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) دام ما يقارب المئة يوم أمام مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي[1]، كان هؤلاء المعتصمون يطالبون بتوظيفهم في دوائر الدولة وتخليصهم من حياة البطالة المذلة، وهنا آمنت السلطة بضرورة قمع الكلمة رغم أن أسلوب فض الاعتصام أقل عنفاً مما سيليه من عمليات قمع واستهداف للاحتجاجات والاعتصامات. حينها، كان عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق منتشياً بمنجزاته التي ذكرها مراراً، ومنها فتح المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً أمام المواطنين، وعقده سلسلة اتفاقات مع الصين التي كان عائداً منها إبان فض الاعتصام بفارق ساعات قلائل فقط.
انتشرت صور قليلة لفض اعتصام الخريجين كالنار في الهشيم، وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في الغالب، ولامست جرحاً انسانياً في المتلقي العراقي، حيث كانت بعض المعتصمات ممن طالبن بالتوظيف مع زملائهن قد تعرضن للإذلال بمدافع الماء، مما رسمهن في المخيال العراقي كطيور مبللة لا تقوى على الهروب. كانت هذه اللحظة رسالة بصرية ذهبت عميقاً في غضب شريحة الشباب وأعادت شحنه تمهيداً للانفجار الكبير بعد أيام قليلة من ذلك النهار العادي.
ممهّدات تشرين والتهيئة الذهنية لقمعها
لم تخل ممهدات احتجاجات تشرين الأوّل عام 2019 من نبوءات وتهديدات بين أطراف السلطة، رغم أن جميع صنّاع القرار تفاجأوا لاحقاً من حجم ما توقعوه أو هددوا به ضمن صراعاتهم المستمرة منذ تأسيس النظام السياسي الجديد عام 2003.
في البداية، كان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قد منح رئيس الوزراء المكلف حينها عادل عبد المهدي مهلة بدأت في 2 تشرين الأول 2018، وهي المهلة التي انتهت مع انطلاق احتجاجات تشرين الأول 2019 دون ترابط بين الأمرين بحسب مصادر من داخل الصدريين([2])، ومن جانب آخر، توقع قيس الخزعلي أمين عام عصائب أهل الحق، وهو فصيل مسلح وجزء من العملية السياسية والحشد الشعبي، أن تخرج تظاهرات تطيح بحكومة عبد المهدي في الشهر العاشر لأسباب وصفها بأنها تتعلق بموقف العراق من صفقة القرن، وكان تصريحه هذا في يوم 26 آب 2019([3])، أي قبل انطلاق احتجاجات تشرين الأول بشهر تقريباً.
غير أن ممهدات الاحتجاجات كانت أكثر من ذلك، إذ جاءت إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي يوم 27 أيلول 2019 الى إمرة وزارة الدفاع، بعد أن كان قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، المؤسسة القتالية المعنية بمواجهة الإرهاب ولها دور كبير في هزيمة “داعش”، لتزيد الطين بلة، حيث اكتسب الساعدي نجومية شعبية بين العراقيين إبان معارك تحرير المحافظات الشمالية والغربية من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بين أعوام 2014 و2017، مما جعل الشباب المتحفز للتظاهر أكثر حنقاً وهو يرى السلطة تقصي قائداً عسكرياً لطالما داعب مظهره واسلوبه خيال الناس وامنيات بعضهم في حدوث انقلاب عسكري بقيادته ينهي العملية السياسية المليئة بالفاسدين.
يشبه الساعدي، من جوانب ظاهرية، عبد الكريم قاسم الذي قاد انقلاب 1958 في العراق على الملكية الهاشمية، والذي ما زال أحفاد النازحين الى العاصمة بغداد يحبونه لأنه كان منصفاً وعادلاً وفقيراً ينتمي لطبقتهم الاجتماعية، بحسبهم. الساعدي، والحال هذه، في عيون هؤلاء ينحدر ايضاً من أسرة فقيرة ويوحي مظهره البسيط وغير المتكلف بالنزاهة التي يحلم بها العراقيون، حيث يؤمن جزء كبير من العراقيين أن الطريق نحو تغيير سلمي في واقع إدارة الحكم بات مغلقاً في ظل تغوّل الأحزاب التي تعيد انتاج نفسها دائماً وفق انتخابات تصمم هي قانونها والمفوضية المشرفة عليها بما يتوافق مع مصلحتها دون إمكانية فسح المجال أمام أي قوى جديدة، لذلك تجد الفقراء ومن يشعرون بالخوف في ظل الانفلات الأمني المستحكم، يتمنون حدوث انقلاب عسكري بقيادة عبد الوهاب الساعدي أو من يشبهونه في بلد له تاريخ انقلابي عريق، حيث شهد العراق انقلابات في أعوام 1936، و1941، و1958، و1963، و1968[4]، وهذه جميعها انقلابات ناجحة، وهناك عدد كبير أيضاً من محاولات الانقلاب الفاشلة[5].
كل ما سبق كانت أحداثاً تحفز التظاهرات الواسعة التي ستندلع يوم 1 تشرين الأول 2019، والتي ستترك أثراً كبيراً في حياة العراقيين ونظرة العالم لهم ولدولتهم التي أسست على ركام الانظمة الدكتاتورية ومرّت عليها دبابة الابرامز الأمريكية مطلع الألفية الجديدة.
موجة تشرين الأولى وطبيعة التعامل الأمني معها
بعد الساعة العاشر صباحاً من يوم 1 تشرين الأول 2019 بدأت أعداد من المتظاهرين بالتجمهر في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وقبيل منتصف النهار كان العدد قد زاد وانقطعت حركة السيارات في محيط المنطقة، حيث بادرت السلطات الى اغلاق جسر الجمهورية الواصل بين الساحة والمدخل الشمالي للمنطقة الخضراء، ومع استمرار التحشد وقع إطلاق نار من جهة الجسر باتجاه المتظاهرين بشكل عشوائي، وخلال الساعات اللاحقة التي شهدت سقوط اوائل الضحايا اتضحت استراتيجية السلطات بدفع المتظاهرين باتجاه عكسي نحو المناطق التي اتوا منها، حيث بدأ المتظاهرون بالتراجع تحت الضغط من ساحة الطيران الى منطقة شارع فلسطين وصولاً الى منطقة البلديات في خط عمودي حالت القوات الأمنية دون انتشار المتظاهرين في الشوارع الافقية المتعامدة عليه.
الاتجاه الذي تم دفع الجزء الأكبر من المتظاهرين نحوه في ذلك النهار يحدد خلفيتهم الاجتماعية والمذهبية، حيث أن هذا الجزء الشمالي الشرقي من بغداد يسكنه في غالبيته العظمى شيعة من الطبقة المسحوقة والوسطى وتعود أصول غالبيتهم الى جنوب العراق قبل ان ينزحوا في ثلاثينيات القرن الماضي وما بعدها الى العاصمة.


خلال 6 عقود خضعت مناطق بغداد التي يسكنها النازحون من الجنوب إلى هندسة أمنية اتقنتها الأنظمة المتعاقبة، وقد نجحت الحكومات في تعطيل قوة الحشود في هذه المناطق مراراً. ففي عام 1963 تم إبطال زحف جماهير غفيرة كانت في طريقها لإنقاذ نظام عبد الكريم قاسم من الانقلاب الذي قاده البعثيون. وبعد ذلك، سيطر نظام البعث على هذه المناطق عبر زرع مقترباتها بمؤسساته القمعية الرهيبة من الشرق والغرب، وبعد احتلال العراق عام 2003، نجح الجيش الأمريكي والحكومات العراقية في تطويق هذه المربعات السكنية المتجاورة على مراحل، وخاصّة في أعوام 2004، و2005 و2008 وذلك إبان المواجهات مع التيار الصدري[6].
ما حدث في تشرين الأول 2019، كان عشوائياً في مرحلته الأولى، وامام اندفاع غير منظم للمتظاهرين فقد بات عنف القوات الأمنية قاتلاً ومفتقداً لأي حسابات منطقية يعتمدها القادة الأمنيون عادة، ونتيجة لذلك فقد سقط عدد كبير من القتلى برصاص كثيف تم اطلاقه دون مبرر أمني.


ورغم أن تقارير دولية اشارت في أعوام سابقة الى وجود 9 ملايين قطعة سلاح خارج إطار الدولة بالعراق[7]، إلا ان الليالي العنيفة والساخنة لم تشهد ردة فعل عنيفة من أهالي الضحايا ورفاقهم المتظاهرين، وهو ما شكّل ظاهرة متميزة في بلد منفلت أمنياً منذ 17 عاماً، ويستعمل فيه السلاح لأصغر الأسباب وأكبرها. لكن مرد عدم استخدام السلاح يعود لسببين رئيسيين، أوّلهما هو أن لجوء المتظاهرين إلى السلاح يعني خسارتهم “السلميّة” التي شكّلت حراكهم وبالتالي خسارتهم لتعاطف المجتمع معهم، وثانياً هو خوف من اندلاع اقتتال شيعي – شيعي متوقع، لم تدخر قوى السلطة وجماهيرها وسعاً في الترهيب من مآله، مما جعل الأهالي والعشائر والقوى الاجتماعية الغاضبة تعض على النواجذ خشية من حرب الأخ مع أخيه والتي لا يمكن إيقافها في حال نشوبها بوقت قصير أو تضحيات قليلة.
وقد تكرر العنف من السلطة أكثر من مرة خلال الايام السبعة الاولى للاحتجاجات قبل توقفها في اليوم الثامن بشكل مؤقت ريثما تنقضي زيارة اربعين الامام الحسين في كربلاء، وقد خرجت تظاهرات في ميسان وواسط باليوم الاول وتم منع تظاهرات البصرة بالقوة.
شهد اليومان اللاحقان سقوط 18 متظاهراً، وقامت السلطات بفرض حظر التجوال وقطع خدمة الانترنت عن العراق بالكامل عدا اقليم كردستان، وعاشت المناطق الشعبية في الرصافة شمال بغداد ليالي ساخنة بفعل قطع الطرقات من قبل المحتجين وتحول مجالس عزاء ضحايا التظاهرات الى بؤر تحشيد تدعم الاخذ بالثأر من السلطة بوصفها المسؤولة عن مقتل ابناء هذه المناطق التي يغلب عليها الطابع العشائري، الأمر الذي لم يتفاقم بسبب تداخل جماهير قوى السلطة مع بقية الممتعضين منها.
ولأن عبد الوهاب الساعدي ونجوميته كانا سبباً في الغضب الاساس الذي انطلقت منه الاحتجاجات، فقد رُفعت صوره ومطالبته بقيادة انقلاب عسكري للسيطرة على مفاصل الدولة في اغلب الساحات، الامر الذي دفع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الى الخروج بمؤتمر صحفي للحديث عن مؤامرة انقلابية تم اسقاطها، وهو الخطاب الذي زاد من استفزاز الجموع بشكل كبير وتسبب باستياء عام يوم 8 تشرين الأول 2019. منذ ذلك الحين بدأت جموع المتظاهرين بنصب خيام في ساحة التحرير، وهو الامر الذي سيستمر لأكثر من عام لاحقاً، معلنة بداية اعتصام طويل في قلب بغداد وصداع في رأس العملية السياسية.
فرضية القنّاص في الاسبوع الأول من احتجاجات تشرين
في اليوم الرابع من الاحتجاجات، قام ناشطون وبالتنسيق مع إعلاميين عراقيين يعيشون خارج العراق بتوثيق مشاهد مصورة لإصابات طالت المتظاهرين تم وصفها بأنها “حالات قنص”، وقد نقل مكتب وكالة رويترز ببغداد خبراً عن مصادر خاصة بها من داخل القوات الامنية العراقية اتهمت فيه فصيلاً من الحشد الشعبي – تحديدا سرايا الخراساني بحسب عدد من المدونين – بأنه يقف وراء قنص المتظاهرين.
فيما شهد اليوم الخامس من الاحتجاجات قيام قوة مسلحة (تم اعتقال افراد منها لاحقاً واتضح انتماؤهم الى مديرية أمن الحشد الشعبي) بالاعتداء على مقرات قنوات فضائية وشركة للبث الفضائي تقدم خدمات لقنوات عربية على خلفية نقلها للتظاهرات.
لاحقا، وبعد انتهاء الموجة الاولى من الاحتجاجات ليلة يوم 7 تشرين الأول 2019، شكلّت السلطة بضغط من مرجعية النجف ومنظمة العفو الدولية وعدد من البعثات الدبلوماسية لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب العنف ضد المتظاهرين، وترأس اللجنة وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، وكان أبرز ما جاءت به اللجنة سقوط 149 قتيلاً في صفوف المتظاهرين و4207 جريحاً، إضافة إلى ثمانية قتلى من قوات الأمن في عموم العراق.
وتضمن تقرير نتائج التحقيق إحصائية صحية لدائرة الطب العدلي تبين أن 70% من الإصابات لقتلى المظاهرات في منطقتي الرأس والصدر، وهو ما عزّز لجوء السلطات الأمنية إلى استخدام قنّاصين في البنايات المحيطة بمنطقة التظاهرات، غير ان التحقيق لم يتهم الحشد الشعبي واوصَ بإحالة قادة امنيين وعسكريين بما فيهم مسؤول حماية شخصية في رئاسة الجمهورية الى التحقيق بعد اعفائهم، وهو ما جعل السياسيين والمدونين المنحازين للاحتجاجات يشككون بقيمة التحقيق.



لكن التحقيقات والأحداث تُثبت، بما لا يقبل الشكّ، أن القوات الأمنية -رسميّة كانت أم لا- كانت تهدف إلى قتل المتظاهرين. فاغلفة الرصاص المكتشفة فوق أسطح أحد البنايات والتي تم توثيقها في تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في اسباب العنف وهي من نوعية 5.8 × 42 ملم، وبحسب خبراء، يمكنها ان تستعمل لأسلحة القنص وللأسلحة العادية، وعلاوة على ذلك، فإن إطلاق الرصاص الحي بكثافة وبشكل عشوائي على جموع يصيب عدداً كبيراً بإصابات قاتلة.
وقد اثبتت الأيام القصدية في استهداف رؤوس المتظاهرين عبر قنابل الغاز المسيل للدموع، مما يعزز القصدية في استهداف المتظاهرين قنصا في الأيام الأولى لتظاهرات تشرين الأول، حيث أن الغطاء الحكومي للقوى القامعة وفّر مساحة نجاة للقتلة من خارج القوات الأمنية وهو ما يجعل الغطاء مناسبا للقوات نفسها أكثر إقناعاً، وقد ظهرت تبريرات حكومية لاحقة لا بد من ذكرها رغم هزالتها وشناعتها، ومنها انتشار تعاطي عقاقير الهلوسة بين المنتسبين الأمنيين من جهة وكذلك عدم تدرّب هذه القوات على مكافحة الشغب بطريقة صحيحة من جهة أخرى، بالإضافة الى ربط عنف المنتسب الأمني الحكومي بعودته القريبة من ساحات المعارك ضد الإرهابيين.
ولا يُمكن فهم هذه التبريرات، إلا على أنها محاولة من الجهات الرسمية لحرف الأنظار عن قرار استخدام الرصاص والقتل من منهجية معتمدة في التعامل مع التظاهرات، إلى تحويلها لأحداث فرديّة يتحمل مسؤوليتها أفراد داخل المؤسسة الأمنية.
وفي الواقع، فإن هذه التبريرات تحوّلت، في وقت لاحق، إلى منهجية لدى المؤسسة الأمنية، إذ أنها لم تحاكم ضباطاً ورتباً كبيرة منحت أوامر مباشرة باستخدام الرصاص الحي، وقامت، بدلاً من ذلك، بمحاكمة عناصر أمنية نفذّت أوامر قادتها[8].
انتقال الشرارة الى المحافظات الجنوبية
بالإضافة الى بغداد، شهدت محافظات ذي قار والبصرة وميسان وواسط والديوانية والنجف وكربلاء وبابل والمثنى احتجاجات مماثلة في الايام السبعة الاولى، غير ان طبيعة الاحتجاجات في ذي قار اتخذت بعداً أكثر عنفاً، مع استمرار احراق مقرات الاحزاب الاسلامية الشيعية (ما عدا مقرات التيار الصدري) بالإضافة الى الحزب الشيوعي، وهذه الظاهرة كانت تكراراً لما شهدته تظاهرات البصرة عام 2018 على خلفية ارتفاع ملوحة المياه وفشل الحكومة المحليّة في توفير الخدمات، غير ان مسلسل الحرائق سيستمر ويطال قنصليات إيرانية وبيوتا للمسؤولين[9] وهو ما سيخلق تبعات خطيرة وموجات عنف ارتدادية لاحقاً.
من جهة ثانية، تبلورت صفة ساحات احتجاج جديدة في المحافظات على غرار ساحة التحرير، وكانت أبرزها ساحة الحبوبي في ذي قار، وساحة ثورة العشرين في النجف، وساحة البحرية في البصرة، وبات لكل محافظة ساحة احتجاجها الخاصة والتي شهدت لاحقاً نصب خيام للاعتصام في كل واحدة منهن ما عدا بعض الاستثناءات.
وقد تحولت الساحات المتناسلة من ساحة التحرير الأم الى ملاذات للمتظاهرين الخائفين على حياتهم، خصوصاً بعد حالات الاعتقال والاختطاف التي رافقت عودة بعضهم إلى بيوتهم، بالإضافة الى رغبة عدد كبير من شباب التظاهرات بالتحرر من الضغوط الأسرية التي تطالبهم بالتوقف عن الاحتجاج، وصولاً إلى مرحلة بات البقاء في الساحات والخيم يمثل انقطاعاً لبعض المتظاهرين عن المجتمع الذي باتوا يرونه مدجناً حسب وجهات نظرهم الغاضبة والحانقة.
الموجة الثانية من الاحتجاجات
بعد البداية الارتجالية للتظاهرات على مستوى المحتجين وعلى مستوى ردة فعل السلطة، جاء وقت التنظيم، واستعد الطرفان للجولة الثانية بطريقة أكثر حنكة.
قامت السلطة، بتطويق ساحات الاحتجاج وعلى رأسها ساحة التحرير عبر قطع الشوارع المؤدية لها ونشر القوات الامنية في مداخلها، وكانت الصفوف الاولى للقوات الامنية بمواجهة المحتجين ليلة 24 تشرين الأول 2019 لا تحمل اسلحة قاتلة، إلا ان ذلك لم ينه الكارثة ابداً.
من جانبهم، عبّأ المتظاهرون أنفسهم جيداً، ثم قاموا بالاستقرار في ساحة التحرير في بناية متروكة مشرفة على نهر دجلة وجسر الجمهورية تسمى شعبياً بالمطعم التركي، حيث اسموها المتظاهرون “جبل أحد”[10]، مكسبيها صفة برج المراقبة ومشاغلة قوات مكافحة الشغب، وستكون هذه البناية مصدراً للكثير من الحكايات على مدى أشهر لاحقة، وقد انطوت رمزية المطعم التركي على ثنائية بليغة جداً، اذ ان البناية نفسها كانت مقراً للقوات الحكومية القامعة للتظاهرات السابقة في ساحة التحرير على مدى عقد كامل، حتى ان بعض السياسيين الشامتين بالمتظاهرين اعتلوا تلك البناية في تظاهرات عام 2011[11]، وهكذا مثّلت السيطرة عليها رد اعتبار للمتظاهرين من قامعيهم، كما ان البناية تمثل بالنسبة للعراقيين دلالة واضحة على فشل النظام وعجزه، خصوصاً وانها بقيت مهجورة لنحو 17 عاماً في قلب بغداد بحجة أنها قصفت من قبل القوات الامريكية بقنابل تحتوي اليورانيوم المنضب في عام 2003.
شهد يوم 25 تشرين الأول 2019 الكثير من الحراك باتجاه المباني الحكومية في عموم محافظات الجنوب، وتم حرق الكثير من المقار السياسية، ومحاصرة بنايات الحكم المحلي رغم فرض حظر التجوال، ولم تكن هذه التحركات بدون تضحيات مؤلمة بلغت 40 قتيلاً وإصابة أكثر من 1700 آخرين بجروح في اليوم الاول فقط[12].
العصيان المدني
في هذه الايام، ظهرت فكرة الاضراب العام ودعوة الطلبة والموظفين إلى تعطيل الحياة العامة وتفعيل العصيان المدني، ثم ظهرت مجاميع – في الجنوب غالباً – تسمى (افواج مكافحة الدوام)، وكان جمهور التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، عنصراً اساسياً في هذه الجماعات، وفي يوم 27 تشرين الأول 2019 توِّجت هذه الجهود بخروج تظاهرات طلبة المدارس والكليات بملابسهم البيضاء لتكون لحظة فاصلة في تاريخ الاحتجاجات بالعراق، حيث غابت مشاركة الطلبة بالشأن السياسي العام منذ ستينيات القرن الماضي، وباتت صورة افواج الطلبة داخل النفق المؤدي الى ساحة التحرير بداية كل أسبوع مظهراً اساسياً في الاحتجاجات وزخماً قوياً داعماً لها.
ومع نصب الخيام برزت ظاهرتان كانتا عنصراً اساسياً في ادامة الاحتجاجات، الاولى هي ظاهرة المفارز الطبية لكوادر من المسعفين والمسعفات والذين قاموا بمعالجة غالبية حالات اصابة المتظاهرين قبل نقلهم الى المستشفيات، والثانية هي ظاهرة المواكب الحسينية التي انتشرت في ساحات الاحتجاج لتقديم المساعدات كالغذاء والماء وعدد كبير من الخدمات، وقد ساهم في الكثير من تلك الجوانب نقابات مهنية ومنظمات انسانية، غير ان السلطات الرسميّة تحدّثت عن “خطوط تمويل” بمبالغ كبيرة قد اتصلت بساحات التظاهر ومصدرها كان من خارج العراق في الغالب -في اشارة الى دعم خارجي لتقويض النظام، وهذا الامر اكده متظاهرون لكنهم قللوا من حجم المال السياسي المنفق قياساً إلى التبرعات الخيرية الوطنية، كما انهم أدانوا شكلاً من اشكال التبرعات جاءت من الخارج وتم طرد من أوصلها أحياناً وبُرّر رفضها بهزالة مواقف من يقف وراءها أو شذوذه الفكري والسياسي[13].
مطلع شهر تشرين الثاني ٢٠١٩، شهد بداية قطع الطرق باتجاه حقول النفط في جنوب العراق، وتحديداً في البصرة وميسان وذي قار، وقد بادرت السلطة إلى فتح الاعتصامات الخانقة لصناعة النفط بالقوة بغية وصول الموظفين الى الحقول وضمان استمرار تدفق المورد الاساس للعراق مالياً، لكن هذا الامر لم ينجح وبقيت الامور تتصاعد بين الحين والآخر، ثم تطورت الى محاصرة موانئ البصرة ومحاولة قطع الطريق السريع الرابط بين محافظات الجنوب وبغداد وهو الأمر الذي سيتكرر ولأكثر من عام، تزامن ذلك مع انخفاض حاد بأسعار النفط وأزمة اقتصادية شديدة.
وأظهرت الحركات الاحتجاجية التي حاصرت حقول النفط والموانئ وقطعت الطرق السريعة تطوراً في عقلية المعارض للنظام الريعي والمنتفعين منه، حيث باتت حقول النفط رمزية إضافة لسبب أساس من أسباب فشل النظام الذي وجد قدرته على البقاء في استنزافها وتقاسم مواردها، برغم ان عدداً كبيراً من المحتجين كانوا يريدون ضمان فرص توظيف في تلك الحقول قبل وبعد احتجاجات تشرين الأول.
الاغتيال والاختطاف أو الاعتقال المزامن للاحتجاجات
شهدت الموجة الاولى والثانية التي استمرت طويلاً من احتجاجات تشرين الأوّل عدداً كبيراً من حالات التغييب التي كان اغلبها اعتقالاً لم تتضح فيه الجوانب القضائية المعهودة، فيما حدثت عمليات اختطاف أقل تم إطلاق سراح بعض المختطفين فيها وبقي عدد منهن في حالة تغييب لم تنجح السلطة في ايجاد حل لها حتى بعد تغيير الحكومة، وقبيل انتهاء الشهر العاشر من التظاهرات كانت الحصيلة 158 معتقلاً، أطلق سراح 123 منهم وبقي 35 معتقلاً في حينها[14].
اما على مستوى الاغتيالات التي بدأت في البصرة بعد يوم واحد من اندلاع الاحتجاجات وراح ضحيتها ناشط وزوجته تمت تصفيتهما داخل البيت[15]، فلم تتوقف رغم التباعد الزمني لحالات الاغتيال، واستهدفت ناشطين وناشطات في عموم بغداد والمحافظات الجنوبية، وتنوعت طرق الاغتيال بين استعمال القتلة لدراجات نارية تطارد الضحية او اقتحام بيوتهم وإطلاق النار المباشر عليهم، في حين كان استعمال القنابل أقل ولم تتجاوز حالات القتل بهذه الطريقة الحالتين في مجمل الاستهدافات.
وقد باتت الصناعة الإعلامية المناوئة للتظاهرات غطاء لعمليات الاغتيال والاختطاف والاعتقال وشرعنة لها، مما يؤكد تصميم السلطة على اتباع هذا النهج واستبعاد كونه تخبطاً في القرارات، كما ان نشاط بعض الفصائل المسلحة في استهداف أسماء محددة من قيادات الاحتجاج ضمن تبريرات سياسية يكمل الصورة، اذ ان الحكومة والطبقة السياسية الصانعة لها منحت تلك الجماعات المسلحة فرصة الدفاع عن النظام باعتقادهم أنه نظام شيعي مدعوم من إيران ومستهدف من السنة وحلفائهم الخارجيين، وعلى ضوء ذلك فقد تم اعتبار مواجهة النشطاء الشيعة واغتيالهم امتداد للحرب على الإرهاب.
قنابل الغاز القاتلة
في الموجة الثانية للاحتجاجات، بعد 25 تشرين الأول 2019، استبدلت السلطة القناص ليحضر بدلاً منها قتل المحتجين عبر اطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه رؤوسهم مباشرة من قبل قوات مكافحة الشغب والقوات الامنية ايضاً، وفي يوم 28 تشرين الأول 2019 سقط صفاء السراي احد قدماء المحتجين الشباب في ساحة التحرير والذي سيصبح لاحقاً ايقونة للاحتجاجات بالطرقة هذه، حيث تم خرق رأسه بقنبلة غاز ادت الى وفاته قرب جسر الجمهورية، وعلى مدى عام لاحق من الاحتجاج سيتكرر القتل بهذه الطريقة كثيراً رغم حديث السلطة المتكرر عن عدم اعطائها موافقة بإطلاق النار او تصويب اسلحة تفريق الجموع الى رؤوس المتظاهرين.
معركة الجسور
اختار جزء من المتظاهرين، غالبيتهم من جمهور التيار الصدري الاتجاه شرقاً من ساحة التحرير لتعطيل جسري السنك والشهداء، ونجحوا في السيطرة على مرآب مطل على نهر دجلة وجسر السنك ليكون مماثلاً للمطعم التركي (جبل احد) في ساحة التحرير، لكن اعداد المتظاهرين بدأت بالتناقص كلما ابتعدوا عن موقعهم الاساس في قلب بغداد، ورغم كتابة شعارات تدعو لإغلاق المقرات الحكومية في عموم مناطق الرصافة ابان حظر التجوال، الا ان الحياة كانت تعود الى طبيعتها كلما تم رفعه، ولم تبلغ نسبة الموظفين المضربين عن الدوام نسبة كبيرة في بغداد قياساً الى محافظات الجنوب، ورغم شيوع ظاهرة التنمر على الموظفين الحكوميين غير المنقطعين عن دوائرهم في مواقع التواصل، إلا ان هذه الظاهرة لم تتسرب الى الشارع المحتقن وهو ما يعزز مفهوم انضباط التظاهرات في عدد من جوانبها.
حتى ذلك الحين، كان عدد ضحايا القمع قد بلغ 319 شخصاً على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات. ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أصيب 15000 آخرين بجروح[16].
المجازر
قبل ان ينتهي تشرين الثاني ٢٠١٩، وهو الشهر الثاني للاحتجاجات، وقبل يوم واحد من قبول البرلمان استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، شهدت النجف موجة عنف بالقرب من مرقد محمد باقر الحكيم بعد محاولات من محتجين لاقتحامه وحرق بوابته الرئيسة.
وفي توقيت مقارب، شهدت الناصرية مجزرة راح ضحيتها العشرات من المحتجين قرب جسر الزيتون، وجاءت المجزرة بعد وفود قوات من الرد السريع (أحد الاذرع الامنية الحكومية) لحقها تنسيب الفريق الركن جميل الشمري مشرفاً امنياً على ذي قار، غير ان اوامر بإطلاق النار المباشر فضحت آلية السلطة لضبط الوضع في المحافظة الجنوبية وتسببت بانعدام الثقة تماماً بين القوى الفاعلة فيها من جهة والسلطة في بغداد من جهة اخرى.



وفي يوم 5 كانون الثاني 2019، خرجت تظاهرات تطالب بتنفيذ مطالب مرجعية النجف والتي نصّت ضمناً على ضرورة تنقية المتظاهرين صفوفهم من مفتعلي الشغب والمندسين، وكانت هذه التظاهرات عبارة عن أول احتجاج جماعي لجمهور الحشد الشعبي منذ تأسيسه، وقد قرر المحتجون الذين يوصفون بـ (الولائيين)[17] الذهاب باتجاه ساحة التحرير التي دخلوها دون مصادمات، غير ان مصادر اتفقت على ان عدد من هؤلاء المحتجين تم اختطافهم، واشيع ان من قام بذلك هم جماعات تابعة للتيار الصدري، حيث كان جمهور الصدريين قد ادعى حماية التظاهرات بواسطة مجموعة من اتباعه اطلق عليهم “القبعات الزرقاء”. في اليوم التالي، حدثت مواجهة عنيفة في مرآب السنك بين متظاهري الحشد الشعبي وبين محتجين غالبيتهم من الصدريين، وقررت هيئة الحشد الشعبي التدخل مستعملة اطلاق النار الحي مما تسبب بسقوط ضحايا في محيط المرآب وساحة الخلاني وعلى مقربة من ساحة التحرير[18].
وقد استمرت المجازر حتى شهر شباط من عام 2020، حيث شهدت ساحة الصدرين في النجف موجة عنف جديدة راح ضحيتها أكثر من عشرين ضحية سقطوا نتيجة التصعيد بين جمهور التيار الصدري والمدنيين من المحتجين الرافضين لوجود الصدريين في الاحتجاجات كونهم أحد اقطاب السلطة[19].
الصراع بين الوجود الأمريكي وحلفاء إيران
سبقت الاحتجاجات عدد من الخروقات الجوية وعمليات القصف الممنهجة طالت عدداً من مواقع الحشد الشعبي في العراق، بحسب التصريحات الامريكية المعلنة فان اسرائيل كانت وراء هذه العمليات بحجة وجود صواريخ بالستية ايرانية بحوزة عدد من الفصائل بالعراق يمكنها ان تطال تل ابيب[20]، وعلى ضوء هذه الاستهدافات انتهت هدنة غير معلنة بين الوجود الامريكي في العراق منذ 2014 وبين الفصائل الشيعية المسلحة المتحالفة مع ايران، وكان قصف احدى القواعد ومقتل متعاقد امريكي من اصول عراقية سبباً في هجمات امريكية ضد مقار للحشد الشعبي بالتزامن مع الاحتجاجات.
كانت الفترة ما بين 29 كانون الأول 2019 حيث قصفت الطائرات الامريكية مقراً للحشد الشعبي وقتلت 25 مقاتلاً على الحدود العراقية السورية وبين 3 كانون الثاني 2020 حينما قامت طائرة مسيرة امريكية باغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في مطار بغداد الدولي من أشد الفترات ضغطاً على الاحتجاجات، حيث انقسم المتظاهرون الى فريقين. لم يخفِ الفريق الاول سعادته بمقتل قائد فيلق القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بحجة انهما داعمان لحكومة عبد المهدي ولهما يد في قمع الاحتجاجات، والثاني لا يريد ان يقف في صف قوات غازية تنتهك السيادة العراقية. ورغم محاولة الجمع بين الموقفين في بيانات موحدة، إلا ان الانقسام بدأ يزداد يوما بعد آخر، ومع انسحاب جمهور التيار الصدري من الاحتجاجات وظهور بوادر انتشار فايروس “كورونا” في العالم والعراق ضمناً، ثم احتجاب المرجعية عن اقامة صلاة الجمعة التي منحت المتظاهرين دفعاً معنوياً كبيراً، وكذلك استقالة عبد المهدي التي فتحت باب المزايدات على من يخلفه مما اضعف الساحة وسمح لجماهير كتل سياسية باختراقها لإدعاء تمثيلهم للمتظاهرين وترشيح من يريدونه للموقع الابرز، كل هذه الاسباب ادت في المحصلة النهائية الى فتور التظاهرات وتقلص اعداد المحتجين في بغداد، رغم استمرار العنف ضدهم في عدد من المحافظات منها ذي قار والبصرة التي شهدت تغييباً لعدد من الناشطين واغتيال عدد آخر.
الخلاصة لا تكفي!
بدأ مشهد تظاهرات تشرين وانتهى، ولم تفرز تلك الاحداث الكبيرة قيادة متفق عليها بين مجموع التنسيقيات، وقد ترك ذلك التشظي واللا مركزية فراغاً كبيراً في آلية تحويل الاحتجاجات إلى قوّة سياسية، أو أن ينبثق عنها مؤسسات تضغط على السلطة لإجراء تغيير هيكلي في طريقة التعامل القوات الأمنية مع الاحتجاجات، فضلاً عن محاسبة القيادات التي منحت أوامر بالقتل المباشر للمتظاهرين.
والحال، فإن الحقوقيين المحتجين او المتعاطفين مع احتجاجات تشرين الأوّل عام ٢٠١٩ لم ينتظموا في جبهة واحدة لإدانة السلطة والقمع والعنف داخلياً أو خارجياً، وشهدنا اجتهادات لا تعدو كونها شجاعة فردية – في الغالب – فرضتها ظروف المواجهة من اجل إطلاق سراح معتقلين أو توثيق جرائم القتل أو الاختطاف.
ميدانياً، لم يملك المحتجون ما يضمن سلامتهم من القمع الشديد، وكانت بعض الإجراءات البسيطة – مثل درع التحرير وهو تجمع شبابي لصد قنابل الغاز المسيل – دليلاً على ان عنف السلطة أكبر من أن يتم صده أو تقليل ضرره.
من جانب السلطة، فقد نجحت بجميع قواها المتصارعة في الاتفاق على تثبيط الاحتجاجات وتوهينها، وعملت السلطة بكل أذرعها إعلامياً وامنياً وسياسياً على التقليل من زخم الاحتجاجات واندفاعها، وجاءت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتعمل عبر قوى ناعمة تلتقي مع قيادات احتجاجية مؤثرة في مشتركات من اجل فض التظاهرات ورفع الاعتصامات وهو ما جرى لاحقاً.
لقد مثلت الأساليب التي تعاملت بها الحكومة العراقية مع احتجاجات تشرين نموذجاً قريباً من القمع الذي شهدته الاحتجاجات الإيرانية 2009 او احتجاجات الربيع العربي التي انطلقت في ٢٠١١، ولكنها تميزت بعدم تحميل المسؤولية لقوى الدولة الرسمية والحاضرة في الميادين بشكل واضح وصريح ومباشر، وتعدى الأمر تلك القوى الى ادانة قوى غامضة تم وصفها بالطرف الثالث.
النص جزء من كتاب “رائحة الفلفل – تحليل وتأريخ وسير لانتفاضات العراق” الصادر عن دار الرافدين