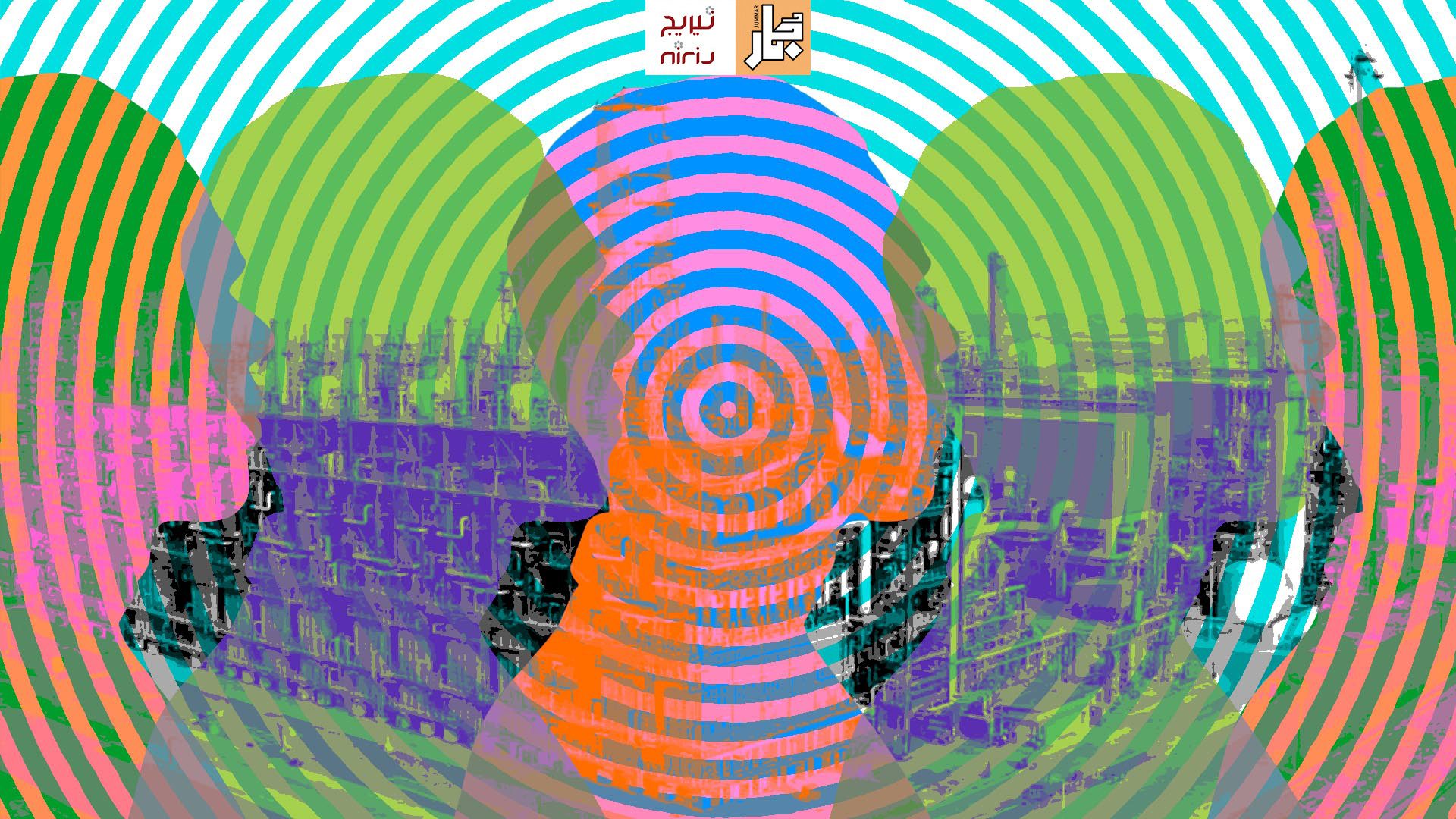"أبناء السلاح".. كيف حوّلت ماكنة الحرب أطفالنا إلى جنود؟
12 شباط 2023
أشبال صدام، أشبال الخلافة، حماة المدن والمذهب والعقيدة، يتنازع أمراء حرب وقادة على هذه التسميات لتصميم مصير أطفال العراق، كلٌّ يبحث عن مستقبل فصيله المسلح، دون انتظار الأطفال حتى يبلغوا ويكونوا قادرين على الاختيار، أو على الأقل أن يتحملوا مسؤولية قرارهم..
كنت طالباً في الصف الثاني المتوسط عام 1999، عندما أُجبرت على المشاركة في تدريبات المسير العسكري وتركيب وتفكيك السلاح الآلي، وحفظ قواعد إطلاق النار، بل وحتى قواعد الاشتباك بالسلاح الأبيض المتصل بسبطانة بندقية الكلاشنكوف.
كان زميلي ضئيل الحجم وعمره 13 سنة، ويجلس في المقعد الأول. طفل فزِع من صيحة المدرب -نقيب- أثناء محاكاته لعملية الطعن بالحربة، شارحاً أهمية هذه الصيحة في إخافة العدو أثناء الاشتباك بالسلاح الأبيض.
بعض هذه التدريبات كان بعد دوام المدرسة وفي مبناها، دون أن يكون لأيٍ منا أو ذوينا رأي أو رغبة في الانخراط فيها من عدمه. فكلُّ هذا كان بقرار رئاسي، وهو جزءٌ من استراتيجية صدام حسين في صنع جنودٍ يموتون من أجل الوطن أو القائد. لا فرق بين الاثنين، فالوطن هو القائد.. والقائد هو الوطن، ومن يضحي في سبيل أحدهما، فقد فعل في سبيل الآخر بالضرورة.
تاريخ تجنيد الأطفال
في العراق الحديث، بدأ تجنيد الأطفال في مطلع القرن العشرين. أُجبر القصّر على القتال في العمليات العسكرية والحروب المتعددة، أو كانوا أدوات في الأعمال اللوجستية لتأمين الخدمات للمعسكرات.
فالعراق كان يقبل متطوعين وطلاب كليات عسكرية من أعمار أقل من 18 سنة حتى، ناهيكَ عن فصائل وميليشيات مسلحة عمادها الأساس من الأطفال، كأشبال صدام مثلاً، وجيش القدس والفتوة وغيرها.
والأولى غُطيت بشكل موسع على التلفزيون، كانت هناك فترة تلفزيونية منتظمة تعرض مقاطع لتدريبهم على القفز المظلي، والقتال الحر، والتدريب على استخدام مختلف الأسلحة في معسكراتِ تدريبٍ مخصصة لهم.
آنذاك، سجّلت المنظمات الحقوقية انخراط آلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة في التدريبات، ثمانية آلاف منهم في بغداد لوحدها!

لم يكن تجنيد الأطفال قبل 2003 حدثاً منفصلاً، أو عملية عشوائية، بل كانت منظمة ضمن منهجية طويلة الأمد تبدأ من المدرسة وحتى مختلف صنوف التشكيلات العسكرية، رسمية وغير رسمية.
كان صدام مهووساً بإظهار العراقيين جميعاً كمقاتلين مستعدين للموت من أجل العراق أو من أجله، وكان مهتماً أيضاً باستدامة جميع تشكيلات وصنوف القوات المسؤولة عن حفظ أمنه ونظامه، والحفاظ على ولائها.
لم يكن الأمر محصوراً بالتشكيلات الخاصة والميليشيات فحسب، ففي تقرير صدر عن منظمة ” Child Soldiers International” عام 2001، وهي منظمة متخصصة بالحد من تجنيد الأطفال، فإن العراق قبل متطوعين للجيش النظامي من سن 15 سنة، رغم أن الدستور والقانون يمنعان ذلك.
وشخّص التقرير ذاته امتلاك أحزاب كردية معارضة مثل الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب العمال الكردستاني لمعسكرات كانت تدرّب أطفالاً لم يتجاوز بعضهم العاشرة على القتال ضد قوات الجيش النظامي.
اعتراف عالمي متأخر
حتّى وقت قريب، استخدم الأطفال في الحروب بشكل مباشر، كمقاتلين، وبشكل غير مباشرٍ، كسُعاةٍ وطهاة، وجواسيس، وتعرّضوا للعنف واستغلوا جنسياً، ورغم ذلك، فإن القانون الدولي لم يُجرِّم أي دولة أو مجموعة ترتكب هذا الفعل.
وحتّى مع إقرار “البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977”، لم يتم الاتفاق على تعريف للطفل على أنه كلّ من هو دون عمر الثامنة عشرة. بل نصّ البروتوكول في المادة 77 ثانياً على “عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة”، وإعطاء الأولوية في التجنيد لمن تجاوزوا الثامنة عشرة.
ولم يتم اعتبار تجنيد الأفراد -دون الثامنة عشرة- عملاً منافياً لحقوق الإنسان حتى عام 2000، حين تم إصدار البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي صادق عليه العراق، وانضم له رسمياً في تموز عام 2007.
رغم الغطاء القانوني الدولي، بقيت مشكلة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة قائمة، وغالباً ترتكبها قوات غير نظامية، وخاصّة عند اندلاع نزاعات مسلحة داخلية.
هذه ليست المشكلة الوحيدة، فتكييف القانون المحلي ودعمه للتشريعات الدولية حاجز آخر، فالعراق يحدد حسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 السن القانونية لقبول الضباط بعشرين سنة، والمتطوعين بثماني عشرة سنة. لكن المشكلة الحقيقية في عدم اعتبار اشراك الأطفال أو تدريبهم على السلاح جريمة.
من المسؤول؟
لم تمرّ على العراق بعد عام 2003 فترة سيئة بالنسبة للأطفال، مثل فترة الحرب مع التنظيمات الإرهابية بين أعوام 2014 و2016. قُتل الأطفال فيها تحت حصار داعش، ونتيجة للعمليات العسكرية، إضافة إلى إشراكهم في العمليات العسكرية.
بحسب تقارير أممية وحكومية، استخدم تنظيم داعش الأطفال بطرق بشعة، وذلك عبر تجنيدهم كانتحاريين، وحتى بدفعهم للقتال في مواجهات مباشرة مع القوات العسكرية.
كان لـ”داعش” كيان يختص ببناء الأطفال هو “أشبال الخلافة”، حيث يتلقّى هؤلاء التدريبات العسكرية والدروس الدينية والوعظيّة ليتشرّبوا أفكار التنظيم، والتضحية بالحياة. عماد هذا التنظيم كان أطفالاً تطوعوا أو أرغموا على الانضمام بعد أن قتل التنظيم أسرهم.
بالمقابل، وثقّت تقارير، حالات لأطفال تدربوا في أكثر من خمس محافظات عراقيّة في جنوبه ووسطه وشماله، ضمن فصائل مسلحة مدعومة حكومياً.
حسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن “الأطفال والنزاع المسلح في العراق” فإن جميع أطراف الصراع غير النظامية، متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.
وفي الكواليس السياسيّة والتشريعية لم يكن هذا الأمر بالغ الأهميّة، بل أن نائباً عدّ تسليح العشائر للأطفال على أنها “ظاهرة غير عدائية”، بل واعتبرها في بعض المناطق الساخنة ضرورة.
أطفال يبحثون عن الانتقام!
يعترف العراق عبر ممثليه الرسميين بجرائم تنظيم داعش ضد الطفولة، لكن الاعتراف وحده لا يحلّ المشكلة، ولا يعفيه أمام المجتمع الدولي والمنظمات واللجان الأممية المعنية من إخلاله بالتزامه بالاتفاقات والمواثيق الدولية.
تأريخ العراق في التقارير الدولية سيئ، إذ تشير هذه التقارير إلى تقصير الحكومة نفسها، في أحسن الأحوال، عبر ضعف إجراءات حماية الأطفال. وبينما تعترف بتجنيد داعش للأطفال، فإنها تنفي القيام بالأمر نفسه بالنسبة للفصائل المسلحة الشيعية والسنية والكردية التي قاتلت ضد التنظيم المتطرف.
ليس هذا، بحسب التقرير، إلا مؤشراً على حجم المشكلة وصعوبة حلها.
يوضع العراق على قائمة الدول المنتهكة للطفولة، ولإزالة اسمه، فعليه اتخاذ مسارات ثلاث، أول هذه المسارات هو إيقاف الانتهاكات فوراً، وهو ما أقرّه العراق بالفعل. المشكلة في المسارين الآخرين وهما: إعادة تأهيل وإدماج الأطفال الذين تعرضوا للانتهاك، وتقديم المنتهكين للعدالة. المساران يستلزمان إصلاحين اثنين، أحدهما أصعب من الآخر، فالأول يعني اعترافاً مجتمعياً ودينياً وقانونياً بأن تجنيد الأطفال خطأ حتى يتقبل ذوو الأطفال تأهيلهم، أو يتقبل الأطفال أنفسهم ذلك. والآخر وهو قدرة النظام العدلي على محاسبة مرتكبي الانتهاكات من المتنفذين وأصحاب السطوة.
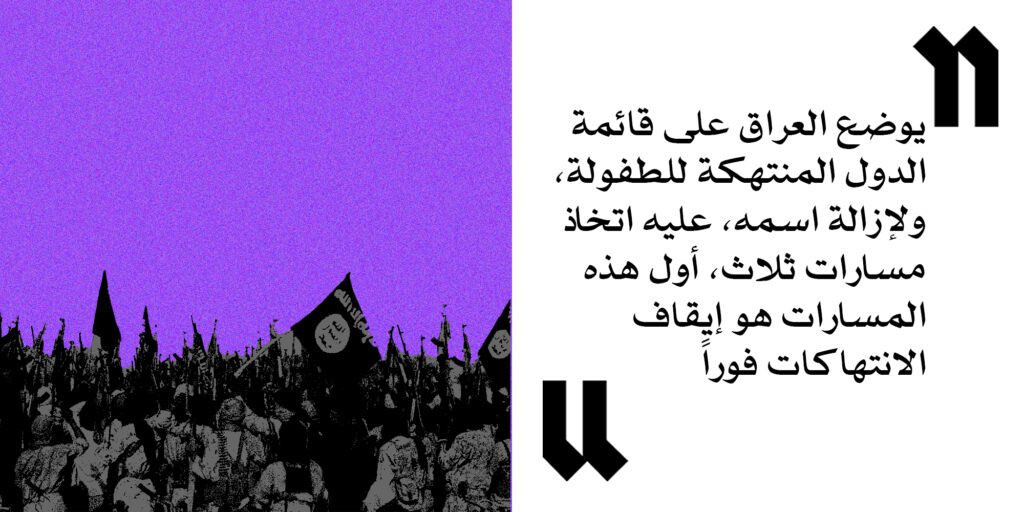
لكن لماذا، بالأساس، جُنّد الأطفال في الحرب على “داعش”؟
يغادر بعض الأطفال طفولتهم مُبكراً نتيجة للظروف الأمنيّة والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من خمسة عقود، ويدفع هذا الكثير منهم للذهاب إلى حمل السلاح. هكذا انخرط بعض القصِّر في الحرب على “داعش”، بعضهم كان دافعه انتقاميا، إذا ما قتل أحد أفراد عائلته. وللفصائل المسلحة دوافعُ أيضاً لاستخدام الأطفال، دينيةٌ، واجتماعية على مستوى العشيرة. فمن سيقاتل تنظيماً حتى أطفاله مقاتلون؟ وأحياناً دوافع التنظيمات سياسية تذهب لاستخدام الأطفال كمقاتلين خارج الحدود، مثلما جرى في الحرب السورية.
دائرة العنف المستدامة
في بحثهما “اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة بين الجنود الأطفال السابقين في العراق”، وجد الباحثان Jan Ilhan Kizilhan وMichael Noll-Hussong أن من بين 83 طفلاً مجنداً تمت معاينة أن 69 منهم مصابون باضطراب ما بعد الصدمة BTSD. ووجدت الدراسة أن غالبية الأطفال المجندين تعرضوا لأحداث صادمة مثل مشاهدة العنف، والأذى الجسدي، والخوف من الموت.
بالإضافة للآثار النفسية الفردية أو المحصورة بنطاق الأسرة، هناك آثار اجتماعية وثقافية على المدى البعيد تخّص مستقبل الأطفال. فهؤلاء الذين جُنِّدوا بأعمار قصيرة، كثير منهم إما في السجون بتهم تتعلق بالإرهاب، أو موصومون اجتماعياً بانتمائهم لجماعات منبوذة.
لكن الأمر لا يتوّقف هنا فحسب، إذ أن عمليات تجنيد الأطفال، جميعها، تتضمن تثقيفاً باتجاه الولاء للجماعة. يُعلّم الأطفال ويُلقنوا الولاء للفصيل لا الوطن، وتُغذى حميّتهم على الجماعة لا المجتمع.
لكن المُجنِّدين لن يعنيهم هذا.
فتحويل الجماعات الموالية للسلطة، الأطفالَ إلى جنود، يُديم دائرة العنف والصراع ويبقيها مستمرة بلا هوادة. وحتّى بزوال المُجنّدين، فإن المجنَّدين يغيّرون ولاءاتهم. مآل ميليشيات صدام بعد 2003، الذين تحوّل أفرادها بسرعة إلى المجاميع المُسلّحة الشيعية والسنيّة، أفضل مثال.
الحال هذه، نحن في دائرة عنف مستدامة نطاقها العشيرة وصراعاتها المسلحة، ونطاقها الأوسع نزاع الفصائل المسلحة مع الدولة على السلطة والهيمنة، وهذا كلّه يغذي عوامل استمرار الفوضى التي قد تمتد لعقود.
ومنكم/ن نستفيد ونتعلم
هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media
اقرأ ايضاً
كنت طالباً في الصف الثاني المتوسط عام 1999، عندما أُجبرت على المشاركة في تدريبات المسير العسكري وتركيب وتفكيك السلاح الآلي، وحفظ قواعد إطلاق النار، بل وحتى قواعد الاشتباك بالسلاح الأبيض المتصل بسبطانة بندقية الكلاشنكوف.
كان زميلي ضئيل الحجم وعمره 13 سنة، ويجلس في المقعد الأول. طفل فزِع من صيحة المدرب -نقيب- أثناء محاكاته لعملية الطعن بالحربة، شارحاً أهمية هذه الصيحة في إخافة العدو أثناء الاشتباك بالسلاح الأبيض.
بعض هذه التدريبات كان بعد دوام المدرسة وفي مبناها، دون أن يكون لأيٍ منا أو ذوينا رأي أو رغبة في الانخراط فيها من عدمه. فكلُّ هذا كان بقرار رئاسي، وهو جزءٌ من استراتيجية صدام حسين في صنع جنودٍ يموتون من أجل الوطن أو القائد. لا فرق بين الاثنين، فالوطن هو القائد.. والقائد هو الوطن، ومن يضحي في سبيل أحدهما، فقد فعل في سبيل الآخر بالضرورة.
تاريخ تجنيد الأطفال
في العراق الحديث، بدأ تجنيد الأطفال في مطلع القرن العشرين. أُجبر القصّر على القتال في العمليات العسكرية والحروب المتعددة، أو كانوا أدوات في الأعمال اللوجستية لتأمين الخدمات للمعسكرات.
فالعراق كان يقبل متطوعين وطلاب كليات عسكرية من أعمار أقل من 18 سنة حتى، ناهيكَ عن فصائل وميليشيات مسلحة عمادها الأساس من الأطفال، كأشبال صدام مثلاً، وجيش القدس والفتوة وغيرها.
والأولى غُطيت بشكل موسع على التلفزيون، كانت هناك فترة تلفزيونية منتظمة تعرض مقاطع لتدريبهم على القفز المظلي، والقتال الحر، والتدريب على استخدام مختلف الأسلحة في معسكراتِ تدريبٍ مخصصة لهم.
آنذاك، سجّلت المنظمات الحقوقية انخراط آلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة في التدريبات، ثمانية آلاف منهم في بغداد لوحدها!

لم يكن تجنيد الأطفال قبل 2003 حدثاً منفصلاً، أو عملية عشوائية، بل كانت منظمة ضمن منهجية طويلة الأمد تبدأ من المدرسة وحتى مختلف صنوف التشكيلات العسكرية، رسمية وغير رسمية.
كان صدام مهووساً بإظهار العراقيين جميعاً كمقاتلين مستعدين للموت من أجل العراق أو من أجله، وكان مهتماً أيضاً باستدامة جميع تشكيلات وصنوف القوات المسؤولة عن حفظ أمنه ونظامه، والحفاظ على ولائها.
لم يكن الأمر محصوراً بالتشكيلات الخاصة والميليشيات فحسب، ففي تقرير صدر عن منظمة ” Child Soldiers International” عام 2001، وهي منظمة متخصصة بالحد من تجنيد الأطفال، فإن العراق قبل متطوعين للجيش النظامي من سن 15 سنة، رغم أن الدستور والقانون يمنعان ذلك.
وشخّص التقرير ذاته امتلاك أحزاب كردية معارضة مثل الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب العمال الكردستاني لمعسكرات كانت تدرّب أطفالاً لم يتجاوز بعضهم العاشرة على القتال ضد قوات الجيش النظامي.
اعتراف عالمي متأخر
حتّى وقت قريب، استخدم الأطفال في الحروب بشكل مباشر، كمقاتلين، وبشكل غير مباشرٍ، كسُعاةٍ وطهاة، وجواسيس، وتعرّضوا للعنف واستغلوا جنسياً، ورغم ذلك، فإن القانون الدولي لم يُجرِّم أي دولة أو مجموعة ترتكب هذا الفعل.
وحتّى مع إقرار “البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977”، لم يتم الاتفاق على تعريف للطفل على أنه كلّ من هو دون عمر الثامنة عشرة. بل نصّ البروتوكول في المادة 77 ثانياً على “عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة”، وإعطاء الأولوية في التجنيد لمن تجاوزوا الثامنة عشرة.
ولم يتم اعتبار تجنيد الأفراد -دون الثامنة عشرة- عملاً منافياً لحقوق الإنسان حتى عام 2000، حين تم إصدار البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي صادق عليه العراق، وانضم له رسمياً في تموز عام 2007.
رغم الغطاء القانوني الدولي، بقيت مشكلة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة قائمة، وغالباً ترتكبها قوات غير نظامية، وخاصّة عند اندلاع نزاعات مسلحة داخلية.
هذه ليست المشكلة الوحيدة، فتكييف القانون المحلي ودعمه للتشريعات الدولية حاجز آخر، فالعراق يحدد حسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 السن القانونية لقبول الضباط بعشرين سنة، والمتطوعين بثماني عشرة سنة. لكن المشكلة الحقيقية في عدم اعتبار اشراك الأطفال أو تدريبهم على السلاح جريمة.
من المسؤول؟
لم تمرّ على العراق بعد عام 2003 فترة سيئة بالنسبة للأطفال، مثل فترة الحرب مع التنظيمات الإرهابية بين أعوام 2014 و2016. قُتل الأطفال فيها تحت حصار داعش، ونتيجة للعمليات العسكرية، إضافة إلى إشراكهم في العمليات العسكرية.
بحسب تقارير أممية وحكومية، استخدم تنظيم داعش الأطفال بطرق بشعة، وذلك عبر تجنيدهم كانتحاريين، وحتى بدفعهم للقتال في مواجهات مباشرة مع القوات العسكرية.
كان لـ”داعش” كيان يختص ببناء الأطفال هو “أشبال الخلافة”، حيث يتلقّى هؤلاء التدريبات العسكرية والدروس الدينية والوعظيّة ليتشرّبوا أفكار التنظيم، والتضحية بالحياة. عماد هذا التنظيم كان أطفالاً تطوعوا أو أرغموا على الانضمام بعد أن قتل التنظيم أسرهم.
بالمقابل، وثقّت تقارير، حالات لأطفال تدربوا في أكثر من خمس محافظات عراقيّة في جنوبه ووسطه وشماله، ضمن فصائل مسلحة مدعومة حكومياً.
حسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن “الأطفال والنزاع المسلح في العراق” فإن جميع أطراف الصراع غير النظامية، متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.
وفي الكواليس السياسيّة والتشريعية لم يكن هذا الأمر بالغ الأهميّة، بل أن نائباً عدّ تسليح العشائر للأطفال على أنها “ظاهرة غير عدائية”، بل واعتبرها في بعض المناطق الساخنة ضرورة.
أطفال يبحثون عن الانتقام!
يعترف العراق عبر ممثليه الرسميين بجرائم تنظيم داعش ضد الطفولة، لكن الاعتراف وحده لا يحلّ المشكلة، ولا يعفيه أمام المجتمع الدولي والمنظمات واللجان الأممية المعنية من إخلاله بالتزامه بالاتفاقات والمواثيق الدولية.
تأريخ العراق في التقارير الدولية سيئ، إذ تشير هذه التقارير إلى تقصير الحكومة نفسها، في أحسن الأحوال، عبر ضعف إجراءات حماية الأطفال. وبينما تعترف بتجنيد داعش للأطفال، فإنها تنفي القيام بالأمر نفسه بالنسبة للفصائل المسلحة الشيعية والسنية والكردية التي قاتلت ضد التنظيم المتطرف.
ليس هذا، بحسب التقرير، إلا مؤشراً على حجم المشكلة وصعوبة حلها.
يوضع العراق على قائمة الدول المنتهكة للطفولة، ولإزالة اسمه، فعليه اتخاذ مسارات ثلاث، أول هذه المسارات هو إيقاف الانتهاكات فوراً، وهو ما أقرّه العراق بالفعل. المشكلة في المسارين الآخرين وهما: إعادة تأهيل وإدماج الأطفال الذين تعرضوا للانتهاك، وتقديم المنتهكين للعدالة. المساران يستلزمان إصلاحين اثنين، أحدهما أصعب من الآخر، فالأول يعني اعترافاً مجتمعياً ودينياً وقانونياً بأن تجنيد الأطفال خطأ حتى يتقبل ذوو الأطفال تأهيلهم، أو يتقبل الأطفال أنفسهم ذلك. والآخر وهو قدرة النظام العدلي على محاسبة مرتكبي الانتهاكات من المتنفذين وأصحاب السطوة.
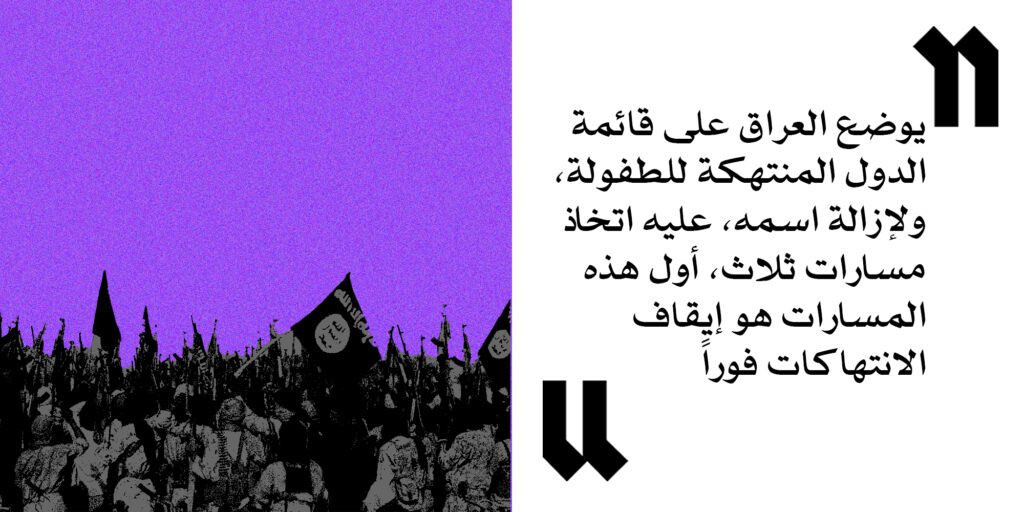
لكن لماذا، بالأساس، جُنّد الأطفال في الحرب على “داعش”؟
يغادر بعض الأطفال طفولتهم مُبكراً نتيجة للظروف الأمنيّة والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من خمسة عقود، ويدفع هذا الكثير منهم للذهاب إلى حمل السلاح. هكذا انخرط بعض القصِّر في الحرب على “داعش”، بعضهم كان دافعه انتقاميا، إذا ما قتل أحد أفراد عائلته. وللفصائل المسلحة دوافعُ أيضاً لاستخدام الأطفال، دينيةٌ، واجتماعية على مستوى العشيرة. فمن سيقاتل تنظيماً حتى أطفاله مقاتلون؟ وأحياناً دوافع التنظيمات سياسية تذهب لاستخدام الأطفال كمقاتلين خارج الحدود، مثلما جرى في الحرب السورية.
دائرة العنف المستدامة
في بحثهما “اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة بين الجنود الأطفال السابقين في العراق”، وجد الباحثان Jan Ilhan Kizilhan وMichael Noll-Hussong أن من بين 83 طفلاً مجنداً تمت معاينة أن 69 منهم مصابون باضطراب ما بعد الصدمة BTSD. ووجدت الدراسة أن غالبية الأطفال المجندين تعرضوا لأحداث صادمة مثل مشاهدة العنف، والأذى الجسدي، والخوف من الموت.
بالإضافة للآثار النفسية الفردية أو المحصورة بنطاق الأسرة، هناك آثار اجتماعية وثقافية على المدى البعيد تخّص مستقبل الأطفال. فهؤلاء الذين جُنِّدوا بأعمار قصيرة، كثير منهم إما في السجون بتهم تتعلق بالإرهاب، أو موصومون اجتماعياً بانتمائهم لجماعات منبوذة.
لكن الأمر لا يتوّقف هنا فحسب، إذ أن عمليات تجنيد الأطفال، جميعها، تتضمن تثقيفاً باتجاه الولاء للجماعة. يُعلّم الأطفال ويُلقنوا الولاء للفصيل لا الوطن، وتُغذى حميّتهم على الجماعة لا المجتمع.
لكن المُجنِّدين لن يعنيهم هذا.
فتحويل الجماعات الموالية للسلطة، الأطفالَ إلى جنود، يُديم دائرة العنف والصراع ويبقيها مستمرة بلا هوادة. وحتّى بزوال المُجنّدين، فإن المجنَّدين يغيّرون ولاءاتهم. مآل ميليشيات صدام بعد 2003، الذين تحوّل أفرادها بسرعة إلى المجاميع المُسلّحة الشيعية والسنيّة، أفضل مثال.
الحال هذه، نحن في دائرة عنف مستدامة نطاقها العشيرة وصراعاتها المسلحة، ونطاقها الأوسع نزاع الفصائل المسلحة مع الدولة على السلطة والهيمنة، وهذا كلّه يغذي عوامل استمرار الفوضى التي قد تمتد لعقود.